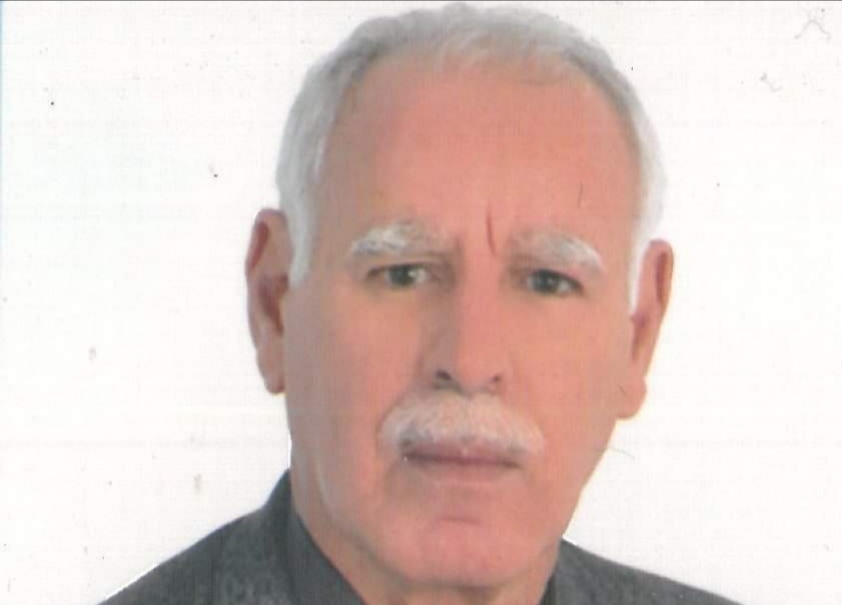الروائي السعودي آل زايد و د.هناء الصاحب (وجها لوجه)

لقاء أدبي خاص مع الروائي السعودي عبد العزيز آل زايد
صاحب رواية البردة ومهاجرون نحو الشرق

يقول الروائي آل زايد:
“الحياة مرّة، ونحتاج لقراءة الطرائف”
“الجوائز فقاعة فرحة يتناقص أثرها مع الأيام”
“يحتاج الكتاب أحيانًا لبضع سنين حتى يُقرأ”
“الرواية أحيانًا تكون علاجًا نفسيًّا”
“الكتّاب هم السبب الأساس في عزوف الناس عن القراءة“.
في سماء القاهرة أضاءت مؤخرًا روايات الروائي السعودي عبد العزيز آل زايد، والتي رفع عنها الستار، وشاهدها الجميع، يقول الروائي آل زايد بمناسبة صدور باكورة إنتاجاته: “تلقيت آلاف التباريك والتهاني والإعجابات على صدور رواياتي من كل دول العالم العربي، وهذا ما رفع معنوياتي لأقصى حد، ووضعني في مسؤولية ضخمة”، كما يقول في مناسبة أخرى: “المقياس ليس بكثرة الكلام، بل بالمعاني التي تحملها الكلمة الرصاصة“.
أحببنا في هذا الحوار طرح بعض التساؤلات للإستفادة من هذه التجربة الجديدة الطازجة، لعلنا نقدم ما فيه النفع والفائدة، ولنبدأ مع الأديب الروائي الكريم بعد الترحيب.
–أهلًا وسهلًا بك ضيفًا كريمًا..
س: بعد أن تكحلت عيوننا وعيون القراء بمشاهدة رواياتك الأربع في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 في ركن دار البشير، ماذا تقول كافتتاحية للحوار، بهذه المناسبة السعيدة وأنت ترى إنتاجاتك الأولى في أيدي القراء؟
ج: كما أنّ لصائم فرحتان، كذلك للكاتب فرحتان، فرحة عند إصدار كتابه، وفرحة عند لقاء ربه.
س: باكورة إنتاجاتك سلسلة روائية مهاجرون نحو الشرق، منهم أبطالها؟، وما أحب رواياتك لديك؟
ج: لكل رواية مذاق ونكهة، فوقت لاحتساء الشاي، ووقت لارتشاف القهوة، ووقت للإرتواء من الماء وقت العطش، وكذا كل رواية تنقل للقارئ عالمها الخاص بها، المهم أن يوفق الكاتب لانتخاب الكتاب الذي يناسبه، لهذا نفصل في الحديث عن محتوى الروايات حتى لا يخيب توقع القارئ، ولاختصار الحديث نقسم الأبطال إلى مستشرقين، ومقاومين، أما المستشرقون، فهم: الليدي استر استانهوب، والسير ريتشارد بيرتون، والمستشرق البريطاني جوزيف بيتس، والمستشرقة الألمانية أنّا ماري ميشل، والمستشرق ويليم مونتجومري وات، والمستشرقة كارن أرمسترنغ، أما المقاومون فهم: الأمير عبدالقادر الجزائري، والشيخ ماء العينين، والشيخ أحمد الهيبة، ولالة فاطمة نسومر. والقديسة جان دارك، وهناك شخصيات أخرى كالشاب الجزائري جلال الفارس، وسواه.
س: الملاحظ في رواياتك أنك تميل إلى سرد الروايات المركبة، فلماذا اخترت هذا المنحنى؟، وهل هي سمة دائمة في كتاباتك؟
ج: الحياة بطبيعتها مركبة، والفصول على أربعة أشكال، فلماذا يُشكل الله لنا الأيام؟، طبيعة القراء يملون من الغرق في بحر واحد، والتنويع يكسر الرتابة، كما أنّ المسارات المتنوعة تضيف ما لا يضيفه المسار الأحادي، وليس هذه صفة دائمة لرواياتنا، إلا أننا لا نقبل الرتابة التي تسبب الملل للقارئ، وأرى أن الكتّاب هم السبب الأساس في عزوف الناس عن القراءة، وعليه أدعو أصدقاءنا الكتّاب وأنا منهم أن نطور أدواتنا الكتابية لاستقطاب القراء لبلوغ الصفحة الأخيرة.
س: كسبت جائزة في الأدب، وبعد عام أصدرت مؤلفاتك الروائية، أي الفرحتين أكبر بالنسبة لك: حصد جائزة؟، أم إنتاج كتاب؟
ج: السؤال غير دقيق، فالجوائز على مراتب، والكتب على مستويات، لنصحح السؤال: إذا تساوت قيمة جائزة وقيمة كتاب، أي الخيارين ترجح؟، بالطبع أرجح الكتاب، الجوائز فقاعة فرحة يتناقص أثرها مع الأيام، بينما الكتاب تظل فائدته لكل الإجيال، ولهذا حتى إذا أغلقت الجوائز أبوابها، فإن دكان المؤلفين لن يتوقف، فالأساس هو الكتاب والجائزة ظل ينكمش تدريجيًا، ولا يعني أنه لا قيمة لها أو مرفوضة.
س: هل تعتقد أن باكورة إنتاجاتك نجحت أم لا؟
ج: من المبكر الإجابة عن هذا السؤال، فالقراء يحتاجون لمزيد من الوقت،
وهذا حقهم، فليس أمامهم كتاب واحد فقط، بل العديد من الكتب، وقد تسبق قراءة كتبنا العشرات من الكتب الجيدة التي تستحق القراءة، وربما لا يسعف الوقت الجميع للمطالعة في هذا العام، ومن خلال متابعة يحتاج الكتاب أحيانًا لبضع سنين حتى يقرأ، ومن الجيد الإشارة إلى صعوبة تحصيل الكتاب، لأسباب كثيرة، منها الحالة الاقتصادية، والأسعار التي ليست في متناول الجميع، رغم وجود خصومات تصل إلى ٤٠٪و٥٠٪وربما أكثر، وهي فرصة ذهبية لا تتاح دائمًا إلا في مناسبات خاصة، ثم أنّ للناس ميولات وتوجهات، فهناك من لا تستهويه الكتب الروائية، وعليه لا يحكم على الرواية إلا من قرأها وأدرك حجم الجهد الذي بذل فيها.
س: ألا ترى أن الروايات من الكتب المترفة التي تقرأ للتسلية؟
ج: كلنا نحتاج للتسلية، فالحياة مرّة، ونحتاج لقراءة الطرائف، فالتسالي ليست من الكماليات كما يتوقع البعض، وقد ورد: “أن النفوس تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكم”، فالرواية أحيانًا تكون علاجًا نفسيًّا، ومن الغريب أن أحد أصدقائنا انتقدني على تأليف الروايات، فلما عدلت للكتابة في مجالات أخرى، وثب لقراءة الروايات المطولة، ثم تعجبت أنه بدأ مشروعه الروائي، ليس دائمًا الرواية كتاب مترف، البعض يقرأ روايات معطوبة أو تجربة أولية فيحكم على جميع الروايات بالنموذج المجتزأ، وهذا اجحاف، الترويح عن النفس ساعة بعد ساعة، أمر مطلوب، فأنا شخصيًّا إذا تعبت من قراءة كتاب رصين، انتقلت لكتاب آخر، على هيئة المفرحات، ثم أنّ هناك من الروايات ما يفوق العديد من الكتب إن أنصفح الحكم.
س: لماذا تقلصت كتاباتكم في الصحف وقلت مشاركاتكم المقالية في الآونة الأخيرة؟
ج: لم تتقلص بل تظافرت، إنما اختلف التصنيف، فتارة تنشر لنا حوارات متعددة، وتارة تخرج عنا تغطيات أدبية، وأخرى أخبار عن آخر انتاجاتنا، وهذا يدعم الثقافة ويروج لاقتناء الكتب، وهو امتياز لا نقدح عليه، وبلاشك أن كتابة المقال أسهل من انتاج كتاب، واتجاهنا نحو التأليف مرهق، ويحتاج لجهد ووقت وصبر.
س: ألا ترى تقصيرًا من قبلكم أنتم الكتّاب في الكتابة لفئة الأطفال؟
ج: الكتابة للأطفال صعبة، وليس كل واحد يجيدها، ولهذا نحتاج أن ندعم هذا الأدب، وندعم الكتّاب لهذا الصنف، ورغم أني واحد من كتّاب أدب الطفل، إلا أني أعترف بهذا التقصير، وكلنا نتحمل قسط من هذا العتب، ولا أتوقع أنّ إنشغالي بالتأليف في مجالات أخرى، يعفيني من هذا الإنسحاب، وهو حق اعتذر للأصدقاء الصغار، لعدم ملئه بما هو حق لهم، ونأمل أن نوفق لسد هذه الثغرة.
س: ذكرت أنك واحد من كتّاب أدب الطفل، حدثنا عن مشاريعك الكتابية المخصصة للأطفال؟
ج: في بدايتي المهنية كنت أدرس المرحلة الإبتدائية ثم الإعدادية، فلما كنت أحكي للطلاب بعض الحكايا، أدرك أنشدادهم، وهذا ما دفعني للكتابة في هذا الاتجاه، وقد وفقت لكتابة بعض الأعمال للأطفال، آخرها مجموعة قصصية كاملة قدمت لجائزة عبد الحميد شومان تستهدف الفئة العمريّة من 10-14 سنة، كما أنه لدينا رغبة في كتابة الكتب التربوية للتعامل مع الصغار، وهذا ما لم يفسحه لنا الوقت حتى اللحظة، أظن أن لنا تجربة جيدة في التعامل مع الصغار، ونظن أنّ القارئ سيستفيد منها، من باب التثاقف التربوي وتبادل الخبرات.