ثقافة الناقد والنص الشعري
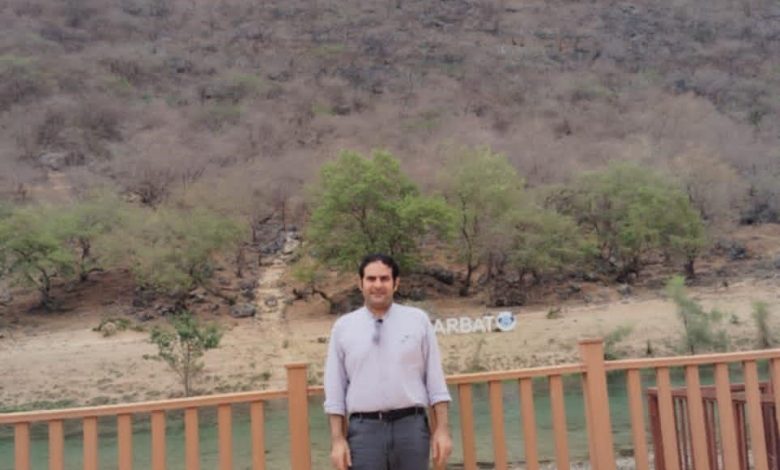
بقلم : د.محمد عبدالعظيم حبيب
يجب أن يتمتع الناقد بحدس عال؛ ليتعامل مع الحدس الإبداعي للمبدع، إضافة إلى الذكاء الاجتماعي الذى يساعد الناقد على رؤية اجتماعية أكثر وضوحا.
والناقد الواعي يجب أن يكون واسع الدربة والمران، دارسا لعلوم مختلفة كعلم الجمال، وفلسفة الجمال، وعلم الاجتماع، وعلم النفس ، وعلم الجريمة والانحراف ،والتاريخ ،والجغرافيا ،والأنثربولوجى، هذا بالإضافة إلى علوم اللغة والنقد كعلم البلاغة، وعلم اللغة وبخاصة النظريات المعاصرة فيه، ومناهج النقد الأدبى القديمة والحديثة، هذا بالإضافة إلى ضرورة اطلاعه على الآداب العالمية التي ستعلى البنية الثقافية لديه .
فالناقد الأدبى يجب أن يتمتع بالموسوعية من خلال التزود بتلك العلوم البينية التي تجعله ملما بقضايا المجتمع ومشكلاته المختلفة ؛ مما يؤدى إلى زيادة حصيلته النقدية، وبذلك تكون آراؤه أقرب إلى الصواب.
تتجلى ثقافة الناقد في معرفته لعلم الجريمة والانحراف، فالشعراء الصعاليك في العصر الجاهلى انحرفوا عن المجتمع، ورفعوا راية العصيان ،والتمرد، والثورة على المجتمع الذى تنكر لهم ، ولم يوفر لهم الحماية الاجتماعية .
وحينما تبحث وراء ظاهرة الصعلكة تعرف أن الصعلوك هو ذلك الفقير الذى لا يجد المال ،والأهل، والعشيرة، يواجه مشكلات الحياة بمفرده دون نصير، هم أبناء الليل وقطاع الطرق. تجد غيابا واضحا لمفهوم العدالة الاجتماعية في مجتمعهم الجاهلىّ ، ومن هنا تولدت في نفوس الصعاليك ثورة ذات طبيعة اشتراكية بالمفهوم السياسى والاقتصادي المتعارف ـ كما أشار بعض النقاد ـ
هذه الثورة دفعت عروة بن الورد إلى مهاجمة الأغنياء ليوزع ما يغنمه منهم على الفقراء الذين كانوا يلتفون حوله، ويلوذون به، في سنىْ الجدب والجفاف.فالصعلكة عند عروة فكرة اشتراكية تشرك الفقراء في مال الأغنياء، وتجعل لهم فيها نصيبا، بل حقا يغتصبونه إن لم يؤد لهم، وتهدف إلى تحقيق لون من ألوان العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادى بين طبقتي المجتمع المتباعدتين: طبقة الأغنياء، وطبقة الفقراء، فالغزو والإغارة للسلب والنهب لم يعد عنده وسيلة وغاية، وإنما أصبح وسيلة غايتها تحقيق نزعته الإنسانية وفكرته الاشتراكية. فالصعاليك هم ضحية لمجتمع تنكر لهم، وأسقط عنهم حمايته، وجعلهم شذاذا خارجين عليه
وهذا الأمر دفع الصعاليك إلى الارتباط بأمهاتهم أكثر من آبائهم؛ لأنهم لم يجدوا الحماية في كنفهم ، ولم يضمنوا لهم الحياة الكريمة التي تقوى انتماءهم لهذا المجتمع. فهذا السليك بن السلكة يصرح بأن رأسه قد شاب مما تقاسيه خالاته من ضيم وهوان ومذلة يعجز لفقره عن إنقاذهن، وهو يذكر هذا في مجال دفاعه عن تصعلكه وفخره بهن مما يشعر بأن العصبية النسائية كانت من الأسباب الفعالة لهذا التصعلك.
فشعر الصعاليك عبر عن نفسيتهم المتمردة، فلا يكون الشاعر الصعلوك لسان عشيرته ؛ لأن ما بينه وبينهم قد انقطع ،ولايكون شعره صحيفة قبيلته، وإنما يصبح شعره صورة صادقة كل الصدق عن حياته فقط .
وأثر التضاد الجغرافى في تشكيل نفسية الصعاليك خاصة والعرب عامة، فهم لا يعرفون الاعتدال في الخير ولا في الشر، فهم دائما مبالغون في العداوة و مبالغون في المحبة، فهؤلاء العرب يعيشون في الجزيرة العربية التي عرفت الأغوار المنخفضة ذات الحرارة الشديدة ، والجبال ذات القمم الثلجية، وكان لهذا التضاد أثره في نفوس سكان الجزيرة العربية، فقد أوجد في شخصياتهم لونا من التضاد النفسى اصطبغت عناصره بما في البيئة الجغرافية من لونىْ المبالغة وعدم الاستقرار.كل ذلك أصبغ على العربى تضادا نفسيا ،واجتماعيا، وأخلاقيا.
وعند قراءة شعر ذي الرمة تلحظ أبعادا نفسية، واجتماعية، وأخلاقية، وتاريخية إضافةإلى المدخل الجمالي الذى ينفذ إلى مكمن الجمال في العمل الأدبى، فجوهر النقد البحث عن سر الجمال في العمل الأدبي.
فإذا نظرت إلى ذي الرمة في طور المراهقة تجد أنه كان مشغولا بالجسد ومفاتنه، حريصا على الوقوفعلى مواطن الإثارة الحسية منه، مشغولا بالحديث عن أولئك الجميلات، وهذا الأمر يداعب أخيلة المراهقين من الشباب عند بداية اشتعال الغريزة الجنسية.أما عن شغفه بالحب والصحراء فكأنما وجد فيهما المجال الرحب للتعبير عن هذا الازدواج في شخصيته العاطفية بين حب الحب، وحب الصحراء ، فالأطلال جزء لا يتجزأ من شخصية الشاعر العاطفية ،أما عن حبه لمية فهوحب المغلوب على أمره العاجز عن نسيان صاحبته ،الذىلم يعد قادرا على الخلاص من حبها .
وتتجلى ثقافة الناقد في إظهارالصراع النفسى بين المرقش الأكبر مع صاحبته أسماء وما يعانيه من قلق وعذاب وألم وهموم :
أغالبك القلب اللجوج صبابة
وشوقا إلى أسماء أم أنت غالبه
يهيم ولا يعيا بأسماء قلبه
كذاك الهوى إمراره وعواقبه
وأسماء هَمُّ النفس إن كنت عالما
وبادى أحاديث الفؤاد وغائبه
إذا ذكرتها النفس ظلت كأننى
يزعزعني قفقاف وِرْد وصالبُه
فهو محير النفس في حبها ،يعانى من ذلك الصراع الحاد العنيف الذي يعانى منه كل عاشق من المتيمين الجاهليين. لقد أصبحت أسماء كل شيء في حياته، إنها أمله الذي يرتجيه ونجوى فؤاده التي يعيش معها لقد غلبه حبها وانتصر عليه في ذلك الصراع المستعر بين عقله وقلبه.
ويمثل ديوان (سقط الزند) لأبى العلاء انعكاسا نفسيا لشخصية أبى العلاء المتشددة التي انتهت به إلى سجونه الثلاثة،لذا نظر إلى الحياة بتشاؤم كبير، ولذا انصرف عنها وزهد فيها وسرعان ما فرض على نفسه العزلة عن الناس في منزله وهو ينشد مثل قوله :
أرانى في الثلاثة من سجوني
فلا تسأل عن الخبر النّبيث
لفقدي ناظري ولزوم بيتي
وكون النفس في الجسم الخبيث
سجون ثلاثة أحاط بها أبو العلاء نفسه ،وأحاطت به.
ولزوميات أبى العلاء المعرى انعكاس لحياته المقيدة الثابتة، لذا التزم أبو العلاء في هذا الديوان ثلاث لوازم ثابتة فرضها على شعره وألزم نفسه بها مع أنها مما لا يجب التزامه في الشعر، وكأنه حبس نفسه في شعره ،ومن هنا جاءت تسميته لهذا الديوان: اللزوميات أو لزوم ما لا يلزم .
وشعر أبى العلاء يمثل انعكاسا لفلسفة مجتمعه التي تدور حول محورين: المجتمع الذى يعيش فيه ، والناس الذين يعيشون في هذا المجتمع .
وتجد أيضا التأملات النفسية في ديوان همس الجفون لميخائيل نعيمة الذي يشكل حياة نفسية تامة بكل ما تحمله الكلمة من معنى،وهى حياة نفس مطمئنة هادئة ورغبة في الوصول الصوفى إلى عالم السماء الروحي، وشعور عميق بوحدة الوجود فالله يتجلى في جميع صوره وأشكاله .
والنزعة الصوفية عند ميخائيل نعيمة خاصة وشعراء المهاجر عامة متأثرة بالتأثيرات المسيحية لا الإسلامية، وهذه النزعة جعلتهم يفكرون في الأديان، وانتهوا أن الأديان لله.
وتظهر هذه الفكرة جلية في قصيدة (من أنت يا نفسي) لميخائيل نعيمة، فهو يشعر أنه يتحد مع مظاهر الطبيعة اتحادا كليا كما فعل المتصوفة المسلمون لمشاهدة المرائي التي يعجز الآخرون عن رؤيتها، وهو اتحاد تتجلى فيه أضواء الذات الإلهية وتشع أنوار جمالها، يقول مختتما لقصيدته :
إيه نفسى أنت لحن
فىّ قد رن صداه
وقعتك يد فنا
ن خفىّ لا أراه
أنت ريح ونسيم
أنت موج أنت بحر
أنت برق أنت رعد
أنت ليل أنت فجر
أنت فيض من إله
فهو يرى أن الله والعالم شيء واحد وكل ما يراه من مظاهر خارجية وصور متعددة إنما يشهد به الحس الظاهر ، أما الحس الباطن فإنه يشهد بأن تلك ظواهر لحقيقة واحدة حقيقة لا تبلى ولا تفنى ،وهى حقيقة الذات الإلهية التي تفيض على الوجود، بل التي تتجلى فيه وفى صوره وأشكاله المختلفة .
وتتجلى ثقافة الناقد في معرفة طبائع الناس الاجتماعية، فظاهرة الحب العذرى ظاهرةظهرت في قبيلة عذرة كعدوى اجتماعية جعلت من هذا الحب بدعا بين شباب القبيلة يلعب فيه التقليد دورا كبيرا يدفع كل شاب إلى صاحبة له ليعرف بها كما عرف غيره من شبابها بصاحباتهم، ثم تتدخل الظروف الاجتماعية لتطبع هذا الحب بالطابع العذرىالمعروف ،فالمسألة ظاهرة اجتماعية انتشرت كما تنتشر سائر الظواهر على أساس العدوى والتقليد ـ كما قال بعض النقاد ـ .
وثقافة الناقد ومعرفته باللغة والتراث العربى هي التي دفعت النقاد إلى الدفاع عن ذى الرمة الذى اتهم بالسرقة لكثرة العناصر القديمة في شعره ،ورأوا أن ذا الرمة كان شديد الصلة بالشعر القديم ، واسع الاطلاع عليه، عميق الإحساس به، وأن صلته به أمدته بثروة فنية ضخمة احتفظ بها في ذاكرته ، وراح ينفق منها كلما أراد في كثير من السخاء و الإسراف، ومن هنا كان طبيعيا أن تكثر العناصر القديمة وتنتشر في شعره .
ودافعوا عن المتنبى الذى اتهمه الصاحب بن عباد بالتفاصح واستخدام الألفاظ النافرة الشاذة . اعتبر النقاد هذا الأمر فصاحة فطرية، وليست ألفاظ نافرة أو كلمات شاذة ، والشاعر له مطلق الحرية في التصرف في اللغة ، فهو صاحب اللغة .
ووقفوا مدافعين عن رؤبة بن العجاج ابن البادية صاحب اللغة الذى يختار اللفظ النادر أو الشاذ ،والذى جاء به من أعماق البادية العربية ثم يشق صيغا جديدة لا عهد للناس بها من قبل ،وهى صيغ وألفاظ كان اللغويون في عصره يقفون أمامها عاجزين عن فهمها ساعده على ذلك حسه اللغوى الدقيق وسليقته البدوية الموزونة .
وتتجلى ثقافة الناقد في اكتشاف ذوق المتلقى، وهذا الذوق الذى كان له الأثر الكبير في بلاط سيف الدولة الحمدانى الذى كان يجالسه كبار الفلاسفة، واللغويين، والفقهاء، فخف الصوت الانفعالى في شعر المتنبى، وعلا قليلا صوت العقل، وأخذ العنصر العقلى يفرض نفسه ، فظهرت الأفكار الفلسفية ، وظهرت الأقيسة المنطقية، وظهرت القدرة على التعليل العقلى الدقيق ، وظهرت الحكم الناضجة التي استمدها المتنبى من ثقافته الفلسفية ، وأيضا مكن لتجربته الواسعة في الحياة، وظهرت أيضا صور التعقيد المعنوىواللفظى، وجنوحه إلى اللغات الشاذة التي كان يؤكد بداوته بها . فهو يحاول أن يثبت تفوقه عليهم من خلال استخدامه للهجات القبائل العربية التي يعرفها جيدا.
ثقافة بعض النقاد دفعتهم إلى إيجاد معنى باطنى غير المعنى الظاهرى لفن المديح ، فخرجوا بفكرة جديدة ،وهى أن المديح فن تمجيد لزعامتنا وبطولاتنا على مر التاريخ ، مما يحيله وثائق تاريخية ذات شأن عظيم .
ومن هنا نجد دفاعهم عن شعراء المديح، فشاعر المديح يقول لممدوحه ما ينبغي عليه أن يفعله، فهو يريد الصورة المثالية في الممدوح، فحينما يمدح الشاعر الممدوح بالكرم مثلا رغم عدم وجود الصفة فيه، فهذا ليس نفاقا أو تزلفا، فهو يقول ما ينبغي أن يكون عليه .
فهذا جرير قد مدح الحجاج بن يوسف الذي شوهه الرواة العباسيون ـ في رأيي ـ وطبعا كانت فيه قسوة ولكنها كانت قسوة ضرورية في زمن الفتن والقلاقل، وإن من يقرأ وصف جرير له يعرف أنه كان يتبع سياسة حازمة رشيدة . يقول جرير:
من سَدَّ مطلعَ النفاقِ عليكمُ
أم مَنْ يَصُولُ كصَوْلَةِ الحجاجِ
إنَّ ابن يوسفَ فاعلموا وتيَّقنوا
ماضى البصيرة واضحُ المِنْهاجِ
ماضٍ على الغَمَرات يُمْضِى هَمَّهُ
والليلُ مُخْتلفُ الطرائقِ داجى
مَنَعَ الرُّشا وأراكمُ سبُلَ الهُدَى
واللص نكَّلَه عن الإدْلاجِ
ولقد كَسَرْتَ سِنَانَ كلِّ منافقٍ
ولقد مَنَعْتَ حقائبَ الحُجَّاجِ
فهو يصفه بالشجاعة ونفاذ البصيرة ووضوح المنهج واختراق عزيمته للشدائد وانطلاقه في الأمور. ويعطف على سياسته؛ فيبين رشدها وما أفاءت على الناس من منافع، فقد منع الرشوة وأمَّن الطرق من اللصوص، وأصبح الحجاج لا يخافون على حقائبهم نهبا ولا سلبا.
فجرير أراد أن تكون تلك الصفات في ممدوحه على الرغم من أن الحجاج لم يكن يتمتع بتلك الصفات مجتمعه، ولكنه أراد له الصورة المثالية التى يجب أن يكون عليها صاحب القرار.
والهجاء ليس فى ظاهره إحصاء لعيوب المهجوّ، ولكنه فى حقيقته إحصاء لعيوب المجتمع ومثالبه، فالشعراء حاولواأن يطهروا المجتمع من نقائصها ويستنقذوه من براثنها.ففى ظاهر الأمر هجاء،وفى حقيقته إصلاح وتهذيب وتقويم لكل ميل أو فساد فىالمجتمع.
دخلت الخصال الإسلامية الجديدة فى فن الهجاء، فكأنما أراد الشاعر للمهجو في حقه أن يعدل من نفسه؛ ليتصف بتلك الخصال التى أرادها الأسلام .
أما عن فن الرثاء ففي ظاهره عزاء وتأبين وندب، وفى حقيقته نظرة تحليلية لحقيقة الحياة وحقيقة الموت ومن أين نأتى ؟ وإلى أين نذهب؟ وما الفرح؟ وما الحزن؟ وما علاقتنا بالوجود؟ففى الظاهر رثاء وفى الحقيقة تفكير فلسفى خليق بالبحث والدرس .
وقد تطور الرثاء فى العصر العباسى من هذا المنطلق حين دخل على معانيه مراثي اليونان، ورؤية الأمم للحياة والموت، ومن هنا تعمق الشاعر العباسي في تحليل آلام الموت على نفسه والإنسانية ومن أروع مراثيه بكاؤه لمصارع الأبطال والقواد فى الحروب إذ مجد فيهم بطولاتهم ونضالهم حتى الموت دفاعا عن العرين .
فهذا أبو تمام قد رثى محمد بن حميد الطوسي الذىقتل فى ساحة الحرب ـ بمرثية رائعة بين فيها محمود سيرته الحسنة. يقول أبو تمام :
توفيت الآمالُ بعد محمدٍ
وأصبح فى شُغلٍ عن السَّفَر السَّفْر
فتى كلما فاضت عيون قبيلةٍ
دَماً ضحكت عنه الأحاديث والذِّكرُ
فالرثاء من هذا المنطلق ليس نواحا بل ثناء خالصا، فالشاعر معبر عن حزن الجماعة، وما فقدته في هذا الفرد. والغزل عنده يتضمن معانىالحب ،والهيام ، والشوق ظاهريا ، وفى حقيقته يتضمن بواعث ومؤثرات اقتصادية واجتماعية وثقافية .فالعزل العذرى ظهر نتيجة حزن أصحابه على من فارقوهم ، ولم يظهر نتيجة مثالية الإسلام مع عدم إنكار تأثير هذه المثالية على هذا النوع من الشعر.
أما الغزل الصريح فقد كان يقصد به إفساد الشباب العربى،ولم يقصد به التعبير الصارخ عن الغرائز الجنسية ـ كما اعتقد بعض النقاد ـ .
وفن الخمريات فى ظاهره مجون وخمر، وفى حقيقته محركات وبواعث جنسية واجتماعية وسياسية ومذهبية .
فهذا أبو نواس قد غرق فى حضارة عصره المادية وفى آثامها وخطاياها، تدفعه إلى ذلك أزمته النفسية العنيفة إزاء سيرة أمه المنحرفة وكأنما اتخذ من المجون والفسق أداة، بل ملجأ للهروب من أزمته ومن هموم الحياة وأحزانها .
وفن الزهد فى ظاهره دعوة إلى التقوى والعمل الصالح هروبا من الحياة ، وفى حقيقته دعوة إلى التقوى والعمل الصالح حبا للحياة، فالزهاد الحقيقيون يكسبون قوتهم لأنفسهم ويعيشون من كسبهم لا من كسب غيرهم مما يلقى إليهم من الفتات، وكانوا دائما يلبون داعى الوطن حين يدعوهم لكفاح الأعداء بل كانوا يتقدمون الصفوف محمسين محرضين على الاستشهاد فى سبيل الله مؤمنين بأن جهاد العدو هو الزهد الأكبر .
فهذا عبدالله بن المبارك الزاهد المعروف يجاهد فى سبيل الله مع الجيوش الغازية إلى بلاد الروم بالسيف أو بتحريض المجاهدين للجهاد. وكان صديقه الفضيل بن عياض يتنسك لله فى البيت الحرام بمكة ، فأرسل له الفضيل برسالة يحثه فيها على أن يصنع صنيعه من المجاورة بمكة ولو إلى فترة قصيرة، فرد عليه برسالة شعرية يبين له فيها أن الجهاد فوق النسك درجات، وأنه حرى به أن يترك مكة ومناسكها إلى النسك الحقيقى: نسك الجهاد فى سبيل الله وسبيل إعلاء كلمته ، وله يقول :
يا عابدَ الحرميْن لو أبْصرَتنا
لعلمتَ أنك فى العبادة تلعب
من كان يخطبُ جيدَه بدموعه
فَنُحُورُنا بدمائنا تتخضَّبُ
فالزهد الحقيقى عند عبدالله بن المبارك فى جهاد العدو حفاظا على الأرض ؛ ولذا عدها أفضل من النسك ببيت الله الحرام بمكة.
في النهاية أقول:إن الأدب لجأت إليه الجماعة الإنسانية؛ ليكون معبرا عنها، وعن عالمها النفسي الواسع ،وكل ما يجرى فوق محيطه، وفى داخله من أهواء ورغبات ونزعات ودوافع. والناقد هو الشخص الوحيد القادر على فهم مراد المبدع بما يمتلكه من علوم بينية تساعده على فهم النص وإدراك كل مايدور حوله من رؤىوتوجهات.





