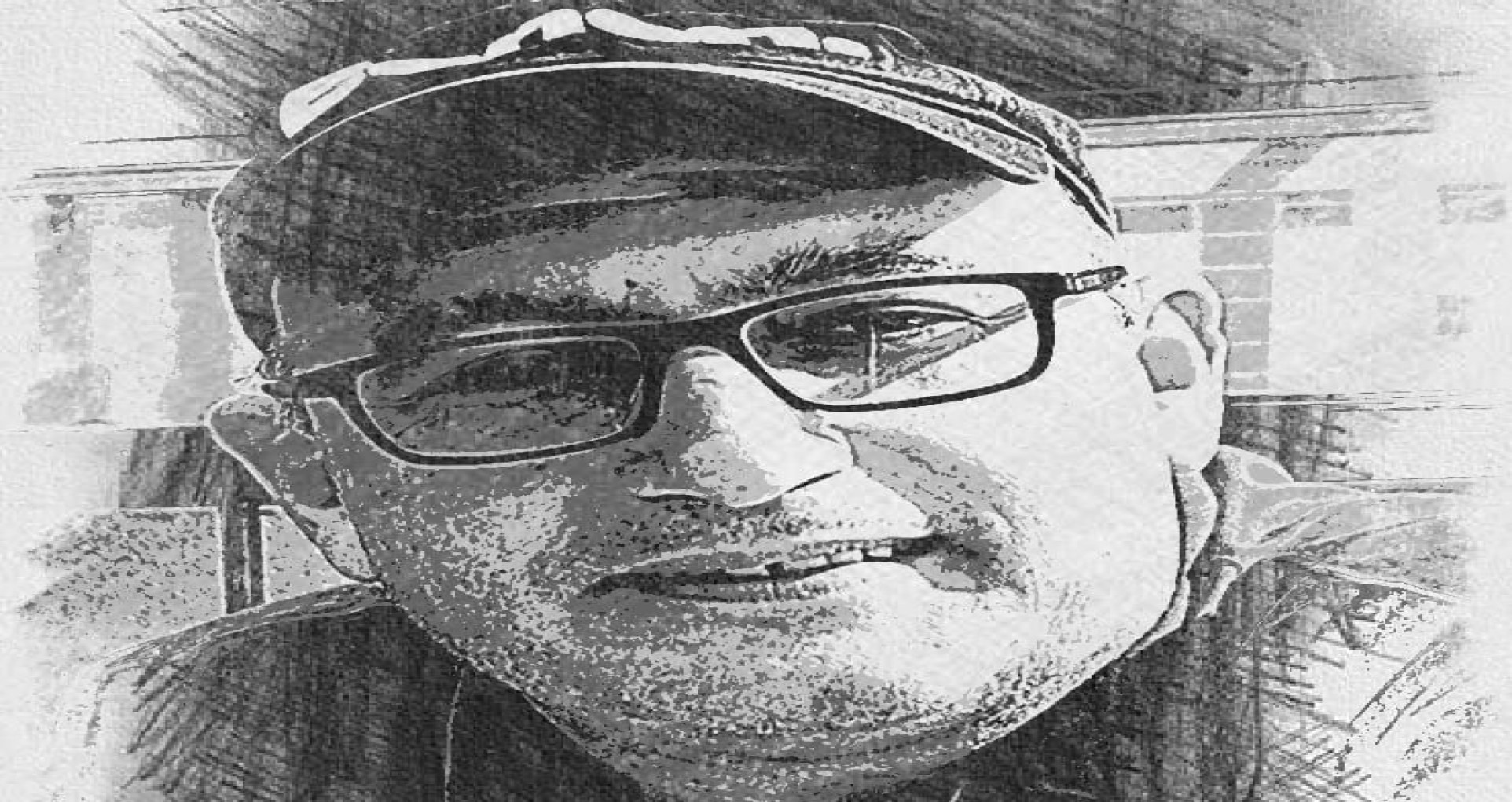سليمان التمياط| السعودية
ملخص:
لا يتقصّد هذا النص الدفاع عن الخير أو تسويغ الشر، بل يتأمل المسافة بينهما حين لا تكون فاصلة، بل خصبة.
يطرح المقال إمكانية أن يكون الخير والشر ليسا متقابلين كما اعتدنا، بل متداخلين في التجربة الإنسانية حدّ الالتباس.
في غياب مطلقات واضحة، يقف الإنسان لا ليحكم، بل ليتأمل، في حقل أخلاقي لا ينضبط بلغة التصنيف، بل يرتجف في مساحةٍ تُختبر فيها النوايا، ويتهدّل فيها الميزان.
المتن:
منذ لحظة الوعي الأولى، لم يظهر الكائن البشري إلا ككُتلة قابلة للانقسام.
الخير والشر، لم يكونا قِيَمًا مضافة إلى التجربة، بل نواتين متوازيتين في أصل البنية.
لم تكن المسألة في امتلاك الإنسان لأحدهما، بل في استحالة فصله عنهما.
الشر لم يكن دخيلًا، ولا الخير استثناءً… بل كلاهما جزء من تركيب لا يعرف ذاته إلا بالتضاد المؤقّت.
ليس الحديث عن الأبيض والأسود،بل عن ضبابيةٍ واضحة…تُربك اليقين دون أن تُلغي الإدراك،
فيها تتشابك النوايا، وتتداخل الدوافع، وتتلوّن الأفعال.
كل محاولة لتعيين الخير والشر تصطدم بحقيقة واحدة:
أن المفهومين لا يتقابلان كضدّين، بل يتداخلان كاحتمالين متكرّسين في التجربة.
الخير لا يُقاس بما يُفعَل، بل بما يُقصَد… والنية، بطبيعتها، لا تخلو من التواء.
والشر لا يُعرَّف بما يُدان، بل بما يتجاوز قدرة اللغة على التبرير.
قد يبدو السلوك خيّرًا، لكنه ناتج عن رغبة بالتفوّق الأخلاقي.
وقد يبدو الفعل شريرًا، لكنه نابع من صدمةٍ نقيّة.
ثمّة تلوّن مستمرّ في لبّ الفعل…
حيث لا تعود الأحكام أدوات للتمييز، بل مرايا مشروخة تعكس هشاشة المُصنّف أكثر من حقيقة الفعل ذاته.
ما يُسمّى بالخير، لا يُولد دائمًا من التعاطف.
أحيانًا يُولد من الخوف… من الذنب… من العجز عن المواجهة.
وما يُسمّى بالشر، لا ينشأ بالضرورة من الحقد، بل من الانفصال، من الفقد، من محاولة استعادة التوازن على حساب الآخر.
النية ليست صافية،
والفعل ليس خالصًا،
والأثر لا يتطابق مع المصدر.
وهذا لا يُنكر الخير، ولا يبرّئ الشر، بل يُعلّقهما داخل شرط الوعي،
ويحوّلهما من مساحتين أخلاقيتين إلى حقلٍ معرفيّ مضطرب،
يُختبر فيه الإنسان لا من حيث ما يفعله، بل من حيث قدرته على تفكيك دوافعه، دون استعانة بمرآة الآخرين.
كلما اقتربنا من المفهومين، تداخلت حدودهما.
كل محاولة لتحديد “هذا خير” و”ذاك شر”، تنتهي بمفارقة واحدة:
أننا لا نملك الأدوات الكافية للحكم، لأننا جزء من النظام الذي نحاول تحليله.
نحن لسنا خارجه، بل مادة من مواده.
ولذلك، كل تعريف للخير أو الشر لا بد أن يكون تعريفًا ارتجاليًا… مؤقتًا… مشكوكًا فيه.
ليس لأن الحقيقة غائبة، بل لأن وعينا مشروط بلغة تحاول أن تُمسك بما يتفلّت منها.
وكلما حاولنا التثبيت، ازداد المفهومان اهتزازًا.
الخير يلمع بما يكفي ليُضلّل.
والشر يخفت بما يكفي ليُمرَّر.
لستُ هنا لأُحسِّن صورة الشر، ولا لأُشوّه ملامح الخير.
لا أُحاكم المفهومين، ولا أُبرئ أحدهما على حساب الآخر.
إنني فقط أقف في الحيّز الذي غالبًا ما يُغفَل:
الحيّز الذي يُفلت من الثنائيات،
حيث لا يُقاس المعنى بما وُصف، بل بما يُعاش.
لستُ في ساحة محاكمة،
بل في مختبرٍ داخليّ،
أُعيد فيه طرح الأسئلة التي تمّ إسكاتها تحت ضغط اللغة، والخوف، والتبسيط.
ربما لا نُحسن لأننا نعرف الخير،
بل نُحسن لأننا نكره مواجهة قدرتنا على أن نكون غير ذلك.
وربما لا نُخطئ لأننا أشرار،
بل لأننا لم نُدرّب أنفسنا على مقاومة العبور إلى ضفّة أخرى… دون أن نشعر.
الشر ليس دائمًا ما نفعله للآخر،
بل أحيانًا ما نغضّ الطرف عنه في دواخلنا.
والخير ليس دائمًا ما نمنحه،
بل ما نمنعه في اللحظة التي توشك على افتراس قدرتنا على التماسك.
ليس هناك ميزان.
ليس هناك نقاء.
فقط هذا الاهتزاز المستمرّ في الكائن،
حين يقترب من المعنى،
ثم يُدرك أن المعنى لا يُعرّف، بل يُعاش.
لا في المطلق، بل في صراع اللحظة.
لا في النوايا وحدها، ولا في الأفعال وحدها،
بل في الفراغ الذي يفصل بينهما، والذي لا يُرى، لكنه دائمًا حاضر…
كدليل على أننا نحاول.
فلا تُقاس الأخلاق بخرائط المسميات،
بل بالارتجاف الداخلي حين نقف بين خيارين لا يَظهر أيٌّ منهما كليّ النقاء.
وحينها، لا تعود المسألة عن الخير أو الشر،
بل عن الإنسان…
حين يحاول أن يكون حيًّا بما يكفي…
ليعترف: أنه لا يعرف.
لكنّه مع ذلك، لا يتوقّف عن المحاولة.