ابتساماتٌ ودموع!

صبري الموجي – مصر
دقتْ ساعةُ التنبيه، فاستيقظتُ من نومي نشيطا فرحا، يكادُ قلبي المُفعم بالسعادة يقفزُ من صدري.
فقد قررتُ أنا و صديقاي أن نخرج في رحلة إلي مدينة بنها، بعدما قضينا اليوم الأول من العيد في زيارة الأهل والأقارب؛ لنستمتعَ بالمشي علي الكورنيش تحت ظلال أشجار البونسيانا بزهرها الأحمر القاني، وأشجار الجميز التي رسم عليها الزمنُ آثار الشيخوخة، كما يفعل بعجوز طاعن في السن، فترهلت جذوعها، وتشعبت أغصانُها، التي وقفت عليها طيورٌ مُختلفة الأشكال والأحجام تصدح وتشدو.
وفي سعادة أخذنا ندور كطواحين الهواء حول أشجار الكافور، التي وقفت مُستقيمة شامخة تتحدي عمارات المدينة وأبنيتها الخرسانية؛ لتؤكد أن صنع الله أحسن من صنع البشر، ونشتري قراطيس (الترمس) وحَب العزيز، والجيلاتي المُثلج، الذي يُخفف علينا حرارة الجو، إذ كنا في مُنتصف أغسطس، ذي الشمس المتوهجة والصيف القائظ، وشرعنا نتباري في الجري بين صفين من المتفرجين لنري أينا أسرع، ولم ننسَ أن نستأجر (فلوكة) تمخر بنا فوق صفحة الرياح التوفيقي، ونحن نرقص ونُغني لنستريح يوما من وِرد (سيدنا) في الكُتاب، وتلطيخ أيدينا بالحبر الأسود أثناء كتابة الواجب بـ(الألواح)، وعند الشعور بالجوع أخذنا نزدرد أطباقا من الكشري المملوءة بزيت الفلفل الحريف، فتضطرم بأفواهنا نارٌ لا تطفئها إلا أقداحُ الماء البارد، وعصير القصب المُثلج، بعدها هرعنا لسينما (حرفوش) لمشاهدة أحدث أفلام (الأكشن) كما أخبرني صديقاي في حفلة من 3 : 6.
كنتُ دون العاشرة، أما صديقي (ط) فكان قد تجاوز الخامسة عشرة من عمره وكان (ن) علي مشارف الرابعة عشرة، وقد ظهر فوق شفتيهما خطان أسودان يُعلنان أنهما قد تجاوزا مرحلة الطفولة، وصارا علي أعتاب الشباب والمراهقة، وما تحمله تلك المرحلة من تغيرات فسيولوجية وجسمية، وشغف بالحديث مع الجنس الآخر، ومشاهدة أفلام الإثارة والرومانسية.
ولأنني وحيدُ والديَّ فقد تربيت علي الحشمة والوقار، فكان الموتُ عندي أهون من أن أُكلم فتاة، أو أن تمتدَ إليها عيني خلسة، خشية الحبس في (حجرة الفئران)، والحرمان من الخروج من البيت واللعب مع الأصدقاء؛ لهذا أخفي عليّ صديقاي أن دار العرض ستعرض فيلم (المُغتصبون) وهو أكثر الأفلام إثارة ورومانسية آنذاك؛ لكيلا أُحجم عن الذهاب معهما، وتفسد عليهما الرحلة، التي كنتُ سأزينها بروحي المرحة ونكاتي الظريفة، خاصة أنني كنتُ أتحلي – رغم التضييق عليّ – بالخفة والمرح.
وسريعا أخذتُ ما تبقي من (عيدية) الأمس، ولبست بيجامة من (الكستور) المٌقلم طوليا، أكسبتني طولا أخفي صغرَ سني، وضآلة جسمي، كان قد اشتراها لي والدي من شركة بيع المصنوعات لألبسها يوم العيد وأتباهي بها أمام أصحابي، الذين يلبسون (جلاليب)، فأبدو أكثرَ منهم مدنية وتفرنجا.
خرجتُ مُسرعا من باب البيت لا تكاد تُلامس رجلي الأرض من شدة فرحي، أقفزُ وأغني، كعصفور نسي صاحبُه باب قفصه مُفتوحا، فأسرع يضربٌ الهواء بجناحيه الصغيرين عازما علي ألا يعود للحبس مرة ثانية، ولا أبالغُ إن قلتُ إنني كنتُ أشبه بريشه تُطيرها الرياح.
وقفتُ تحت شُرفتي صديقي (ط ، ن) أستعجلهما لنلحق اليوم من أوله، ولا تضيع منا لحظةٌ دون لعبٍ ومرح، يحدوني الشوق إلي قاعة العرض السينمائي لمُشاهدة فيلم الموسم؛ لأري كيف ينتصرُ البطل علي خصمه، ويكيلُ له اللكمات، ويُوسعه ضربا وتكسيرا؛ وأتعلمَ حركاتٍ قتالية جديدة، تُمكنني من الانتصار علي خصومي بمباريات النزال، التي تنعقدُ لها حلباتُ المصارعة بين أبطال ناحيتنا، والناحية المجاورة، ويُحمَل بعدها البطلُ علي الأعناق باعتباره فتوة الناحية، ويصير الآمر الناهي بين الصبيان، تماما كما كان عاشور الناجي فتوة الحرافيش.
وصلنا إلي الكورنيش بمنطقة (الفلل) بمدينة بنها ذات العمارات الأنيقة، والبلكونات الواسعة التي وقف أصحابها – كما لو كانوا بصالة عرض سينمائي يشاهدون منظر الرياح والقوارب، ولعب الناس ومرحهم، وفي حالة من النشوة والفرح أمسكنا درابزين الكورنيش، وأخذنا نتأمل صفحة الرياح بمائه الفضي الساحر، لتمتلئ صدورنا بالهواء النقي، ونحن نتناول الترمس، والسوداني، واللب، فأغرانا منظر المراكب الشراعية التي استأجرنا إحداها لتجوب بنا صفحة الرياح مع بعض المتنزهين الذين أخذوا يتراقصون ويلعبون ويُغنون أغاني العيد، ويُطيرون بالونات مختلفة الألوان والأحجام، جعلت السماء – في عز الظهر – كأنها مُزينةٌ بزينةٍ الكواكب.
وبعد دقائق من المرح فوق صفحة الرياح، عادت بنا المركب إلي الشاطئ، لنُسرع إلي حجز تذاكر السينما لمشاهدة الفيلم من أوله.
كانت هذه هي المرة الأولي التي أدخل فيها دار عرض سينمائي، فأدهشني صمتُ الحضور، واتساع القاعة التي تراصت مقاعدُها، وتدرجت فكانت أعلي من الخلف، وتنخفض كلما توجهنا ناحية الأمام، خيَّم عليها صمتٌ مُطبق، عزلنا عن العالم بصخبه وضجيجه.
انطفأت أضواء القاعة، فشعرتُ برهبة وخوف صرفه ضوء الشاشة الكبيرة القادم من بعيد ليأخذ بأيدينا إلي عالم النشوة والمرح، والتي جلس الحضور أمامها، كأن علي رؤوسهم الطير.
بدأت أحداثُ القصة وكان الفيلم بعنوان : (المغتصبون)، والذي خرجت فيه البطلة مع خطيبها للتنزه بمنطقة المقطم، فرآها مجموعةٌ من الشباب غيَّب تعاطي المخدرات عقولهم، فعزموا علي الاعتداء عليها باعتبارها فريسة سهلة، تروي ظمأ شهوتهم الجامحة، ونفوسهم الآثمة، التي لم تقل عنها أبدا نفسا صديقي اللذين خدعاني، ثم انبري الممثلون يُفقدون الفتاة أعز ما تملك وسط صرخات استغاثتها، التي كانت طعناتٍ في قلبي.
كانت البطلةُ كلما خلا بها ذئب تتعالي صرخاتها وتنسكب دموعها، فتنسكب لها دموع عيني إشفاقا وتأثرا، وتهيج مشاعري فأتألم، وتُحدثني نفسي بأن أتخطي المشاهدين، وأخلصها من براثن تلك الذئاب البشرية، ثم سرعان ما أتذكر أنها شاشة صماء، فأجلس مُكتفيا بمشاركتها أحزانها بدموع عيني، بينما كان الحضورُ يعضون علي أناملهم استمتاعا بمشاهد الإثارة.
وفي خضم ذلك الصراخ والدموع التي نزلت مني ومن البطلة، كان يحدوني الأمل بأن ينهض خطيبُها بعد أن يشرب من – ماء النيل وهو راقد – فتسري فيه قوةُ خارقة، يثأر بها لشرف خطيبته المهراق، إذا بي أفاجأ بانطفاء شاشة العرض وامتلاء القاعة بالضوء إيذانا بانتهاء الفيلم، وألتفت فأري صديقيّ ضاحكين، بينما كنتُ أنا أزرف الدمع من عينيّ مدرارا؛ حزنا علي البطلة أولا وعلي الخديعة التي تعرضتُ لها ثانيا.



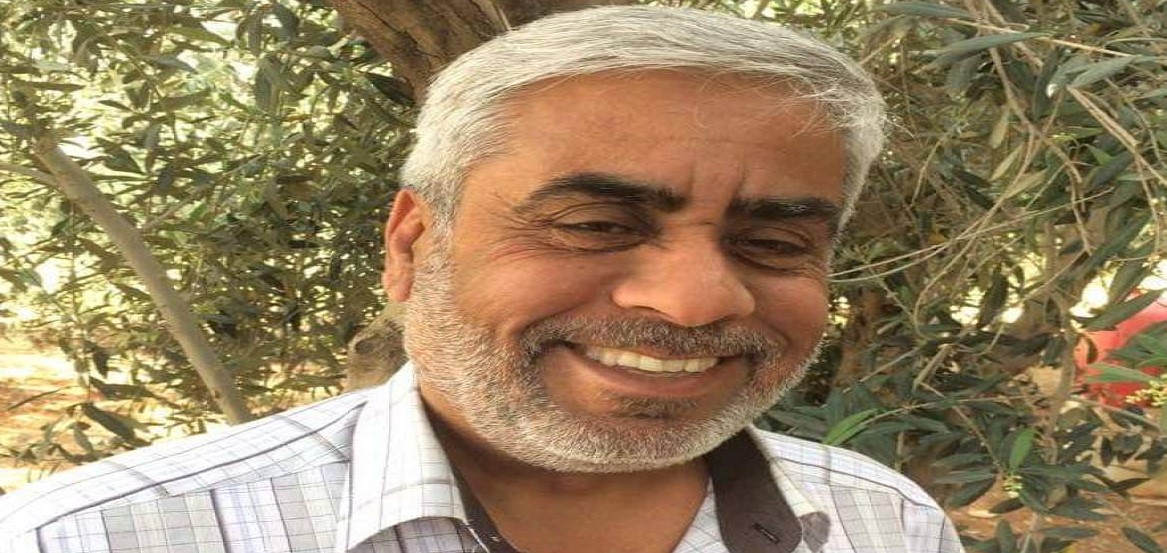


رائعه كالعاده ياأستاذ صبري وكل ما ذكرته حدث معنا بنفس الطريقه