شاهد محاورات الشاعر عبد الرزاق الربيعي في دار المأمون للترجمة
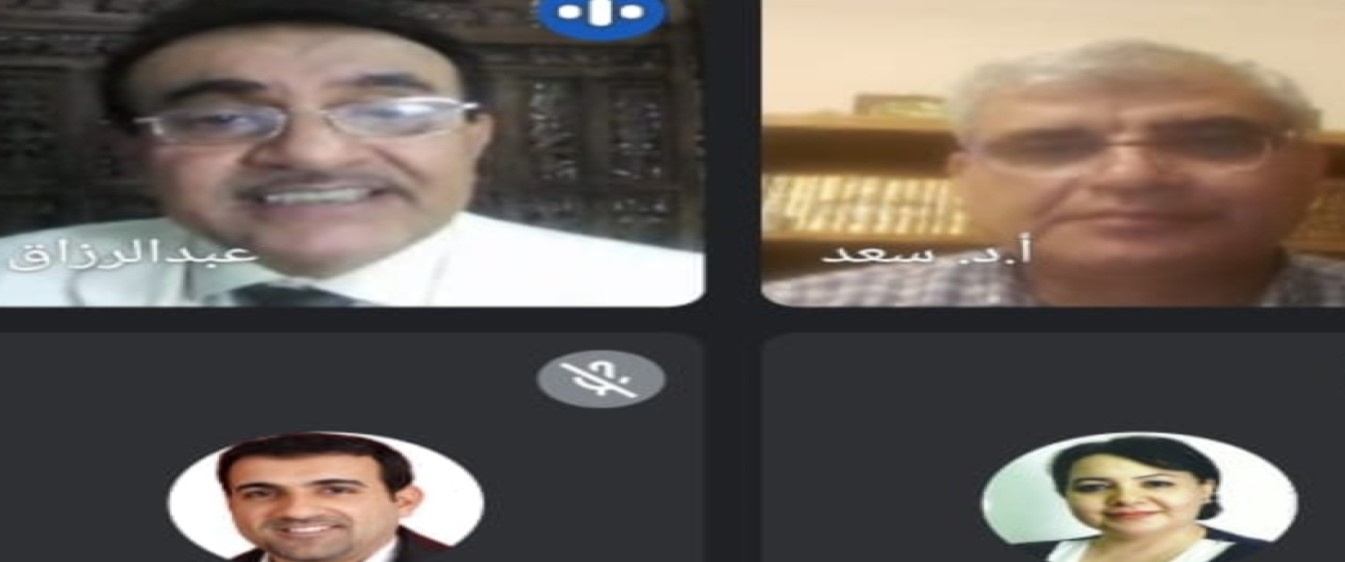
أدار الحوار والنقاش: أ. زينب عبد اللطيف
متابعة: علي جبّار عطيّة – رئيس تحرير جريدة أوروك العراقية
استضافت دار المأمون للترجمة، والنشر بوزارة الثقافة والسياحة والاثار الشاعر، والكاتب عبد الرزّاق الربيعي في جلسة عن بُعد بعنوان ” الشعر… ناسكا في محراب المسرح”،عبر برنامج google meet أدارتها أ. زينب عبداللطيف التي بعد أن رحبت بالضيف، ومديرة عام الدار أ. إشراق عبدالعادل، والحضور، قدّمت تعريفا بالضيف وجهوده في الشعر، والمسرح، ودعته لبدء محاضرته.
عبد الرزاق الربيعي يقول:
- خرج الشعر والمسرح من المعابد فحملا معهما هالة القداسة
- ليعود الشعر لحضن المسرح لابدّ من مخرج مغامر، وممثل يمتلكان حسّا عاليا، ومتلق واعٍ
- جهود شوقي، وأباظة في المسرح الشعري، تبقى ذات قيمة رياديّة وتأسيسيّة
- لا مسرح بدون مكان، وجمهور، و ممثل، ونص
وعلى مدى ساعة تحدّث الربيعي علاقة الشعر والمسرح، وهي علاقة لم تكن دائما على وفاق، كما قال” فيحدث أحيانا ما يعكّر صفوها، من حيث أن هذا النوع من العروض الذي يقدّم مسرحيّات شعريّة، لا يجذب إليه، كما يقول محمد مندور” غير صفوة المثقفين الذين تغريهم المتعة العقلية حتى، ولو لم تثر فيهم تلك المسرحيات الذهنية أي انفعال عاطفي”، خصوصا أن الكثير من المسرحيات الشعرية يمكن إدراجها ضمن المسرحيات المقروءة التي كتبت بالأساس لكي تقرأ، وليست للعرض، فهي “متحرّرة من الأعراف المسرحية”حسب ماري الياس، كمسرحيات الروماني لوكيوس أنايوس سنيكا التي تركت أثرا على كتاب الدراما في العصر الاليزابيثي، وزاد من ذلك النزعة الذاتية للشعراء التي حالت دون وصول نصوصهم لخشبة المسرح، ولهذا يتحفّظ د. طه حسين على تجارب الشاعرين احمد شوقي، وعزيز أباظة، إذ اعتبر نصوصهما ذاتية، وغنائية لا تمتّ بصلة للمسرح الشعري الذي يفترض أن يكون ذا طابع درامي، فهي بنظره مقطوعات يمكن أن تكون منفصلة، فلم تراع الحبكة، والصراع الدرامي، وهذا الوصف ينطبق على ما أثير حول مسرحيات كوليردج وتشيلي، وبايرون، فقيل عن مسرحياتهم” قصائد درامية ” ومع أن كلامه لا يخلو من صواب، إلا أنّ جهود شوقي، وأباظة في المسرح الشعري، تبقى ذات قيمة رياديّة وتأسيسيّة، فقد فتحا طريقا جديدا سلكه من تبعهما، وهكذا ظلّ الشعر يقف بثقة على خشبة المسرح العربي، فكتب محمد فريد أبو حديد، مسرحية” ميسون الغجرية” في قالب الشعر المرسل، وعلي أحمد باكثير مسرحية “أخناتون” و”نفرتيتي”، وصلاح عبد الصبور ” الحلاّج” و”ليلى والمجنون”، وعبد الرحمن الشرقاوي، وعبد الرزاق عبد الواحد الذي كتب مسرحية “الحر الرياحي” ويوسف الصائغ، ومحمد علي الخفاجي، ومعد الجبوري، وللشاعر عبد الوهاب البياتي مسرحية يتيمة عنوانها “محاكمة في نيسابور”، وكذلك الشاعر نزار قباني الذي كتب مسرحية” جنونستان”.
ورغم تلك الطروحات، ينتصر إليوت للشعر في المسرح على حساب النثر، فيقول “إن الدراما النثرية هي منتج بسيط للدراما الشعرية، والنفس البشرية في عنفوان انفعالاتها، انما تحاول أن تعبّر عن نفسها شعرا، فإن النثر المسرحي يتّجه غالبا نحو توكيد كل ماهو سطحي زائل، أما إذا أردنا أن نتّجه الى ماهو كوني دائم، فعلينا أن نعبّر عنه شعرا”.
وحول سيميائية العنوان، قال الربيعي” لقد نشأ المسرح في أحضان المعابد، التي كانت يقدّم فيها الكهّان المرويّات، والأدعية، ، فكان يؤدي وظيفة دينية، ويعيد أرسطو في كتابه”فن الشعر” نشأة المسرح التراجيدي إلى فن الديثرامب (وزن من أوزان الشعر اليوناني القديم) الذي يمجّد آلهة ديونيزوس من خلال إلقاء الأناشيد، والتراتيل، والترانيم فكانت النشأة الأولى للمسرح مرتبطةً بتمثيل الطقوس، والشعائر الدينيّة القديمة.
وهو أوّل نبّه للعلاقة بين الشعر والمسرح ووصف الشعر بأنه شكل من أشكال المحاكاة كالرقص والموسيقى، فهو فن، أما في عصرنا الحديث، فقد تطوّرت العمليّة، فحلّت الخشبة محلّ المعبد، والنص محلّ الأدعية، والمرويّات، والتراتيل، ووقف الممثل بدلا عن الكاهن، ومرتادو المعابد هم الجمهور، وظلّت هذه الشروط واجبة، وملازمة، لأيّ عرض مسرحي، فلا مسرح بدون مكان، وجمهور، و ممثل، ونص، إن ارتباط المسرح بالمعابد في بداية نشوئه، يفسر هالة القداسة التي ظلّت تهيمن على المسرح اليوم”.
وأضاف الربيعي الذي صدر له حوالي ٤٠ كتابا في شتى المجالات أبرزها الشعر، والمسرح، والعمل الإعلامي، وجُمعت مجاميعه الشعرية في مجلدين صدرا عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت٢٠١٩، وثلاثة مجلدات بالتعاون مع دار سطور ببغداد٢٠٢١ “ هذه القداسة كانت موجودة في حضارة وادي الرافدين، فكان التمثيل يقام في المعابد الرئيسة، كما في عيد رأس السنة البابلية، وهذا يماثل (التشابيه) في عاشوراء، ولم يكن قد بلغ مرتبة المسرح الحقيقي، أما الثابت، فإن أول مسرح ظهر في أحد معابد مدينة دورا- أو وبس (الصالحية على الفرات في سوريا)، وتاريخه يعود إلى العهد السلوقي، كما يشير الدكتور نائل حنون،
مؤكّدا أنّ الدكّة المسرح موجودة في الركن الشرقي من مبنى معبد الإلهة أرتيمس، وفي المدينة نفسها يوجد مسرح أغريقي مستقل شيّد في وقت لاحق، وتساءل الربيعي، لماذا شيد الإغريق ذلك المسرح على انقاض المعابد؟ ألا يعطينا هذا دليلا على مراعاة قدسية المكان، ومنه قدسية المسرح، وأشار ” في حوار أجريته مع الشاعر الراحل سليمان العيسى قال لي أنّه في طفولته حفظ القرآن الكريم، وديوان المتنبّي على يد والده، وكان في العاشرة من عمره، أو أكبر بسنة، بما يدعو للتساؤل: كيف لطفل عاش في لواء الاسكندرون، قبل اقتطاعه من قبل تركيا أن يفرض عليه والده حفظ كتابنا المقدس مع وديوان شعر، لو لم يكن للشعر هذه الهالة ؟
كل هذا يؤكّد أنّ المسرح ولد في رحم الدين، مثل سائر الفنوان التي من بينها الشعر الذي أقترن بالتراتيل الدينية ، وسجع الكهان” وخلاصة القول ان الشعر والمسرح خرجا من المعابد، وحمل كل منهما معه شيئا من قداسته، ولهذا فأوّل تهمة وجهت لرسولنا الكريم(ص) أنه شاعر، لذا حين أعجب الوليد بن المغيرة ببلاغة القرآن وقال حين عاد لقومه ” إن لقوله لحلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلا عليه”، فقالوا: هذا شعر، فقال:ماهو بشاعر،لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضة ومبسوطه فماهو بالشعر، فقالوا :إذن كاهن” إلى بقية الحكاية، إذن للمسرح هالة تخالطها القداسة وكذلك الشعر، والمسرح كما يرى الشاعر الإسباني لوركا “هو الشعر الذي ينهض من الكتاب ويتحول إلى بشر”
وعند ذكر لوركا وأعماله المسرحية كالزفاف الدامي، وبيت برنالد البا، أشاد الربيعي بجهود حركة الترجمة التي نقلت أهم الأعمال المسرحية، لاسيما أن المسرح نتاح الحضارة الغربية، وهكذا تمكنا من قراءة شكسبير بترجمة جبرا إبراهيم جبرا، وقرأنا مسرحيات اليوت ولوركا، وناظم حكمت، وونحن نعرف أن ترجمة الشعر من أصعب أنواع الترجمة، ثم انتقل للحديث عن مسرحة القصيدة الحديثة، مستعرضا عددا من النماذج للسياب وعبد الرزاق عبد الواحد وعدنان الصائغ، وواقع المسرح الشعري اليوم وتراجعه، وانحساره، فقال “تحوّل كتّاب المسرح إلى النثر بهدف الاقتراب من الجمهور، باستثناء بعض العروض التي تقدّم في المهرجانات المسرحية، وعمّق المشكلة حاجة هذا النوع من المسرح لممثلين قادرين على التحليق في فضاءات المفردة الشعرية، والحس الملحمي، فيشترط بيتر بروك على الممثل “أن يجد طريقة للتعامل مع الشعر، فهو إن تناوله بانفعالٍ مبالغ فيه، فسينتهي إلى لغوٍ منمّق فارغ”، مع تقديرنا لممثلين عرب دخلوا محراب القصيدة، وبرعوا في فنون الإلقاء كعبد الله غيث، وعبد المجيد مجذوب، وسامي عبدا لحميد، وعزيز خيون، وجواد الشكرجي، وآخرين، كما أن بعض المخرجين أداروا ظهورهم للمسرح الشعري، لأنهم وجدوا الأدوات مختلفة، فالنص الذي يكتبه الشاعر للمسرح يجد صعوبة في شق طريقه إلى الخشبة، وكما يقول الباحث عمار الجنابي ” الحيل الشعرية التي يستخدمها الشعر ليست بذات بال في المسرح، لأن المسرح ـ أساساً ـ ليس قائماً على اللغة فحسب، بل هو قائم على عوامل أخرى أكثر أهمية من اللغة نفسها” لذا تجنّب المخرجون نصوص الشعراء، وإذا ما اقتربوا منها، فأنهم يلجأون إلى القصّ، وتشذيب الكثير منها،وحتى الباحثون الذين يرون أن الشعراء “عندما دخلوا المسرح أفسدوه” كما قال د.عبدالكريم جواد، كونهم أثقلوه بالملفوظ، ولغة الحوار العالية، وألقوا باللائمة على “أرسطو”، فهو كما يقول د. بشار عليوي “حوّلَ المسرح بوصفهِ ممارسة شعبية، وفرجة حية، إلى مسرح أدبي مسرح للقُراء عبر طروحاتهِ في متون “فن الشعر” ، وكما تقول “دوبون” في كتابها (أرسطو أو مصاص دماء المسرح الغربي) ترجمة د. محمد سيف إن الفعل المسرحي الوحيد الذي عرفهُ الجمهور الأغريقي كان هوَ الأداء الطقسي، وهذا يُناقض عملية ربط المسرح بالشعر “ويشير د. بشار عليوي في مقال له عنوانه (في كتاب”أرسطو”..فلورانس دوبون ومحمد سيف يُحرران المسرح مِن أدبيتهِ)نشره في موقع الهيئة العربية للمسرح إلى نقطة تشير إليها “دوبون” في كتابها (أرسطو أو مصاص دماء المسرح الغربي) حينما تُعرج على المسابقات الموسيقية المسرحية التي كانت تُقام سنوياً في أثينا التي كانَ يشترك فيها جميع الأثنيين كما يُشاركون في تحكيمها عبر نُظم مُعينة وهذا أعطاهم نوعاً من الدربة في التعاطي مع مُجمل الأداءات الطقسية الفرجوية الحية لتلكَ المُسابقات، في حين أرسطو اللا أغريقي والأجنبي الغريب عن أثينا بعيد كُل البُعد عن هذهِ الحقائق والأجواء الطقسية يُحدد جمال المآساة من خلال المعايير الموضوعية والجمالية خارج السياق الاجتماعي “،ود. عليوي يفرّق بين النص، والعرض، وهذا غير ممكن أن النص هو العمود الفقري للعرض، ولا يمكن للعرض الاستغناء عن النص، والمشكلة تبدو أعقد عندما يكون النص، إذا كان شعريا، أثقل من العرض !”
وقال” لقد بقيت اللغة الشعرية مهيمنة، فالكثير من الشعراء الذين كتبوا للمسرح نقلوا عدّتهم الشعرية، بما فيها اللغة مع ما حملوا معهم إلى المسرح كالشاعر خزعل الماجدي الذي كتب العديد من النصوص المسرحية بلغة، وأخيلة شعرية، ترجم الكثير منها د. صلاح القصب في “حفلة الماس” و”عزلة الكريستال”، و”هاملت بلا هاملت”، والتي جاءت على شكل مشاهد درامية مكثفة بلغة رمزية بطقوس ٍ شاعرية، سحرية وحالمة كما يقول د.وسام مهدي كاظم وقامت على “تفكيك العرض المسرحي، ومن ثم تركيبه من جديد على أسس تحليلية وتأويلية جديدة لأن المتلقي لديه هو منتج لدلالة العرض والباعث المتجدد في الوعي الفني، لذالك نجد أن جمهوره هم من النخبة المنتخبة من أكاديميين ورساميين وشعراء”وفي محاضرة له، حول تداخل الاجناس في أدب ما بعد الحداثة اعتبر د. سعد التميمي هيمنة الصورة البصرية من مرتكزات ما بعد الحداثة “فلم تعد اللغة لوحدها وأصبحت الصورة المحرك الأساسي” كما قال مشيرا إلى توظيف الشعراء التاريخ السرد، والمسرح، والسينما في قصائدهم، وبالمقابل الاستفادة من الصور الشعرية في تأثيث المشهد البصري على الخشبة، ومشكلة هذا النوع من العروض، أنّه موجه للنخب، لذا ضاقت الدائرة على عنق المسرح الشعري، وبقي إما حبيس الورقة، أو المهرجانات، ولكي نعيد الشعر إلى حضن المسرح لابد من وجود مخرج يمتلك مخيّلة خصبة يتعاطى مع المفردة الشعرية بحس جمالي عال، وممثل يتقن الإلقاء، وتلفظ مخارج الحروف، ومتلق واعٍ يتفاعل مع جماليات المفردة الشعرية.
وأعقبت الجلسة مداخلات، واستفسارات قدّمها: ا.إشراق عبدالعادل، د.سعد محمد التميمي، علي الفوّاز، د.صبري مسلم، د.وجدان الصائغ، د.ماجدة هاتو، عصام ثائر،سميرة جبار عنبر، عبداللطيف الموسوي، وقام الربيعي بالردّ عليها، متطرّقا إلى جهود المخرج قاسم محمد في دعن المسرح الشعري، وآخرها إعداده لمسرحية” مكاشفات” للمخرج غانم حميد التي لم تر النور إلا بعد عشرين سنة من وضعه النص بين يدي المخرج غانم حميد، وكان ينوي إعداد نص عن صفيّات وحروفيات الشاعر المبدع أديب كمال الدين، لكن حال المرض دون ذلك، وأشار إلى نيّة المخرج سامي عبدالحميد لتحويل نص” جسر ااجمهورية” للشاعر جليل صبيح إلى عرض مسرحي، كما أخبره عند مشاركته في مهرجان المسرح العماني أواخر 2009، وتطرّق لمسرحياته الشعرية، وأهمها ” كاسك ياسقراط ” التي كتبها ليشارك بها المخرج الراحل كريم جثير في مهرجان علي أحمد باكثير، لكن تقديراته لتكلفة الانتاج العالية، ورفضه التنازل عنها،حالت دون مشاركته، في المهرجان، وبعد عشر سنوات شاركت في ” أيام الشارقة المسرحية”، وقدمت من قبل فرقتين بدورة واحدة، وكذلك قدمت في جامعة السلطان قابوس، وبعد ذلك وقعت انظار المخرج الجزائري لحسن بتقة عليها في عام٢٠١٧، ولم يزل يجوب الجزائر،وتونس والمغرب مع فرقته “فرقة جمعية الرسالة المسرحية”، فقدّمها لأكثر من أربعين عرضا نال عنها جوائز عديدة منها الجائزة الذهبية في الأيام الوطنية بالجزائر وأفضل عرض متكامل في المهرجان الدولي الركح الذهبي في تونس،
مختتما بتوجيه كلمة شكر لدار المأمون التي فتحت نوافذ واسعة لقراءة الأدب العالمي في سنوات مبكّرة من عمرنا” كما قال.


