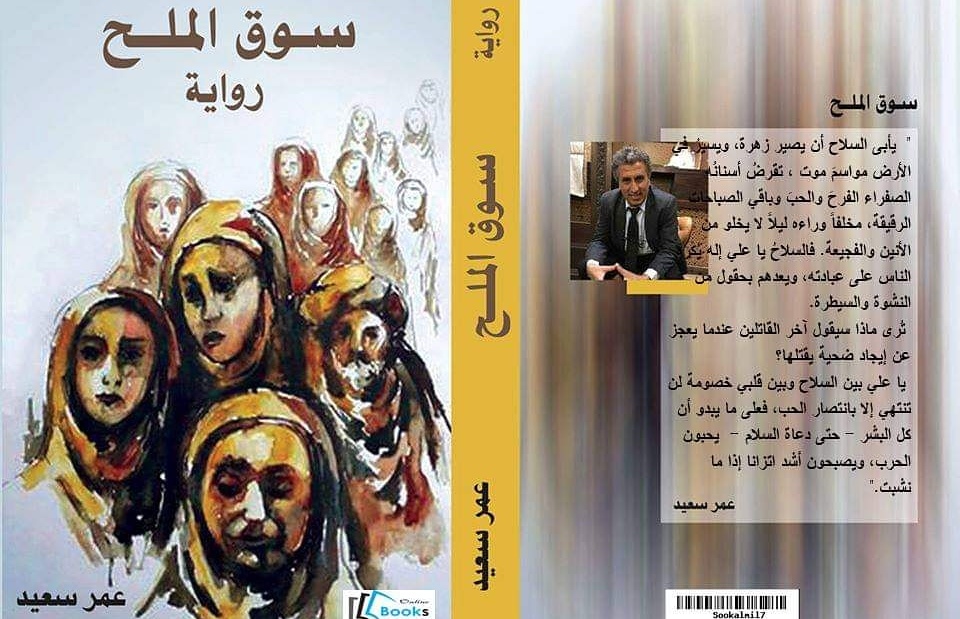من يعيد الفرح والأمان لفضاءاتنا العامة؟

المحامي جواد بولس | فلسطين

اللوحة للفنان : جون لويس إندريس
أقامت، في الخامس من الشهر الجاري، جمعية “انغام للموسيقى” و”الفرقة الماسية النصراوية”، حفلًا تكريميًا للموسيقار الخالد بليغ حمدي، وذلك على مسرح مدرسة “راهبات مار يوسف” في مدينة الناصرة. كان مشهد السيارات التي ملأت ساحات المدرسة مبشّرًا بعدد الحضور الكبير، الذي تجاوز عدده الستمائة شخص، كما علمت لاحقًا.
دخلنا القاعة الرحبة مباشرة عندما شرعت الفرقة تعزف. لوهلة قد تتخيل انك في احدى المسارح ” الاجنبية ” الراقية ؛ فالصمت في القاعة جارح وطغيانه يشي بشغف الحاضرين باجتراع الموسيقى الأصيلة. جلس العازفون، وكلّهم ابناء البلد، على المسرح، وتحتهم قليل من ريح. كانوا يحتضون آلاتهم برفق العشاق، وامامهم كان ينتصب، كسهم، المايسترو كميل شجراوي الذي ما أن رفع قوس كمانه وحطّه، بما يشبه الغضب، على خاصرة الوتر، بدأت رحلة الفرقة على طريق النحل، وأخذتنا والسعادة، مع باقة من اغاني الكبار ، ام كلثوم ، وردة، صباح، ميادة الحناوي، عبد الحليم، نحو المدى البعيد، فأمضينا بضع ليلة مع تناهيد ماض جميل وبقايا من نور كنا قد افتقدناه. كان تكريم واحد من اعمدة الموسيقى العربية لائقًا ومشرفًا، فألحانه عزفت بحرفية لافتة وقد زادها صوت ابنة قرية الرامة، الرائعة رنا حنا-جبران، شجنًا وطربًا، ثم “عَشّقها” صوت الشاب الوسيم، ابن قرية ترشيحا، شادي دكور، بقطع من عذوبة وورد. لقد توالت فقرات الحفل كسكب رقيق من عسل، فطارت ساعة ونصف من زمن ليس كالزمن، حتى انتهينا على وجع وما زال فينا “الغليل لظًى، والوجد محتدمًا، والشوق ظمآنا”.
لست ناقدًا موسيقيًا، ولا اكتب من هذا الباب؛ لكنني اعترف، انني كلّما أشارك في مثل هذه المناسبات أصاب بنوبة من فرح وزهو؛ لا لما نسمع من طرب اصيل ونشاهد من أبداع محلي مبهر وحسب؛ بل لانني، وكثيرون مثلي، نعتبر هذه النشاطات الفنية ومثيلاتها جزءًا من معارك مجتمعنا على فضاءاته العامة وتعزيزًا لانتشار الثقافة الحرّة فيه ولدور الابداع في بناء الحصانة الجماهيرية واشاعة التعددية الفكرية والثقافية بين ظهرانيه.
كم كنت أتمنى أن يتعرّف العالم على ما ينتجه المواطنون العرب في اسرائيل من أعمال ثقافية وفنية ابداعية مختلفة؛ ومن الواضح ان هذا المقال لن يتسع لذكر قوائم المغنين البارزين والفنانين والمبدعين واسماء الفرق الغنائية والمسرحية الجادة وما يقدمونه من انتاج فني سنوي مرموق؛ وهم يفعلون ذلك بالرغم من ضيق الهوامش المتاحة لمعظمهم وبالرغم من انحسار عدد المنصات والمواقع العامة التي يستطيعون عرض انتاجاتهم عليها، ومحاربتهم ومنع عروض بعضهم في كثير من البلدات كما حصل في الماضي وكما قرأنا مؤخرًا.
تتداعى الأحداث في مدننا وقرانا بسرعة جنونية وبتواتر متصاعد من يوم إلى يوم؛ ويكاد المواطن العادي لا يعيرها من اهتمامه إلا لحظات عابرة، رغم انها تؤدي، من خلال تراكمها الضاغط والعفوي، إلى تزايد مشاعر الاغتراب الاجتماعي والخوف بين الناس والى ابتعادهم عن الحيزات العامة ولجوئهم إلى ملاذات ضيّقة، قد يكون أهمها “البيت” أو ما ينوب عنه من بدائل وهمية يحسبها المواطن “حصونًا” تؤمن للمهدّدين منهم وللخائفين حماية، في واقع خسرت فيه المجتمعات المحلّية معظم مظلاتها الواقية وفقدت كوابحها القيمية والسلطوية والقيادية.
وليس من الصعب على الباحثين الجدّيين في علوم الاجتماع والسياسة الرجوع إلى بدايات التحوّلات/الانهيارات الكبيرة التي أصابت مجتمعاتنا المحلّية، والكشف عن العوامل الحقيقية التي أدت إلى تدهورها ووصلوها، كما هو الحال في أيامنا، الى حافة الهاوية؛ لكننا، كمجتمع مأزوم ومفجوع، يجب أن نقرّ بأننا لن ننجح في مواجهة واقعنا المقلق والخطير من دون تشخيص مسببات تلك الآفات بموضوعية وبجرأة وبوازع غير مرتهن لأي مصلحة فئوية أو دينية أو مادية.
فهل توجد بيننا تلك الفئة القادرة على انجاز هذه المهمة ؟ وإن وجدت كهذه الفئة بيننا، فهل ستكون لديها الدوافع والنوازع والاستعدادات لتتصدّر المواجهة التي ستتفجر، حتمًا، على جبهتين كبيرتين وخطيرتين؛ الأولى، هي جبهة الدولة ونهج مؤسساتها العنصري والفاشي في بعض تجلّياته؛ والثانية، وقد تكون الأخطر، هي المواجهة مع جميع القوى البلدية المحلية التي تنتج مؤسساتها ثقافات العنف على أشكاله، وتسوّغ مفاهيمُها ومصالحها وقدراتها، المادية والمعنوية، جميعَ اشكال الصدام مع “الآخرين” ، وتبرر غاياتُها كلَّ وسائل الاستقواء والبلطجة وترخيص القتل على أشكاله.
انها باختصار المعركة على أمن البشر وضمانة حرّياتهم وصون كراماتهم وهي كذلك معركة من أجل حماية رئات الوطن وتسييج ساحات البلدان.
لقد خرجنا من قاعة مدرسة “راهبات مار يوسف” منتشين، ولكن بنا بعض من الحسرة والحزن. فبعضنا استذكر كيف أعلن قبل ايام معدودات مجلس محلي في احدى قرى الجليل عن الغاء حفل موسيقي كان من المفروض ان تحييه الفنانة نادين خطيب، وذلك “استجابة لتوجه رجال الدين لرئيس مجلس القرية”؛ بينما تذكّر آخرون مشاهد اطلاق الرصاص على احد المشاركين في حفل زواج خاص فأرداه قتيلًا.
تحلّقنا طاولة في بيت أحد الأصدقاء؛ وبلهفة المنتصرين تغنينا بالموسيقى وتسابقنا بالحديث عن نهفات بليغ الحر حتى آخر أنفاس الزبد، وعن شقاواته وحبه للحياة مثل حب زوربا اليوناني. كانت اخبار النهارات، بمرّها، تتناثر بيننا كلما جنّ الليل وزاد عتمةً، حتى وصلنا، رغمًا عنا، الى آخر اخبار الرصاص، فتناقشنا حول قضية اشراك جهاز المخابرات العامة في مكافحة الجريمة والعنف بين المواطنين العرب. لم نتفق على موقف واحد ازاء هذه القضية، فعدنا الى قصص الغناء والشعر والنحت والتمثيل والفرح. كان واضحًا لجميعنا ان نجاح مثل هذه الليالي يؤخر موعد اعلان هزيمتنا الثقافية الكبرى، ويضخ في مطارحنا جرعات هامة من مصل الأمل؛ لكن ذلك لن يثمر ولن يتم الا اذا حظي جميع المبدعين والفنانين برعاية مؤسساتية ومجتمعية أكبر وبدعم قطاعات نخبوية واسعة وبمساندة حاسمة من قبل من يصلّون بهدوء وبصمت وبدون أن يراهم الناس تمامًا، كما كان يصلي زوربا ، لأنهم مثله يؤمنون بألا “تستطيع قطرة البحر إلّا أن تكون في أعماق الموج”.
لم نعرف كيف اقتحمت صلاة زوربا اليوناني ليلنا، وهو الذي أجاب حين سألوه كيف تصلي فقال: “بالحب.. أقف وكأن الله يسألني: ماذا فعلت منذ آخر صلاة صليتها لتصنع من لحمك روحًا ؟ فأقدم تقريري له وأقول: يا رب أحببت فلانًا، ومسحت على رأس ضعيف، وحميت امرأة في أحضاني من الوحدة، وابتسمت لعصفور وقف يغني لي على شرفتي، وتنفست بعمق أمام سحابة جميلة تستحم في ضوء الشمس ..”. لم ننتبه كيف حضر معنا زوربا ليلة لتكريم موسيقار مصري عاش يرتشف الحب ويوزعه ألحانًا بجنون عبقري، لكننا مثله، انهينا جلستنا بكثير من الصلاة وتراتيل الحب والشوق لمثل هذا الفرح.
لقد تمنينا في تلك الليلة كثيرًا، وافترقنا وكلنا نعرف انها مجرد أمنيات سوف تمحوها سكرة أول فجر دامٍ كان جدّ قريبا ؛ ففي الواقع لقد خسرنا المعركة على “حيّزاتنا العامة” وقبلها، كنا قد أضعنا “ساحة البلد “.