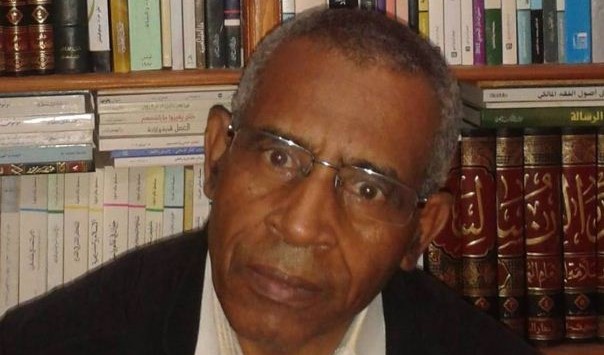العرب بين النفي والسبي

توفيق أبو شومر
منذ أيام شاركتُ في ندوةٍ ثقافية، وفي هذه الندوة، افتخر الباحثون بالمجتمع الفلسطيني، ليس في نضاله البطولي، وصموده في وجه الاحتلال، ولكنهم افتخروا؛ بأن المجتمع الفلسطيني ليس فيه سوى عرقٍ واحدٍ، من نسل يعرب بن قحطان، ودينٍ واحد هو الإسلام، أما المسيحون فهم قِلَّة، ومذهبٍ فقهي إسلامي واحد، هو المذهب الشافعي ، فهو نسيجٌ مُتشابه في كل غرزة إبرةٍ !
وانفعل بعضهم حين اعتبرتُ هذه الصفة نقطة ضعف في المجتمع الفلسطيني، وقلتُ إن التماثل عيبٌ من عيوب المجتمعات، وهو علامة على الانغلاق، فالمجتمعات الحضارية القوية ينبغي أن تكون مجتمعاتٍ متعددةَ المذاهب، والأعراق، والثقافات، والانتماءات!
وكل مجتمع يفتخر بتماثله ووحدته، وانتمائه إلى الجينة نفسِها، مجتمعٌ غيرُ مُبدع، ولا يسعى للمنافسة الحضارية!
مَن يتابعْ تاريخ الأمم، يُدركْ بأن أحد أبرز أسس الحضارة والرقي، هو الاختلاف في الأعراق والأفكار، وهذا الاختلافُ يُنتجُ تزاوجا بين الأعراق والأجناس، مما يُصلب المجتمع، ويبعث على التفوق والرقي! كما أن الاختلاف هو الباعث على الإبداعات بمختلف أشكالها وأنماطها، الثقافية، والفنية، والاجتماعية!
أدركتْ أممٌ كثيرة أهمية التعددية، وعززتها، فالدولة العباسية مثلا أسَّست حضارة، لا مثيل لها في تاريخ العالم، ليس بفعل الجنس العربي النقي، ولكن باستقدام العنصر الفارسي، والتركي، وإشراكهم حتى في الحكم.
إنَّ المُتابع الواعي المثقف، يستغرب ما جرى، وما يجري حولنا من أحداث، ولا سيما في البقعة الجُغرافية المسماة(الوطن العربي)، ويتساءل:
ما أسباب عداوة كثيرٌ من مواطني دول العرب للمختلفين عنهم عرقيا، وفكريا، ودينيا؟
أليس مفروضا أنَّ عصر التكنلوجيا والانفتاح المعلوماتي، هو بوابة العالم، ونافذته المُطلة على كل الجناس والثقافات؟
وأن العولمة ليست سوى سبيكة عرقية، ومصكوكات ثقافية جديدة، تصوغ العالم كله في بوتقة واحدة، وتلغي إلى الأبد عصر الأنساب والأحساب، وعصر الجينات العرقية؟
فلماذا إذن، عاد العربُ إلى انغلاقهم من جديد؟ وعلامَ يَدلُّ ذلك؟
إنَّ دول العالم المتحضرة، تَجِدُّ في البحث عن الأعراق النادرة، لتحفظ سلالتها، ليس من منطلق حقوقي وثقافي فقط، ولكن من منطلق مبدأ رئيس وهو إثراء الحضارة بتعدد الأجناس والأعراق!!
وليس من المبالغة القولُ:
إن سرَّ تفوُّق إسرائيل على العرب كلهم، هو إدراكُها لأهمية استقطاب الأعراق، والادِّعاء بأنهم من نسلٍ يهوديٍ خالص، فما في إسرائيل من إثنيات عرقية، لم يُسهم فقط في الثراء اللغوي والثقافي، بل في الثراء الإبداعي.
كما أن إسرائيل وظَّفت أسطورة القبائل اليهودية العشرة الضائعة، التي ما تزال مفقودة حتى اليوم في تكثير الفسيفساء العرقية اليهودية، وتنويعها.
وشجعتْ إسرائيلُ جمعيةً فريدة، ليس لها مثيل في العالم، وهي جمعية، شافي إسرائيل، الباحثة عن أحفاد هذه القبائل اليهودية العشرة المفقودة، ودعمتها بالأموال لتعزيز وتقوية دولة إسرائيل، حتى أنها منحتْ مؤسسها، متشل فروند، جائزة إسرائيل الكبرى، لأنه اكتشف قبائل يهودية ضائعة عديدة، منها، الفلاشاه في إفريقيا، ويهود كايفونغ في الصين، وبني منشه في الهند، ويهود جزيرة هايتي، وغيرهم.
لم تكتفِ إسرائيلُ بذلك، بل شجعت تهويد واستقطاب الأعراق المطرودة من دول العرب، وعلى رأس هذه الأعراق، الأيزيديون، فقد نشرت صحف إسرائيل خبرا طريفا، يوم 20/8/2015 عن تأسيس جمعية يهودية في كندا لإنقاذ الأسيرات الإيزيديات المسبيات في العراق على يد الإرهابيين، وذلك بافتدائهن وشرائهن من الإرهابيين البائعين:
“أسس اليهودي الكندي، ستيف مامان جمعية لتحرير الرهائن المسيحيين والإيزيديات المسبيات في العراق، وتمكن حتى الآن من إطلاق 130 امرأة وفتاة أيزيدية من قبضة داعش، بشرائهن من أسواق الجواري.
ويُقدِّر ستيف عدد النساء الأيزيديات المحتجزات في سوق داعش بألفين وسبعمائة، وسوف يعمل على افتدائهن بالمال، وهو يحصل على دعم مالي كبير”
انتهى الخبر.
ظللتُ أعتقد بأن العراق نموذج رائع للفسيفساء العرقية، ليس في عصر بني العباس، بل في العصور السابقة عليه، وفي تاريخه الحاضر، فهو البلد العربي الأكثر تعددا للأعراق والأجناس، ففيه الأكراد، والشبك والأيزيدون، والعرب والتركمان والمسيحيون بطوائفهم!
فما في العراق من فسيفساء عرقية وثقافية ودينية، تجعله قابلا لإرساء حضارة قوية، يُنافس بها الدول القوية، وهذا ما جعل العراق دائما مرتعا للمؤامرات من كل الأطراف التي تخشى عودة هذه الحضارة القوية!
أما اليوم فقد صار الصراع فيه يجري بين، السنة، والشيعة، والأكراد، ويجرى اقتسام العراق بتكنلوجيا التفكيك والطرد والسبي والنفي!
إن السبائك البشرية، تشبه إلى حدٍّ بعيد السبائك المعدنية، فالذهب وحده لا يمكن أن يكون سبيكة قوية، إلا إذا مُزِجَ بمعادنَ أخرى!
إنَّ ما يحدث اليوم، هو ناتجٌ عن التقصير في حقِّ الثقافة والوعي، فثقافة العولمة الاستهلاكية التجارية هي السائدة اليوم، ولا مجال لثقافة التواصل الفكري بين الأمم، لأنها تعوق تمدد الثقافة الاستهلاكية، وتشجع على الترشيد.
فقد أخضعتْ العولمةُ الثقافة لعملية تسليع، وصار المُنتَج الثقافي سلعة غالية الثمن، بفعل رغبة الشركات الكبرى في الامتلاك، والاستحواذ، وإشاعة الإفراط في الاستهلاك، مما دفع تلك الشركات إلى غض النظر، أو الإسهام، أو المشاركة، في إنتاج مصادر النزاعات، بتربية دفيئات التطرُّف، لتتمكن من تسويق منتجاتها، وتُعيد من جديد إعادة ترتيب العالم، وفق رؤى استهلاكية جديدة، لا علاقة لها بالأيدولوجيات الفكرية والثقافية، فإنسانُ العولمة ينتمي اليوم إلى طائفة بنك أمريكا والصين، وإلى عائلة ماكدونالدز، وهامبورجر، وإلى حزب المارسيدس والماتسوبيشي والتيوتا، وإلى جمعية بورصة النازداك، وقبيلته الرئيسة هي بالتأكيد منظمة التجارة العالمية!