الهاتف اللَّعين
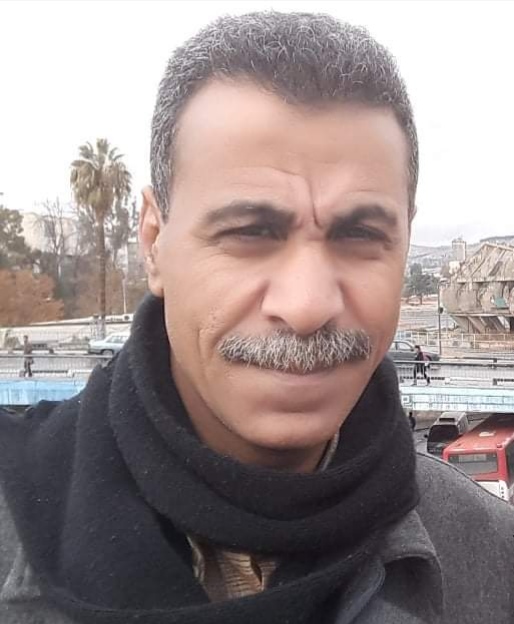
محمد حسين أبو حسين | كاتب فلسطيني – سوريا
دنا اللَّيل ليرخي بجدائله فوق الوجوه العابسة ويغطِّي رموش النَّهار الثَّقيل جدًا كسابقاته. شوارعه تبدو شبه فارغةٍ من الأرجل وضجيج السَّيِّارات، وأدخنة تنطلق من هنا وهناك راسمةً لوحةً سرياليَّة. القلق يدثِّر بوضوحٍ وجوه بعض المارَّة، والأغلب في حالة انتظارٍ وحيرة؛ أسئلةٌ تنقر قاع الدِّماغ وتجتاح ضواحيه، فيما الإجابة الشَّافية تحلِّق في بحر اللَّاوجود. تشعر أنَّك تدور في حلقةٍ مفرغةٍ تعارك فيها طواحين الهواء.
السَّاعة تقترب من المغيب، والجوال اللَّعين الذي كرهته ذات مساء لكثرة ما جلبه من أخبار سيِّئة، مستلقٍ على الطَّاولة. أمعنت النَّظر إليه قائلًا: أحمد الله أنَّك لم تسمعني صوتك اليوم أيُّها البومة.. وعلى غفلةٍ من صحوتي، وجدتُني أستسلم للنَّوم، راكنًا بقربي ثقل نهاري بما فيه.
بعد مرور ساعة، أيقظني ابني حسين، عدوُّ النَّوم الذي كنت أعتقد أنَّ حركته المفرطة ما هي إلَّا فرط نشاطٍ طفوليٍّ كما يقول العلماء، لأكتشف لاحقًا أنَّها حالة خوفٍ من الأوضاع العامَّة التي كنَّا نعيشها، قائلًا: بابا بابا!
ما بك يا حسين؟ أجبته والوهلة تتشبَّث بي.
قال حسين: لقد رنَّ هاتفك يا أبي ولكن فاتني الرَّد على المكالمة.
أعطني البومة اللَّعينة.. آمل أن يكون خيرًا.. أجبته.
وما إن حملت الهاتف حتى رنَّ، كان المتَّصل الرَّفيق أبو هاني.
مرحبًا، كيف حالك يا صديقي؟ طمئني على الأهل والرِّفاق؟ وهل تسير الأحوال على ما يرام في المخيم؟ قال أبو هاني.
الحمد لله، الجميع بخيرٍ يا صديقي، وأنا سأكون بطرفكم غداً إذا شاء الله..
أهلا وسهلًا بك، بانتظارك غدًا.. أعلمني فور وصولك.
في اليوم التَّالي، كان الجوُّ يميل إلى البرودة، استيقظت والرَّعشة تفترسني، شربت فنجان قهوتي فسرى دفء البنِّ الطَّفيف كما لو أنَّه شعاع شمسٍ يسري في جسدي الضَّعيف. تناولت ما تيسَّر من الطَّعام من دون أدنى إحساسٍ بنكهته، فالحسُّ الذوَّاق كان قد بدأ يفقد صلاحيَّته بحكم الظُّروف. خرجت إلى الشَّارع المكتظِّ بالفراغ، المفتقر لأدنى نسائم الحياة والحركة.
انتظرت لأكثر من ساعتين قبل وصول ابا هاني. وعند اللِّقاء، صافحت أبا هاني ودخلنا البيت على عجلٍ. وما إن جلسنا حتى صفعني أبو هاني بسيلٍ من الأسئلة عن المخيَّم، بغية معرفة أدقِّ تفاصيله ومجريات الأحداث فيه. انتابني شعورٌ ملحٌّ بأنَّ الحديث بيننا كان محض إجابات مشوَّشةٍ لأسئلة تلامس صغائر التَّفاصيل. وبعد تلك الجلسة ارتأينا وبطلبٍ من أبي هاني أن نذهب معًا في زيارة خاطفةٍ لبعض الأصدقاء والرِّفاق في المخيَّم، والذي كان لا يبعد عن منزلي سوى بضع مئات من الأمتار.
كانت الحركة في المخيَّم شبه اعتياديَّة، لكن ذاك لم يخفِ القلق الذي غلَّف وجوه قاطنيه. زرنا بعض الأصدقاء (عبد الرَّحمن سعيد، د. سامي الشَّيخ.. ) وتجوَّلنا في شوارع وأزقَّة المخيم. وأثناء مسيرنا استوقفنا عددٌ من الأصدقاء بغية طرح أسئلةٍ على الرَّفيق أبي هاني حول مستقبل المخيَّم.
السَّاعة تقترب من اللَّيل وكنَّا لا نزال في بيت الصَّديق الدُّكتور سامي، الذي كان قد أصرَّ أن نقضي اللَّيلة عنده لأنَّ الوضع ليلًا ليس على ما يرام غالبًا، لكنِّي أصررت على المغادرة بحكم ارتباطي بسهرةٍ وبعض الأصدقاء والرِّفاق لنجتمع سويًّا برفيقنا أبي هاني. وهذا ما حصل، فقد سهرنا تلك اللَّيلة سهرةً مقتضبة على عكس ما كنَّا نفعل سابقًا. أسئلةٌ مثخنةٌ بالقلق انهالت من جميع الحاضرين لكن الأجوبة كانت تسبح في فضاءٍ مفتوحٍ على كلِّ الاحتمالات.
في صباح اليوم التَّالي، استيقظنا وشربنا القهوة، وإذ بالهاتف اللَّعين يرنُّ؛ كان الرَّقم غريبًا، غير موجودٍ في قائمة الأسماء، فانتابني بعض القلق الذي ما لبثت أن بدَّدته بسرعة.
الرفيق ابو أحمد فؤاد: مرحبًا، كيف حالك، خبِّرني عن الأهل، الرِّفاق، والناس في المخيَّم، إن شاء الله الكلّ بخير؟
الحمد لله الجميع بخير.. أجبته.
فتوجَّه إليَّ بنبرةٍ تخفي ما تخفيه من قلقٍ: اسمعني يجب أن تبقى على تواصلٍ مع الجميع لنتابع أوضاع المخيَّم بشكلٍ يوميّ.. هذا شعبنا.. ونحن سنتشاور مع جميع القوى لتقديم يد العون إن شاء الله. حسب الإمكانيات المتاحه لن نترك شعبنا سنبذل قصارى جهدنا للتخفيف من معاناته.
غادر الرَّفيق أبو هاني عند الظَّهيره حاملًا في جعبته المتخمة بالوجع أسئلةً كثيرةً من جميع من التقاهم.
“هل نستطيع أن لا ندخل مربَّع النَّار أو أن نخفِّف من شدَّة حروقها في هذا المخيم الذي أتعبته سنوات اللُّجوء؟” حدَّثت نفسي بعد أن ودَّعت أبا هاني.



