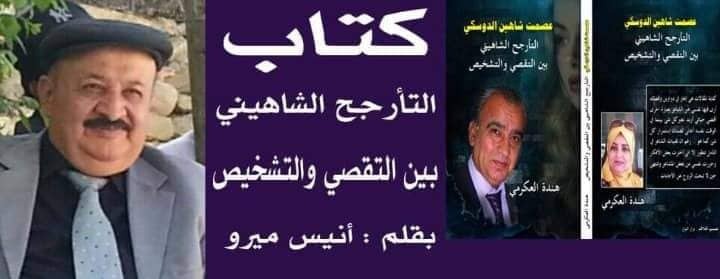إشكاليةُ الإعلامِ الثقافيِّ: رَغْوُ تَرْوِيجِ المُرَوَّجِ أَمْ لَغْوُ تَأْجِيجِ المُؤَجَّجِ؟

د. آصال أبسال | كوبنهاغن (الدنمارك)
أعيدُ فحواءَ الكلامِ في هذا المقالِ من زاويةٍ أخرى متوائمةٍ، بنحوٍ أو بآخرَ، مع ما استجدَّ بعدئذٍ من مَاجَرَيَاتِ المشهدِ الإعلامي الثقافي المعنيِّ، وكذاك مع ما صاحبَهُ أو ما وازاهُ من مشهدٍ إعلامي «لاثقافي» مقابل.. قبل كلِّ شيءٍ، ها هنا مرَّةً ثانيةً، لا بدَّ من الاعترافِ الواجبيِّ بأنني قد تعلَّمتُ، منذ زمانٍ جامعيٍّ ليس بالبعيدِ، هذين الاصطلاحينِ الأسلوبيَّيْنِ المتجانسين تناظرا – وأعني بادئَ ذي بدءٍ اصطلاحَ «ترويج المُرَوَّج» To Propagate The Propagated، وذاك من حيثُ فاعليَّتُهُ الظاهريةُ فعلا مباشرا (أو بالكادِ) من جانبٍ أوَّلَ، وأعني بدئيًّا كذاك اصطلاحَ «تأجيج المُؤَجَّج» To Instigate The Instigated، وذلك من حيثُ فاعليَّتُهُ الباطنيةُ فعلا لامباشرا (أو باللاكادِ) من جانب ثانٍ، أقولُ هنا لا بدَّ من الاعتراف الواجبيِّ بأنني قد تعلَّمتُهُمَا بكلِّ امتنانٍ وشكرانٍ من أستاذي الكريم، غياث المرزوق، حينما كان أستاذا زائرا قد ألقى علينا سلسلةً من المحاضراتِ الحوارية الشيِّقة حول ما انضوى إذَّاك تحت المبحثِ الفكريِّ العامِّ «بلاغيات الإخبار والإنشاء» من كلٍّ من المنظورين اللسانيَّيْن التزامني والتزمُّني.. رَغْوُ ترويجِ المُرَوَّج، منظورا إليهِ بهكذا أسلوبيةٍ من منظارِ لَغْوِ تأجيجِ المُؤَجَّج في حدِّ ذاته، يتبدَّى أكثرَ ما يتبدَّى، إذن، كوسيلةٍ إعلاميةٍ (أو حتى صحافيةٍ) لامبدئيةٍ بخسةٍ غيرِ شريفةٍ تلجأ إليها لجوءا قسريًّا وقهريًّا لـ«حاجاتٍ ومآربَ مقصوداتٍ في أنفُس اليَعَاقيبِ واليعاقبةِ طُرًّا»، تلجأ إليها الكثيراتُ من الصحائف الغربية الشهيرة والكثيراتُ من نظيراتِها من الصحائف العربية الأشهر كذلك – وعلى الأخصِّ في مقدِّمة هذه الصحائفِ الأخيراتِ، صحيفةُ «القدس العربي» بالذاتِ، هذهِ الصحيفةُ «العربيةُ» التي لا تني، كعهدها منذ تاريخ تأسيسها الأوَّلِ قبلَ أكثرَ من ثلاثينَ عامًا لِزامًا، تتبجَّح أيما تبجُّحٍ بـ«استقلالها» السياسي وبامتثالها «المبدئي» و«النزيه» وحتى «الشريف» لكافَّةِ القِيَمِ الإنسانيةِ والأخلاقيةِ، فيما له مساسٌ وثيقٌ بكلٍّ من عالَمِ التحرير وعالَمِ النشر على حدٍّ سواء..
مرة أخرى، ودونما الاحتياج كذاك إلى استخدام أيٍّ مِمَّا هو راسخٌ من عبارات الاستهلال البياني أو التمهيد البلاغي في متون الكتابة الصحافية و/أو الإعلامية التقليدية، يستهلُّ الكاتب الصحافي (الثقافي)، سهيل كيوان، متنَ تقريره الحديث العهد نسبيًّا، هو الآخر، إذ صدر قبل أكثر من حولٍ ونَيِّفٍ من الزمان تحت عنوان اسمي تركيبي هازئ ومتهكِّمٍ أيضا، كما سيبِينُ من التوثيق عمَّا قليل.. يستهلُّه تأجيجا بالإشارة إلى ذلك السجال أو حتى الجدل المؤجَّج بالحماس الاجتماعي والاستغلال السياسي حينما أثارته كلَّ الإثارة إذَّاك تسميةُ شارعٍ من شوارع مدينة حيفا باسم المغنِّية المصرية الشهيرة الراحلة، «أم كلثوم».. وقد كانت هذه الإثارة بالذات تفعل فعلها فعليًّا، في واقع الحال، وسطَ ما رامَ بعضٌ لافتٌ من أزلام الكيان الصهيوني من تظاهُرٍ نفاقيٍّ معسولٍ بالتعايش «السلمي» وحتى بالتقارب «الودِّي» بين الإسرائيليِّين والفلسطينيِّين (أو، بالأحرى، بين العبريِّين والعرب، توسُّعا) – وقد كانت وقتئذٍ حينما نطق الناطق الرسمي باسم جيش دفاع هذا الكيان لوسائل الإعلام العربي، أﭬيخاي أدرعي אביחי אדרעי، بعبارات منتقاة بالغُلُوِّ والعُتُوِّ من أغنيات المغنِّية أم كلثوم ذاتها، وذلك تدعيما وتعضيدا لـ«مصداقية» ذلك التظاهر المعسول، وتمهيدا من ثمَّ لـ«تظاهراتٍ معسولاتٍ» أخرى في المستوى الاجتماعي المقبول.. كلُّ ذلك التظاهر بالهيئة المتوخَّاة، إذن، جاء جائحا كلاًّ من وسائل الإعلام العربي ووسائل الإعلام العبري في أوانٍ متزامنٍ في هكذا زمان «فائتٍ»، على الرغم، في حالة هذه الأخيرة، من ظهور أشكالٍ شتَّى من الاعتراض الصارخ من البعض اللافتِ الآخر من أزلام الكيان الصهيوني بعينه، وخاصَّةً من أولئك الأزلام المتجانفين الذين كانوا، وما زالوا، يكنُّون الولاء «اليميني» لرئيس حكومة هذا الكيان سابقا، بنيامين نتنياهو בנימין נתניהו، بدءا من الولاء «اليميني» من نجله بالذات ناجحا به نجاحا باهرا، فيما يظهر، ودرءا للفشل الذريع الذي كان، وما زال، يُمنى به آنا بعد آن – حتى لو لم يُهملْ هكذا رئيسُ حكومةٍ مسألةَ «ضمِّ غور الأردن إلى إسرائيل» في حدِّ ذاتِها، وذلك نزولا متواضعا عند رغائب الكثير الجَمِّ من معشر «المحبِّين للتوسُّع» من الصهاينة المتعصِّبين وكذاك المتعنِّتين (يُنظر، هنا، تقريرُ سهيل كيوان المعنيُّ: «أبو كلثوم الأدرعي»، من إصدار «القدس العربي» في يوم 15 تموز (يوليو) 2020)..
من المعلومِ علمَ اليقينِ في الواقع الفلسطيني المُسْتَلَبِ، في كلٍّ من السياقين التاريخي والجغرافي، أن سياسةَ طَمْسِ الأسماءِ العربيةِ للأماكنِ عامَّةً وتبديلِها بأسماء عبرية مصطنَعة ومفتعَلة لَسياسةٌ قد بُدِئَ بتنفيذها القسري بالتدرُّج والتدريج الفعليَّيْن، كلَّما سنحت فرصٌ مناسبة وانتهازاتٌ مؤاتية، منذ بدايات عهد الاستيطان الصهيوني الفعلي، أو هكذا يتبدَّى، سنة 1948، على أقل تقدير.. وهذه السياسة «الطَّمْسِيَّة» و«التبديلية» بالتنفيذ القسري المعني، في هذه القرينة بالتحديد، إنما تعود بجذورها «الزمنية»، بدورها القومي العُصَابي هي الأخرى، إلى ما يقرب من ثلاثةٍ من العقود المديدة التي سبقت حتى طرحَ فكرة «الدولة الصهيونية» من خلال طرحِ ذلك الإطار التنظيري التطلُّعي لتأسيس مَا صَارَ يُسَمَّى بـ«المنظَّمة الصُّهيونية العالمية» WZO سنة 1897 – وبالحَرِيِّ ذِكْرًا، ها هنا، تلك العقودِ الثلاثةِ المديدةِ التي تجلَّت فيها أيَّما تجلٍّ تسمياتُ المدائنِ وما تحتويهِ كذاك تسميةً عبريةً بالعَنْوَةِ والعُنُوِّ مِنْ لدن مَنْ كانوا إبَّانَئذٍ يُسمَّون اصطلاحا تبشيريا مصطنَعا ومفتعَلا أيضًا، في أبهى حُلَّتِهِ، بجماعة «محبِّي صهيون» חובבי ציון، يُسمَّون مُذَّاك بوصفهم رهطَ المؤسِّسين الأوائل (أو، بالأحرى، رهطَ المسؤولين عن التأسيس الأوَّل) لعشرين مدينةً «يهوديةً» أو «مُتَهَوِّدَةً» في فلسطين بالعدِّ، على أدنى تخمين، وذلك ما بين سنة 1870 وسنة 1897.. هذا، إذن، هو عينُ الموجَّجِ لَغْوًا بين الحينِ والحينِ الآخرِ، في الأصلِ، فيما يخصُّ أيًّا من تيك التسميات العبرية منذ ذلك الحينِ وحتى هذا الحينِ ذاتًا: فكيف يكونُ ذاتُ اللَّغْوِ، عندئذٍ، في تأجيج هذا المؤجَّج، أصلا، إنْ تسمَّى تسمِّيا انتقائيا، بالغُلُوِّ والعُتُوِّ كذاك، شارعٌ «عبريٌّ» أو «مُسْتَعْبِرٌ»، بحكم واقعه الاستيطاني، لا بل الاستعماري والاِحتلاليِّ بامتيازٍ، إن تسمَّى تسمِّيًا «عربيًّا» أو حتى «مُسْتَعْرِبًا» من جديد؟؟.. للأسف الشديد، وبحجَّةِ الحِجَاجِ أنه لا تسميةُ شارع من الشوارع ولا تسميةُ حيٍّ من الأحياء ولا حتى تسميةُ مطارٍ من المطارات تكفي، في القرائن، للتكفيرِ عن جرائمِ أو حتى جرائرِ هؤلاءِ الصهاينةِ الأنجاس منذ أكثرَ من سبعين عاما في المَحْو والتغيير الاسميَّيْن (من الأصلِ العربي إلى «الفرع» العبري)، يلجأ الكاتب الصحافي (الثقافي) المعني، سهيل كيوان، من خلال لَغْوِه التأجيجي لما هو مُؤَجَّجٌ قبلا، في تقريرهِ المذكور آنفا، يلجأ كَرَدِّ فعلٍ يعتريهِ فَوْرُ الحماسِ «الوطني» وتنتابُهُ كذاك فَوْرَةُ الحميَّةِ «القومية» إلى عينِ الرَّغْوِ الترويجي، من طرفهِ هو الآخَرُ، لما هو مُرَوَّجٌ من قبلُ عن شخصِ المغنِّيةِ أم كلثوم بالذاتِ على أكثر من صعيدٍ، سياسيًّا كانَ أو قوميًّا أو حتى لغويًّا، في المقام الأوَّل..
وهكذا، يشيد هذا الكاتب الصحافي (الثقافي) المعني، على سبيل المثال، بموقف المغنِّيةِ أم كلثوم السياسي ذاك «الملتزم أيَّمَا التزامٍ» حينما غنَّت بأعلى عقيرتها أغنية «والله زمان يا سلاحي»، غنَّتْها وقتَئذٍ إبَّانَ العدوان الثلاثي الشهير على مصرَ عام 1956، وبالتحديد إذَّاك على أثر إعلان تأميم «قناة السويس» الواقعِ في اليوم السادس والعشرين من شهر تموز (يوليو) من نفس ذلك العام – وعلى الأخصِّ، ها هنا، حقيقةَ أن تلك الأغنيةَ بالذاتِ سرعانَ ما تحوَّلت إلى نشيدِ مصرَ الوطنيِّ الأثير، وقد استمرَّت كذاك إلى أن تمَّ إلغاؤها إلغاءً «لاتعسُّفيًّا»، أو هكذا قد خُيِّل للمهتمِّ بهكذا إلغاءٍ، على لسان «المسالم» أنور السادات بعضلة لسانه (قبلَ عظمتِه حتى).. ويشيد كذاك هذا الكاتب الصحافي (الثقافي) المعني، فضلا عن ذلك، بموقف المغنِّيةِ أم كلثوم القومي ذاك «المعتصم أيَّمَا اعتصَامٍ» عندما غنَّت بأجهر صوتها أغنية «أصبحَ عندي الآنَ بندقيَّهْ»، غنَّتْها آنَئذٍ نيابةً عن ناظمها «الناصري» الشاعر نزار قباني، لكي تكون الفنانة بالذات جسدا وروحا في آنٍ معا «مع [سَائر] الثُّوَّار الفلسطينيِّين ومنهم»، وعلى الرغم من أنها، بعد زمانٍ قد دامَ «عشرين عاما و[هي] تبحث عن أرضٍ وعن هُوِيَّهْ» بحثًا دؤوبًا، لم يحدثْ لها بّتَّةً أن التقت بأي من أولئك «الثُّوَّار الفلسطينيِّين»، لا على أرض الواقع من قريبٍ ولا حتى في سماء الحلم من بعيدٍ – ناهيك، بطبيعةِ الحَالِ، عن إشادتهِ الجَمُوحِ، إشادةِ الكاتب الصحافي (الثقافي) المعني، كذاك بموقفِ ذاتِ الفنانةِ اللغويِّ ذاك «المنتظمِ أيَّمَا انتظامٍ، بدوره هو الآخرُ» وبمدى تلك الخدمة الجليلة التي قدَّمتها إلى اللغة العربية بالعين تثقيفا جليلا لكلٍّ من الأُمِّيِّينَ و«اللاأُمِّيِّينَ» من آنامِ العربِ والمستعربينَ على حدٍّ سَوَاءٍ: وقد كانَ ذلك كلُّهُ من خلال صَدْحِ أغنياتها القِصَارِ والطِّوَالِ (وما بينَهما حتى) بأشعار الشكل الفُصْحَوِيِّ «النَّحَوِيِّ» من هذه اللغة الجميلة بالعين أيضًا، وهو (أي عين الكاتب الصحافي (الثقافي) المعني)، فيما يبدو، متغاضٍ تغاضيا أجلَّ بكثيرٍ عن غياب قدرتها على النطق السليم بالنَّحْو المُشْبَع صوتيًّا للجيم حرفا، بالمثال لا بالحَصْر.. هكذا كانَ رَغْوُ المُرَوَّجِ فاشيا وأكثرَ منه حتى في صفحاتِ الإنباءِ من وسائل الإعلام القديمة في ذلك الزمان، وهكذا صَارَ رَغْوُ ترويجِ المُرَوَّجِ حاشيا في صفحاتِ الإنباءِ من الوسائلِ النظيراتِ الحديثةِ في هذا الزمان، وإلى حدِّ ذلك الحَشْوِ التعبيريِّ الإغراقيِّ بأن عينَ المغنِّيةِ «أم كلثوم [قد] ارتقت بالموسيقى العربية إلى مستوياتٍ غيرِ مسبوقةٍ، وتعتبرُ اليومَ الممثِّلَ الشرعيَّ الأوَّلَ للموسيقى العربية التي نستطيعُ أن نفاخرَ بها بين الأمم»، على حدِّ تعبير الكاتب الصحافي (الثقافي) المعني..
على أقلِّ تقديرٍ هنا، في رأي المفكر والناقد الأدبي الكبير إدوارد سعيد، هذا إن لم ننظرْ رَأْيًا في أيٍّ من آراء الكثيرين ممَّن يؤيِّدُونَهُ ويؤيِّدْنَهُ (وأنا منهنَّ، ولا ريب في ذلك بتًّا)، فإن ذاتَ المغنِّيةِ أم كلثوم بوصفها «مغنِّيةً»، في الحيِّز الأوَّل، ليست بالبتِّ الدَّامغِ (أو بالكادِ) من كلِّ ما قيلَ عنها، قبلَ قليلٍ، في شيءٍ.. وفيما يخصُّ حالَ الموسيقى العربية المتكلَّمِ عنها كذلك، على وجهِ التحديدِ، فقد كانت ذاتُ المغنِّيةِ أم كلثوم «تغنِّي»، حينما كانت «تغنِّي» فعليًّا، بكلِّ تأوِّهاتها الجسدانية والحِسَّانية وحتى الشهوانية التي تزيد عن حدِّها وَقْعًا و«إيقاعًا» بالنسبة للأذن الخاصَّة، وحتى قبلَ حدِّها الوَقْعي و«الإيقاعي» كذاك بالنسبة للأذن العامَّة، فقد كانت «تغنِّي» كالمرأة الموجوعة الوَجُوعِ أيَّما وجعٍ في الضَّرَاءِ لا السَّرَّاءِ حتمًا، فقد كانت «تغنِّي» وهي تئنُّ تئنُّ بأعلى ما «تقدرُ عليهِ» أنينًا من أنينِ آلامها وتباريحها طُرًّا، وكأنها كانت، بهكذا أنينٍ مضاعَفٍ، تعاني كلَّ المُعَانَاةِ من مغصٍ زُحاريٍّ شديدٍ ومن التهابٍ معويٍّ حادٍّ إلى أبعد الحدود.. والمفارقةُ الكارثيةُ وحتى الطَّامِّيَّةُ في هكذا قرينةٍ، ويا للأسفِ الأشَدِّ الأشَدِّ هنا، هي أنه في الأوقاتِ الأشدِّ الأشَدِّ إيجاعا وإيلامًا حتى، أوقاتِ الحروبِ «الضَّرُوسِ» بين أولئك الأنامِ من العرب والعبريِّين بوجه العموم، كانَ سَائرُ الجنودِ العربِ (وكذلك العربانِ) منهمكين كلَّ الانهماكِ الرَّغَبِيِّ بالاستماع إلى «أغاني الحماس» بتأوِّهاتِ المغنِّيةِ أم كلثوم تلك ليلَ نهارٍ، بينما كافَّةُ الجنودِ العبريِّينَ من طرفهم، في المقابل، فكانوا منكبِّين كلَّ الانكبابِ الرُّوحِيِّ على ترتيل ما كان يتيسَّرُ لهم إذَّاكَ من آياتِ التوراةِ بالذاتِ، وبالأخصِّ ممَّا كانوا يتوخَّونه بالإنشاد قصدًا من مزاميرِ داوودَ دونما سواها.. يا تُرى هل كانت عينُ المغنِّيةِ أم كلثوم، من جرَّاء كلِّ تلك الخدماتِ «القتاليةِ» الجليلةِ التي كانت تسديها عن وعيٍ أو حتى عن لاوعيٍ لآلِ صهيونَ كافَّتِهِمْ، يا تُرى هل كانت بذاتِ الصوتِ حقًّا في صفوفِ «الثُّوَّار الفلسطينيِّين» ولو حتى جُزءًا أم كانت بذات الصوتِ بالذاتِ حقيقًا في صفوفِ «المقاتلين الإسرائيليِّين» كُلاًّ بالكُلِّ، على النقيض؟؟.. كما نوَّهت إحدى المعلقاتِ النبيهاتِ وقتَها تنويهًا لافتًا، لو بقيتِ المغنِّيةُ الحقيقيةُ والمبدعةُ «أسمهان» على قيد الحياة أيَّامئذٍ، على الأقلِّ بالقدر الذي بقيتْ عليهِ «المغنِّيةُ» أم كلثوم ذاتُها (وبصرفِ النظرِ كليًّا عن أيٍّ من مخلَّفاتِ تلك الإشاعةِ التي أُشيعت حول «مؤامرة» قتل الأولى بتدبيرٍ خفيٍّ من لدن أزلامِ الأخيرةِ بغيةَ التخلُّص من «غريمتها» في تبوُّءِ عرشِ الغناءِ العربي الأنثوي)، لما تمَّ اعتبارُ «المغنِّيةِ» أم كلثوم ذاتِها في هذهِ الأيامِ «الممثِّلَ الشرعيَّ الأوَّلَ للموسيقى العربية»، ولما استطاع الكاتبُ الصحافي (الثقافي) المعني ذاتُهُ بالتالي «أن يُفاخرَ بها بين الأمم»، ولا شكَّ في ذلك بتًّا!!..
وعلى فكرةٍ، في الأخيرِ ها هنا، فإن ترويجَ المُرَوَّجِ بالرَّغْوِ المبتَنَى بهكذا أسلوبٍ وضيعٍ بَخْسٍ ليس مقصُورًا مقتصرًا على معشر هؤلاء الكتبةِ الصحافيين و/أو الإعلاميين وحدهم، بل هو جدُّ فاشٍ متفشٍّ كذلك بين معشر أولئك الدَّجَّالين الأدعياءِ من أشباهِ «الطبابيِّين» (أو، بالأحرى، معشر أولئك الدَّجَّالين الأدعياءِ الذين يدَّعونَ طَفَالةً وجَهَالةً بأنهم «طبابيِّون» لا أشباهُهُمْ).. فعلى سبيلِ المثالِ لا الحصرِ، في هذا السياق، يظهر الآنَ، كما كانَ يظهرُ من قبلُ، على السطح لاجئٌ (أو، بالحَرِيِّ، منتهزٌ غسيفٌ لقيطٌ «عَكُوفٌ» للِّجُوءِ في ألمانيا) عسيفٌ نقيطٌ عَتُوفُ الحاجبينِ تنطُّ أيَّما نطيطٍ إرسالاتُهُ «الفيسبوكية» المكتظةُ بالعباراتِ المسروقةِ عمدًا من هنا أو من هناك، تنطُّ فجأة من آنٍ لآنٍ، لاجئٌ (أو منتهزٌ غسيفٌ لقيطٌ «عَكُوفٌ» للِّجُوءِ) عسيفٌ نقيطٌ عَتُوفُ الحاجبينَ يكتبُ عن نفسهِ بكلِّ ثقةِ نفسٍ بأنه «طبيب نفسي»، وجلُّ، إن لم يكنْ كلُّ، ما يخطلُ به من خطلٍ أجوفَ أعجفَ عن «نفسية» المرأةِ وعن «نفسية» الرجلِ وعن ماهيةِ الكذب عند كلٍّ منهما وعن كيفيةِ «إيقاع» أحدهما بحبال الآخر، وما شابهَ من هذا، بتعميماتٍ جارفةٍ جوفاءَ عجفاءَ ما أنزلَ اللهُ بها من سلطانٍ، خطلٍ لا يعدو أن يكونَ خطلاً عنصريًّا ذكوريًّا متخلِّفا قميئًا مقيتًا بكل ما تحتويه هذه الكلماتُ من معنى ومن حتى ظلالِ معنى، وحتى قبل أن ينأى كذلك كلَّ النأيِ عن أيِّ شيءٍ آخَرَ له مساسٌ بما يُسَمَّى بالاصطلاح المغلوطِ أصلا بـ«الطب النفسي».. والأنكى من ذلك كلِّهِ، فوق كلِّ ذلك، أن هذا اللاجئَ النغيلَ (أو المنتهزَ اللُّجُوءِ نُغُولَةً) بوصفِهِ مثالاً مَرَضيًّا نفسيًّا نموذجيًّا من أمثلةِ ما يُعرفُ اصطلاحًا كذاك في علمِ النفسِ تعيينًا وتحديدًا بـ«الشخصية الشرجية»، بالحرفِ، أو حتى بـ«الشخصية الإستية» Anal Character، بالمجازِ، يكتبُ عن نفسِهِ مفخورا ومتباهيًا ومتبجِّحًا بأنه عينُ «المدير الطبي للهيئة العامة لمستشفى ابن سينا سابقا»، راغيًا كلَّ الرَّغْوِ كذاك بالترويجِ على صفحتهِ المكتراةِ بين إرسالٍ وآخَرَ لما رُوِّجَ، في الأساسِ، من قبلُ عن كلِّ أولئك السفلةِ الوصوليِّين والانتهازيِّين من أسيادِهِ ذواتهِمْ حينما كان، كما عهدِهِ ولمَّا يزلْ بعدُ، كالعبدِ الذليلِ السفلِ والفسلِ الحقيرِ ينفِّذ تنفيذًا بالحذافيرِ كافَّةَ الأوامرِ والنواهي التي كانت تأتيهِ إتيانًا منهم بالشخوصِ، بعدَ أن كانوا هم أنفسُهم كالعبيدِ الأذلَّاءِ السُّفَلاءِ والفُسَلاءِ كذلك قد نفَّذوا تنفيذًا بالحذافيرِ سَائرَ الأوامرِ والنواهي التي كانت تأتيهم مأتاةً، وأكثرَ منها حتى، من أولئك السفلةِ الوصوليِّين والانتهازيِّين من أسيادِهِمْ، بدورِهِمْ هُمُ الآخرون!!..
^^^
تعريف بالكاتبة
ولدتُ في مدينة باجة بتونس من أب تونسي وأم دنماركية.. وحصلتُ على الليسانس والماجستير في علوم وآداب اللغة الفرنسية من جامعة قرطاج بتونس.. وحصلتُ بعدها على الدكتوراه في الدراسات الإعلامية من جامعة كوبنهاغن بالدنمارك.. وتتمحور أطروحة الدكتوراه التي قدمتُها حول موضوع «بلاغيات التعمية والتضليل في الصحافة الغربية» بشكل عام.. ومنذ ذلك الحين وأنا مهتمة أيضا بموضوع «بلاغيات التعمية والتضليل في الصحافة العربية» بشكل خاص..