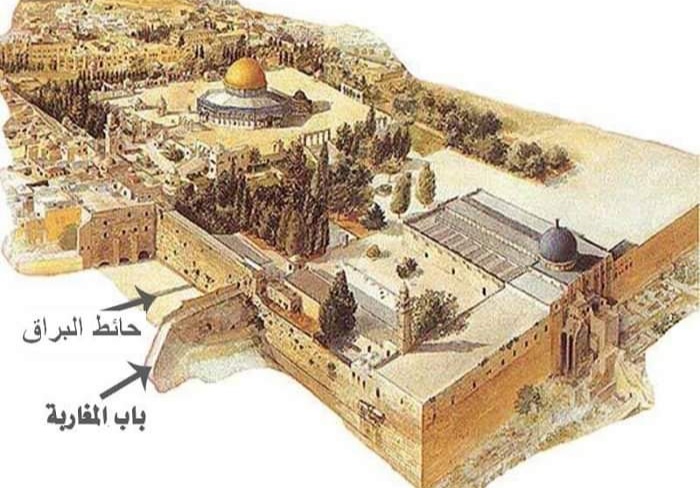في الطريق إلى البيت

عبد الرزّاق الربيعي | شاعر ومسرحي وكاتب صحفي
“هزني الحنين لهلي
والشوق بي عاد
هيا بنا ياربع
نمشي درب بغداد”
( من أغنية لعفيفة إسكندر)

“إنني أحمل بغداد معي في القلب
من دار لدار
أبداً لن يستر الثوب المعار
عري أهلي
آه من عري القفار
أه لو عدت إلى بيتي
لمزقت مكاتيبي وأوراق الغبار”
(عبد الوهاب البياتي)
“عند نافذة معلقة
وجدتَ نفسك
أكثر وضوحا
تحت الشمس
الشمس التي
جلدتْ
بسياطها البيض
سطحَ البيت
وأنت تدور
من بيتٍ
إلى بيتٍ
إلى بيت
تذكّرتَ
وسألتَ روحَك:
ياه…
منذ متى
لم تعد
إلى البيت؟”
كنت قد كتبت هذا النص عام 1994 بعد شهور قليلة على مغادرتي بيتنا ببغداد. وأذكر أنني كتبته، وكنت بضيافة الكاتب الراحل محمد طملية مضطجعا على سطح بيته في منطقة “الحسين”، حينها كانت موضوعة الحنين إلى البيت تشغلني ولم أكن أعلم أنّ غيابي عن “البيت” سيمتد لستة عشر عاما، انتقلت خلالها بين عدة بيوت، لكنّ حنيني ظلّ متسمّرا عند عتبة ذلك البيت الكائن في مدينة الحرية ببغداد.
* * *
حين تلقّيتُ رسالة من إدارة مهرجان المربد تدعوني للمشاركة في المهرجان السادس الذي كان قد تقرّر عقده في البصرة من الفترة 23، ولغاية 26 مارس “آذار” 2010م، لم أكن أتصور أن هذه الرسالة ستطلق النار على كلّ تلك السنوات التي وقفتْ بطابور طويل، ولأنني كنت مستبعدا جدّا العودة للبيت، لذا أجبتُ بالموافقة على الدعوة، بلا تفكير ولا تردد، لألقي الكرة في ملعب الأيام، وأريح ضميري تجاه أهلي الذين فوجئوا بالخبر، وصفّقوا لي، وبدأوا الاستعدادات للزيارة، كطلاء البيت، وترتيب جدول و.. و.. و.. و, وكنت حين أسمع تلك التفاصيل أضحك بيني، وبين نفسي، وأقول: يتصرّفون كأنني حقّا سأزور البيت!!!
وصرتُ كلّما أفتح بريدي، أضع يدي على قلبي خوفا من وصول رسالة من إدارة المهرجان تخصّ الدعوة، واستمرّ الحال أياما حتى تناهى لسمعي أن المهرجان أجِّل، فطرتُ فرحا!!
ذلك لأنني لم أكن على استعداد نفسي كامل لمواجهة حدث كهذا، لكنّ فرحتي لم تستمر طويلا، لأنّ الدكتور سعيد الزبيدي الذي كان سيرافقني في الرحلة، أبلغني أنّ وزير الثقافة أعلن عن إقامة المهرجان بموعده المقرر نقلا عن قناة “العراقية” الفضائية.
إذن لا مفر من الرحلة الصعبة التي ستعيدني إلى نقطة وضعتها صباح يوم 1/2/1994م حين ودعت والدي ووالدتي، وجدتي وأخوتي، حاملا حقيبتي، متّجها إلى كراج علاوي الحلة بصحبة أخي المرحوم محمد الذي ودعني هناك مع الصديقين وديع نادر الخزرجي، وجبار المشهداني، وكانت معي في الرحلة الصديقة الشاعرة أمل الجبوري، وابنتها الرضيعة “ملائكة” والصديقة حكمية جرار، والشاعر منذر عبدالحر ، واليوم بعد هذه السنوات الطوال، رحل الثلاثة الذين ودعتهم في بيتنا “والدي، ووالدتي، وجدتي”.
أمّا الرضيعة “ملائكة” فقد صارت شابة في السابعة عشرة من العمر، وحكمية جرار رحلت قبل عامين، من تلك الزيارة، وتغيّر وجه بغداد بالتأكيد، لكنها ظلّت تتنفّس في مخيلتي!
“عندما تعود إلى الوطن
لا توجّه وجهك
صوب البيوت
والمدن
والحدائق
أعطِ وجهك المقبرة
هناك
هناك
ستجد الكثيرين
ممن تودّ أن ترى
ويودّون أن يروك
ولو من تحت
تراب الذكريات”
كنت أطرد هذه الأفكار من رأسي بالانغماس بالعمل، بخاصة أن الأيام التي تفصلني عن موعد الدعوة كانت مليئة بالعمل والأنشطة، والفعاليات، كان أبرزها الاشتغال بملحق يومي عن جريدتنا يغطي فعاليات مهرجان مسقط السينمائي، وقبل ذلك المشاركة بمهرجان مسرحي جامعي أقيم بالرستاق، لذا لم أطل التفكير كثيرا في الرحلة، حتى وصلتني التذكرة، وكانت إلى بغداد، فصرتُ وجها لوجه أمام الحدث المنتظر، وأي حدث!
تذكّرت د.محمود الجادر، رحمه الله، أستاذ مادّة الأدب الجاهلي، الذي درّسنا هذه المادّة في كليّة الآداب، وكان يكرّر بيت الشاعر الجاهلي أوس بن حجر:
أيّتها النّفس أجملي جزعا إنّ الّذي تحذرين قد وقعا
باعتبار أنّ “الحذر أشد من الوقيعة” كما تقول العرب
كان قلبي يزداد خفقانا، كلما اقترب الموعد المحدّد للسفر، ويُصاب تفكيري بالشلل، لكنّني في الأيام الثلاثة الأخيرة بدوتُ مستسلما للفكرة، مقتنعا بما سيأتي، لذا أوقفت التفكير بهذا الأمر تماما، وصرتُ ألملم ملابسي، وأضعها في حقيبتي بشكلٍ ميكانيكيّ، وفي الليلة الأخيرة كنتُ مصمّما على امتصاص آخر رشفة في رحيق مسقط، ومهرجانها السينمائي ، فحضرت حفل الختام، وحين خرجتُ من القاعة فتحتُ هاتفي، وإذا بسيل من الاتصالات من أهلي يخبرونني أنهم سيكونون بانتظاري في ساحة “عباس بن فرناس”! وحين استفسرتُ عن تلك الساحة، قيل لي أنها آخر نقطة يسمح بها توديع، واستقبال المسافرين في مطار بغداد الدولي من باب التحوّطات الأمنية، وتقع على بعد عدة كيلومترات عن المطار, فطلبتُ منهم انتظاري في فندق “المنصور ميليا” مقر إقامة ضيوف المهرجان ظهرا، إذ أن الطائرة ستنطلق في الثامنة صباحا متجهة للمنامة، وبعد “ترانزيت” لأقلّ من ساعة، ستتّجه الطائرة لبغداد، وبعد عدّة محاولات اقتنعوا باقتراحي، حاولت في تلك الليلة المحافظة على هدوئي محاولا النوم، ولو لساعات قليلة حيث إن بانتظاري رحلة شاقة، وبالفعل تمكّنتُ من النوم قليلا، نهضتُ فجرا، وبعد أدائي لطقوس الصباح المعتادة، حملتُ حقيبتي وغادرت البيت بصحبة زوجتي- رحلت بعد خمس سنوات من ذلك اليوم- لاحظتُ أن عدّة دمعات طفرتْ من عينيها، فلم تكن موافقة على السفر، لاسيما أن وسائل الإعلام كانت تنقل لنا يوميا صورا مؤلمة عن تدهور الوضع الأمني، استحضرتُ أبا زريق البغدادي:
لا تعذليه فإن العذل يوجعه قد قلت حقّا ولكن ليس يسمعه

لكنّ اتّجاهي كان متعاكسا مع البغدادي الذي قالها مودّعا بغداد، والقمر الذي “من فلك الأزرار مطلعه” بينما أتجه أنا إلى بغداد التي بدتِ الطائرة مسرعة جدّا، وهي تتجه صوبها, لم أصدق أذني حين أعلن أحد أفراد طاقم الطائرة عبر مكبّر الصوت دخولنا الأجواء العراقية، ثم أردف “راجين البقاء في مقاعدكم نظرا لوجود مطبات هوائية غير متوقعة”
قلت: إذن دخلنا فعلنا الأجواء العراقية!
ابتسم الدكتور سعيد، ثم أغمض عينيه مستسلما لنعاس لذيذ أفسدته مطبّات خفيفة داعبت جسم الطائرة التي ظلت تسير بسرعة خلتها جنونية!
بدأت الطائرة تهبط شيئا فشيئا، مثلما تهبط أية طائرة على وجه البسيطة!
نظرتُ إلى الأسفل عادتْ إلى روحي الطمأنينة، شاهدت المربعات والمستطيلات الخضراء تذكرت أننا في موسم الربيع الذي ترتدي خلاله أرض العراق ثوبا مطرّزا بالاخضرار, بل أن ذلك اليوم هو يوم عيد الربيع، أو عيد نوروز، وبه تبلغ الطبيعة هناك ذروة عنفوانها!
سلاما أيتها الطفولة الغارقة تحت ركام الأيام والدخان
سلاما أيتها الريح الحنونة
سلاما أيتها المآذن ودعوات الأمهات
سلاما… سلاما
بدأت البيوت بالظهور، مثل حبات قمح صغيرة، ثم صارت تكبر، صرنا نرى مآذن وساحات، ظلّ نظري شاخصا يبحث عن البيت وسط مئات أطنان حبات القمح!
تبادلنا الابتسامات حين هبطت الطائرة وأوقفت محركاتها عن الدوران، إذن كل شيء سار بسلام، ولم يبق لي سوى دخول عتبة البيت! ولكن دون ذلك طرقات، ونقاط تفتيش، وحواجز كونكريتية كانت تبدو من الأعلى مثل أسوار رفيعة تفصل مناطق بغداد عن بعضها!
حين نزلنا من السلّم شعرنا ببرودة الهواء، وعذوبته، لحسن الحظ أن الحرائق لم تفسد علينا الهواء الذي لم يزل مثلما تركته، بداية طيبة، جعلتني أتفاءل خيرا، وأحثّ السير لأضع قدمي على الأرض التي فارقت، لكن إسفلت أرضية المطار حرمني من ملامسة التراب.
وقبل أن أطيل التفكير كانت الحافلة التي تقلّنا إلى بناية المطار، قاطعة أمتارا قليلة، لا تعرف ماذا يجري في رأسي من أعاصير، وعواصف،صعدنا، وبعد دقائق وجدنا أنفسنا في الباب الخلفي للقاعة، شاهدت رجلا من إدارة المهرجان يتقدم إلينا، ويرحب بنا بلطف شديد ويأخذ جوازاتنا أنا ومن كان معي في الرحلة: الدكتور سعيد الزبيدي، والشاعرة هاشمية الموسوي، والشاعر حيدر النجم، والشاعر المغربي كمال أخلاقي. اتّصلت بأخي الأصغر عدنان قلت له: أنا في بغدااااد.
بدا أخي من خلال ارتعاشة صوته غير مصدّق، فصاح: “هلا، ألف الحمد لله على السلامة،أهلا، نوّرتْ، سننطلق الآن من البيت لنلتقيك في فندق “المنصور ميليا” “.
أغلقتُ الخطّ، وأنا أدرك أن أخوتي رغم كل وعودي لم يصدّقوا أنني سأفعلها، وها إنني فعلتها، وجئت لمكان ربما لم أجد لي به مكانا أجالس به ذكريات الأمس البعيد, ربما كيّف نفسه على الاستغناء عن وجودي! ربما.
لاحظ “النجم” صمتي حاول أن يستفسر، قلت له: هذه عودتي الأولى لبغداد بعد 16سنة متواصلة، فبدا على وجهه التأثر، قلت له: دعك من هذا الآن ولنلتقط صورة بالمناسبة، وقبل أن يجيب أخرجتُ كاميرتي، وسلمتها لأحد الذين كانوا معنا على متن الطائرة، ولكن على الفور جاء رجل أمن شاب وقال: عذرا، التصوير ممنوع، فأعدت غطاء الكاميرا، علّق: إنها تعليمات الشركات الأمنية، قلنا له: لا عليك، فقط أردنا أن نوثّق اللحظة، فكرّر اعتذاره. بعد دقائق عاد، وقال: إنها مجرد صورة، لكن ماذا نفعل للشركات الأمنية، وتعليماتها، قلنا له: نقدّر ذلك، لا تهتم، بعد قليل عاد إلينا قائلا: التقطوا الصورة، وليحدث ما يحدث، فضحكنا وقلنا: بهذه أثبتت عراقيتك!
أعادوا إلينا جوازاتنا، فعبرنا الحاجز، وهناك وجدنا مجموعة من الرجال الأنيقين يتقدمهم الشاعر منعم الفقير، تبادلنا التحيات، والقبل، والسؤال عن الحال، والرحلة والمدعوّين.
توزّعنا على السيارات التي انطلقت بنا، كان معي في السيارة د.سعيد الزبيدي، وحيدر النجم، وكمال أخلاقي، مددتُ البصر، على الجانبين بدت لي الأشجار واقفة في مكانها كما كانت، لم أشاهد أثرا لدوريات عسكرية محطمة كما خيل لي, ومن بعيد لاح لي تمثال “عباس بن فرناس” وهو يفرش جناحيه المثبتين بالشمع في الهواء في محاولة يائسة للطيران أجهضتها أشعة الشمس، فسقط ليظفر بتمثال احتل هذا المكان منذ سبعينيات القرن الماضي, وهاهو مثلما كان في مكانه، لكنه ما زال محافظا على حلم الطيران!
قال لي د.سعيد الزبيدي: هذا هو المكان الذي قال لك أهلك أنهم يريدون انتظارك به.

نظرتُ إليه، شاهدت العديد من السيارات الواقفة في العراء وعشرات المستقبلين والمودعين، فجأة تحركت سيارتان عسكريتان، وثالثة للإسعاف، واصطفّ الجميع بموكب طويل، استفسرتُ من السائق عن ذلك، أجاب: السيارات معنا من أجل أمن الضيوف، كان من المفترض أن جملة كهذه تشعرني بالطمأنينة، لكنها أحدثت أثرا عكسيا، فوجودها دليل وجود خطر، وهو ما نحاول التغلب على الاحساس به بالانغماس بأحاديث شتّى!
في الطريق شاهدنا العديد من نقاط التفتيش، وكان رجال النقاط يلقون نظرة علينا، ثم يفسحون لنا الطريق حتى وصلنا فندق المنصور ميليا، وصدمتُ برؤية الخراب الذي حل بمسرح الرشيد، المسرح الذي شاهدنا به أروع العروض المسرحية والسينمائية، والحفلات الموسيقية، هاهو يتحوّل إلى أنقاض:
“إذا صادفتم موتا ضالا
في أحد شوارع بغداد
لا تأخذوا بيده
فهو لا يحتاج إلى إدلاء
إنه يعرف طريقه جيداً
إنه يذهب إلى الشموس الأولى
والأعناق
إنه يذهب إلى المكتبات
والمساء العريق
إنه يذهب إلى الحدائق المعلقة
في القلوب
حاملاً خرائط الغزاة
من أسلافه
إنه يذهب إلى الطفولة
التي تفيض من أثداء دجلة
لتغرقنا بمحبتها
إنه يذهب
حيث تشاء النهايات المفتوحة
وعليه…
إذا صادفتم موتاً ضالاً
في أحد شوارع بغداد
لا تأخذوا بيده
بل قولوا له:
تفضل
أنت في بيتك
أيها الخراب”
أوقف رجال الأمن المزروعون عند باب فندق “المنصور ميليا” السيارة التي تقلنا، سألنا رجال الأمن إن كنا نحمل معنا سلاحا، فأجبنا بالنفي، وبدأوا تفتيشا دقيقا للسيارة، خلال ذلك رفعتُ نظري إلى الأعلى، فشاهدت لافتة كتب عليها رقم قرار صادر بأمر من رئيس الوزراء نوري المالكي يفرض به تفتيش الجميع حتى كبار المسئولين في الدولة، وفجأة أشار جهاز الكشف عن المتفجرات وجود مادة كيمياوية، او معدنية في السيارة!!
كرّر رجال الأمن سؤالنا إن كنا نحمل معنا سلاحا، فأجبنا بالنفي، قال أحدهم: هل معكم عطر أو أحد بأسنانه حشوة؟
قلت: يمعود، كلّي حشوات!
فضحك من كان معي
طلب مني بأدب جمّ النزول من السيارة.
نزلتُ، أعاد فحصها من دوني، فلم يؤشر الجهاز، عندها طلب مني العودة للسيارة مع اعتذار شديد والسماح بالدخول، فضحك كل من كان معي، قال كمال أخلاقي: لن نركب معك ثانية، أنت رجل ملغوم بالحشوات!
تحول الموقف الذي وتّر أعصابنا إلى طرفة نتبادلها، كما كنا نفعل أيام الحرب في الثمانينيات، كانت السخرية دواء ناجعا للكثير من العلل، ولذا حين التقيت لاحقا بعدد من الشعراء من بينهم: جاسم بديوي، و عمر السراي وحسين القاصد وعلي وجيه، وعلياء المالكي، و عارف الساعدي، رووا لي عددا من الطرائف التي أبطالها رجال النظام السابق، سألتهم: نريد أن نسمع طرائف عن المسئولين الجدد،سكتوا، ذكر أحدهم طرفة حول جلال الطالباني، علق بديوي: الطرائف تحتاج إلى مناخات كبت لكي تزدهر !

* * *
وجدنا في الباب الداخلي بوابة فحص إلكترونية، اجتزناها فدخلنا الفندق الذي كان المكان المفضل للقاءاتنا وضيوفنا في مرابد الثمانينيات.
تحركت عدة خطوات بحثا عن بقايا الذكريات عبثا، كان قد أصبح كل واحد منا تحت نجمة من نجوم سماوات المنافي:
“عندما تعود إلى الوطن
وتشتاق إلى رفاق الصبا
فلا تبحث عنهم في الأزقة الحامضة
ولا في حانات الذنوب
بل تتبع آثارهم
في خارطة المنافي المعلقة
على طاولة القيامة”
أول من رأيت من الوجوه الشعرية الجديدة كان الشاعر مضر الألوسي، صافحته وسألته عن عارف الساعدي، وعمر السراي وجاسم بديوي، فقال: ستلتقي بهم في البصرة، فكلّهم مشاركون في المربد.
جلستُ على إحدى الطاولات، وماهي إلا دقائق حتى دخل أخي عدنان مع طفلته، وزوجته التي رمت على رأسي الحلوى، تبادلت مع أخي عناقا حارا، ثم أشار إلى الزاوية القصوى من الفندق، ظننت أنه يطلب مني الذهاب إلى الداخل، وإذا بي أرى عددا من أفراد عائلتي كانوا بانتظاري ولم يعلموا إنني كنت جالسا على بعد أمتار قليلة من مجلسهم، تبادلنا العناق، والقبل، والتحيات، والدموع، كنتُ أشبه بالمنوم مغناطيسيا، شاهدت آثار السنين على وجه عمّتي التي أصرّتْ على استقبالي، كما قال ولدها الدكتور خالد عجمي لتعوّض عن غياب والدتي، سألتها عن صحتها، أجابت: الحمد لله، ثم أطرقتْ، وقالت: “هذه هي الحياة يا ولدي مضوا، ونحن سنمضي خلفهم، وسيأتي أناس آخرون”، فساد صمتٌ متّشحا بالحداد، نظرتُ في الوجوه الجديدة بعائلتنا من أولاد أخوتي، وأخواتي الذين تركتهم قبل أن يتزوّجوا، وبدأتُ أستفسرُ عن أسماء أولادهم التي كنتُ قد سمعتُ بها، وكانوا يعرفونني من صوري!
في تلك الدقائق العاصفة، لم تزل حقيبتي ملقاة في الاستقبال، ومفتاح غرفتي في يدي، والدموع بقلبي!
بعد قليل وصل بقية أخوتي: علي وعادل ومحمد- توفي لاحقا بسكتة قلبية- وأختي الكبرى نضال التي لم تتمالك نفسها، فبكتْ بصوت أثار انتباه الجالسين الذين يبدو أنهم اعتادوا كثيرا على مثل هذه المشاهد!
قال لي أخي عدنان: هناك جزء من العائلة يتهيأ للقدوم، فهل تفضّل أن ننتظره، أم نذهب إلى بيتنا لتقابله هناك؟
فلم أحر جوابا.
أما أخي الأكبر أد. حاتم جبار الربيعي، فقد ظل يتّصل من الصين متابعا خبر وصولي بغداد.
كنتُ في حالة ذهول، وهيجان عاطفي، نهضتُ لأستأذن من إدارة المهرجان التي طلبتْ أرقام هواتف أخوتي بعد التأكد من صلة النسب لأسباب أمنيّة، وكانوا في البداية رفضوا اقتراح أهلي بمرافقتهم، فتمّ كلّ شيء، وخرجنا من الفندق باتجاه البيت، ولكن كيف سأراه من دون عموديه اللذين رحلا خلال الغياب، الأب عام 1994م، والأم عام 2006م، وخلال ذلك تهاوى العمود الثالث :جدتي.
خرجنا من الفندق الذي زوّدني ببطاقة تؤكد إنني من المقيمين لتسهيل مروري عند الدخول في محيط الفندق، في الخارج مررنا بأكثر من نقطة تفتيش، شفعتْ لي عندها البطاقة التي زودني بها الفندق، ربطتُ حزام الأمان، قال لي أخي: ماذا تفعل، هنا لا تحتاج إلى حزام أمان؟ وضحك، وحين شاهدني مصرّا على إحكام إغلاق حزام الأمان ربط حزامه أيضا، وعند أول نقطة تفتيش نظر إلينا أحد رجال الأمن بدهشة، وقال:كلاكما يربط حزام الأمان، ما بكما؟ هل يخيفكما رجال الشرطة إلى هذا الحد؟ وأطلق ضحكة عالية، فعلمت أنني يجب أن أغيّر بعض عاداتي، لكي أندمج في الواقع الجديد أو القديم!!
حين وصلنا منطقة علاوي الحلة شاهدتُ بناية تجنيد الكرخ التي كانت تمثل لنا نقطة تكدير مزاج، فمنها كان الشباب يساقون لمراكز التدريب التي تعدهم بعد ثلاثة شهور أو أكثر أو أقل حسب الصنف للذهاب إلى جبهات القتال، رأيتها قد تحوّلت إلى مركز لمنظمة نسائية!!!
سألتُ عن أصدقاء طفولتي، أجاب أخي علي جبار عطية مذكرا إياي بنص لي:
“عندما تعود إلى الوطن
ويقودك الحنين
إلى مدرستك الأولى
لا تبحث عن رحلتك المدرسية
تلك التي تآكل عليها الوقت
وجدول الضرب والقمع
وسروالك الموشى بخرائط الفقر
بل اذهب إلى أي ثكنة عسكرية
ستجد دم طفولتك
مسفوحا تحت المجنزرات
بالقلم العريض”
سكتُّ، استعرضت عددا من الأسماء، اتصلت بعدد منهم: قاسم جبر، وعباس عباس ناصر الواسطي، وبهجت عبد الوهاب الذي لم يبق من شكله القديم حين التقينا في نادي الشعر باتحاد الأدباء سوى صوته!
* * *
رغم أنّ المساء كان قد حل إلا أن الازدحام كان على أشده، استفسرتُ من أخوتي! قالوا: إنها حديقة الوزراء تستقبل المحتفلين بعيد النوروز.
قلت لهم: ألا يخافون من تفجير سيارة مفخخة أو عبوة ناسفة؟
أجابوا: هذه الأمور لم تعد تخيف الناس، وحتى لو ماتوا سيموتون سعداء!
تذكرت “الموت السعيد” لألبير كامو وعبثية الموت في المدن المكتظة بالفجائع!
في الطريق إلى مدينة الحرية مررنا بلافتة كبيرة كتب عليها “مقرّ حزب الدعوة الإسلامي” قلت: سبحان مغير الأحوال! حين غادرت العراق كان مجرد الهمس باسم هذا الحزب يعني الدخول في غيابة الجب! أما الآن…
تذكرت قوله تعالى من سورة آل عمران “إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ* وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ”
على الحيطان كانت تنتشر صور المرشحين لانتخابات البرلمان, إلى جانب صور لشهداء ورجال دين بعمائم سود وبيض!
بعض تفاصيل المشهد العراقي الراهن
حين بلغنا ساحة عدن انحرفتْ سيارة أخي عدنان باتجاه الجهة اليمنى، نحو الكاظمية، قلت له: لماذا لا نستمر؟ قال: كما ترى الشارع قُطع خلال سنوات العنف الطائفي بلوائح كونكريتية عالية للتحكّم في عملية دخول، وخروج السيارات، وبذلك كثرت الازدحامات!
مالت السيارة يسارا، وبدأتُ أستعيد الأماكن، فبدوتُ مثل طفلٍ صغيرٍ يتهجّى الحروف، والأرقام وسط استحسان معلميه، قلتُ: هذا معمل الشاي، فشهق جميع من كان في السيارة: صحيح ما شاء الله!
وهذه منطقة الدباش وووووأخيرا توقف أخي وقال: والآن إلى أين نتجه؟
عصرتُ ذاكرتي، واغرورقتْ عيناي بالدموع، قلتُ: إلى اليمين بيتنا، فصاح: ممتاز! أنت شاطر!
قلتُ لهم: من الغريب إنني حاولتُ الوصول إلى بيتنا عن طريق تشغيل محرّك البحث في “كوكل إرث” فتهت، لكنّني عند تشغيل ذاكرتي على التراب نجحت!
ربما لأنّ التراب ينشّط الذاكرة، ويدلّ على نفسه.
قبل أن تنحرف السيارة إلى اليمين شاهدت قبة كبيرة محطمة قال لي أخي: إنها شاهد على العنف الطائفي، ففي أحد الأيام صعد أحد الإرهابيين قبة هذا الجامع، وتمركز في المنارة، وظلّ يطلق النار على كل من يمر بهذا الشارع، فقتل الكثير حتى جاءت جماعة مسلحة ففجرت القبة، وقتلت القناص!
“عندما تعود إلى الوطن
لا تحمل ورودا لمن ينتظرك
وسط دخان الحرائق
تحت أنقاض الغد
فالورود معرضة للرياح المفخخة
وقد تجد مأوى لجثامينها
فوق قطرة دم تسلق
الشبابيك البلاستيكية
عند انفجار أقرب لغم”
* * *
ظلّت السيارة تمشي حتى قلتُ لأخي، والدموع تملأ حدقتيّ: قفْ، نزلتُ لم أطرقِ البابَ
“وأنت تدور
من بيتٍ
إلى بيتٍ
إلى بيت
تذكّرتَ
وسألتَ روحك:
ياه…
منذ متى
لم تعد
إلى البيت؟”
بنات أختي اللواتي تركتهن صغيرات، وصرن نساء متزوّجات يقفن مع أطفالهن، نثرن الحلوى على رأسي، علامة ابتهاج، كما فعلت زوجة أخي الأصغر في الفندق.
كانت النخلة التي تركتها صغيرة صارت عالية جدا، تطاول قامتها الطابق الثاني من بيتنا، نظرت إلى حشائش حديقتنا وجدتها قد شاخت وأصيب جزء منها بالصلع حيث ظهر طين الحديقة الذي سحقت ظهره أقدام الأيام واضحا للعيان!
تحركت باتجاه غرفة الضيوف، وجدتها غاصة بالضيوف من الأهل، استعدت المكان، شاهدت لوحتين زيتيّتين للدكتور برهان جبر استقاهما من نصوص لي، وقد استقرا في مكانهما، وكنت قد نسيتهما، شاهدت جزءا من كتبي في المكتبة، شاهدتُ صورة معلقة لأخي الشهيد عبد الستار كنا نخفيها عن الأعين، بينما الآن كبرت الصورة، واحتلت مكانا بارزا في الغرفة، وجوه في البيت اختفتْ، وظهرتْ وجوه أخرى جديدة مؤكّدة حركيّة الزمن.
بعد أن تناولنا وجبة عشاء حافلة بالمأكولات العراقية، قلتُ لأخوتي: علىّ أن أعود إلى الفندق، فغدا ينتظرني سفر آخر للبصرة.
وبصعوبة استطعتُ مغادرة البيت.
- الفصل الأوّل من كتاب وضعته عن الرحلة حمل عنوان ( 14ساعة في مطار بغداد) الصادر في القاهرة٢٠١١