
د. آصال أبسال | كوبنهاغن (الدنمارك)
قبلَ كلِّ شيءٍ هنا، وعلى ضوءِ مَا قد بانَ من إرهاصٍ قديمٍ لكنْ ليسَ بالقديمِ، ومنذ بيانِ تجلِّيهِ الأوَّليِّ مُحاطًا بهالاتٍ جَثِيلاتٍ من سرديَّةِ الضَّبَابِ ومن سرديَّاتِ السَّدِيمِ، إنه لَعَيْنُ التَّبْسِـيرِ المعرفيِّ مقتربًا اِقترابًا على كلٍّ من المستويَيْن الكمِّي والكيفي إن كانَ ثَمَّةَ إتباعٌ ثنائيٌّ أصلًا، هذا التَّبْسِـيرِ المعرفيِّ الذي يتبدَّى جليًّا في معنى الانهباط الثقافي بالحرف أو بالمجاز فصلًا: وذاك واقعٌ صارخ وفاضح من وُقَّعِ الصحافة العربية ‹الرسمية› التي لم تعد تحتاج إلى أيما إثبات دامغ، أو حتى غير دامغ، في هذا الأوانِ العصيب من زماننا العربي السليب على المَرَائِي والمسامعِ كلِّها.. فعلى سبيل المثال لا الحصر ها هنا، وفي اليوم الخامس من شهر آذار (مارس) عامَ 2025، صدر إذَّاك في تلك الصحيفة المُسَمَّاةِ بـ«القدس العربي» – وهي الصحيفة العربية الغنية عن نفسِ التعريف بـ‹استقلالها السياسي› المصطَنعِ اصطناعًا بالفحوى النفاقي والفحوى الازدواجي سواءً بسواءٍ، وبانتهاكها اللاإنساني واللاأخلاقي الزَّرِيِّ لحقوق القرَّاء والقارئات في التعليق تصعيدا صباحَ مساءَ، ناهيك عن تَبَجُّحِهَا الزَّيْفِيِّ والاِفترائِيِّ الأشدِّ زِرَايَةً بنشر ‹أفضل› التقارير الصحفية من حيث المصداقية والموضوعية بالعمق وما إلى ذلك في العراء – صدر تقريرٌ صحفيٌّ منضودٌ باقتضاب على شاكلة مقال إنبائيٍّ من مقالات الرأي ‹الثقافي› أو ‹شبه الثقافي› فيما يبدو بدوره هو الآخر، ومسرودٌ كذاك بذات الاقتضاب شاكلةً تحت العنوان التعيينيِّ والتحديديِّ المباشر سائرًا بالتسيارِ السَّجْعِيِّ الشَّائِرِ، هكذا: «رمضان في مواجهة ‹تسليع› الإنسان»، وذلك بعد إجراءِ شيءٍ من التقويم الرقمي والترقيمي في الوضع الملائمِ في عبارة العنوان بالذات.. والمقرِّرُ الصحافيُّ الذي تجشَّم عناءَ هذين التنضيد والتسريد المقتضبين كلَيْهما مدعوًّا بالاِسمِ السَّمِيِّ، محمد جميح، إنما هو بادِّعائهِ العينيِّ كاتبٌ لاتقليديٌّ وكذلك ‹شاعرٌ› تقليديٌّ يكتب دأبًا على النحوِ الكتابيِّ الدَّوْريِّ، أو حتى شبهِهِ، في صفحاتِ ذات الصحيفة العربية منذ زمن ليس بالقصير بتاتًا.. بيدَ أن إشكاليَّتَهُ الكتابيةَ هذه التي لا يظهرُ أنه يُدرِكُهَا إدراكًا فعليًّا من حيثُ جانبُهَا الفحوائيُّ في توخِّي الموضوعِ المُؤَاتي، كما سبقَ ذكرُهُ في موضع آخَرَ، هي أنه غالبًا ما يورِّط نفسَهُ في الكلام عن مواضيعَ ليست من حدود اختصاصِهِ العلميِّ قطعًا ولا حتى من حدود اقتنائِهِ المعرفيِّ تبعًا، مِمَّا يُوقِعُهُ بين أخذٍ وردٍّ ذاتِيَّيْنِ مِزَاجِيَّيْنِ في الكثيرِ من أشراكِ الخلطِ والالتباسِ والمغالطة.. ففي متن التقرير الصحفي المعني هذا، يُبْدَأُ بالكلام الحماسيِّ المُتَوَازي، وما أكثرَ أشتاتَ هكذا كلامٍ حماسيٍّ مُتَوًازٍ، على فكرةِ البحثِ الدؤوبِ والجادِّ عن نموذجٍ مَنْعِيٍّ، أو حتى عن طرازٍ رَدْعِيٍّ، إزاءَ تعرُّضِ الإنسانِ المعنيِّ لِبرنامجِ مَا يُشَارُ إليهِ وضعًا عربيًّا خُصُوصيًّا بـ‹التَّسْلِيع› Commodification، وعلى الأخصِّ الأشدِّ ها هنا من جَرَّاءَ تأدِيَةِ الناسِ المؤمنين المعنيِّينَ والمؤمناتِ المعنيَّاتِ لتلك الشَّعِيرةِ الخاصَّةِ بامتيازٍ في إبَّانِ شهر الصِّيامِ الإسلاميِّ، شهرِ رمضانَ الفضيلِ بالعَيْنِ (يُنظر، مَثَلًا، تقريرُ محمد جميح المعنيُّ: «رمضان في مواجهة ‹تسليع› الإنسان»، من إصدار «القدس العربي» يوم 5 آذار (مارس) عام 2025)..
وهكذا في ذاتِ التقرير الصحفيِّ المعنيِّ، فإن هذا الشُّرُوعَ في الكلام الحماسيِّ المتوازي ذاتِهِ إنما يُستهَلُّ، من لَدُنْهُ هو الآخَرُ، بشيءٍ من الاستعراضِ المعجميِّ مكتوبًا بلغةٍ ذاتِ ميزاتٍ لا تُذَكِّرُ، من حيثُ التنطُّعُ الظاهريُّ والحالُ هنا، خلا بـ‹ميزاتِ› ما قدِ اصطلحَ عليه ذلك السياسيُّ الفرنسيُّ، جورج كليمنصوه، سخريةً وتهكُّمًا مَوْزُونَيْنِ مُدَوْزَنَيْنِ اصطلاحًا فرنسيًّا أو حتى مُفَرْنَسًا بـ‹اللغة الخشبية› Langue de Bois، وذلك إبانَ اندلاع الحرب البولندية-الروسية (السوفييتية) في بداية العام 1919 (أو هكذا يُظَنُّ، بعد نهاية ما كانَتْ تُسَمَّى بـ‹الحرب العظمى› في العام 1918).. وبالتنظيرِ النظيرِ في شيءٍ من التَّفَصُّحِ الباطنيِّ ‹لَامُتَخَشِّبًا› و‹لَامُتَفَذْلِكًا› مع ذلك، يتبيَّنُ من هذا الاستعراضِ المعجميِّ لاشتقاقِ مفردةِ الشهرِ المعنيِّ ‹رمضان›، أُسْوَةً باشتقاقِ مفردةِ القرينةِ المعنيَّةِ ‹رمضاء› من لَدُنْهَا هي الأخرى، كيف أن الجذرَ الثلاثيَّ العربيَّ ‹ر م ض› في حَدِّ ذاتِهِ يُحيلُ بالمعنى المُرادِ إحالةً إلى فحوى ‹الحَرِّ الشديدِ› أو فحواءِ ‹الحَرِيقِ المديدِ› كحَدٍّ دلاليٍّ أدنى في الحرفِ والمجازِ على حَدٍّ سَوَاءٍ – في الحرفِ تمثيلًا جسديًّا بسببٍ من ‹غَيْهَبَانِ› الغَرَثِ والظَّمَاءَةِ عن طريقِ العِلَّةِ المُثْلَى، من طرفٍ أوَّلَ، وفي المجازِ تمثيلًا روحيًّا مقابلًا بمدعاةٍ من ‹نورانِ› الحكمةِ والبصيرةِ عن سبيلِ المَعْلُولِ الأمْثَلِ، من طرفٍ آخَرَ.. فالغاية المُبْتَغَاةُ ها هنا، إذن، ليست تكمنُ في التَّغْرِيثِ والتَّظْمِيءِ الجسديَّيْنِ في منتهى المطافِ، وما من غايةٍ مُبْتَغَاةٍ غيرِها، بقدرِ ما تكمنُ في الإشباعِ والإِرْوَاءِ الروحيَّيْنِ على النقيضِ في كلٍّ من المبتدى والمنتهى وما بينهما من هكذا مطافٍ، وذاك سعيًا إلى التسلُّحِ بنوع من الفلسفة ‹المثالية› في إطارِ تجلِّيها السامي أو المتسامي من أجل التصدِّي المَكِينِ لطغيانِ الفلسفةِ ‹المادِّية› في إسارِ تعدِّيها الرأسمالي وَ/أوِ الاستهلاكي سائدًا أيما سُؤدَدٍ ومُسَنَّدًا كذاك بأنيابِ التكنولوجيا، وما يترتَّبُ عليها من تَبِعَاتٍ وخيماتٍ هي الأُخرى – وتلك هي، بادئَ ذي بدءٍ، نقطة الانعطافِ ‹التحليليِّ› الفجائيِّ التي كانَ على الكاتبِ اللاتقليديِّ المعنيِّ أن يَثِبَ إليها أو بالأحرى منها عنوةً، فيما يتبدَّى، ولكن دونما سابقِ إنذارٍ أو حتى شيءٍ من إيماءٍ يُذْكَرُ.. ومن البداهةِ في أوانِ الإجحافِ المادِّي، من هذا المنظورِ تحديدًا، أن يصيرَ الحديثُ عن الإنصافِ الروحيِّ ضربًا من المهازلِ مهزوءَةً في أحسنِ أحوالِهِ، نظرًا لتركيزِ النظامِ الرأسمالي وَ/أَوِ الاستهلاكي عينِهِ على خَلْقِ فردٍ ‹مُسَلَّعٍ› بكلِّ أهوالِهِ، ومن ثَمَّ على تكوينِ مجتمعٍ أو حتى مشتركٍ ‹مُدَجَّنٍ› قابلٍ للتطويعِ والتوجيهِ حَسْبَ المُرَادِ بأيِّ شكلٍ من أشكالِهِ، وذلك بغيةَ إفراغِ الإنسانِ من محتواهُ الإنسانيِّ كليًّا ومِمَّا يبتنيهِ من محتوًى أخلاقيٍّ مُلَازِمٍ تحتَ نيرِ منظومةٍ أو منظوماتٍ ليس لَهَا سوى الاِحتفاءِ المديدِ مُرَوْسَمًا بما يُسَمَّى بـ‹تقديسِ التفاهةِ› أو حتى كَلِمِيًّا عكسيًّا بـ‹تَتْفِيهِ القداسةِ› مَاخِرًا، والمَالُ المَالُ، ومَا أدراكَ مَا المَالُ عندَئذٍ، إنما هو الآمِرُ والناهي في هكذا عالَمٍ مُصَنَّعٍ مُصْطَنَعٍ إلى حدِّ التسطيحِ الضَّحَالِيِّ أوَّلًا وآخِرًا.. وبالتالي، فإن أدَاءَ الصَّوْمِ هذا، بغضِّ الطرفِ عن أيِّمَا بُعْدٍ دينيٍّ من أبعادِ ‹الفَرْضِ› الإسلاميِّ أو حتى اللَّاإسلاميٍّ، إن هو إلَّا ضرورةٌ وُجوديَّةٌ (أو كونيَّةٌ) لَا بُدَّ للإنسانِ الحديثِ منها لكي يتحرَّرَ من رِبَاقِ ذاتِ التسلُّطِ الغَرَزِيِّ الزَّرِيِّ تحرُّرًا يتجلَّى، في أزهَى مَا يتجلَّى، بمثابةِ خطوةٍ استهلاليَّةٍ جَادَّةٍ على دَرْبِ المقاومةِ الحَرُونِ لهذا التزييفِ المُخيفِ وهذا التشنيعِ المُريعِ سَوَاءً بِسَواءٍ..
وهكذا، أيضًا، فإن إجراءَ الصيامِ ذاك، بوصفِهِ نهجًا فلسفيًّا مناهضًا بامتيازٍ لاستبدادِ النظامِ الرأسمالي وَ/أَوِ الاستهلاكي ذاتِهِ، ليسَ مجرَّدَ إجراءٍ امتناعيٍّ مادِّيٍّ عن مَادَّتِيِ الغذاءِ والماءِ في غضونِ الساعاتِ المكتوبَةِ حَدًّا بينَ الشرُوقِ والغرُوبِ الشَّمْسِيَّيْنِ على الأقلِّ (ومَا أكثرَهُمْ أولئك المَهَنَةُ العَتَفَةُ المُتَأَسْلِمُونَ الأَفَّاكُونَ مِمَّنْ يمتنعونَ عن هاتينِ المادَّتينِ فحسبُ)، بلْ هو إجراءٌ مِرَانِيٌّ رُوحِيٌّ يُمَكِّنُ رُوحَ الإنسانِ الحديثِ المعنيِّ من التسيَارِ الدَّؤُوبِ كلَّ الدَّأْبِ على دَرْبِ المقاومةِ الحَرُونِ ذاك تَحَاشِيًا وتفاديًا لِسَيْرُورَةِ استحالتِهِ إلى ‹سِلْعَةٍ› بَخِيسةٍ ضِمْنَ مُقْتَضَيَاتِ برنامجِ ‹التَّسْلِيعِ› المُتَحَدَّثِ عنهُ في هذهِ القرينةِ ذاتِهَا – تمامًا مثلَما هي الحالُ هنا في ذلك الإجراءِ المِرَانِيِّ الرُّوحِيِّ الذي كانَ الرَّسُولُ الكريمُ يتَّخِذُهُ لنفسِهِ قبلَ أيِّ امرئٍ آخَرَ، وذلك من جَرَّاءِ مَا قد يُدْرَك من قولِهِ، من جملةِ مَا قالَ، في الحديثِ المعلومِ فَحْوًى بأن «الصَّوْمَ جُنَّةٌ» قبلَ أن يكونَ أيَّمَا شيءٍ آخَرَ.. ومن ها هنا، كذلك، يُشْرِعُ الكاتبُ اللاتقليديُّ المعنيُّ في الوقوعِ في أشراكِ الالتباسِ الحقيقيِّ وسُوءِ الإدراكِ الفعليِّ حينما يحشكُ في هذا السياقِ عِلًَةَ مَا يفكِّر فيهِ فيلسُوفُ الاجتماعِ الألمانيُّ كارل ماركسُ (1818-1883) من مَسَاقِ تفسيرِهِ المادِّيِّ للتاريخِ على وجهِ التحديد.. يقولُ الكاتبُ اللاتقليديُّ المعنيُّ، مع إحداثِ شيءٍ من التعديلِ النصِّيِّ لاتِّسَاقِ صَوْغِ الكلامِ: «وعلى الرَّغمِ من أن [الرَّسُولَ الكريمَ] قد مرَّت عليهِ سنواتُ رخاءٍ، بعد توسُّعِ دولتِهِ، إلَّا أنه ظلَّ يصومُ عن الدنيا لكيمَا يملكَهَا كليًّا، حيث يكونُ حظُّ الكُمَّلِ من الكبارِ أن يعيشوا معَ المعاني العظيمةِ والقيمِ النبيلةِ والمبادئِ الخالدةِ والعقيدةِ الراسخةِ، وهي المعاني والقيمُ والمبادئُ والعقيدةُ التي لا يؤثِّرُ فيها الوجودُ المادِّيُّ، إذ يتكثَّفُ الزمنُ في اللحظةِ التاريخيةِ التي يبدو أن المستوى الأعلى (الروحيَّ المجرَّدَ) هو الذي يؤثِّرُ في المستوى الأدنى (المادِّيِّ الملموسِ) على عكسِ التصوُّراتِ المادِّيةِ التي بَلْوَرَهَا كارل ماركس في أفكارِهِ عن التفسيرِ المادِّيِّ للتاريخِ». فمن هذا التصريح الالتباسيِّ الصريحِ، إذن، تتجلَّى إساءَةُ فَهْمِ الكاتبِ اللاتقليديِّ المعنيِّ صَارخةً فيمَا يخصُّ التفسيرَ المادِّيَّ للتاريخِ عندَ ماركس، إذ يمكنُ رصدُهَا في ثلاثِ نِقاطِ رئيسيَّةٍ بأقلِّ تقديرٍ على النحوِ التالي – أوَّلًا، ثمَّةَ خلطٌ سافرٌ بينَ الجَانِبِ الفرديِّ، متمثلًا في رُوحَانيةِ الرَّسُولِ الكريمِ بالذاتِ، وبينَ الجَانِبِ المجتمعيِّ، متمثلًا في مَادِّيَّةِ الجَدَلِ المُرَادِ من خلالِ تطبيقِهِ المنطقيِّ على سَيْرِ الحضارةِ الإنسانيةِ بأن على الناسِ كلِّهَا أن تُسَاهِمَ في سَيْرُورَةِ النشاطِ الاقتصاديِّ لأجلِ ضروراتِ الحياةِ وتبعًا لوسائلِ الإنتاجِ تخصَيصًا.. ثانيًا، يتبدَّى من فَحْوَاءِ التصريحِ الالتباسيِّ جَلِيًّا أَخْذُ مصطلحِ ‹المَادِّيِّ› هذا بمعناهُ الحرفيِّ كليًّا، فيتبدَّى منهُ بجلاءٍ أشدَّ كذاك أَخْذُ مصطلحِ ‹الرُّوحِيِّ›، في المقابلِ، على أنهُ المحرِّكُ الأسَاسِيُّ للتاريخ، كما فعلَ من قبلُ فيلسوفُ التاريخِ الإنكليزيُّ آرنولد توينبي (1889-1975) الذي انتقدَهُ كثيرٌ من فلاسفةِ التاريخِ وعلماءِ السياسةِ انتقادًا شديدًا، وبخاصَّةِ أولئك الذينَ يؤمنونَ إيمانًا عميقًا بنظرية التطوُّرِ.. ثالثًا، وأخيرًا لَا آخِرًا، وعلى النقيضِ التامِّ مِمَّا ذهبَ إليهِ فَحْوَاءُ التصريحِ الالتباسيِّ بالعَيْنِ، فإن نظريةَ ماركس المُسَمَّاةَ إجماعًا بـ‹المَادِّيَّة التاريخيَّة› Historischer Materialismus تسعى بقدرِ الإمكانِ سَعْيًا علميًّا إلى تفسيرِ كلٍّ من التاريخِ والتطوُّرِ الإنسانيَّيْنِ على أساسِ الشروطِ المادِّيَّةِ (أي الاقتصاديَّة) للوُجُودِ الإنسانيِّ، ولهذا فإن أهمَّ أشكالِ النشاطِ الإنسانيِّ باليقينِ المطلقِ أو بالكادِ إنما هو النشاطُ الإنتاجيُّ من سبيلِ عاملِ ‹العملِ› في حَدِّ ذاتِهِ..
هذا فضلًا، بطبيعةِ الحَالِ والمَآلِ، عن أن هناك في واقعِ الشأنِ الكثيرَ الجَمَّ من التفصيلِ العلميِّ دقيقًا بَاهرًا وكذاك سَاطِعًا، لكنْ جِدُّ عَوِيصٍ وجِدُّ شائكٍ، حَوْلَ موضوعٍ من الأهمِّيَّةِ والخُطُورَةِ بمكانٍ كهذا، مِمَّا يستوجبُ الاكتفاءَ بمِيدَاءٍ محدودٍ ودَالٍّ في آنٍ معًا وبالتحديدِ في حَيِّزٍ كتابيٍّ إنْبَائِيٍّ ثقافيٍّ كهذا.. إنَّ مَا يَهُمُّ أكثرَ فأكثرَ من حيثُ الطابِعُ النقديُّ الكشفيُّ المُبْتَغَى عن قَصْدٍ وعن عَمْدٍ، ها هنا، إنما هو عَينُ التنويهِ النَّبِيهِ اللَّحُوحِ إلى مَدَى التناقضِ الذاتيِّ الواضِحِ والفاضِحِ شَائِرًا وواقعًا في شَرَكِهِ، مَرَّةً أُخرى، ذلك اليَرَاعُ من كاتبٍ لاتقليديٍّ معنيٍّ كهذا، فوقَ هذا وذاك بالكلِّ ولَا رَيْبَ فيهِ بَتًّا.. فمن جِهَةِ أُولى، يُصَرِّحُ الكاتبُ اللاتقليديُّ المعنيُّ هذا بأن العيشَ معَ تيك المعاني العظيمةِ والقِيَمِ النَّبِيلةِ والمبادئِ الخَلُودِ والعقيدةِ الرَّسُوخِ التي لَا يؤثِّرُ فيهَا الوُجُودُ المادِّيُّ فعليًّا، بحيثُ يبدو أن أَعْلَوِيَّةَ المستوَى الرُّوحيِّ (أو المُجَرَّدِ) حَدًّا لَهِيَ التي تؤثِّرُ في أَدْنَوِيَّةِ المستوَى المَادِّيِّ (أو المَلْمُوسِ) بذاتِ الحَدِّ – مُعْتَرِفًا بذلك اعترَافًا جَلِيًّا، وهو يدري، بأن العاملَ الرُّوحيَّ (أو المُجَرَّدَ) بالذاتِ إن هو إِلَّا المُحَرِّكُ الرَّئيسِيُّ للتاريخِ من منظورِهِ العِلِّيِّ.. ومن جِهَةِ أُخرى، يُدْلِي الكاتبُ اللاتقليديُّ المعنيُّ عَيْنُهُ بأن تلك الفلسفةَ الرأسماليَّةَ وَ/أَوِ الاستهلاكيَّةَ قد قَسَّمَتْ هذا العَالَمَ الدُّنْيَوِيَّ إلى عَالَمَيْنِ متغايِرَيْنِ متنافِرَيْنِ: عَالَمٍ أَوَّلَ ينتمي إلى نيويورك ولندن وطوكيو ومَا شَاكَلَ، وعَالَمٍ آخَرَ ينتمي إلى مَدَائِنِ الصَّفِيحِ وأحيَاءِ الهَامِشِ بُدًّا إذ تعصفُ بالكيَانِ منهَا شَتَّى الاضطراباتِ السياسيَّةِ والعرقيَّةِ النَّاتِجِ عن مَدَى اختلالِ الميزانِ الاقتصَاديِّ بعَيْنِ البُدِّ – مُقِرًّا بذاك إقرَارًا حتى أشدَّ جَلَاءً، دونَ أن يدري، بأن العاملَ الاقتصَاديَّ أو العاملَ المَادِّيَّ (أو المَلْمُوسَ) بالعَيْنِ لَهُوَ المُحَرِّكُ الأسَاسِيُّ للتاريخِ على النقيضِ الكُلِّيِّ بِعَيْنِ الرُّمَّةِ!!..
[ولهذا الحديثِ، فيما بعدُ، تَتِمَّة]
————
ملاحظة هامة:
هذه المقالات التي يتمُّ إعدادُها في مجال النقد الإعلامي والصحافي تحديدا إنما كانت، وما زالت، تصدر تباعا في المركز الإعلامي الفلسطيني المتميِّز باسمِ «الإعلام الحقيقي» Real Media، هذا المركزِ الكائنِ أصلا في حيِّ الرمالِ من مدينةِ غَزَّةَ الأَبِيَّةِ بالذات.. ولكنْ، إذْ يعترينا القلقُ الشديدُ والحزنُ الأشدُّ من هول القتل والدمار اللذين يُمَارَسَا بحقِّ أخواتنا وإخوتنا من الشعب الغَزِّيِّ الكُمَيْتِ والهُمَامِ من طرف أنجاس العدو الصهيوني الفاشي العنصري الإجرامي والهمجي والبربري هو الآخَرُ على مدى أكثر من حَوْلٍ ونيِّفٍ من الزمان الآن، يبدو أن مركز «الإعلام الحقيقي» هذا قد توقَّف عن إصدار موادِّهِ الإعلامية والصحافية حتى إشعارٍ آخَرَ منذ اندلاع «طوفان الأقصى» المُزَلْزِلِ في اليوم السابع من شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2023 (وهذا اليوم بالذاتِ قد شهد الذكرى السنوية الأولى لهذا الحدث الجلل في اليوم السابع من شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الفائت 2024).. وكلُّنا، في هذا، أملٌ وتطلُّعٌ وتشوُّفٌ على أحرّ من الجَمْرِ في عودة هذا المركز الفريد إلى نشاطه المعتاد في المستقبل القريب – وإنَّهُ لَسَمِيعٌ مُجِيب.

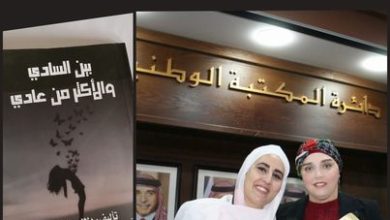

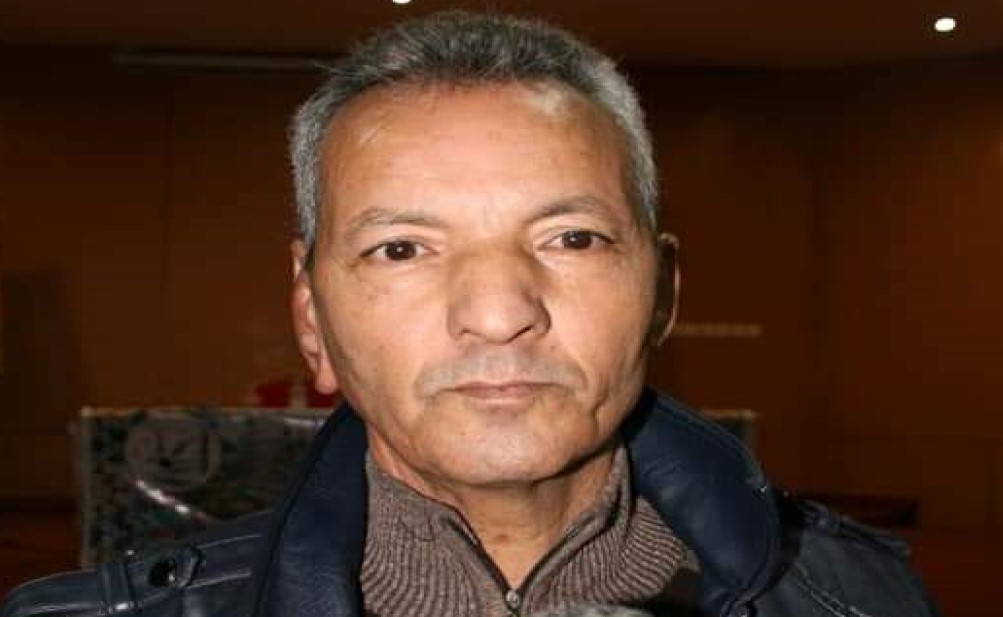


هام إلى أسرة التحرير
يرجى تعديل الحد اليسار من مقال الدكتورة آصال أبسال
لكي يكتمل جمال هذا المقال الرائع
وشكرا
هام الى السادة المحررين
يرجى تعديل الهامش من اليسار في المقال الرائع للدكتورة آصال أبسال
لكي يكتمل جمال النص / وشكرا
ملاحظة
ارسلت رسالة بهذا الخصوص من قبل / مع التحية
هام جدا
الى المحررين الأكارم
يرجى تعديل الهامش من اليسار للمقال الرائع للدكتورة آصال أبسال
لكي يكتمل جمال الإخراج / وشكرا
هام إلى المحررين الكرام
مقال الدكتورة آصال أبسال رائع حقا
يرجى تعديل الهامش من اليسار كي يكتمل الجمال
مع جزيل الشكر
تم التعديل واكتمال الجمال بالفعل ونأسف علي الخطأ
مرة ثانية
هام إلى هيئة المحررين الأعزاء
مقال الدكتورة آصال أبسال رائع حقا
يرجى تعديل الهامش من اليسار كي يكتمل الجمال
مع فائق الشكر
تم التعديل وتظبيط المقال.. المقال رائع بالفعل وواضح انه تم بذل مجهود في كتابته
الإخوة الأكارم..
شكرا جزيلا على تعديل هامش النص من طرف اليسار..
يرجى جعل العبارة (إِشْكَالُ الإِنْبَاءِ الثَّقَافِيِّ:) في بداية العنوان كما كانت..
فنحن نتّخذ منهجا معيّنا في كتابة المقال الأكاديمي..
شاكرين لكم تعاونكم / آصال
تم التعديل