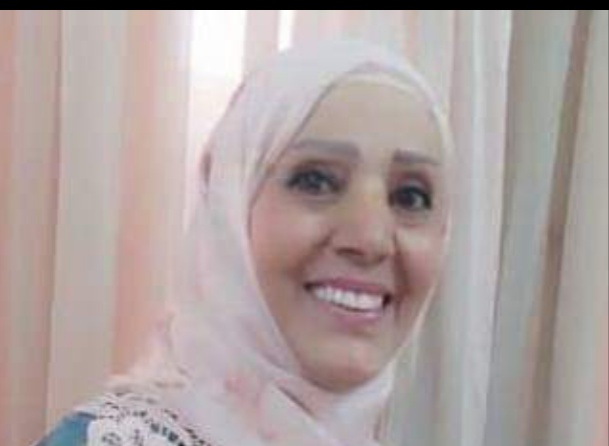(خريف غضبٍ)، ولم يكن يوما (ربيعًا عربيًا)

ناصر أبو عون
مع تداعيات الأزمة السياسيّة في بلدان الخريف العربيّ، وتأثيرات الانتكاسة الاقتصاديّة الأشد ضراوةً على بلدان الشرق الأوسط وفق تعبير كريستين لوغارد مدير عام صندوق النقد الدولي فإنّ الحرب (ليست في سورية أو الأنبار أو العرق.. الحرب هي اقتصاديات الدول وتفقيرها وتجويع شعوبها وتجريدها من قوتها المالية ومن ثمَّ العسكرية وجعلها غير قادرة على تسديد رواتب موظفيها وخاصةً رجالات الجيش والأمن مما يمهد لظهور قوى مسلحة خارجة على الدولة تنتهك القانون، وتسلب الناس وتثير الفوضى وتفرض الأتاوات)، لقد كانت قوى المعارض بمختلف أطيافها في بلدان الشرق الأوسط عينها على (كرسي الحكم) وفي القلب منها حركات الإسلام السياسي، وكان (رجال المال والمنظمات الاقتصادية الكبرى) عينها الجغرافيا، وتمديد النفوذ، وامتصاص دماء الشعوب، وشفط مقدراتها بِحَرَف البوصلة، وتغيير أولويات الأجندة الوطنية، وإزاحة أنظمة الحكم بالقوة
ومع تحوّل قوات المعارضة في العديد من الدول إلى (مليشيات مسلحة)، وانكشاف خبايا الأطراف المتناحرة في سوريا، وانطفاء “شعلة حركات الإسلام السياسي” في العديد من دول العالم وفي القلب منها جماعة الإخوان المسلمين وانفضاض (الظهير الشعبويّ) من حولها، وتركها وحيدة في الشارع السياسي تواجه مصيرها، وتلف حبل التفكك والتحلل حول رقبتها يتوجب الأمر مع انفراط حبات العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين واختتامهما بحروب اقتصادية بين الصين وأمريكا وأتباعهما من الأقزام وتطور الأمر إلى حرب بيولوجية تلوح في الأفق، وما إلقاء التهم بانتشار فيروس كورونا بين الأقطاب الكبرى إلا دخان وراءه جبل عظيم من النار وطاحونة عظام عملاقة ستطحن السوقة والدهماء في النظام الدولي الجديد الذي بات يتشكل في الأفق .
ومن ثم يتوجب على كل الأنظمة القطرية والجماعات المؤدلجة ولا نستثني أحدا إجراء مراجعة للأخطاء والخطايا الاستراتيجية التي أودت بأحلام (الشعبويين) إلى دهاليز النسيان، وبشّرت بعودة (الكولونيالية) بثوبٍ جديد، وفكرٍ أجدّ، إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، وطيّ صفحات طويلة من النضال، خاضتها شعوب القارة السمراء وبلدان الشرق الأوسط في سبيل التحرر بجرة قلم، بذريعة الحفاظ على “الأمن القومي” وأضحى معها حلم الإسلامويين والشعبويين بعودة الخلافة الإسلامية إلى الواجهة كابوسا جرف في طوفانه ونسف في طريقه أمنيات الشباب بـ(قيامة مجيدة للديموقراطية)؛ بل انتهى المطاف بأحلام البسطاء والشباب غير المؤدلجين إلى المطالبة الخجولة بتحسين شروط الاحتكام والانصياع إلى الأنظمة العسكريّة والاستبداديّة التي اكتشفت بين عشيّة وضحاها أنّ لها شعوبا، وأضحت مطالبة بأن تمنُّ عليها بتوفير الاحتياجات الدُّنيا للبقاء على قيد الحياة؛ حيث صارت الحقوق الأساسيّة وأهمها: الحق في (المسكن والعمل، والتعلّم، والصحة، والسفر) أمنيات لن تتحقق ولو بعد حينٍ من الدهر.
وفي ظل هذه الخيبات تقتضي الفطنة من قادة مليشيات المعارضة وبخاصةٍ الجماعات الإسلامويّة إجراء العديد من المراجعات الفكرية للعديد من التوجهات، وتغيير العديد من القناعات، وهدم الكثير من الثوابت الدوجمائية، ونسف الرؤية الأصولية من الداخل المنبنية على قاعدة (السمع والطاعة)، وإعمال العقل، وفتح مغاليق أبواب الاجتهاد الفكري المؤصدة منذ القرن الثالث الهجري، والبحث عن منهجية للتقارب المذهبي، والالتفاف حول المشتركات ومن نافلة القول فإن مجمل حركات الإسلام السياسي المنضوية تحت راية الإسلام الأصولي، قد أجلت هذه المراجعات منذ ولادة جماعة الأخوان المسلمين على يد المؤسس الأول حسن البنا وانشغلت بـ(تثبيت الزمن)، و(ثبات الفكرة)، ولم تتخذ من التجديد الفكري منهاجا لبناء دولة مدنية حديثة ولم تلتفت يوما هذه الحركات إلى الخطايا الكبرى التي تراكمت عبر السنين، وانتقلت من جيل إلى آخر كبرديات الموتى وانتهت إلى الإطاحة بها من قمة السلطة ودحرجتها إلى غياهب السجون، وصولا إلى القتل على الهويّة، والتصفية الجسدية خارج القانون.
لقد حان الوقت الآن إلى من هذه التيارات إلى الاعتراف بالخطايا الاستراتيجية، والبحث عن طريق أخرى لإنقاذ المواطن العربي والإسلامي، وإدماجه في منظومة (مصالحة وطنية كبرى) تتخذ منها منطلقًا إلى الاندماج في ما يسمى بمصطلح (دولة المواطنة)، أو ما يعرف بالدولة المدنية الحديثة.
ولكن ما أهم هذه الخطايا إجملا لا تفصيلا التي وقعت فيها التيارات الأصولية وحركات الإسلام السياسي التي تمكّنت من الوصول إلى سُدّة الحكم؟
أولا – خلطت الجماعات الإسلامية عن قصد بين الدعوي والسياسي وتأرجحت بين رؤية براجماتية لا ترضى بالقبول الكامل بالديمقراطية في إدارة شؤون الحكم ممزوجة بورؤية متحجرة تحلم بعودة الخلافة الإسلامية.
ثانيا – كرست الجماعات الإسلامية جهودها في التأكيد على (الهوية الإسلامية) في مواجهة التيارات العلمانية بدلا من البحث عن نقاط مشتركة ورؤية موحدة من أجل الوطن.
ثالثا – تعيش الجماعات الإسلامية في (كهف المظلومية) ولم تعلن يوما مسؤوليتها عن الفشل في الحكم وركزت على نظرية المؤامرة ودخلت في (نفق التبرير) لفشلها ولم تعترف بسوء تقدير الموقف السياسي وسارعت للحصول على الأغلبية في الانتخابات ومعاداة القوى العلمانية وسعت للهيمنة على مقاليد السلطة عبر قانون الانتخاب من دون مشاركة القوى الأخرى ومن دون إدراك خصوصية المرحلة الانتقالية وحساسيتها فالخطأ في هذه المرحلة كان بمثابة خطايا
رابعا – جميع الحركات الإسلامية وفي القلب منها جماعة الإخوان المسلمون أبقت على شعرة معاوية بينها وبين الأنظمة السابقة.
خامسًا – عاشت هذه الحركات مرتدية الثوب الإصلاحي ولم تخلعه لتتحول إلى حركات ثورية تنتقل بالشعوب من مرحلة النضال المسلح إلى النضال الفكري وبناء دولة القانون والعدالة والمساواة.
سادسًا – لم تبذل جماعات وحركات تيار الإسلام السياسي جهودا لوضع (خطة للحكم وإدارة شؤون البلدان) لأنها لم تتصور يوما أنها ستصل إلى (سدّة الحكم) وبنت رؤيتها على مجابهة (نظام الحكم)، والبقاء في خانة المعارضة إلى قيام الساعة وأقصى غاية كانت تحلم بالوصول إليها هي (التواجد في البرلمانات العربية) بنسبة مُرضية تسمح لها بالتحرّك على الأرض، ورعاية مصالحها الفوقية، ودعم أفراد عشيرتها، المنضوية تحت راية المعارضة (المظلومة)، غير (المسموعة)، ومن ثم لم تهتم هذه الجماعات ببناء كوادر سياسية استعدادا لتولي مناصب وحقائب وزارية سيادية وصولا إلى حلم إدارة شؤون البلاد.
سابعًا – لم تهتم الجماعات الإسلامية بتطوير منظومتها الفقهية والفكرية بما يتناسب مع الشروط الواقعية والاجتماعية لبناء مجتمع مدني حديث يتخذ من العلم رؤية لبناء الدنيا دنيا عادلة غير ناقمة تصل بالإنسان إلى آخرة مرضي عنها من سائر الأديان والمواطنين.
ثامنًا – سائر الجماعات الإسلامية في في تنظيمتها الداخلية لم تؤمن يومًا بالديمقراطية ولم تمارس آلياتها، ولم تُرسّخ مبادءها فظلت تنظيماتها تقليدية تقودها ثُلة من العواجيز الجاثمين على كراسي صنع القرار ولا تغادره إلا بالموت روحا وجسدًا ولا مانع من بقاء هذه القيادات في أماكنها رغم موتها إكلينكيا فقرار الإطاحة بها أو إحالتها للتقاعد قرار فوقي لا يجوز مناقشته ومنضوٍ تحت مبدأ السمع والطاعة في زمن انفتاحي تسيطر عليه تكنولوجيا الاتصال ويقود قاطرته الشباب.
تاسعًا – لم تضع الجماعات الإسلاموية تصورات مستقبلية أو خططا استراتيجية لردم الفجوة العميقة بين الشرق (المتخلف) والغرب (المتقدم)، وظلت تنظر للغرب في إطار (العدو)، و(فكره) في إطار (منظومة التكفير) المعلّبة والجاهزة؛ لا في إطار حوار الحضارات.
عاشرًا – لم تهتم هذه التيارات الأصولية، بتحسين الصورة الذهنيّة عنها لدى الجماهير، ولم تنفتح إعلاميًا، وظلّ أعداؤها يقصفونها بما فيها، وإلصاق التهّم المتحدرة من بعض الكتب والأفكار المحسوبة على التراث الإسلامي زيفًا وكذبًا، وليست من الإسلام في شيء.
وفي النهاية يمكننا القول بأن الحقيقة الصادمة والواردة في هذا المقال والتي يغضُّ الطرف عنها كثير من العرب، ولا يريد أن يصدّقها، ويهرب من النقاش العقلانيّ والمنهجي حولها، وخاصةً الجناح الشعبويّ والجماهيريّ وفي القلب منهم (التيار الإسلامويّ)؛ ونؤكد عليها في العديد من الكتابات التي ننشرها في الدوريات والصحف العربيّة تأتي للتأكيد على أنّ فكرة أنّ (الهوجات العربيّة) التي اندلعت في عام 2011 ليست ثورات بالمعنى الاصطلاحي للكلمة، وأنّ الطقس السياسيّ في منطقة الشرق الأوسط ليس إلا (خريف غضبٍ)، ولم يكن (ربيعًا عربيًا) كما توَّهم البعض، وأنّ (تنظيم الدولة الإسلاميّة) في بلاد الشام والعراق ليس إلا جرثومة تمّ تصنيعها في (معامل أجهزة استخبارات) الدول الكبرى، وأنّ (حلم عودة الخلافة الإسلامية) ليس قاب مظاهرتين أو أدنى في ميادين الهاتفات العربية المجانيّة.