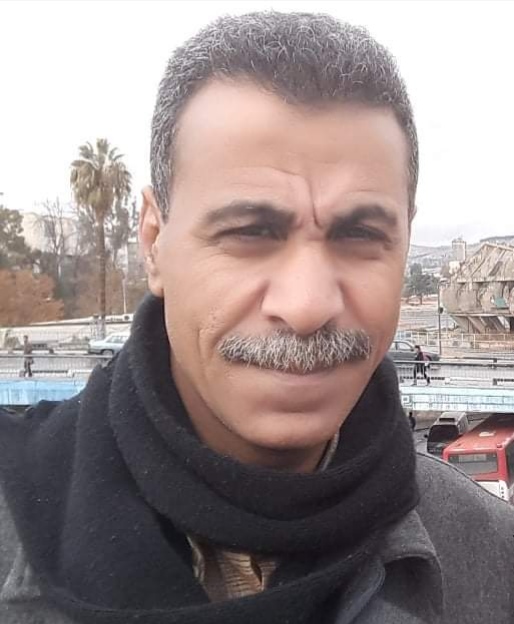حذاء البيك والراعي وأنا (سرديّة)

عمر سعيد | روائي لبناني
نادرا ما كنت أستطيع التمييز بين سروال أمي وسروال أبي الداخليين على حبل الغسيل، حين كانت تقول أمي:
” لِمْ الغسيلات، وطوي ثياب بيك ع جنب”.
فكلاهما من الخام الأسمر، وكلاهما كان عبارة عن ثلاث مخدات، اثنتان عاموديتان، وواحدة أفقية تشكل السَّرج من الأعلى..
ولكليهما حبل مجدول من الكتان، يسمى الدِكة، ومن هنا كان لا بد أن أطرح على أبي سؤال:
كم دفعت حق فكة الدِكة؟!
في البداية كنت أظنها الدَّكة بفتح الدال، والتي تعني الطلقة أو الخرطوشة.
لكني بعد أن كبرت وصرت ألبس سروالاً بدكة، أدركت أن المقصود هو الدِّكة، بكسر الدال.
وأذكر أن أبي أجاب، بأنه قد دفع حقها خمس ليرات، يوم كانت أجرته اليومية تساوي ليرتين ونصف.
ومن ثم أخبرني أن أمي قد أعادتها له.. ثم ضحك.. وفهمت لم ضحك..
عندما ماتت جدتي لجهة والدتي، وجدت أمي في صندوقها، ثلاثة سراويل نسائية، أرادت أن تأخذها لنفسها، غير أن أباها قال لها دعيها سألبسها أنا!
كانت سراويل نساء القرية كلها تتكور بين أفخاذ النساء كالملفوفة.
وإلى اليوم لا أعرف إن كانت تلك الملفوفة مثيرة أم لا..
غير أن كل ملفوفة منها، كانت تخبىء تحتها وعلى الأقل عشرة أطفال صغار..
ضاقت بهم، فخرجوا، يشكلون عائلة ريفية، تملأ الحارات صراخاً، والأزقة عدواً، والليالي قصصاً لا تنتهي.
لم تكن أسرتي أقل من سواها، فقد كنا اثني عشر فرداً ننام في غرفة واحدة، هي غرفة الجلوس والاستقبال والنوم.
كذلك لم نكن من الأسر التي تتلقى الهدايا، بل كنا من تلك الأسر التي تحرم نفسها شهوراً، لتجمع ثمن هدية، يلقيها مَنْ توددنا إليه بها في سلة المهملات؛ بعد مغادرة حاملها بقليل.
وكذا كان حال كل الأسر الفقيرة، لا تبلغ شيئا بلا ثمن يرهقها، على الرغم من أنه لا يلامس أبسط مشاعر المحمولة إليهم.
كنا أسرة تدفع ثمن محبة الآخرين من حرمانها وعرقها..
وقد كان هذا حال كافة أسر قريتنا، ولعله لا يزال.
يقضي أباؤها العام وهم يرددون على مسامع أولادهم:
– لا تمسوا هذه السلة، فهي لفلان.
– كلوا من هذا المرطبان، أما ذاك القطرميز، فلا تقربوا منه، لإنه لبيت فلان.
وهكذا يمر العام والأسرة منشغلة في تموين مطبخ فلان من ” اللبنة المشفتة” كما كنا نسميها، والبيض البلدي، والكشك، والبرغل، والقاورما، والمخللات، والمكدوس، والزيتون، والعدس، والحمص، وغيرها..
وكل ذلك ضمن استراتيجية “قد نحتاج فلان في خدمة يوماً ما”
ماتت أمي، ومات أبي، دون أن يأتي ذلك اليوم، لا بل إن ابن فلان، لم يكلف نفسه مشقة الاتصال والتعزية بمن كان يدعي أنهما: “أنكل وتانت”
قلت لأبي: لقد تغربنا جميعنا، ذكوراً وإناثاً.
ولم نحتج من فلان أي خدمة، وما كانت كل تلك الهدايا إلى على حساب تعليمنا وحاجاتنا..
فأجاب يائساً: كله رايح..
ونادراً ما كان أبي ييأس، لأنه فلاح عنيد.
أذكر، أني كنت فتى يوم تجمع عدد من أهل القرية لاستقبال البيك في منزل قريب من آخر الزفت، ذلك لئلا يضطر سعادته للمشي في الأزقة الترابية، ويوسخ حذاءه (مشايته) كما كنا نسميها..
خلع الجميع أحذيتهم في عتبة البيت المضيف، ودخلوا، فقد كان الطقس ماطراً، وتوزعوا في المجلس بانتظار البيك.
وطلبوا مني الوقوف خارج الباب، تحت البرندة، لأعلمهم بوصوله؛ إذا ما أطلت سيارته من بعيد.
وقفت متحمساً متباهياً بمهمتي، حتى لمحت سيارة سوداء قادمة..
فتحت الباب، وهتفت منفعلاً:
وصل البيك.. وصل البيك.. !
اصطف الجميع بوِقفة عسكرية، وقد اشرأبت وجوههم استبشاراً بالخير لاستقباله.
توقفت الكاديلاك السوداء، ونزل منها من فتح له الباب، وقد رفع المظلة فوق رأسه، ثم نزل وخطا صوب الباب..
لم يكن البيك ذكياّ، لكن أهلي كانوا أغبياء.
فعندما لمح الأحذية في العتبة، خلع حذاءه، ودخل، وسط رفض الحضور وإلحاحهم بضرورة الدخول بحذائه “فالسجادة ما بتغلى على البيك”
لكنه تمكن بإصراره من السيطرة على الموقف.
بعد أن جلس، وشرح للحاضرين أنه لن يطيل الجلوس فيما بينهم، لضغط الأعمال، انهالت عليه المطالب الصغيرة التي تليق بمحتاجيها، فتناول قلمه، وأخذ يدون على غلاف علبة سجائره الاسم والطلب، حتى امتلأ غلاف العلبة، فأشعل آخر سيجارة كانت في العلبة، ووضعها في جيبه.
هتفت امرأة في الخارج من بعيد، تنادي زوجها، والذي كان معٌازاً، وقد كان مسكيناً، شحيح النظر، أعشاه، يلبس نظارة تحطمت إحدى زجاجتيها السميكتين، فربطها خلف رأسه بمطاطة، لئلا تسقط ثانية، فتنكسر الزجاجة الأخرى.
ولما علا الهرج في الجلسة، بسبب إحدى نداءات زوجته التي قالت:
“تعا يا عمي، تعا.. العنزات ابقى لك من هالبيك”
نهض الرجل ساباً، لاعناً النسوان وساعتها، وخرج يغادر المكان، مخلفاً وراءه ضحك البيك الذي كان يحفز الجميع على الضحك.
بعد دقائق نهض البيك ليغادر، سلم، ووقف في العتبة، يبحث عن حذائه فلم يجده..
وانهمك الجميع بالبحث عن حذاء البيك، وقد داهمهم الإحراج.
تنبهت أنا لبقاء حذاء الراعي، وقد غاب حذاء البيك.
فلفتت انتباههم للأمر، فطلبوا مني اللحاق به لاسترجاع الحذاء.
انطلقت أجري، حتى وصلت بيته.
سألت عنه زوجته، قالت لي:
“طلع لعند العنزات، الصبي ساخن، تركهم بين القلعات وإجا”
قلت لها: والحذاء؟!
فردّت: أي حذاء ؟!
فاستدرت عائداً، أجري ..
وصلت مكان الاجتماع، وقد بللني المطر، وأخبرتهم بما حصل..
فما كان من البيك إلا أن انتعل حذاء الراعي، وتوجه إلى سيارته منزعجاً، تاركاً لأهلنا توجسهم، والشتائم واللوم ومشاعر الخيبة والجرصة.
استدارت السيارة، وانطلقت عائدة من حيث أتت..
فيما بقيت أنا أراقبها، فلمحت شيئاً تطاير من نافذتها بعد انطلاقها بعدة أمتار..
ركضت أبحث عما سقط من السيارة، فإذ به حذاء الراعي، وعلبة السجائر التي ثنتها كف البيك قبل إلقائها.
حملت الحذاء الذي كان موحلا، تفوح منه رائحة بعر الماعز بيد، وعلبة السجائر بالأخرى، وعدت، إلى المجتمعين.
وضعت الحذاء مكانه، ورحت أقوّم علبة السجائر، وأقرأ ما كتب عليها..
ثم دخلت، وأخبرتهم بما حصل، ومددت علبة السجائر إلى صاحب البيت المضيف..
وهنا انقسم أهلي إلى قسمين، قسم يبرر أن البيك نقل المعلومات إلى مفكرته التي يحتفظ بها في حقيبة السيارة، وقسم يسب ويشتم الراعي الذي أودى بأحلامهم.
وفجأة فجّر أحد المدافعين عن البيك غضبه بي، يحملني مسؤولية ما حصل، ويقول:
“وإنت يا سعدان.. شو ركضك تجيب العلبة، وليش كنت ع بتراقب البيك، وليش ما تشاطرت ونبهت الراعي إن هذا مش صباطه! “
وصار يرعد ويزبد..
حتى شعرت بأني أنا الذي حطمت مستقبل القرية كلها..
تغيرت سراويل أهل القرية الداخلية، وتغير قماشها، وأسماؤها، وباتوا يسمونها كيلوتات، وبوكسرات، وانتشر مشهد كيلوتات السترنج على حبال الغسيل فوق الأسطح..
غير أنه وإلى اليوم لا زال ذاك الراعي هو هو، والبيك هو هو.
ولازال تنورنا يحمّلُ ذلك الراعي تردي أوضاع القرية، وازدياد نسبة البطالة والفقر فيها.