كيف الخليل؟ اللقاء الأخير مع عز الدين المناصرة
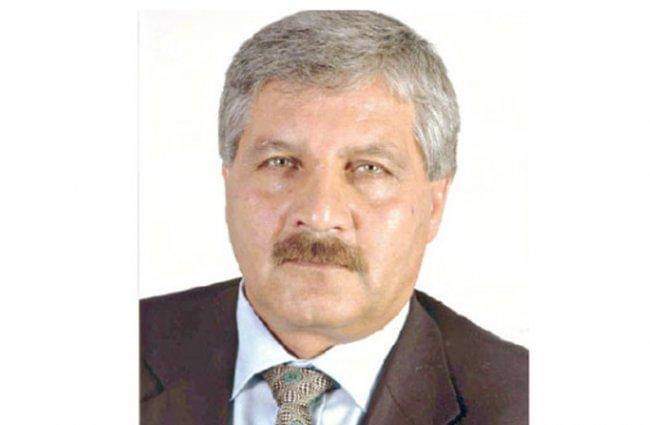
المتوكل طه | قلقيلية _ فلسطين

لم أشَأْ أنْ أقولَ له؛ قد كبرتَ،
فقد دخل البَهوَ مُتّكئاً بالعصا،
وارتمى جالساً مُنهَكاً..
لم يعانقني،
كان قد زاغَ من لفحةِ البَرْدِ، واضطربَ الصدرُ،
حتى إذا هدأَ القلبُ فتَّحَ عينيه ثم أشار إليَّ سلاماً،
وفرَّجَ عن ساعديهِ فقبّلتُه في الجبين،
وقلتُ له؛ كيف حالُكَ يا سيِّدَ المستحيل؟
ربما قد بكى،
أو تفتّقَ جَفنُ السوادِ عن الماءِ،
وانفعلَ الوجهُ وارتجَّ…
لم يتلعثمْ،
ولكنه كان يجمعُ أغصانَهُ كي أراهُ، كما كان قبلَ ثلاثين،
حتى تماسكَ..
سلَّطَ عينيه في ناظري،
واستردَّ الحضورَ، وأشعلَ سيجارةً ثم مَجَّ الدّخانَ، وقال،
كأنَّ الحروفَ ستعرف أحزانَها، وهو يسألُ:
كيف الخليل؟!
لا شيءَ يُشبهُها، يا صديقي، سوى دَمِها في الأصيل!
ولا شيءَ في الطرقاتِ سيُفضي إلى نَفقٍ، كي نُغنّي لها،
قد تغيبُ قليلاً..
فقاطعني؛ قد يطولُ القليلْ!
وهل سأعيشُ إلى أن ترانيَ جفرا،
وتبغمُ قربي يمامةُ حيفا،
وأعلو على تلّةِ الكرملِ المُتعالي،
وأرقبُ عودةَ مَنْ غابَ مشتعلاً ذاتَ ليلٍ طويل؟
قد خذلتني المعاركُ!
كُنّا نعدُّ الرجوعَ على وَقْعِ شمسِ الخنادقِ،
لكنَّ مَنْ أمسكوا البندقيةَ قد كرِهوا الشِعرَ،
والشعراءُ يخونون إيقاعَهم إنْ تراءى لهم شبهُ مملكةٍ في السرابِ،
ولكنني لن أصدِّقَ إلاّ الذي سوف يحْمِلُني للجليلْ..
وما ذاك؟
قالَ: الرصاصُ الرصاصُ.. وقنديلُ شاهدةٍ والقتيل.
***
قبل خمسٍ وخمسين ودَّعَني في المطارِ أبي،
كان يشبهُ كرمتَنا، عسلاً، ثم يرمي العناقيدَ للطيرِ
أو يشبهُ العشبَ دفئاً وينشرُ طيبَ الندى في الحقولِ،
ولم يقرأ الغيبَ لكنه شاءَ أن أتعلّمَ،
قال: ستقرأُ عنّي وعن روحِ هذي المرايا، لتحملَها في الجناحِ،
على أن أراكَ نبيّاً لصوتِ الجبالِ وموجاً فُراتاً إلى كلّ نِيل..
وكان يفاجِئُني كلَّ عامٍ، فيأتي إلى مصرَ،
يحملُ أعنابَه من زبيبٍ وشَهدٍ،
ويمشي مع النّهرِ،
يعجبهُ البحرُ والأغنياتُ وشايُ الحسينِ وأهرامُها،
والمواكبُ والصّخبُ الحُلْوُ والباعةُ الطيّبون،
ويبتاعُ ما يُفْرِحُ امرأةً في السبيل.
وساءَلني مرّةً والحياءُ يدبّغُ خَدّيه؛
هل أخذتكَ النساءُ إلى المَهدِ؟
قل لي! فإن شئتَ زوّجتُكَ الآنَ،
حتى إذا ثَمِلَ الطينُ، كان لنا في البلادِ النخيلْ.
وماتَ،
ولم أستَطِعْ أنْ أودّعَه أو أتمّمَ رقصةَ عاشقةٍ في البعيدِ،
وكنتُ أنادي عليه إذا هزّني الشوقُ؛
كيف تُخلّي صغيرَكَ في الليلِ دون غطاءٍ
وأنتَ الجميلْ؟!
***
حلمتُ كثيراً بأني أطيرُ،
وأسبحُ بين الغيومِ، فتحملُني نجمةٌ للبلادِ،
وحين أكونُ قريباً من البيتِ أسقطُ
حتى أراني شهاباً يئزُّ وينثرُ أضواءَهُ في الدروبِ،
وأجمعُ نفسي وأمشي،
وأطرقُ بابَ أبي..
لكنّه لا يُجيبُ،
كأن الكرومَ التي في السفوحِ ستسقيهِ راووقَها العسليَّ،
وقد راقَها؛
فهو في نبعةِ الزَّنجيل..
أنادي، أصيحُ، أجوحُ، ويعلو نشيجي،
ويملأُ دمعي خدودي،
وألمحُ طفلاً يدقّ بقبضتِه البابَ، يندهُ..
لكنة نامَ من تعبٍ، وأرى أنه ذابَ في زُرقةِ السلسبيل..
وحين مشيتُ إليه لأوقِظَه.. كنتُ أنا الطفلَ،
حاولتُ ثانيةً أن أراه، فَراحَ بلا عودةٍ في الرحيل..
أنا لستُ يوسفَ،
إذْ لن يُعَبِّرَ لي والدي ما رأيتُ،
ولكنني كنتُ يوسفَ حين رموني هنالك في عتمةِ الجُبِّ،
دون حِبالٍ وسيّارةٍ،
وأنا منذ سبعين، وحدي، بلا أي دارٍ وجارٍ وخيلٍ وليلٍ،
وحيداً طريداً غريباً،
ولا أيَّ جنبٍ لديَّ.. فكيف أميلْ؟
قرأتُ،
كتبتُ،
ومزّقتُ ما خامَرَتْهُ الشكوكُ،
تفاءلتُ، قلتُ سنرجعُ يوماً كما قال لي صاحبي، وانتظرتُ،
وأيقنتُ أن الكتابةَ جرحٌ يِنزُّ من الجرحِ،
أو أنها الوَهْمُ في أجملِ الكلماتِ،
تُعينُ على الهَجْرِ والقَهْرِ،
تتركُنا في جَمالٍ فسيحٍ ونحن على ضفّةِ المستحيل..
تُحيل التشاؤمَ شُبّاكَ نورٍ..
وتبقى الرقابُ معلّقةً في الأثيل.
وننفخُ في الفحمِ حتى نراهُ نهاراً بديعاً،
لنطردَ بردَ المنافي،
ونركبُ قاطرةً من تصاويرِ أقواسِنا،
أو نزوّقُ جدراننَا بالحريرِ الملوّنِ،
نرقصُ في عُرْسِ جفرا،
ونجعل سامرَها عيدَ فرحتِنا بالكحيلْ..
وحين تُطالِعُنا صورُ الحائطِ الدامعِ العينِ،
نعرف أنَّا ابتعدنا كثيراً،
وجفرا هنالك بين السبايا!
فَصَبرٌ بغيضٌ، وزوجٌ مريضٌ، وعمٌّ يخونُ، وخالٌ ذليلْ..
وما من شقيقٍ، وما من رفيقٍ، وما من دروبٍ، وما من بديلْ..
****
أراك تُطيلُ..
كأنك لا تعرفُ الأمرَ؟!
قالَ؛ بلى.. إنها غُربَتي في السراج،
وزيتي خفيفٌ وليلي ثقيلْ..
وراحَ إلى الصمتِ،
أو أُدْخِلَ النًّصلُ في رئتَيْهِ،
وما راقَ، قامَ، وأبقى عصاهُ على حالِها،
ثم – منفعلاً – فزَّ: قُلْ..! لم تُجِبْني..
على أيّ شيءٍ؟
فقال: الخليل.. الخليل.. الخليل..
***
ويهمدُ،
ثم يدخّنُ،
يشربُ قهوتَهُ بهدوءٍ، وينظرُ في الغيبِ؛
غرّبتُ في كلّ فَجٍّ،
تزوّجتُ نارَ المجرّاتِ،
صادقتُ سيّدةَ النّاي،
أربكني الزّهرُ في عروةِ الغصنِ،
أفرحني أنني أسمعُ الجرَسَ المعدنيَّ إذا رقّ في شُرفةٍ للهديل..
ويعجبني شاعرٌ كان يخبطُ في الحربِ،
يحكي عن السيفِ
وهو يُجندلُ مَنْ خانَ أوطانَه أو رماها ممزّقةً في العويل..
وكنتُ توقّفتُ عند مَنْ جاءَ نصفَ إلهٍ ونصفَ تُرابٍ..
وتابعتُ وثبتَه مثلَ فَهدٍ رشيقٍ..
ولكنني قد أخافُ عليه من السِّرِّ،
قلتُ؛ أتقصدُ كَعْبَ أخيلْ؟
فأومأ،
ثم أشارَ بأنّ الذي ماتَ قد مات غَدْراً،
فقد رشقوهُ بِسَهْمٍ صقيلْ..
وأن الذي قد رمى كان فينا ومنّا،
ولم ندرك الفرقَ بين الدليلِ وبين الدَّخيلْ..
وها نحن، ثانيةً، في العراءِ وفي التِّيهِ..
وقد غلَبَتْهُ الدموعُ.. فلم أتكلّم..
إلى أن توقَّفَ ثم توهَّجَ وجهُ القصائدِ،
إذ كانت النارُ في وجنتيهِ تمورُ..
وجمرٌ على عاتقيه يسيلْ…
ومجَّ اللهيبَ،
وما كان يسألُ،
بل كان ينفثُ وهو يردّد؛
كيف البلادُ التي لن أراها،
وكيف الخليلْ؟!


