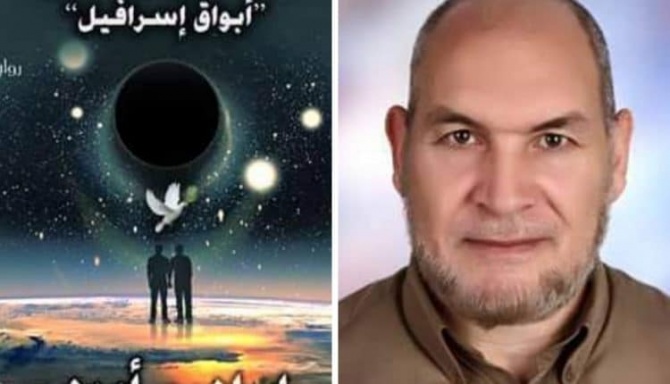الفلسطيني المتفائل.. الفلسطيني المتشائل والفلسطيني المتشائم

زياد شليوط | شفا عمرو – الجليل – فلسطين

الانسان الفلسطيني، ليس انسانا خارقا وليس استثنائيا، فهو انسان عادي مثل أي انسان في العالم. ومن الطبيعي أن تجد بين أبناء الشعب الفلسطيني من هو متفائل ومن هو متشائم ومن يقف بينهما ألا وهو الانسان “المتشائل”، كما أطلق عليه أديبنا الكبير إميل حبيبي.
الدكتور عزّ الدين أبو عيّاش والإصرار على التفاؤل
ربما يكون الدكتور عزّ الدين أبو عيّاش من غزة،والذي فقد ثلاثا من بناته وابنة أخته، خلال حملة “عوفيرتيتسوكاه- الرصاص المسكوب” العسكرية الإسرائيلية على قطاعغزة، نموذجا للإنسان المتفائل، ورغم كل ما حصل له ورفض المحكمة الإسرائيلية العليا لطلبه مؤخرا، إلا أنه يصر على بقاء جذوة الأمل في قلبه.
وفي مقال نشره في صحيفة “هآرتس”، يوم الجمعة 26/11/2021 (ص 2)، كتب: ” في 24 نوفمبر، المحكمة العليا الإسرائيلية وقضاتها قتلوا بناتي وابنة اختي: بيسان، ميار، آية ونور مرة أخرى”.
ونقل للقراء بعض ما قاله في قاعة المحكمة: “ردي على المأساة كان: اني لن أكره. بعد تلك الحرب أقسمت لنفسي: لو كنت على علم ان بناتي سيكنّ الضحايا الأخيرة في طريق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كنت أقبل خسارتهن، رغم ألم القلب. لكنهن للأسف لم يكنّ الأخيرات.” وأضاف “ما زلت أومن، أنه يمكن التسوية بين الحفاظ على القانون، قيم إنسانية وأسس أخلاقية بشكل مشابه”.
وختم مقاله بعد ذلك قائلا: “رغم قرار المحكمة ضدي، ما زال لدي أمل واني أومن بكل قلبي، أنه بمقدورنا تحقيق تغيير، والصدق سينتصر، هنا أو في مكان آخر”.
الفنان “المتشائل” محمد بكري وحملة التضامن معه
انطلقت مؤخرا حملة للتضامن مع الفنان الفلسطيني محمد بكري، بمبادرة هيئات وأفراد في المجتمع الفلسطيني، وذلك أمام حملة التحريض المتواصلة عليه من قبل أوساط يمينية ورسمية إسرائيلية، منذ أن أخرج فيلمه “جنين.. جنين”، الذي يروي فيه ملحمة الصمود في مخيم جنين والمجازر التي وقعت فيه عام 2002.
ومحمد بكري لم يحبط أمام تلك الحملة ولم يتراجع، كما أنه لم يخض حربا شرسة في مواجهتها، فهو ما زال يحمل مكنسة “التشاؤل” التي ترافقه منذ ما يربو على ثلاثة عقود، ويجول فيها البلاد بطولها وعرضها وعدد من دول العالم. ولم يجد أنسب من مسرحية “المتشائل” ليعود ويعرضها من جديد، في عدد من الأماكن التي شهدت أمسيات تضامن معه. فالتشاؤل بات من طبع بكري، ولم يعد يستطيع الوقوف إلا في الوسط حاملا راية التفاؤل من جهة، وراية التشاؤم من جهة، لكن تبقى مكنسة “التشاؤل” هي رايته الدائمة، التي يحملها ويشرح من خلالها مأساة شعبه.
المواطن البسيط ضحية الاحتلال والذي لا يرى أي بارقة أمل
أما الانسان الفلسطيني البسيط، المسلوبة مواطنته وحقوقه الأساسية في ظل الاحتلال الرابض على قلبه منذ أكثر من نصف قرن، ما الذي عساه يجعله متفائلا أو حتى متشائلا.. وهو الذي يعاني ليل نهار وعلى مدار 24 ساعة من التنكيل والإهانة والتشريد والاعتداء. هو الذي يتعرض بيته للهدم أمام عينيه ولا يمكنه الاعتراض.. هو الذي يرى بأم عينيه تكسير وقلع أشجار الزيتون في كرمه،واذا”تجرأ” على محاولة حمايتها ينال اعتداء جسديا من أوباش المستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال، واذا تفاءل وقدم شكوى لا يسلم من انتقام أو استهزاء أو إهمال. هو الذي يرى ابنه فلذة كبده يقتل برصاص جنود الاحتلال، ويرغم على التوقيع على تصريح يناقض الواقع ويهين كرامته ويضيع حقه. هو الذي يتعرض لاستفزازات وكلاء “الشاباك” الذين يدفعونه لارتكاب عمل متهور يؤدي الى قتله بدم بارد.. هي الزوجة في سيارة الإسعاف في طريقها للولادة، يوقفها حاجز احتلالي ساعات ويعرض الجنين لخطر داهم قبل أن يرى النور، أو امرأة بحاجة لعلاج سريع وأي تأخيرفي الحاجز يمكن أن يؤدي الى خسارتها حياتها، نتيجة مزاج جندي مهاجر من بلاد غريبة، أو أبناء عائلة تتعرض لوابل من الأحجار عليهم وعلى سياراتهم، وتكون إصاباتهم بالغة، لكن الجنود يمنعون عنهم سيارات الإسعاف فيبقون في مكانهم ينزفون وما من مسعف.
هؤلاء حياتهم لا أفق من نور فيها، فهم أهل التشاؤم حيث لم يبصروا نورا في حياتهم يعطيهم قليلا من الأمل، ويستغرب أصحاب الشأن في الطرف الآخر بالتالي، كيف يخرجون للشارع شاهرين سيوفهم؟ فهل هناك ما يخسروه؟!