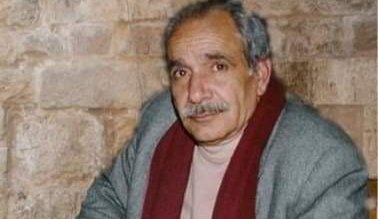مقطع من رواية: قلوب مهاجرة.. الحب ودفء الأخوّة (3)

منى مصطفى | روائية وأديبة تربوية مصرية
الحب
في إحدى حصص الدروس الخصوصية، رأيت تلك العلياء…، فتاة تغار الشمس من إشراقة وجهها، ويَطرَب النسيم إن مرَّ على خديها، ذات ذهن مُتَّقد، ورجاحة عقل نادرة، تتفوق علينا جميعًا في نقاشها وحوارها مع المعلم…، قد كان المعلم لديه ظروف خاصة، فدمج المجموعات التي يدرسها لفترة مؤقتة، كانت هذه الفترة هي بداية معرفتي بها…، بدأت أشعر بمشاعر غريبة تجاهها.
لم أكن جرَّبت بعدُ ما يُسميه الشباب بالحب، بل كنت أعد هذا من قلة التربية، واللهو والعبث، وما توقَّعت أنَّ ما أشعر به هو ذلك الحب المزعوم الذي لا حديثَ للشباب إلا عنه، هل يمكن أن أُسمي تلك اللذة القلبية والقُشَعْرِيرة التي تسري في بدني عند قربها حبًّا، لم أهتم للمسمى كثيرًا، لكني بِتُّ أترقَّبها، أسعَد برؤيتها، يضيق صدري إن تأخرتْ، أحب المواد التي تحبها، عرَفت بيتها، وقد كان مختلفًا عن بيوت القرية كلها، كان يبدو قصرًا شامخًا إلى جوار بيوت القرية، تُحيطه الأشجار وتكعيبة العنب والياسمين، له ثلاثة طوابق، به حديقة أمامية وأخرى خلفية …
أصبح بيتها وشارعها أحبَّ إليّ من رياض عامرة وقصر مَشيد، كلمامررت من أمام بيتها، تَمنَّيت لو بقِيت في ظله؛ كي لا أفارق أصداء جمالهارأيتها مرة شاحبة حزينة، لم يَغمَض لي جَفنٌ، حتى علِمتُ لاحقًا من أُمِّ علي أنها كانت مريضة، أصبحت أجلس مع خالتي أم علي أكثر من أمي؛ لأَستدرجها في الحديث،فسيرة المحبوب نضارة للقلب!، أما علياء فلا تنظر لأحد، ولا تعرف أحدًا، وقد رميتُها في نفسي بالغرور والتكبر أحيانًا، أو عِزة النفس أحايينَ كثيرة، وبدأت أَرْقُبها وأتتبَّعها، فطيفها أصبح يسكنني، فيرسم ابتسامة وادعة على وجهي، ويملأ عيني ببريق الحب! وصدى صوتها يَجول في أنحاء نفسي فيرمم ما تشقق منها، تعلَّقتُ بها حدَّ الجنون، أصبحتْ رفيقة صمتي ولَهْوي، فلو ارتكبتُ شيئًا من حماقات الشباب، تراجعت سريعًا مستشعرًا أنها تراني، وكيف لا تراني ومسكنها قلبي، وإن دخلت مباراة أتقنتُ كل حركة غريبة تُمتع أهل القرية؛ ليَصِلَها الخبر…، عند هذا الحد أيقنت أن قُطيرات الحب مسَّت قلبي، وأينعت وُريقاته في زوايا نفسي، فقد ملَكَت عليائي عليّ كلَّ تفكيري، نظرةٌ إليها تُسعدني، وإعراض منها يَقتلني، قربها يصيبني بقُشَعْريرة خاصة، قُشَعْريرة لست أدري من شأن كُنهها شيئًا أهي لفرحٍ أم لجزعٍ!
كتمت أمري فترة من الزمن، ثم ضاق صدري عن سري، ،فصارحت عليًّا بمشاعري وندِمت بعدها؛ إذ حمل الأمر محمل السخرية، وأخذه مادة للتندُّر، فلم يقدِّر مشاعري؛ لأنه كل يوم يُعجَب بواحدة ويَهيم بها، حتى تُفاجئه أخرى أجمل…، كانوا يُسمونني الحكيم الذي لا يفعل أفعال الصِّبيان كما كنت أُسميها، لم يكف عليّ عن كلامه وسُخْفه، حتى غضِبت وخرَجت من عنده مقاطعًا له…!
لاحظتْ أمي وأخي محمد تغيرًا في حالي مع علي، وأن هناك شيئًا ما وقع بيننا، لم تعطِ أمي الأمر حيزًا من تفكيرها، مجرد صبيان يختلفون ويعودون، هذا انطباعها، أما محمد فذهب لعليّ وأخذ يستدرجه عن سبب الفجوة التي وقعت بيني وبينه، فقال له عليٌّ ما دار بيننا من حديث، واستحلفه ألا يُخبرني، وأنه يجب أن يعرف لينصحني، خاصة أن اهتمامي بالدراسة قد قلَّ…!
تقبَّل محمد الخبر بابتسامة وهدوء غير متوقع، كما أخبرني عليٌّ بعد ذلك، ولم يُعلق إلا بهذه الابتسامة وترك عليًّا وذهب، ظل محمد صامتًا يتحيَّن الفرصة ليختلي بي، وأنا غير مهتم؛ لأن غالب وقته كان مشغولًا، ولم نكن نتقابل كثيرًا، فيومه من المحكمة إلى مكتب المحاماة، وأنا من المدرسة إلى الدروس الخصوصية، حتى جاء يوم عطلة في ذكرى وطنية، وحاول محمد إسعادنا، فذهب واشترى فواكه وأشياء للتسلِيَة، وبخورًا كانت أمي تحبه … أعاد لنا ذكرى أبي، وبقينا بين واقع قصير يشبه الماضي الطويل الجميل، حتى جاء المساء، وكانت ليلةً ليلاءَ، كانت ليلة مست فيها هموم الحياة شَغاف قلبي، علِمت بعدها سرَّ صمت أمي، ودافع التحجر الذي يعلو ملامح محمد، والسكون الذي أصاب ماء الحياة في وجه أمل، بعد أن كان دافقًا بالسعادة دومًا، فقد تحوَّل من نهر دافق إلى غدير راكد.
علِمت ما في قلوبهم، وأصبحت مثلهم … تجمَّد ماء الحياة في وجهي، سَرتْ في جسدي قُشَعريرة الموت والهمِّ، وشتَّانَ شتَّانَ بينها وبين قُشعريرة الحب تلك…، بعد صلاة العشاء طلب محمد من أمل إعداد شاي لنا جميعًا، وأن تحضر التسالي الذي اشتراها اليوم، قائلًا: منذ زمن لم نجلس معًا، وكذلك سأغيب عنكم يومين في مهمة لمكتب المحاماة الذي أعمل به، أخذنا بعض الوقت في مرح وتبادل أحاديث الودِّ والآمال، ولكن شعرت بأن كلاًّ منا يمهِّد لشيء حزين بداخله يريد أن يَبوح به…
قطع محمد هذا الخاطر لدي بقوله: يا أمي، بقيت أسابيع قليلة وتتخرج أمل، وباسل كذلك سيتخرج من الثانوية، أنا قررت عدم البقاء هنا، إنما جئت معك حرصًا على إرضائك، وحفاظًا على عِرضي، وتقديرًا لمشاعرك، ولكن هذه ليست قريتنا، وهؤلاء ليسوا أهلنا، ولسنا منهم وليسوا منا، لا مجال للبقاء أكثر من ذلك، سنعود للإسكندرية، ليس هناك خيار آخر أمامي، ولن أترككم مهما كانت الظروف، صمتت أمي ولم تعلِّق، بل نظرت إلى أمل التي لَمَعت عيناها قائلة:أبي حبيبي، كم أشتاق إليه، لقد ذهب أُنسي بفِراقه، كنت لا أره إلا عصبيًّا عنيدًا، ولكن بعدما فقدته، وعشت بعيدًا عنه، علِمت أنه كان الأمان والحنان، علمت أن وضع الفتاة رأسها على كتف أبيها – ولو للحظة – هو السعادة الوحيدة، وأن هذه اللحظة هي العمر كله، وإن قلَّ تَكرارها ..!
بفراق أبي أحسست أنني غير مجتمعة الإنسانيةولا الأنوثة، عليَّ أن أكون رجلًا في بُعد أبي؛ لأنه لا ساعد أقف خلفه، ولا زَندًا أستريح عليه، ثلاث سنوات مرت وأنا أعيش ولا أعيش، بلا أب أعيش بنصف قلب، بنصف أمان، بنصف بطن ونصف أمل، نعم فقدت اكتمالي بفِقدانك يا أبي، ثم صرخَتْ وانكفأتْ على قدم أمي تُقبلها معتذرة عما قالت، ولكنها مشاعرها، فكيف يعتذر الإنسان عن لحظة بوح تصدر عن قلب صادق مكلوم، يُحاصره الحنين وتضرب الغربة أسوارها العالية حوله؟!كيف يعتذر عن مشاعر اختلطت بدمائه وكِيانه؟!، رفعت أمي رأس أمل واحتضنتها، ولم تجد ما تغسل به وجه أمل لتهدأ إلا دموعها…، تماسك محمد وظل في مكانه ينظر إلي، وأنا أحاول إخفاء دموعي، ولكني لم أستطع إخفاء اختناقي الذي أعجَزني عن أي ردّ، فالتفت إلي قائلًا:ألست معي يا باسل أننا في هذه القرية نُعد غرباء؟، ألا تؤيدني في فكرة أننا مواطنون من الدرجة الثانية، بل العاشرة، مقارنةً ببعض سكان القرية؟ أتدري ماذا يسموننا؟ يقولون علينا: (بيت بائعة الصابون)، وإن تأدبوا قالوا: (بيت المستأجرين)، فكل إنسان هنا يسكن بيته، ومعروف أصله، ومتواصل مع أقاربه، وله وزنه الاجتماعي من جهة أصله وعائلته، أو من جهة ثرائه وأطيانه…، حسبُنا أنه لا يوجد أحد يستأجر بيتًا في القرية كلها غيرنا، فأطلقوا علينا اسم: (المستأجرين)!، فليس لنا الحق هنا في أن نُحب أو نقيم علاقات اجتماعية متكافئة، ثم أعرض عن النظر في عيني وقال: أنت لست كفئًا لها، لا تتعلق بالمستحيل، فمعايير القلوب غير معايير الأطيان…، ضع همَّك في دراستك، فلا خيار أمامك، لا بد من الحصول على مجموع يؤهلك للجامعة، وكليات القمة، فإن لم يكن وفاءً لأبيك، فحرصًا على ألا نُتَّهمَ أنا وأمي بالتقصير معك، هل قصَّرنا يا باسل؟، عجَزت عن الرد، قمتُ، فعانقته، وأكملت قلوبنا الحوار …!
في هذه اللحظة فقط علِمت كم هو حجم اشتياقي لأبي، وزال عني شعور المغامرة بالحياة الجديدة، وكأنني في فيلم أجنبي مما كنت أشاهده مع أخي، ولست في واقع ملموس يقيِّمني الناس فيه، علِمت في هذه اللحظة فقط لماذا تحجر وجه محمد، ولماذا جف ماء الحياة في وجه أمل، بل تحوَّلتُ مثلهم، انحصرت حياتي في غرفتي مع الكتاب فقط، حتى الدروس الخصوصية تركتها، وغبت عن المدرسة إلا في القليل النادر؛ حتى لا يتم فصلي، وكأن الحياة كلها غابت عن أَوْرِدتي إلا في لحظات قليلة، كان يمر عليّ فيها طيف علياء…، علياء التي أصبحت جنتي وناري، أوقاتًا أجتهد في دراستي لأكون مثلها، بل متفوقًا عليها، ومرات أزهد في الدنيا وما فيها، وأجد صوتًا يردد في أعماقي كلمة محمد: (معايير القلوب غير معايير الأطيان) ( كلمة الأطيان يقصد بها كثرة الأراضي = الثراء )
دِفء الأُخوَّة
شعر محمد بي حيث كان يَرقُبني من بعيد منذ تلك الليلة الليلاء، وكان يحاول ملاطفتي، فدخل عليّ ذات ليلة وأنا أذاكر، وقال لي: باسل، هل تعرف أني حزين منذ تلك الليلة وضميري يؤنبني، شعرت أني أضفت لعمرك سنوات من الهم والحزن، وكنت أستمد سعادتي من سعادتك، فعندما فقدت أنت سعادتك كما أرى، فقدت أنا إقبالي على الحياة…، كم كنت مزهوًّا وأنا أسمع أهل القرية يُشيدون بمهارتك في الكرة، وأنك تفوَّقت على أبنائهم جميعًا بل وفرق القرى المجاورة، فأنت منحتني أعظم شعور يفخر به رجل، وهو شعور الأُبوة، وأنا منحتك الهم والثِّقَل…
استمعتُ لهذه الكلمات وأنا لا أُصدق، انفجرتُ بالبكاء، ولا أعلم أهو بكاء على حالي، أم على أمي، أم أخي وأختي، أم حبيبتي التي لا تعلم حبي لها؟!أخذ محمد رأسي في صدره، وجلس يبكي للمرة الأولى أمامي، وأنا أصيح به: لا يا محمد، إلا أنت…، فلا أحتمل أن أراك على هذه الحال، أنت أبي وأخي ولم تقدم لي إلا الخير، يكفيك أنك كنت تعمل وأنت تدرس من أجل تكلفة دراستي، أنت تُؤْثرني على نفسك، أنت أبي وأخي وصديقي… دخلت أمي مفزوعة على صوتنا، فارتمى كلانا في حضنها باكين جميعًا…
الـفـرحـة:
جاء يوم نتيجة الثانوية العامة، وللمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، أرى أمي تفرح، ويعود ماء الحياة إلى وجه أمل، ويبتسم محمد؛ ليسقط القناع الحجري عن وجهه، علِمت وقتها كم أنهم يَملكون قلوبًا مِعطاءَة.
شقّت الزغاريد التي أتت من كل نافذة صمت بيتنا، نساء لم أَرَهُنَّ سابقًا أعدادهنَّ كثيرة، حتى خِلتُ أنهنَّ يَخْرُجْنَ من تحت الأرض، فالباب لا يتسع لهذه الأعداد، يُهنِّئْنَ أمي ويُكْرِمْنَها، وتختلط أصواتهم: ابنك الثاني على المدرسة يا أم محمد، هذا كشف النتائج، وأخرى تقول: أصرَّ زوجي على أن أبارك لك، مع أني لا أعرفك، لكنه معجب بلعب باسل الكرة، وكان ينتظر نتيجته، وثالثة تقول: أنا زوجة ناظر المدرسة، وكل واحدة تحمل معها مظروفًا به مبلغ من المال تُعطيه لأمي، قائلة: هذه هدية باسل، أناس تخرج وغيرهم يدخل، والفرح يملأ القلوب والجدران…!
كان يومًا لا يُنسى، أثار في نفسي شيئًا من ذكرى ذلك اليوم منذ ثلاث سنوات، ولكن هَيْهَاتَ…!ذلك اليوم كان أبي هو المضيف والمنفق، وأمي هي نجمة الحضور، أما اليوم فالحال أقرب للصدقة علينا منه للاحتفال، ذلك اليوم تبِعه مرض أمي وسفر أبي، وهِجرتنا من بلدنا الجميلة. وما زلت لا أعلم ماذا سيتبع يومي هذا!
هل تَتْبَعُه عودة لما كان؟
هل ستوافق أمي على قرار محمد…؟ هل أفارق علياء؟، كل هذا مرَّ في خاطري كالبرق، ولكن هناك صوت في صدري يأبى الصمت يردِّد: ما النتيجة التي حصلت عليها علياء؟
وقبل أن أنطلق من البيت إلى خالتي أم عليّ لأسألها – فحتمًا هي تعرف الخبر – وجدت عليًّا أتى إليّ راكضًا فَرِحًا، يُبشرني بأنها حصلت على المركز الأول على المدرسة والثالث على المنطقة… هنا اكتملت فرحتي، وشعرت بارتياح أتَمَّ عليَّ سعادتي، خرجت مع عليٍّ وتركت البيت يَضِجُّ بالحياة، واجتمعت مع كل زملائي من القرية كلها؛ فينا الفَرِحُ، وفينا النادم على تقصيره، هناك وجوه مستبشرة،يعتلي الأمل أرواحها، وهناك وجوه مُسْوَدَّة يَعَضُّون الأصابع على ما ضيَّعوا، سبحان الله! كأنها نتيجة امتحان الآخرة، كلٌّ يُفضي إلى ما قدَّم!
مرَّ الوقت سريعًا، وجاء التنسيق، ولا بد من ترتيب الرغبات، والأولوية للكلية التي أرغب فيها، وكانت المفاجأة أن محمدًا يصر على عودتنا إلى الإسكندرية، ولا مزحزح لإصراره هذا، ونزلت أمي على رغبته منكسرة حائرة، وقالت: رتِّبْ لباسل الرغبات، واجعل الأولوية لجامعة الإسكندرية، ثم الإسماعيلية، وما يقدره الله لنا خير … وافَقها محمد مرددًا: أيًّا كان مكان قبوله، فلن نُكمل حياتنا هنا، سئِمت من العيش لاجئًا وأنا في وطني، وابنتك هذه مَن سيتزوَّجها، ومَن سينفق على زواجها، أم أنك ستعتبرينها يتيمة..؟!
نحن لا نكاد نعيش، أنترك بيت أبي وماله، ونعيش كادحين بلا سبب مقنع…! استعِدُّوا للسفر بلا تردُّد…، نظرت أمي إليه مضطربةً، واستدارت قائلة له: اسبقنا إلى هناك، وانقل لي صورة عن أحوالهم الآن، لأدبِّر أمري!، قفز محمد قفزة قوية؛ ليقف بوجه أمي، وكأن حياته ورُوحه هما القافزتان، وليس جسده، وقال: صدقًا يا أمي، أنت راضية! فرغم إصراري فإني لم أكن لأُغضبك، إذًا دعيني أخبرك سرًّا، أعرضت عنه وذهبت إلى غرفتها، وكأنها أرادت أن تلوذ بفراشها؛ لتثبتْ وتُخبئ حيرتها، تبِعناها رُغمًا عن إرادتها، أحطنا بها، والفضول سيقتلني أنا وأمل: ما هذا السّر الذي يخفيه محمد؟ أما أمي فلا يهمها، وكأنها تقول: اتركوني ألا يَحق لي أن أَخلوَ بصرخاتي ودموعي، أم أني من إرث أبيكم لكم…؟!
بادَر محمد قائلًا: لقد كلَّفني المحامي صاحب المكتب الذي أعمل به بأن أنوب عنه في أحد القضايا، وفوجِئت أنها في الإسكندرية، ذهبت للمحكمة، ولكن أبت نفسي إلا أن أذهب إلى بيتنا…!، صرخت أمل: أحقًّا يا محمد، أصحيح أنك ذهبت، ثم تُمسك بقميصه وتَستنطقه: وكيف بيتنا، كيف أبي، وكيف الورد الذي كنت أزرعه في شرفتي…؟ هل كل شيء كما كان…؟
ثم يتغشّاها صمت وتردد فتقول: أين تعيش زوجة أبي؟ أتعيش في شقتنا؟، يسمع محمد أنين قلبها، فيحيط كتفيها بذراعه قائلًا:لا يا أمل، بيتنا كما هو، لم يَنَمْ فيه أحد منذ تركناه في تلك الليلة التي لا تُنسى، فبعد عودة أبي من رحلة زواجه وعِلمه بهجرتنا، بنى طابقًا جديدًا فوق شقتنا، وأسكن زوجته فيه، هل تتخيَّلين يا أمل أن أبي لم يُدْخل زوجته بيتنا قط، ولم يَفتحه منذ فارقناه؟!! هدأت أمل، نظرت لأمها علَّها تلتمس نظرة رضا في وجهها، فوجدتها أدارت ظهرها للجميع، والتحفت ونامت، كأنها تطردنا في صمت…!
خرجنا نتحلق محمد وعلى ألسنتنا آلاف الأسئلة، أسئلة بعدد ساعات السنوات الثلاث التي قضيناها هنا بعيدًا عن بيتنا…، سبقتني أمل قائلة: كيف استقبلك بابا…،صمت محمد قليلًا، ثم قال:بابا تغير كثيرًا، لقد هزَّه بُعدنا عنه، وأضعف حماسه وإقباله على الحياة، كان في نظر نفسه وجيرانه وأصدقائه الرجل الذي أضاع أسرته مقابل شهوة لا دافع لها، خاصة أن مكانة أمي في نفوس الجميع عالية، حتى أصحابه، كثيرٌ منهم هجَره ولاءً لأُمك، وبعضهم قال له: إن أعدت زوجتك عندها تذكَّرني، أما أن أُصادقك وأنت تنام ولا تعلم أين ينام عِرضك، فلن أعرفك!!، هل تتخيلين يا أمل أنه عندما فتح لي باب البيت – إذ ذهبت لهم قبيل المغرب؛ لأَضمن عودته من عمله – لم يُصدق أنني أمامه، وانكبَّ على رأسي يُقبلها، ويدي يضعها على خديه، ويَشُمُّها كطفل وجد أباه بعد ضياع…، ظل يحتضنني نصف ساعة ولا يتحدث، مرة يتحسَّسني، وأخرى ينظر إلى وجهي، وثالثة يحتضنني، ورابعة يهذِّب لي لحيتي التي تفاجأ بها..!
كانت لحظات لا تنسى أبدًا…، لحظات اكتنزت كل حنان كان يرجوه ابن من أب سويٍّ، كأن الله قدَّر لنا هذه المحنة؛ ليجلو لنا قلب أبينا، فنراه كما هو، لا كما كان يتعمد إظهار نفسهلنامغلفة بهيبة مفتعلة، وَرِثها بلا تنقيحٍ، ما أرحمه والله! يبدو أننا لم نكن نعرف حقيقة أبينا جيدًا، استطرد محمد: كل هذا جانب، وإحساسي بأنني في بيتي جانب آخر، نمت في تلك الليلة بعمق لم يحدث على مدار السنوات الماضية، فتحت كل غرفة، وقفت في كل شرفة، قبَّلت أرض غرفتي، نظرت على كل بيوت الجيران، وَدِدتُ لو قبَّلت الناس في الشوارع، تمنيت لو صرخت بأعلى صوتي قائلًا: أنا محمد، أنا رجعت، أنا تربيت هنا، هنا طفولتي وصباي، هنا …. ثم اختنق صوته فصمت وانصرف، ولا أعرف ما الذي قفز إلى قلبه فجأة، ثم أخفاه عنا.
استرقتُ النظر إلى أمي فوجدتها نائمة، وكأن القرار أعياها، ثم نظرت لأمل فوجدتها تبكي شوقًا لأبي وشفقة، وأنا ما زلت مضطربًا، أشتاق لنفسي التي كانت، ثم أشتاق لنفسي التي تسكنها علياء…، ظل سؤال يراودني: ألم يبحث عنا أبي كل هذه السنوات؟!
ظهر التنسيق، وكان قدري هندسة الإسكندرية، وعليّ كلية علوم الإسماعيلية، وعلياء اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة…! فشعرت بحيرة شديدة، هفا قلبي لأن أكون معها، لم أتخيل أن تكون هذه الكلية رغبتها الأولى، ولا أعلم سرَّ اختيارها لها، فهي تكاد تقتصر على أبناء الدبلوماسيين؛ ليضمنوا وسيطًا للتوظيف، استجمعت كل جرأتي وتوسَّلت عليًّا أن نذهب لبيتها بحجة أنني سأترك القرية قريبًا، وقد كان…!
جلسنا مع أسرتها في تَرحاب، ودعَتْها أُمها لتأتي؛ حيث افتعل عليٌّ بعض الأسئلة حول الجامعة، وكنت قد أعددت ألف سؤال لأناقشه في وجودها؛ لأعلم عنها المزيد، ولكن لم أَفُزْ إلا بالصمت … كيف لي أن ينطق لساني وقد ملَكت حمرة وجنتيها عليَّ لُبي؟، كيف أستجمع قوتي على الحوار وضوء جبينها يتغلغل في أعماقي، أذهلني شهدُ حديثها عن حديثي، وعذوبة صوتها عن أشواقي وفضولي، جلست وكأني في عالم من الروحانية، أكاد أفقد وزني عنده، كأني محلق في سماء قدسية لا يَشعر فيها الإنسان إلا بقلبه…، ثم أفقتُ على سؤالها: وأنت يا باسل، ماذا ستدرس؟ وما مساحة الكرة في خطتك المستقبلية…؟!
ردَّ علي: تم قَبوله في هندسة الإسكندرية، ولكن الكرة هو يجيب عنها، وكأنه أسعفني حتى أستفيق…
فقلت: سأتابع اللعب بإذن الله، وسأسجل في فريق الجامعة، ولكن لماذا اخترتِ الاقتصاد والعلوم السياسية؟ إنها بعيدة عليك ولا توجد إلا في القاهرة…، قالت: هي كلية ذات شأن، ونصحني بها أبي وعمي الذي يعمل في السلك الدبلوماسي، وجدت في نفسي ميلًا وفضولًا لمثل هذه الدراسة، فإن أردت العمل في مجال الاقتصاد فهو متاح، ولو تحقق لي العمل في السلك الدبلوماسي، فهو أرقى، وإن لم يكن فسأكتب في أي مجلة، ستوفر لي هذه الكلية مادة ثقافية، ووعيًا يعينني على الكتابة، فأنا أحب الكتابة مثلما تحب أنت الكرة…، دومًا تنصحني أمي: لا تنظري لمسمى الشهادة، بل انظري لطبيعة العمل بها.