
بقلم: زيد الشهيد
القصةُ بناءٌ سردي يتوخّى بناءَ علاقةٍ بين “منتج” بمثابة مرسِل و”متلقٍّ” بمثابة مستلم يسعى الاول لجعل هذا البناء رسالةً انسانية يتلقّاها الثاني، تحمل دلالاتٍ متعددة وصولاً ،بعد القراءة والمتابعة، الى مدلولات متعددة هي الأخرى. والقصةُ عالمٌ وإنْ بدا ضيّقاً لا يُقارن بالرواية التي هي عالمٌ واسع إلّا أنَّها تحمل نفسَ الغرض في التفاعل مع الذات القارئة. فهي فعلٌ حيٌّ تتبارى في نسيجِها انفعالاتُ الشخصية او الشخصيات، ويتفاعل فيها الحدث أو الاحداث على ايقاع زمكاني، حيثُ اللغةُ تؤدّي غرضَها، وتترك هاته الذات في حصيلة إنْ كانت القصةُ المقروءةُ ناجحةً أو عكس ذلك.
وفي تعاملنا مع المجموعة القصصية “غبار الرفوف” للقاص الدكتور مصطفى لطيف عارف عبر قراءة القصص وجدنا أنَّ ثمَّةَ اهتماماً كبيراً يوليه القاص لموضوعاتِ قصصِه التي تنوَّعت واختلفت في طريقة قصِّها لكنَّها اتَّسَمَت بنزوعٍ يتعاطفُ مع الانسانِ ومعاناته. يقاوم الشرَّ ويُعلي من شأنِ الخير؛ يدعو الى الحرية ويناهضُ الظلم، يسعى لإشاعةِ السلام ويرفض العَسَف. أمّا شخصيات قصصه فتفاوتت بين مَن يعيشون في القاعِ الاجتماعي( وهي دلالة تواجد القاص بين صفوفِ المُعدَمين والمَسحوقين والمُهمَّشين) وأولئك الذين يتَّسمون بشهاداتٍ عُليا ومستوى ثقافي يُعتد به( كَون القاص استاذ جامعي يحمل شهادة اكاديمية عليا).. وهو بذلك يمثِّل الكاتبَ الذي تَتقدم لديه موضوعةُ الهمِّ الانساني وما يواجه هذا الانسان من عاديات أخيه الانسان وجورِه وشراهةِ الاستحواذ والجبروت بلا خشيةٍ من عقاب سماوي أو انقلابِ أقدار.
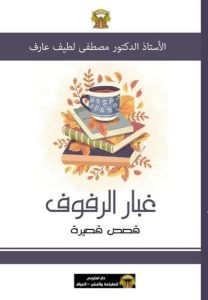
ولقد سعى القاص في مضمارِ كتابة القصة الى تناول نماذج اجتماعية تعاني وتتألم جراء أحداث تكالبت عليها وهي لا تجد مسارَ النجاة الذي يبعد عنها المعاناة أو يقلل من الاوجاع التي تتزاحم داخلها فتقض عليها أيام طمأنينتها واستقرارها. فما يجري وجرى عبر الايام استطاعَ تحفيزَ موهبته وتوجيه انظاره من تسليط الضوء عليها لتكون شهادةً تاريخيةً لِما جرى وما حدث. فالبلاد بعد سقوطِ صدام ونظامِه التسلطي، وكما هو معروف وواضح، شهدت حالةً من تبعثرٍ لم يكن |أحد يتصوَّره. فالمتصوَّر، بَل والمؤمَّل، أنَّ بعد سقوطِه سيدخل الشعبُ الى بُستان الحرية والديمقراطية، وميدانِ البناء والإعمار بعد حصارين جلموديين (حصار النظام، وحصار الامم المتحدة) ولأكثر من عَقدٍ كاملٍ من الزمن، لكنَّ ذلك لم يحدث!.. الذي حدث هو الانفلات المجتمعي، واندلاع نار المذهبية، والانتقام والانتقام المضاد. فمات جراء ذلك الكثيرون، وقُتِل الكثيرون، وغُيِّبَ الكثيرون، واهدرت الثروات، وساد العَبث، وعمَّ الاقتتال. ووجدَ الناسُ انفسَهم في سفينةٍ تمخرُ العُباب وتسعى لوصول جزيرة الامان… في هذا الخضم وجد الراوي( في قصة ” الدكتورة سوزان”) نفسه مدعواً لحضور مَعرض فنون تشكيلية تقيمه زميلةٌ له من ايام الجامعة، فرَّقتهما الاعوامُ وجمعتهما المناسبة. وفي فضاء المعرض ومروره على اللوحات المعروضة يستعيد ذكرياته معها ايام الدراسة في كلية الفنون الجميلة؛ لكن الذكرى التي تبارت مثيرةً للشجن ومؤجِّجةً نسمات السعادة اغتيلت عندما اخبرته الدكتورة سوزان سلسلة المآسي التي مرت عليها بعد سقوط النظام وتفشي الطائفية، فقد اغتيل زوجها الاكاديمي واختطف ولدها الذي لم يعد اليها الا بعد أن دفعت فدية كبيرة لهم اقتضت بيع بيتها التي تسكنه وما تملك. غير انها عودة مأساوية جعلت الدكتورة تفقد الوعي لأكثر من مرة وهي تقص الحادثة؛ ذلك أن عودته لم تبشرها بسلامته، بل سُلِّم اليها مقطوع اليدين والرجلين والرأس؛ وهي جريمة شنيعة اعتاد الارهابيون ارتكابها مع الابرياء بدم بارد وبلا رحمة أو عطف.
وفي قصة” الخيبة” يسلط المؤلف الضوء على جانبٍ مُعتم من جوانب التعثّر الذي عاشته البلاد بعد سقوط النظام.. فالعائدُ من خارجِ الوطن من بلاد العلم والمعرفة/ انكلترا محملاً بآمال وأماني تضمخها رغبةٌ عارمةٌ لخدمةِ الوطن لاسيما وهو يحمل شهادةً علميةً في الفيزياء النووية، وهو تخصّصٌ نادرٌ تسعى البلدان لحيازتها من أجلِ تطويرها في الجانب السلمي الذي بفعلِه يتحقّق انتشالَ البلاد من الحياة الحضرية البسيطة الى المصافي الحضارية الراقية يواجَه بالجَفاء وعدم الاهتمام عندما يجد نفسه يراجع الدوائر الحكومية، من أجل الحصول على وظيفةٍ يُكرّس من خلالها جهوده وما تعلمه من علم ومعرفة البلدان الحضارية المتقدمة، ولكن بلا طائل فقد باتت الوظائف لا تُعطى لمَن كان يعيش في بلاد الكفر؛ وتمنح فقط للذي ينتمي الى الأحزاب التي تمسك زمام السلطة.. فكانت طلباتُه التي يتقدم بها تُقابل بـالـ((رفض فوراً لسببين الأول لا نحتاج إلى اختصاصك ,وأنت تحمل شهادة علمية من دولة كافرة والثاني انك لم تنتم لجهة سياسية تزكيك.)). وهذه حالةٌ من حالات كثيرةٍ وجد فيها أصحابُ الشهادات العليا وغير العليا أنفسَهم مُهمَّشين ومَرميين على قارعةِ الطريق. لا تلبية لدعواتِهم، ولا أحد يستمع لشكواهم وسط خضم من فوضى ادارية تفتقد الى الخطط السنوية والخمسية أو العشرية التي تعتمدها البلدان التي تريد لمستقبلها أن يكون زاهراً.
ولأن القاص توخى القص بأسلوب الواقعية التي تتماس وحياة الناس فقد تناول حالات لا يمكن التغاضي عنها. فهي لم تكن موجودة عبر الانظمة الحكومية المتعاقبة انما خلقتها ظروفُ التسيّب وضعفُ الدولة في ايامنا هذه، ونقصد بها الاعتداء على الكوادر الطبية في مؤسساتِها الصحية.. فقصة” ضحايا ضد مجهول” تتبارى في كشف ما تعانيه تلك الكوادر التي درست وجهدت من أجل وظيفةٍ تضئِّلُ العذابات الانسانية وتقدّم خدماتِها بنكرانٍ ذات ابان الليلِ والنهار وهي تستحقُّ اللقب الكبير” ملائكةُ الرحمة”؛ لكن هذه الملائكة تجابَه بسوءِ سلوكٍ مَن لا يثمِّن خدماتِهما وتضحياتها، فيتمُ الاعتداءُ عليها بدون وازعٍ من ضمير. فعائلةُ عبد المنعم العلي عائلةٌ طبية بامتياز؛ فهو طبيب وزوجته طبيبة. كذلك هيلين ابنتهما هي الاخرى طبيبة اقترنَ بها الطبيب سنان لطلب، وصار من نسيج العائلة الطبية… وعائلة كهذه لابدَّ أنْ تنالَ الاعجابَ والاحترامَ والايثار في اكبارها والافتخار بها من قِبل الجميع؛ لكن ذلك لم يحدث وسط الانفلات، وضعف السلطة، وتردي الاحوال. فقد حدث إنْ فشلت احدى العمليات الجراحية بسبب لا يمت لقصور الطبيبة واهمالها انما السبب هو الاتيان بالمصاب في حالة لا يمكن معها القفز على الواقع. فليس الطبيب بساحر يمسك عصاً يرمي بها فينهض المصاب طيّباً معافى، وهو ما يبغيه الجهلة من الناس والخارجين عن القانون. فقد اطلق الرصاص داخل المؤسسة الطبية على هيلين وابيها وامها، ما أدى الى مقتلهم جميعاً، وخسارة كوادر خدمية تحتاجها الانسانية لإنقاذها من براثن الموت، أو التقليل من معاناتها وآلامها.
تلك هي بعض الموضوعات التي تناولها القاص الدكتور مصطفى لطيف عارف بواقعيةٍ، مُعريّاً أمراضاً اجتماعية وانفلاتات أمنية تسيَّد فيها البغضُ، والكراهيةُ، والجهلُ على النورِ، والثقافةِ، والتحضّر.





