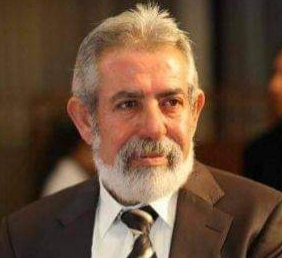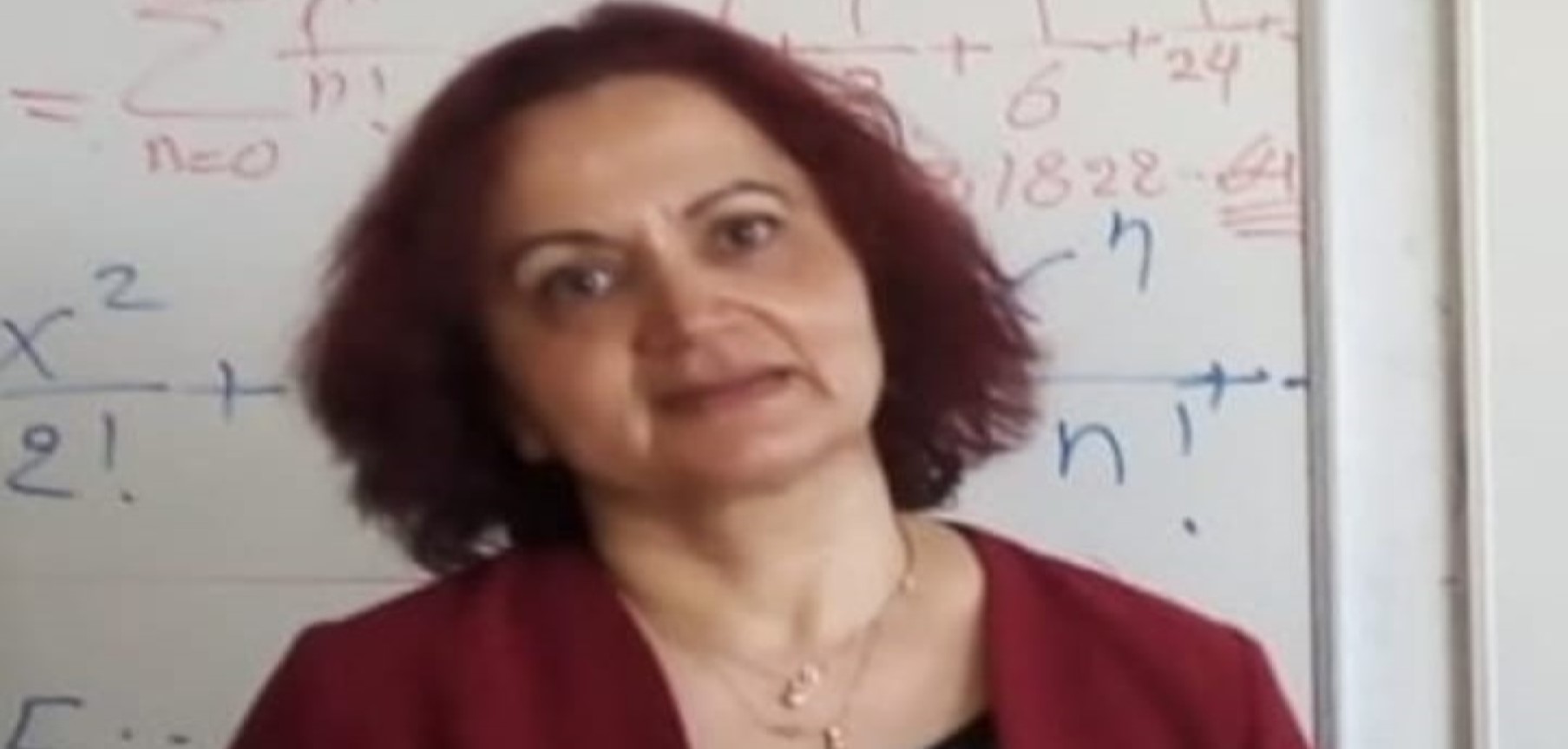“أوَ منْ كان ميتا فأحييناه” (الشيخُ وأنا).
طاهر العلواني | مصر
تعاقب عليَّ الليلُ والنهارُ سبعَ عشرةَ سنةً، وما برز لي حاجبُ الشمسِ ولا جنَّ عليَّ القمرُ إلا وأنا أعلمُ: لم خَلقَ الله الشمس والقمرَ؟ كما يعلَمانِ لمَ خُلِقا؟ وما أصبحتُ ولا أمسيتُ إلا وأنا أعلم أنه سبحانه جعلهما “خلفةً لمن أراد أن يذَّكر” وأنهما مَعاشٌ ولباسٌ، ولكنِّي ما سألتُ هذه النفس التي تسيل في عروقي يومًا: لم خلقها الله؟ ألِأن تزدادَ الأرضُ بها حِمْلًا، وبحركتها رعونة؟ ألِأن تعيش في حواشيها لا تُذكَرُ إلا عن إبهامٍ؟ آأنتِ في تحريفٍ من الحياةِ وغلطٍ عن حقيقتِها؟ ما تحسّسْتُها يومًا لألتمسَ فيها حقيقة النفسِ الإنسانية وحركتَها إلى الحق والباطل، وما جلستُ إليها ساعةً أفهمُ عنها سببَ إغراقِها في الجَور وارتجالِها للزَّيغِ؛ لقدْ كانتْ تكرَهُ كلَّ ما يتَّصلُ بمظاهر النفْسِ المُسْلمة من لحيةٍ وقميص قصير، حتى إنها ما مرَّ بها ملتحٍ فألقى إليها السلامَ إلا قالت له: لست مسلما! لا لعرَضٍ من الحياةِ المصكوكةِ آجالُها، وإنما لِفهمٍ عن الإسلام ليس من الإسلامِ، واتّباعِ طريقةٍ في الدينِ ليستْ من الدين، وهذا الفرقُ بين الضلالِ وتقليدِ الضلالِ. إنَّ هذا موجزٌ عن نَفْسٍ ظلَّت منذُ خُلقتْ ذاهلةً عن حكمةِ وجودِها، بل عن وجودِها، غافلةً عن طبيعةِ الحياةِ، بل عن الحياة.
وبعدَ أنْ قضتْ تلك المدةَ منقطعةً إلى نفسِها عن نفسِها، مَنَّ اللهُ عليَّ بأخي الذي أعفى لحيتَه، فأصبحتْ في بيتِنا شاخصةً حقيقتُها، وما زالتِ النفْسُ في ذهول عن تلك الحقيقةِ؛ فلمْ تزدْها رؤيةُ اللحية إلا نفورًا وإعراضا، ثم ما زال ذاك النفورُ يتناقصُ حتى اقتربتِ النفْسُ من نفسِها، فبدأتُ أسمعُ مع أخي أشرطةَ الشيوخ؛ قائلةً لي نفسي: ماذا علينا لو سمعنا منهم؟ إنَّ الدخان يلوح للعينِ من بعيد، فلا تدري أطِيْبٌ هو أم نفخُ كيرٍ؟ فكان أوَّلُ من سمعتُه منهم الشيخ محمد حسان، وكان أوَّلُ ما سمعتُه له (جهنَّم والصراط)، لقد كان وقعُه على نفسي وقعَ السَّوْطِ على ظَهْرٍ مُشَقّقٍ مدهونٍ بالزَّيتِ، ورأيتُها قد عقدتْ لي محاكمةً مشفوعةً بقانون الطوارئ، حُرَّةً في سجنِها بين لَومٍ وعتابٍ، فلا يزال الحديثُ يهمسُ في أذنِها يُنَبِّهُها إلى حقيقتِها ويُعيدُها إلى طبيعَتِها، وينفي عنها آثارَ التحريف النفسيّ، ويُرَتّبُها من جديد على منهجية النَّفس الإنسانيةِ التي فيها فطرةُ آدمَ – عليه السلام – حديثَ عهدٍ بالأرضِ، ويغرسُ في فطرتِها أوَّلَ أسبابِ الوجود الذي تقتربُ به شيئا مِن حقيقة الحياة وفلسفةِ الوجود في آدابِ الإسلامِ وأخلاقِه. “وما خلقتُ الجنَّ والإنسَ إلا ليعبدون”.
كانت هذه المرحلةُ الفارقَ بين النَّفْسِ الإنسانية ونَفْسِ غيرِه مما يدبُّ على ظهرها، ولكنْ بقيَ الاعتلاجُ الأكبر بينَ النَّفْسِ القانعةِ بالتقليدِ الذي يرفعُ عنها المساءلةَ غدا، والنَّفْسِ المُتَرَفِّعَةِ عن وَصمَتِه التي تجعلُها كالغَنَمِ يسوقُها الراعي فيأمرُها وينهاها، وربّما حَطَمَها بأمرِه وأهلكَها بنهيه. حتى أتاني أخي بشريط جديد، فقال: هذا شريط (مِن المؤمنين رجال) للشيخ أبي إسحاق الحويني، فقالتْ نفسي في نجواها: إسحاق!! هل يُسَمّىهذا الاسمَ إلا من كانوا هودًا أو نصارى؟ لكنّ هذه النجوى لم تستمر إلا قليلا؛ قلتُ لأخي: أليس إسحاق من أسماء النصارى؟! فقال: هذا ما كنا نظنّه؛ إنَّ إسحاقَ نبيٌّ من أنبياء الله، أخذ النصارى اسمَه وتسمّوا به في ظلمة جهلنا. وهذه بداية (رحلتي إلى الحياة).
ما عرفتُ أنَّ إكسيرَ حياةِ القلبِ بيدِ إنسانٍ يُرسي لها الأساس، ويرفع أعمدتها بكلِّ حرفٍ منه مكتوبٍ بين عينيه (صَدَقَ) إلا يومَ طرقتْ مسامعي كلماتُ الشيخِ؛ لقد نبَّهَ القلب إلى أنَّ تحتَ الحياةِ حياةً، وفوقَ الوجودِ وجودًا، والنَّفْسَ إلى قدرتِها وورفورِ طاقتِها في السَّعي إلى إدراكِ الوجودِ الأسمى، وهو (العِلمُ).
كانتْ تلك الانتفاضةُ على النَّفْسِ القانعةِ بالتقليدِ يومَ رأيتُه يبكي، كنتُ كأن الرُّوحَ تأخذُها رعشةُ الموتِ، وهاجتْ نفسي ملء الأفق، ونادت في جوانبي: إذا قضى هذا الرجلُ، كيف نصنع؟! فعزمتُ يومَها على دراسةِ الحديثِ وعلومِه، عشتُ فيه كأنه أنا، وعاش فيّ كأنَّني هو، فلا أعرفُ كتابا في علوم المصطلحِ إلا قرأتُه مرتين في أضعفِ العدد وسبعًا في أقصاها، وأكثرُ ما تردّدتُ عليه منها (تدريب الراوي شرح تقريب النواوي)، فلم تسطع في نفسي شمسُ علمٍ غيره، حتى إنني قرأت كلمة الأصمعي المشهورة في التدريب وغيره مرات ومرات: إن أخوف ما أخافه على طالب العلم إذا طلَب الحديث ولم يعرف النحو، أن يدخل تحت قوله – صلى الله عليه وسلم – ” مَن كذب عليّ متعمّدًا فليتبوّأ مقعده من النار”. فلم يكن لها من نفسي موقعٌ أكثرُ من أنها كلمة قرأتها في كتب الحديث. تركتُ المبالاة بها، حتى سمعتُ شريط (أسئلة حول تخريج الأحاديث)، فإذا الشيخُ يقول: ينبغي للطالبِ أن يضربَ بسهم في كل العلوم، فتحوّلتُ قليلا إلى أصول الفقه، حتى وصلتُ إلى (المستصفى من علم الأصول)، وإذا أنا بالغزالي يقول في شروط المجتهد إنه (لا يلزم أن يكون كسيبويه والمبرِّد وأضرابهما)، فكان وقعُها عليَّ كالنّبلِ في مجامع الأضغان؛ إذ نبَّهتْني من رقدتي إلى قول الأصمعي، وعزمتُ على أن أتفرّغ لعلمِ اللسانِ حينًا من الدهرِ، فبدأتُ بالنحو، ثم الصرف، ثم البلاغة والعروض، ثم النقد الأدبي وشجونِه، وقد كان منتهى آمالي يوم وَلَّيتُ قبلتي نحوها مختصَرًا في النحو أتعلم منه الإعرابَ، ولكنّ عيبَ اللسانِ العربي أنَّ مَن دخلَه وجدَ أبوابه للدخولِ فقط، ولم يعرفْ ذلك إلا بعد الدخول، وها أنا من يومها أدرس علوم اللسانِ، وتركتُ الاشتغال بالحديث إلا على استحياء. “هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون”
هكذا كانت رحلةُ النَّفْسِ إلى حقيقتِها، وإلى حياتِها، وإلى وجودِها في سنخِ الحياة بعد أن كانت تعليقاتٍ في حواشيها مجرَّدةً من الوجود قبل أن تفارق الوجود. “أوَ من كان ميتًا فأحييناه”