مقهي أش أش
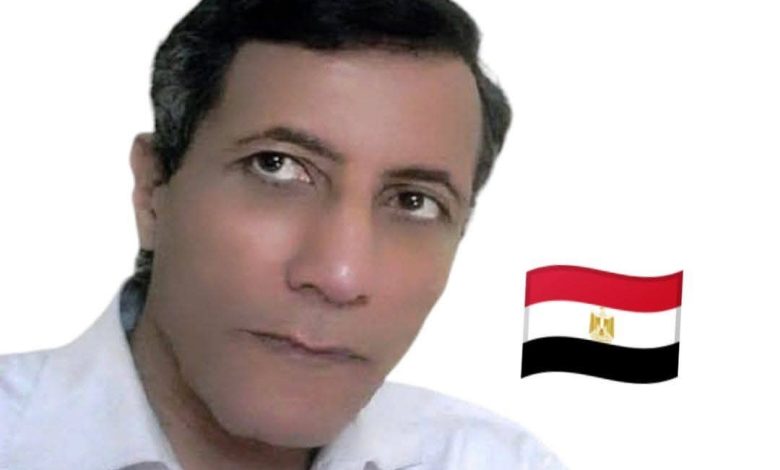
قصة قصيرة – بقلم / سعد جمعة
في حي شعبي، تضج شوارعه، وحاراته بالحياة وتتناثر فيه الحكايات من شقوق الجدران، كان هناك مقهى قديم يتوارى خلف أشجار الياسمين، كأنما يتعمد التواضع ليصير أكثر نقاء. لم يحمل لافتة تعرف به، ولا زخرفًا يغري المارة، لكنّ قِلّة من العارفين كانوا يسمونه “ركن الثقافة”، بينما آخرون يطلقون عليه مقهي أش أش.
اسم لا تسنده الخشب ولا الحديد، بل تمنحه الأرواح التي اعتادته ملاذًا ومأوى. فيه تلتئم الجراح التي لم تجد من يُصغي، وتُستأنس القلوب التي طال اغترابها في صخب العالم.
.. كل مساء، ومع تراجع الضوء عن النوافذ، كانت تتجمّع عند ترابيزة خشبية في الزاوية خمسة وجوه… لا تجمعهم صداقة بالمعنى المعتاد، بل تنسجهم خيوط من الفهم، والرغبة في العطاء.
كان بينهم رجل يرى العالم بلون الرماد، لا يُؤمن ببدايات، ولا يطمئن إلى النهايات. وآخر، آوى إلى عزلته لا هربًا من الناس، بل خوفًا من فقدانهم.
وثالث، يحيا بالأمل كما تحيا الأرض بالندى، لا يكل من الحلم، ولا يضن بالنور على من حوله.. رابعهم، عقلٌ لا ينفصل عن العاطفة، بل يُحسن توجيهها؛ يزن الأمور بمكيال الحكمة دون أن يُقصي الشعور. أما الخامس، فكان هو القلب النابض فيهم… قليل الكلام، واسع الأثر، يحمل حضوره في عينيه وملامحه، أكثر من لسانه.
في مساء مطير، خيّم صمت شفيف، كانت السماء تُعيد اكتشاف طفولتها، حين قال المتشائم وهو يتأمل المدى:
– المطر… تذكيرٌ بأن كل ما هو جميل لا يدوم. بل هو أحيانًا ما يفصل بين الأرواح.
أجابه المنعزل بهدوء:
– أو لعلّه ملاذ. كالصمت، كالوحدة. عطاء من نوع مختلف.
قال العقلاني:
– المطر ضروري، وإن أثقل. كالألم، لا نُحبّه، لكنّه يُعيد تشكيلنا.
ضحك الحالم وهو يراقب قطرات الماء على الزجاج:
– انظروا إليها… تسقط من غيوم متفرّقة، لكنها تلتقي على الأرض. كأن السماء تذكّرنا أن العطاء لا يحتاج إلى موعد.
عندها قال صاحب القلب بنبرة وادعة:
– فلنُحوّل هذه الترابيزة إلى مائدة عطاء. ليُقدّم كلّ منّا شيئًا جميلاً فعله، لا فخرا، بل إهداء للآخر.
ساد صمت خفيف، ثم تتابعت الأصوات:
قال صاحب القلب:
– ساعدتُ رجلاً مسنًّا على عبور الطريق. لم ينطق بشيء، لكن عيناه كانتا كافيتين.
قال الحالم:
– أهديتُ زهرة لطفلة، فغنّت لي أغنية صغيرة، كأنها تعرفني منذ زمن.
قال العقلاني:
– تخلّيت عن جدال كنتُ فيه على حق، وربحتُ احترامًا كان أولى بالبقاء.
قال المنعزل:
– مددتُ يدي نحو قطّي دون سبب. لا كلمة، لا طلب. فقط لمسة صامتة.
تردد المتشائم، ثم قال:
– منحتُ أحدهم فرصة لشرح نفسه قبل أن أحكم عليه… ولم أندم.
امتلأت الترابيزة بما لا يُباع في الأسواق: لحظات خفيفة، نقيّة، تقطرت من عمق الإنسان لا من سطحه.
قال صاحب القلب:
– العطاء لا يشترط وفرة مال، ولا فائض وقت. هو لحظة صدق؛ كلمة في أوانها، أو صمتٌ يُمنَح احترامًا. هو أن تبقي الباب مواربًا… لنسمة، أو لبداية.
منذ ذلك المساء، لم تعد لقاءاتهم مجرّد طقس، بل صارت طقوسا تُصفّي الداخل وتلمّ شتات القلب.
المتشائم بدأ يرى في كل أزمة احتمالًا،
المنعزل بات يفتح نوافذه للنور،
العقلاني تعلّم أن ليس كل ما لا يُفهم خطأ،
والحالم وجد في العطاء وقودًا جديدًا لأحلامه.
وذات مساء، جاء الخبر:
“المقهى مهدد بالإغلاق.”
لكنّ القلوب التي ذاقت المعنى لم تعد تقبل بالعجز.
قال المتشائم، وقد خفت سواد نبرته:
– لن نسمح بذلك.
قال العقلاني:
– سنضع خطة أنقاذ عملية
قال الحالم:
– سأُعيد طلاء الجدران بريشتي.
قال صاحب القلب:
– سأدعو الناس… من خلال فيديو بث مباشر هذا المكان أعطانا الكثير، وقد آن أوان الوفاء.
حتى المنعزل، قال بخجل:
– سأكتب عن المقهى. عنا. عن العطاء.
نظموا أمسية ثقافية، فغصّ المكان بالحضور، بالضحك، بالدفء.
تشارك الغرباء فناجين القهوة، ومشروبات آخري، كأنهم أصدقاء قدامى.
غنّى الأطفال، وتحولت الجدران إلى ذاكرة حية.
وفي ختام الليلة، وقف صاحب المقهى، وصوته مختلط بندى عينيه:
– كنتُ أظن أنني أقدّم المشروبات للناس .. فإذا بهم يُقدمون لي الحياة.
ومنذ ذلك المساء، لم يعد “ركن الثقافة” مقهى فقط
بل صار مائدة عطاء.
مفتوح لكلّ من أدرك أن الإنسان لا يكتمل بالأخذ، بل بالبذل،
ولا يُشفى بالكلمات وحدها، بل بالحضور.
وأن من يُعطي بصدق .. هو أول من يفيض.





