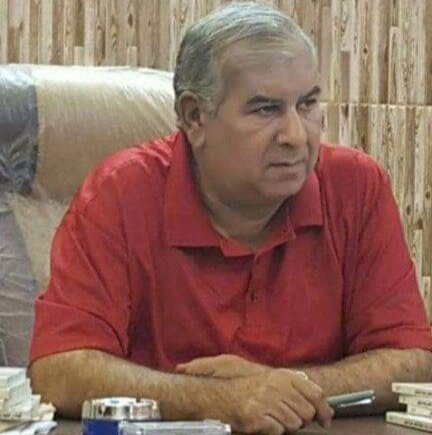عودة عالم ماركو بولو.. الحرب والإستراتيجية والمصالح الأمريكية في القرن 21
تأليف: روبرت ديفيد كابلان
عرض: محمد الشيخ
يعدُّ روبرت كابلان أحد أبرز المحللين الجيو-سياسيين والإستراتيجيين الكبار في زماننا هذا. فضلا عن كونه أحد المسموعين في دوائر القرار السياسي. وقد جمع في شخصه بين أمرين: في كتاباته ما يشبه تقليد مرايا الأمراء حيث يتكفل بإسداء النصح إلى أصحاب القرار السياسي بأمريكا، وفي تفكيره الاستراتيجي في المسائل الجيو-سياسة تفرد ودهاء.. وفي الأمرين معا يجمع بين مذهبين متكاملين، “الواقعية” و”البراجماتية”، ويحارب مذهبين، “الطوباوية” و”المثالية”، ويعمل بالقاعدة الذهبية التي استنها لنفسه: “لكي يفهم الإنسان الماضي ويتساءل حول المستقبل، فإن أفضل حل هو أن يجول وأن يعاين الأمور في مكانها بتؤدة”. ولهذا السبب، ذَرَعَ العالَمَ، طولا وعرضا، ذهابا وجيئة، ودوّن ما عاينه في العديد من كتبه التي تجمع بين التحليل السياسي ومدونات السفر. وقد كتب أزيد من عشرين مؤلفا أهمها “انتقام الجغرافيا” الذي قال عنه كيسنجر بأنه “عظيم في نوعه”، نبه فيه إلى أن حكم الجغرافيا، من الفراعنة إلى الربيع العربي، لا زال ساريا في مصير الأمم. كما رسم صورة دقيقة عن كارثة البوسنة في كتابه “أشباح البلقان”. وفي عمله “الفوضى القادمة” ـ الذي اعتبر أهم كتاب عن مستقبل كوكبنا إلى جانب كتاب فوكوياما “نهاية التاريخ” وكتاب هانتنغتون “صدام الحضارات” ـ تبنى نظرة معادية للطوباوية حاولت فهم عالم ما بعد الحرب الباردة، طرح فيه سؤال: ما الذي ينبغي لأمريكا فعله عندما ينفجر العنف بعيدا عن حدودها؟ ووجه صك اتهام قوي ضد خطط أمريكا لتصدير “الديمقراطية” إلى أماكن لا يمكنها أن “تنجح” فيها.
ويستلهم الكتاب الذي بين أيدينا عنوانه من أول وأهم مقالات كابلان. وقد شمل سبعة عشر مقالا توزعت على أبواب خمسة: إستراتيجية، الحرب وتكاليفها، مفكرون، تأملات، إحياء ماركو بولو. وهو كتاب جمع أشتاتا من التحليل الأكاديمي العميق، وفقرات من مرويات رحلية، ومعطيات من السير … ترى، ما الذي يجمع بين كل هذه الأشتات؟ أمران جوهريان: أولهما؛ وصف العالم كما هو في “واقعيته” لا في “تجريديته”. وثانيهما: عرض المقاربة الأمريكية لما يمكن أن تفعله أمريكا في هذا العالم الموصوف.
1- في توصيف العالم كما هو وبما هو: ما كان أعدى شيء عند الرجل من التجريد. ولئن ذُكِرَ أن الفيلسوف الألماني كانط كان يعرف عالم زمانه، نهرا نهرا وسهلا سهلا، وهو لم يغادر مدينته قط، وإنما من خلال كتب الجغرافيا؛ أي بمعرفة قائمة على ما في الكتب، فإن كابلان، وعلى خلافه، يكاد يعرف مشاهدةً كل نهر نهر وبحر بحر ذكره في كتابه. وما أكثرها! وما أشد تنوعها! فما يهمه هو ما الذي يحدث حقيقة على الأرض. وأطروحته الكبرى، بهذا الصدد، أن ما يحدث في عالم اليوم الشبكي، ما كان انهزام الجغرافيا أمام تكنولوجيا الاتصالات، على ما يروج، وإنما التشابك الذي استجد بين الجغرافيا والتكنولوجيا. لقد أمسى عالم اليوم أكثر تداخلا وأشد عصبية مما كان عليه من قبل. وترتبت عن هذا أمور من بينها هشاشة الجيو سياسة، وتشابك الأزمات .
ويدافع المؤلف عن فكرة مكونة من شقين: أوروبا سائرة إلى الاندثار، و”أوروآسيا” إلى الاندماج. وبين الأمرين تعالق. لقد أمسى ثمة اندماج بين قارتين هما أوروبا وآسيا في قارة كبرى يسميها “أوروآسيا”. ذلك أن أوروبا منذورة كوحدة جيوسياسية قائمة الذات إلى التواري. ما عاد عالم الحرب العالمية وما بعدها ـ الحرب الباردة ـ يسعف في فهم ما يحدث اليوم. وإنما صارت أوروبا متواحدة مع آسيا، وبدأنا نتحدث عن “أوروآسيا”، كما ما أمكن الحديث عنها منذ عقد من الزمن، كوحدة نظام تجارة وتنافس وتنازع. لقد أفل نظام ويستفاليا (24 أكتوبر 1648) الذي أرسى أسس النظام العالمي لقرون، وها هي ميراثات إمبراطوريات -روسيا، الصين، إيران، تركيا- تبيت ذات أولوية في النظام الدولي الناشئ. وها قد صارت “أوروآسيا” متعالقة: ما من أزمة تحدث في أوروبا إلى أزمة تحدث في إقليم بالصين إلا ويوجد بينهما تعالق. ذلك أنه لأزيد من نصف قرن عمل “النيتو” على ترجمة ألف سنة من تقليد في القيم السياسية والأخلاقية مديد ـ اسمه “الغرب” ـ إلى حلف عسكري. لقد كان “النيتو” ثقافة قبل كل شيء. ثقافة تضرب بجذورها إلى الميراثات الفلسفية والإدارية للإغريق وللرومان، فبزوغ المملكة المسيحية في بواكير العصور الوسطى، فإلى حركة التنوير في القرنين 17 و18، والذي نبعت منها الثورة الأمريكية. وكانت القيم التي التأم حولها أهل الحلف هي: حكم القانون ضد التحكم، علو منزلة دول الحق على دول العرق، حماية الفرد بصرف النظر عن عرقه أو دينه. وقد أعلنت نهاية ما يسميه المؤلف “حرب أوروبا الطويلة”، التي امتدت عنده من عام 1914 (بداية الحرب العالمية الأولى) إلى عام 1989 (سقوط الاتحاد السوفياتي)؛ حيث انتصر الغرب على “النظام الشمولي الثاني” (الاتحاد السوفياتي) بعد انتصاره على “النظام الشمولي الأول” (النازية)؛ فأظهر ذلك انتصار تلك القيم واندحار الشيوعية، وتوسع “النيتو” والاتحاد الأوروبي عبر أوروبا الوسطى والشرقية، من بحر البلطيق في الشمال إلى البحر الأسود في الجنوب.
والذي عند المؤلف أنه جرت العادة بأن تزدهر الحضارات في تعارض مع أخرى. فكما ازدهرت المملكة المسيحية ضدا على مملكة الإسلام التي كانت قد انتشرت بدورها من شمال إفريقيا إلى الهلال الخصيب بين القرنين السابع والثامن الميلاديين، كذلك نحت الغرب أنموذجا جيو-سياسيا في تعارض مع ألمانيا النازية والاتحاد السوفياتي. وهذه الحرب الأوروبية المديدة، التي دامت ثلاثة أرباع القرن، أثرت جيوسياسيا ولا تزال تؤثر. وهي ما يشكل مدخل كابلان إلى وصف العالم الجديد والذي على الجيش الأمريكي، فيما يراه الباحث أن يتعامل معه. بالنسبة إلى أوروبا، تم التخلي عن النزاعات القومية السياسية التي أدت إلى الحربين، وتبني منطق الوحدة العابرة للقوميات. لكن غامت الحدود بفعل حركة العولمة التي أمست تعني، بعد انهيار الحدود الاقتصادية، تبني الرأسمالية الأمريكية والممارسات التدبيرية التي تنبثق عنها، مع تقدم حقوق الإنسان -وهي كلها مفاهيم غربية- بما سمح بالتصاهر بين الثقافات؛ وبالتالي إعادة النظر في التقسيمات بين الشرق والغرب. وهكذا، فإنه لَئِنْ ربح الغرب الحرب الأوروبية، فإنه بدل أن يغزو بقية العالم، بدأ الآن يفقد ذاته في ما سماه المؤرخ الألماني راينولد نييبور “شبكة تاريخ واسعة”؛ وها هو سائر إلى التفكك.
وبهذا، بدأت تلوح معالم جغرافيا إستراتيجية جديدة يلخصها المؤلف في قوله: ها هي أوروبا تتخفى، وها هي أوروآسيا تتبدى. وهذا لا يعني أن أوروآسيا سائرة إلى التوحد التام، أو أنها مستقرة على الطريقة التي استقرت بها أوروبا خلال الحرب الباردة وما بعدها، وإنما يعني أن تفاعلات العولمة والتكنولوجيا والجيوسياسة، حيث كل واحد من هذه يدعم الآخر، تؤدي إلى اندماج قارتين في قارة عظمى “أوروآسيا” لكي تصيرا وحدة سائلة مهضومة. وما هو سائر إلى التحقق ما كان “صدام الحضارات” وإنما “صدام الحضارات التي أقيمت إقامة مصطنعة”.
وما عادت ثمة وحدة جغرافية قائمة الذات واضحة المعالم -أوروبا، شمال إفريقيا، الشرق الأوسط، آسيا الوسطى، آسيا الجنوبية، جنوب شرق آسيا، آسيا الشرقية وشبه القارة الهندية- وإنما هي سائرة بالتدرج إلى أن تفقد دلالتها من حيث هي مفاهيم جيوسياسية. وبالنتيجة، فإنه بسبب تآكل الحدود الصلبة والفوارق الثقافية، تسير الخريطة الدولية إلى إبداء اتصالات رخوة تبدأ من أوروبا الوسطى والأدرياتيك وتنتهي في ما وراء صحراء غوبي حيث بدأ مهد الحضارة الزراعية الصينية. نعم الجغرافيا تهم، لكن الحدود المشروعة لم تعد تهم بنفس الدرجة. وكما حدث في العصور الوسطى؛ حيث كانت منطقة الأندلس مألفا للحضارات الإسلامية واليهودية والنصرانية، تحت إمرة العرب، دون أن يجبروا الناس على تغيير ديانتهم، فإن العالم الذي يتبدى اليوم سوف يكون عالم تسامح وامتزاج ثقافي ذي عبق قوي، حيث ستنحل الروح الليبرالية الغربية لكن فقط بهذه الطريقة سوف تستعيد روحها.
ولسوف تكون الانقسامات الجغرافية أعظم وأضأل مما حدث في القرن العشرين: أعظم؛ لأن السيادات ستتناسل في طائفة من المدن-الدول والمناطق-الدول؛ بحيث ستبزغ هذه التقسيمات في جوف الدول نفسها لكي تحقق نتيجة أكبر من تلك التي حققتها التكتلات الكلاسيكية (الاتحاد الأوروبي، اتحاد أمم جنوب شرق آسيا). وأضأل؛ لأن الفوارق بين المناطق -شأن أوروبا والشرق الأوسط، والشرق الأوسط وجنوب آسيا، وجنوب آسيا وشرق آسيا- سوف تنمحي.. ولسوف تصير الخريطة أكثر ذوبية وباروكية.
لكن هذا لا يعني نشأة عالم وردي؛ ذلك أن التعالق بدل أن يقود إلى مزيد سلام وازدهار وتوحيد ثقافي، كما يدعي المتفائلون بالتقنية، قد يكون له ميراث ملتبس: مع مزيد من التواصلات تصير رهانات الحروب أعظم، ويسهل أن تنشب الحروب وتمتد من منطقة جغرافية إلى أخرى. ولسوف تمسي الشركات الكبرى المستفيد من العالم الجديد، لكن بما أنها عاجزة عن توفير الأمن، سوف تند في النهاية عن كل سيطرة.
ولك أن تنظر إلى ما تفعله الصين حاليا من بناء قنطرة تصل آسيا الوسطى والشرقية، من جهة، وأوروبا، من جهة أخرى، ومن بناء شبكة جغرافية عبر المحيط الهندي من شرق آسيا إلى الشرق الأوسط؛ فإنك تجد طريق الحرير الجديدة ترمز إلى هذا التشابك الجديد حيث لا عقائدية ولا مذهبية… لكن، بقدر ما طفق العالم يمضي نحو التصاغر، بسبب التقدم التكنولوجي، أمسى قابلا للاختراق وشديد التعقيد، مع أزماته المستعصية التي لا يمكن حصرها بعد.
وهنا يستحضر المؤلف صورة التاجر الملاح الفينيسي ماركو بولو، في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي، الذي جال عبر طريق الحرير. ويرى أن الطريق التي ارتادها هذا التاجر توفر لنا أرسومة جيدة لتحديد جيوسياسيات أوروآسيا في العهد القريب المقبل. أَلَا ما أشبه عالم ماركو بولو بعالمنا اليوم! لقد بقيت فكرة “الإمبراطورية” المبدأ المنظم لعالم الأعمال. وها هي تجارب تركيا وإيران وروسيا والصين تفسر الاستراتيجية الجيوسياسية لكل بلد. إنما التاريخ هو المفسر. وقد أضيف إليه التعالق بين أزمات العالم. ورغم أن الإمبراطوريات نضحت وفقد لونها بريقه القديم، فإن أهلها لا يزالون يتصرفون بوفق الروح الإمبراطورية، حتى وإن اتسعت حدود البعض وضاقت حدود الآخر. ولَئِنْ كان قد رأى أحد المفكرين الإستراتيجيين أن أقوى حجة للإمبريالية هي المبدأ القائل: “إذا أنت لم تستول على هذه الأراضي استولى عليها الأسوأ”، فإنه لهذا السبب لن تموت الإمبريالية أبد الدهر.
وعلى هذا الأساس، فإن قوى تركيا وإيران وشرق آسيا، حتى وإن كانت تعاني من بعض أنحاء الفوضى، بفضل ميراثها الإمبراطوري العتيق، أمست الدول الأكثر انسجاما في الشرق الأدنى. وقد دعمتها في ذلك الجغرافيا، هذا بينما دولة أشب كالسعودية لا ميراث إمبراطوري لها، دولة هشة. أَوَ ليس أردوغان، بنزعته التحكمية، سائر إلى احياء استراتيجية الإمبراطورية العثمانية وإلى إماتة الإستراتيجية الكمالية التي دفنت الخلافة؟ وأليست إيران تعود اليوم إلى النموذج الإمبراطوري الفارسي؟ لكن للنموذجين حدودهما: تديين النموذج التركي المتزايد، وأدلوجة إيران العقيمة. كل ذلك يجعل بعض الدول تنفض من حولهما.
وتستمر رحلة ماركو بولو الجديدة من الإمبراطوريات الناضحة الذابلة -تركيا وإيران- إلى سمعة الصين المتعاظمة أكثر من سابقتيها، بل حتى أكثر من روسيا وأمريكا. ومن يقدر على لجم روسيا، ما كان هو أمريكا وإنما الصين؛ لا سيما وأن هذه لا تسوق أيديولوجية نظامها السياسي غير الديمقراطي في دول الجوار كما تفعل أمريكا مع نموذجها الديمقراطي الكوني. إذ تتعامل مع كل الأنظمة، “الشرير” منها و”الخير”، بإحياء طريق الحرير الجديد.
2- في ما الذي يمكن أن تفعله الولايات المتحدة الأمريكية وما الذي لا يمكنها أن تفعله؟
هو ذا عالم اليوم.. فما المقاربة التي يمكن أن تقوم بها أمريكا؟
أطروحة المؤلف بهذا الصدد: الواقعية والوظيفية. لا يمكن لأمريكا أن تتحرك في العالم بأكمله، لا يمكنها أن تعمل سلاحها في كل أنحائه. وهذا يدفع أمريكا إلى إعادة طرح السؤال: من نحن؟ ما مهمتنا؟ ما أخطاؤنا؟ ما طبيعة قوتنا؟ ما الذي يحدث في عالمنا اليوم؟
لا ينكر كابلان الصعوبات التي تعتور أرسومته “الواقعية” لعالم اليوم. ويدعونا إلى أن ننسى الثنائية بين المتشائمين الذين يتنبؤون بالفوضى، والمتفائلين الذين يبشرون بمزيد من التشابك. النزعتان معا واقعيتان ومحقتان. ولا تناقض في هذا ما أن نفكر من خارج أنموذج التقدم الخطي الذي تهوس به العقل الليبرالي. علينا أن نفكر مجددا وفق عالم ماركو بولو. فلا مكاسب بلا محاذير. وطريق الحرير ليس كله مفروشا بالحرير. هناك مشكلتان باكستان وأفغانستان ومنافسة الهند. وكل هذا يطرح تحديات على الولايات المتحدة.
وعلى الجُملة، خريطة اليوم أشبه شيء تكون بخريطة نزعة قروسطية جديدة متمحورة حول مدن-دول (أكثر منها حول دول قومية)، تحت ظل إمبراطوريات تقليدية. ونموذج وستفاليا الذي كانت فيه الولايات المتحدة تقليديا تتدخل وتتفاعل بمنتهى الراحة، صار أمرا أكثر فأكثر اندحارا. وباتت أوروبا تشكل المنصهر الذي يوجد في أتون هذه الفوضى. لكن، هل تقدر أمريكا على الحفاظ على سلاحها نظيفا؟ ها هي نخب واشنطن منشغلة بشيطنة حكام روسيا والصين، ومهتجسة بالمواجهة مع هاتين القوتين التحكميتين في مناطق عدة. لكن السؤال الذي لا تطرحه: إن فرضنا، جدلا، بداية مناوشات عنيفة مع هاتين الدولتين، كيف يمكن إنهاء حرب مع روسيا والصين؟ الأمر جلل جسيم. لن يكون العالم، بعد هذه الحرب، بالعالم الذي عهدناه قبلها. ولن يطال شؤبوبها مكانا واحدا. والعاقبة غير مأمونة. وإمكان تغيير هذين النظامين، إذا ما تم هزمهما، غير مضمون. وعلى أي، زعيما النظامين جريئان، لكنهما غير مجنونين.
وفي الجملة، ثمة تعالق بين دول تضعف وإمبراطوريات ناضحة عبر أوروآسيا. وعالم العصر الرقمي أشبه شيء يكون ببيت عنكبوت ممتد. إذا ما أنت مسست منه خيطا ارتجت الشبكة بأكملها. لنتذكر أن حرب البليوبونيز القديمة قدحت زنادها شرارة صغيرة. ولهذا، ينبغي التفكير مأساويا بغاية تفادي مأساة آتية.
——————-
– الكتاب: “عودة عالم ماركو بولو”.
– المؤلف: روبرت ديفيد كابلان.
– الناشر: بانغوان راندوم هاوس، 2018.
– عدد الصفحات: 304 صفحات.