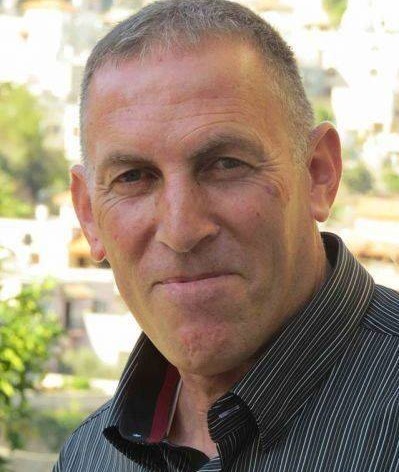من شهادة الشاعر على نصه.. المعنى خارج الإطار

نداء يونس | فلسطين
إن ما ينطبق في عرف امبرتو إيكو على الصور، ينطبق من جانب ما على ما اريده من الشعر “لقد رأيت بوضوح أن الأمر تعلق هنا بحركات نابعة من ذاتية سهلة، تنتهي، بمجرد أن يقال: أحب/لا أحب: من منا لا يمتلك فهرسه الداخلي للمذاقات، للنفور، للامبالاة؟ لكن بالتحديد: دائما ما كنت أرغب في البرهنة على أمزجتي؛ ليس لتبريرها، وبدرجة ما ليس لملء مشهد النص بفرديتي؛ ولكن على النقيض لإهداء هذه الفردية ومدها إلى علم للذات، علم لا يهمني اسمه كثيرا، بشرط أن يصل إلى عمومية (لم تتمثل بعد) لا تختزلني ولا تسحقني”.
كيف تُحدث تلك النصوص التي تولد بلا اشتغالات فكرية وفلسفية خارج النص وفي كواليسه بعدها العمومي، كيف تصبح بعثا لواقع مضيء، شيئ كالسحر لا نسخا للواقع؟ كيف تتجاوز القانون لصالج المتخيل؟ كيف يمكن تجنب موت الشعر/الصورة حين نحبسه في إطار؟
يمكن لنص واحد الإحالة إلى أبعاد أخرى خارج إطار القول. رغم أن الشعر محاولته أن يتجنب أن يتعرض للاختزال والسحق الذي يمارس على الأنا، فإن خلف النصوص اشتغالات تنحى بالكلمات من أحالاتها المباشرة إلى ما خلف كواليس النص، وتعمل على استحضار الغائب من الجهة التي لا تراها العين ولا تنكشف إلا بمقدار التشارك في المعرفة مع المتلقي، حينها تشتغل التصنيفات أو الفهرسة الداخلية للمذاقات بطرق مختلفة تماما.
مرة أخرى تثير قصيدة “أنا الحقيقة وأنت الظلال” أسئلة حول الاشتغالات البعيدة عن النص الذي احتل الإطار، إطار القصيدة، وبقدر ما يعكس هذا النص الإدراكات الجسدية الفينومولوجية لكم من التجارب التي أبدو من خلالها منشغلة بالحب، بقدر ما تجعلني هذه الاشتغالات أتخذ موقفا مرتبكا ومتناقضا بل يائسا وواقعيا من قضايا كثيرة شخصية وذات بعد وجودي.
هنا، تبدو الاشتغالات الفلسفية البنيوية مسرحا آخر للنص، وليس اشتغالا وحيدا إذا إنه قابل لمجموعة قراءات خارج حدود الاشتغال المعلن.
تحيل معالجة الوقت في مقطع “لأنه كل شيء” إلى فكرة تعدد الوسائط الذي يرى بأنها ليست أكثر من توسع لمداها في إحالة واضحة لميديولوجيا دوبريه، إنه ذاك النسخ المتكرر للأدوات بعيدا عن أي أثر حقيقي في المعرفة بل في الوهم وليس أكثر من عملات تحمل ذات الوجه لسلطة خطاب واحدة، لهذا فإن عملية “التحول إلى طائر” أمر مستحيل، لا يمكن بحال التحرر من تلك السلطات، ولذا تستعصي عملية التحول حتى في ظل وجود سحر الوسائط، إننا محكومون لأوات تعيد إنتاج البنى الكبرى، محكومون لإعادة إنتاج الرموز رقميا، ومحكومون بفكرة المحاولة، أما سحر قبعة التحرر من خلال أشكال التواصل الجديدة، فإنه سيثبت ارتهانه كما يؤكد دوبريه للمعرفة الجمعية وخضوعه لها وسيكون في المحصلة انعكاسا لفكرة السلطة عند فوكو التي لا يمكن تجاوزها إلا بالسحر أو الجنون.
وعليه، تتحول علاقتنا بالوسائط من رفض السلطة والعجز عن التأثير في العالم فرديا إلى فكرة اللهو، إننا نستهلك الزمن والمكان والتقنية في ظل رفضنا البدئي للسلطة وللعجز عن تحقيق المعرفة الفردية وفرضها، وبالتالي تصبح فكرة التقاط السلفي التي وردت في القصيدة واقتسام الإعجابات نتيجة طبيعية لذلك الاشتغال الفلسفي، فالأنا لا تصنع معرفة فردية أبدا امام المعرفة الجمعية، وتختزل إلى ميمات وايقونات اتصالية تملأ الوقت فقط ولا تشكله.
وهنا تشتغل فكرة الافتراضي لبودريار ووهم التقنية والاتصال لهذا تساءلت القصيدة عن الحياة الافتراضية وانقطاع الكهرباء إذ تحيل على موت التقني بالتقني، وتشتغل من خلال هذه الفلسفات تحت الإقرار الشعري في القصيدة “لست وحدي تماما ولست معك” على السؤال الأخطر في عالم التقنية:هل نحن متصلون في فضاءات الاتصال هذه أم إننا نحسن بالوحدة.
إننا بهذا نعود إلى كهف أفلاطون، إن الحقيقة التي نراها هي الظلال على جدران الكهف، إنها الحقيقة الوحيدة، لكننا لا نعلم إذا ما كانت هي الأصل تم إنها مجرد صورة، وبالتالي يظل سؤال الظل والأصل رهن ادعاءاتنا ” ما دمت أدعي أنني الحقيقة وأنك الظلال”.
وهكذا، فإن عدم القدرة على التحقق من التعاقب، من الماضي الذي حدث ولم نكن شهودا عليه، الذي لا يمكننا أن نعرف لحظته الصفرية ولا أن نُخضع سيرورته إلى التجربة والقياس ما يجعلنا رهن التأويل والاسطرة.
يعاد إنتاج الماضي في التزامن على شكل مقدس لا يمكننا نفيه أو تأكيده أو الهروب منه وهذا ما تعكسه مقاطع من الفصيدة مثل “لا تعرف الساحرات كيف يعدن الرجفة الأولى”.
هنا تشتغل بقوةٍ تفكيفية دريدا التي تدعو إلى تفكيك المرجعيات والعلامات من خلال تتبع أثر تشكل الدال والمدلول أو اللحظة الصفرية لتشكل المعنى أو المرجع، وهو الأمر المستحيل لكنه طريق هام لنسف الصلب في التاريخ الذي يحتفظ تحت غموضه بتلك الهالة الأسطورية والرمزية التي تحكم، ونجدها في مقطع مثل “كما لو تمكنت من إخفاء التمر”، فهل يمكن فعلا إخفاء جرائم التعاقب وإبرازه الأحداث طازجة ببعدها التزامني؟
يستلزم الاشتراك في السنن المعرفي سهولة تفكيك المعاني، وبهذا فإن الانكشاف الكامل والمعرفة التي سعى إليها آدم في جنته خطرة، إنها تحيل كل سيرورة الزمن الى ركام، انها تقتل السلطة ذاتها، عوقب برميثيوس، ولهذا يبدأ المقطع بالتشكيك “كما لو”، هل يسمح لنا أن نتعلم ان نستنستخ سلطة السلطة ذاتها وأداتها التي تحافظ على نفسها بالغموض، على إخفاء الأشياء، حتى تعيش بالتأويل.
لا بد أن يظل النص ملغزا حتى يعيش. النص الذي ليس صورة طبعا، إنه إذا صار صورة مات لأن الصورة تقدم إحالة إلى تفسيرها وتحمل معها مرجعها، لكنه النص الذي يتحول إلى سينما أو مسرح إذ يمكنه أن يستشرف أو أن يتحول إلى فهم لحركة القادم أيضا.
إن تفسير النص يقتله كما يقتله إنشاؤه كصورة عن الواقع.
الحكمة، بهذا المعنى، فكرة الحكمة، في هذا النص الشعري مرعبة، إنها مادة تالفة، فلا حكمة جاهزة في الشعر ولا حكمة يقدمها النص الذي ليس صورة لقارئ اعتاد عبادة الصور بالطقوس والتعاويذ والتلاوات الفارغة، تقع الحكمة خارج الشعر، هي الأحضنة التي تتعلم المشي باتساق وبحركة وسرعة واحدة، لكنها في النهاية “تجر عربة واحدة” وهنا نعود مرة لعبقرية الميديوم لدى دوبريه وفكرة وهم الاتصال والمعرفة وتعدد الوسائط، وبهذا تصبح الحقيقة أيضا تالفة “الحقيقة كلب لا ينبح لكنه يصيبي بالصداع” وهذه إعادة إنتاج لعبقرية لحكاية شلال الإمبراطور في افتتاحية حياة الصورة وموتها لدوبريه.
يتجاوز اللوح في النص الشعري فكرته المباشرة، إلى بعده الرمزي كبنية كبرى ويحمل فكرة ماركسية رغم فوكويته العالية من خلال إعادة تعيين بنى الإنتاج ويحيل إلى جدليات التوستير حول المدرسة والكنيسة وهي الأطروحة التي لم يكملها وعاد إلى أحضان ماركسيته، وإلى نفس الفكرة تحيل “السماء لا تتوقف” و”الأثر غير القابل للمحو”، وبالتالي تصبح أي معرفة خارج التعاليم والسلطات إما شعرا أو جنونا أو إنها تصبح استعراضا وممارسات هجينة تتحكم بالجسد وتفرض عليه قراءات جديدة للمفاهيم من خلال السماح له بالتعبير لكن بشكل غير مقاوم، عبثي، يسمح لجسد التابع بالحديث الذي لا ينتهي إلى أثر، كما يقول ميمبي، التعبير الذي ليس تصنيفا بل اعادة انتاج مادي للبنى الفوقية، بهذا تمسخ الأشكال المعرفية إلى مجرد استعراضات في مجتمعات للاستعراض والفرجة كما يقول ديبور وتصبح الخطابات العابا لغوية كما أسس لها فنجشتاين حيث تبدو في الظاهر أشكالا للتعبير لكنها في الواقع امتداد للقمع السلطوي كما يقول ليوتار.
تصبح “اللغة انتهاء” ما يؤكد على فكرة إننا محكومون للمواثيق اللغوية، إنها هي التي تحكم، أن اللغة تلتهم الواقع وهنا اشتغلت فكرة الاتصال في استخدام النص الشعري لفكرة “تابوهات اللغة” وفكرة “الميراث”.
إن من يمتلك القدرة على التصنيف، يمتلك الحقيقة دائما وبالتالي السلطة، لهذا يقول النص “لو كان للحُفَر اسماء”، إذا إننا لا نمتلك سلطة التسمية إلا من خلال الشعر أو الجنون وهنا يؤمئ النص إلى عبقرية التصنيف كسلطة.
إن التسمية الوحيدة التي نقدر عليها في ان نعلق أما في أفق الانتظار أو أفق الحنين، اشتغل النص الشعري على فكرة المصيدة هذه، والتي تحيل إلى العبقري ميرلوبونتي في ظاهراتية الجسد.
هذه بعض الاشتغالات الفلسفية لنص قد يكون أريد له أن ياتي سلسا وعفويا، فهل يبدو كذلك الآن؟
مرفق النص الأصلي:
يابس هذا الوقت
ممتليء بالردم والأحجار
كثير كالأصداف
شفاف
مائل ومسحور ومحاط بالآيات
مسور بالرقى والحكايات
نسميه الانتظار اعتباطا
لأنه كل شيء:
الأحجار، الطريق، الأشجار، مقاعد الحديقة،
كرة الولد، ضفيرة البنت،
نار المواقد المعدة للشواء
القرابين في الحكايا
حمالوا البضائع في الموانئ
المرافيء
السرير، الستائر، السر
والجسد المطفي كالسجائر
في الفراغ.
لست وحدي تماما
ولست معك.
ادخل إلى قبعة الساحر
أقول أحيانا إنني سأتحول إلى طائر
لكنني أستعصيت على السحر
ثم أقول – ورغم إنني لم أعد أكترث،
إن التجارب تعلمنا كم مرة يمكننا الفشل.
أيها الحب الذي لم يقفز معي
الذي لم يرغب بأن يتحول إلى طائر
الذي لم أقفز فيه لأنه ليس قبعة
الذي لم يعدني بشيء،
يمكننا أن نلتقي في أكثر الأمكنة غرابة
ونلتقط “سيلفي”
ثم نتلقى الإعجابات بفرح مصطنع
ونقتسمها مناصفة
كأنها ميراث .. أو لنقل إنها كذلك
ما دمنا لا نجد شيئا إخر نقتسمه،
ما دمت أدعي أنني حقيقة
وأنك الظلال.
ارْتَفِعُ بالحب عن الحب.
أعلق جسدي
وأنتظر أن يجف
السماء لا تتوقف
ولا يمشي الانتظار.
لا تعرف الساحرات كيف يعدن الرجفة الأولى
ولا الدهشة
ولا أنا،
يتركن في جذوع الأشجار التعاويذ
يبدأن حين ينتهي الحب
أو حين يوشك أن يبدأ
مع فرق في النوايا.
لا فرق،
لا حاجة للامتلاء،
أظل طازجة كما لو أنني قتلت نفسي للتو
كما لو أنني تمكنت من إخفاء الأمر
كأنني مسحت لوح الحب
الذي لم يكن أكثر من ليل يدخل الحياة من باب مدرسة
ينظر إل التلاميذ الذين يكتب عليهم الوقت
بأثر غير قابل للمحو
ما فسد.
لم يكن في الأمر حكمة أبدا
هكذا تبدأ الحكايا
هكذا تنتهي
عاصفة
ثم
تخمد.
للحكمة منطق أحصنة العربات
التي تتعلم السير باتساق
في ذات الوقت
بسرعة
بجدية مطلقة
لكنها لا تجر في المحصلة
سوى عربة واحدة.
كم يمكن أن نعيش هذه الحياة الافتراضية
قبل أن تنقطع الكهرباء.
الحقيقة كلب لا ينبح
لكن عواءه يصيبني بالصداع.
أول الأشياء آخرها
لغتي انتهاء.
لو كان للحفر أسماء،
لو كان لها ذاكرة،
كنا نناديها
كانت تقفز فينا
كنا نسميها أسماء الخيبات والطرقات والتمكنة
التي لا نستطيع أن نشتمها.
لو كانت اللغة تابوهات فقط
هل كان سيُغفر لي إنني أردد هذه الكلمة:
الحب.