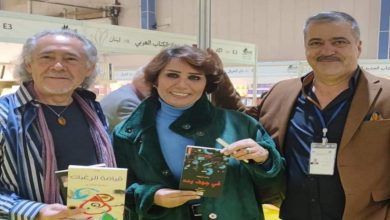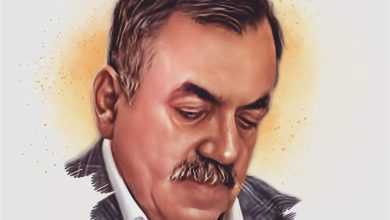الدكتور طالب الأحمد وجهًا لوجه مع علي جبار عطية

عالم الثقافة| بغداد
تصوير : صالح البهادلي
الدكتور طالب الأحمد:
الأدب العراقي الحقيقي الناضج كُتب في المهجر
الإعلام الحكومي يجب أن يطور أدواته ويكون مهنيًا وحرفيًا ويتحلى بالمصداقية
الفن التشكيلي ازدهر عندنا لأنَّ السلطة لا تستطيع أن تحاسب الفنان على استخدام الرمزية !

الحوار مع الدكتور طالب الأحمد شائق، وممتع لأنَّه يشدك بطروحاته الناضجة، وتحليلاته العميقة، وحسه الوطني العالي، وهو متفائل بمستقبل العراق الناهض من رماد الحروب والحصار والدكتاتورية الدموية، ويؤكد أهمية الثقافة بوصفها ماء الحياة، وأنَّ الصحافة لن تموت ولكنَّها تتحول إلى أشكال أخرى…هو كاتب وصحفي، وخبير إعلامي ومحلل سياسي بارز،فضلًا عن تخصصه العلمي في علم الاجتماع، ومن جيل القراءة والشغف المعرفي، ويراهن على بقاء الكلمة مهما تمددت الصحافة الرقمية مع إقراره بتقبل المجتمع الافتراضي الذي أصبح يوازي المجتمع الواقعي… عُرف الأحمد بنشاطه في تحليل الشؤون السياسية والاجتماعية في العراق، وظهوره في القنوات الفضائية، وطرحه القضايا السياسية بموضوعية وصراحة نادرة،وهو باحث في الأنثروبولوجيا السياسية،وتلميذ نجيب لأساتذة علم الاجتماع علي الوردي، وقيس النوري، وغيرهما، وله مشاركات مستمرة في ورش تدريب الكوادر الإعلامية،كما أكسبه عمله مراسلًا تلفزيونيًا في عددٍ من القنوات الفضائية خبرةً ميدانيةً فضلًا عن خبرته في الصحافة المكتوبة، وله في الأدب نصيب إذ بدأ حياته كاتبًا للقصة القصيرة، وحين أصدر روايته الأولى (مرايا الغرام) كشف عن مهارةٍ سرديةٍ لافتةٍ…يشغل حاليًا منصب المستشار في فريق الإعلام الحكومي في مكتب رئيس مجلس الوزراء ، وعلى هامش إحدى الورش التي يحاضر فيها التقيتُ الدكتور طالب الأحمد في مبنى هيأة السياحة بشارع حيفا في بغداد ضحى يومٍ صيفي فأعادني اللقاء به إلى زمن البحث عن المعرفة، واقتفاء الدليل إلى النور .. وإلى الحوار
تشكل البدايات ملامح المسيرة المهنية فما العوامل التي حددت توجهك الإعلامي؟
ـ لقد انجذبت إلى الصحافة من ميدان الأدب فكنت أبدأ بقراءة الجريدة أو المجلة التي تقع بيدي من الصفحة الثقافية، وأقرأ القصص القصيرة وما يكتبه الأدباء والكتاب ونشاطات الفنانين، وكان هذا أول ما جذبني في عالم الفن والثقافة بصورة عامة، وبدأت من الطفولة مع صحافة الأطفال، ولاسيما مع (مجلتي والمزمار)، وظهرت لي مواد في صحيفة (المزمار) فكانت مرحلة تشكيل الوعي، ثمَّ غامرت فأصدرت مجلةً ثقافيةً بمفردي، واستخدمت ألوان الماجك في الرسوم وهذا كان في المرحلة المتوسطة، وقد اطلع وكيل وزارة الثقافة والإعلام وقتئذ الدكتور زكي محمد الجابر على حوارٍ أجريته فوصفني بأنَّني أصغر صحفي عراقي !
كان في تصوري أنَّ الكاتب يمكنه أن يسهم في إصلاح المجتمع، وكنت مهمومًا في ذلك الوقت بهموم الناس ، وأدرك أهمية الحرية للكاتب، ووجدت الأدب الروسي أقرب إلى نفسي لأنَّه كان يعبر عن هموم الناس فقرأت لديستوفسكي، ومكسيم غوركي، وتشيخوف، وغيرهم فوجدت في كتاباتهم شحناتٍ إنسانيةً، والأدب الروسي عمومًا الأقرب إلى أجوائنا فكان ذلك حافزًا إلى دراسة الأدب أكاديميًا لكنَّي في الجامعة لم أجد تخصصًا دقيقًا يدرس الأدب، وكنت أتمنى دراسة الفنون لكنَّ القبول في أكاديمية الفنون كان مقتصرًا على البعثيين (قبول خاص) ،ولم يكن مطروحًا في قناة القبول العام،كذلك القبول في قسم الإعلام، وأنا لم أكن منتميًا لحزب البعث، ولم يكن أمامي خيار سوى أن أذهب إلى كلية الآداب، وأدرس في قسم علم الاجتماع، وقد اخترته لتأثري الشديد بكتابات عالم الاجتماع الدكتور علي الوردي الذي كان شاغل الناس في وقتها كما هو شاغلهم لحد الآن، كنت معجبًا بأسلوبه والتقاطاته الاجتماعية، وكانت أمنيتي أن أحذو حذوه.في ذلك الوقت كان علي الوردي أستاذًا متمرسًا، وكان قريبًا من سن التقاعد.
*برأيكم لماذا لم يظهر في المجتمع العراقي علماء اجتماع بمستوى علي الوردي؟
ـ بل يوجد لدينا علماء بمستوى علي الوردي كالدكتور قيس النوري، والدكتور معن خليل العمر، وهناك أسماء كبيرة وتلامذة نجباء كالدكتور كامل جاسم المراياتي، والدكتور فالح عبد الجبار
وأرى المفكر الدكتور عبد الجبار الرفاعي أيقونة الفكر الإسلامي المعاصر،كذلك الدكتور متعب مناف السامرائي الذي لا يقل أهميةً عن علي الوردي، لكن الذي ميَّز علي الوردي هو اندكاكه مع الناس فكان يعيش معهم ويتنقل بالسيارات العامة فليست له سيارة خاصة، ويلتقي بالناس في المقاهي، وهذا هو عالم الاجتماع الحقيقي، وهو متفرد في لغته لا يستطيع أن يكتب مثلها غيره فهو يكتب أشبه بالرواية الشائقة مع أنَّ لغته علمية في الوقت نفسه.
* ما أبرز التحولات التي رصدتموها في المجتمع العراقي؟
ـ المجتمع العراقي يعاني من ظاهرة ما زالت تلازمه، وهي صفة الازدواجية بين الكلام والواقع.
*أليست هذه الظاهرة موجودة في المجتمعات الأخرى ؟
ـ نعم في بعض المجتمعات التي عشت فيها تكون الازدواجية أكثر، وهي موجودة في كل المجتمعات لكن بمستويات ولكن عند العراقيين تكون أكثر حدة لتطلعهم للمثل بحكم ثقافتهم الدينية، وتمسكهم برموز فهم يريدون حاكمًا يجسد التعاليم النبوية والعدالة الإلهية، وهي نقطة إيجابية في المجتمع العراقي لو استثمرت.
*هل ازدادت هذه الظاهرة بعد سنة ٢٠٠٣م؟
ـ نعم؛ لأنَّ العراقيين أتيح لهم السفر وشاهدوا مجتمعات أفضل، وأخذوا يقارنون بين ما يجدونه في بلدهم وما يرونه في تلك البلدان، وهي مقارنات وأسئلة تدل على الوعي والروح الثورية، ولن يستطيع أن يقمعها أي حاكم.
*هناك مَنْ يصف الحقبة التي عشناها في السبعينيات وما تلاها بالزمن الجميل فماذا تقول؟
ـ ذلك الزمن غير جميل بالمرة، فهو زمن الدكتاتورية، وزمن القمع.
ولا يستطيع الشخص أن يقول كل شيء، وكان توجه الدولة أن يتكلم الإنسان عن التقدم والتطور يعني الدعاية للسلطة ، وكانت الجامعات ملغومةً بعناصر المخابرات، والموضوع الديني لا يذكر أبدًا، وكانت أجواء الحرب العراقية الإيرانية تلقي بظلالها على الأوضاع.
وكان لي صديقان أحدهما من البصرة واسمه (فؤاد) والثاني من الموصل ويُدعى (وعد) ، وكانت علاقتي بهما طيبهً، وفي أحد دروس الصف الأول من قسم الاجتماع، كانا يتحاوران بشأن رؤية ماركس للمجتمعات في درس يتناول نظرية ماركس، وقد دافعا عن التغيير الاجتماعي عند ماركس ، أتدري أنَّ هذا النقاش أدى إلى اعتقالهما وإدانتهما وإعدامهما ! تصور مدى الظلم.. فمجرد نقاش أدى إلى إعدامهما، وهو شيء مؤلم للغاية. وقد شكل اعتقالهما ثمَّ إعدامهما صدمةً كبيرةً لي في بداية شبابي وكنتُ أرى الدنيا لوحةً زاهية الألوان.
للأسف وأقولها بمرارة : إنَّني لم أعش حياةً جامعيةً كما ينبغي أن تكون، وقد جئت باندفاع، وكنت أتوقع في الجامعة أن تفتح لي آفاقًا أوسع فإذا الأجواء كانت خانقةً، وقد اضطر الأساتذة إلى الهرب خارج البلد، لكن بالقدر المتيسر كنا نقرأ وكانت القراءة ملاذي لكن الكتابات لا يمكن أن تنشر؛ لأنَّ كل شيء كان مسخرًا للحرب، وقادسية صدام وإلى آخره فلم أستطع أن أعبر عن رأيي بالحرب خوفًا من القتل، والفنانون والأدباء كانت لهم مواقف سلبية من النظام والحرب فكانوا يلجأون إلى الرمزية لاسيما في الفن التشكيلي، وقد ازدهر عندنا الفن التشكيلي وتحديدًا الفن التجريدي؛ لأنَّ السلطة لا تستطيع أن تحاسب الفنان على استخدام اللون والإيماءة. كذلك كان الكاتب أوالشاعر يلجأ إلى الرمزية والسريالية، وأنا كنت أميل إلى المدرسة الواقعية التي لم تزدهر في تلك الفترة، وكانت قراءاتي للأدب الروسي والغربي للكتاب الذين يمثلون الضمير الغربي ضد الحرب مثل : ريمارك وهنري ميلر، واضطررنا بعد التخرج إلى الهجرة لاشتداد القمع، وكنت من ضمن الذين هاجروا نهاية الثمانينيات، وبداية التسعينيات فنشأ أدب المهجر، وأرى أنَّ الأدب الذي كتب في المهجر هو الأدب العراقي الحقيقي الناضج الذي فيه نزعة إنسانية عالية، وهو الأدب الراقي الذي يستحق أن يعطى أرقى الجوائز، مع وجود أسماء كبيرة بقيت في العراق لكنَّها لم تستطع أن تكتب كما تريد أو كما تتمنى عن الوضع فاضطرت إلى أن تمالىء السلطة بشكل أو بآخر، أو تتوارى خلف الرمزيات لكنَّ كبار الأدباء كانوا خارج العراق كالبياتي الذي احتفظ له بأجمل الذكريات في حياتي، وقد التقيت به قبل وفاته ببضعة أشهر، كذلك الجواهري الكبير ، ومظفر النواب، وعدنان الصائغ، وعبد الرزاق الربيعي، وغيرهم، وعلى مستوى الروائيين نتوقف عند الدكتور محسن الرملي الذي كتب روايته الشهيرة (حدائق الرئيس) التي أعدها أيقونة الرواية العراقية أو الفن الروائي العراقي التي تستحق عن جدارة جائزة البوكر لكن لأسباب سياسية أو غيرها ربما لم تمنح الجائزة.
*كيف ترى الأوضاع بعد التغيير النيساني سنة ٢٠٠٣م؟
ـ بعد سنة ٢٠٠٣ م رجعت الطيور المهاجرة إلى البلد، وأنا من ضمنهم، وصدمنا من أحوال بلدنا الذي كان من المؤمل أن يستعيد عافيته الثقافية، وعلى أكثر من صعيد لكننا نقدر الظروف الموضوعية التي يمر بها البلد، ويبقى الأدب والفن والرواية والقصة والفن التشكيلي، وكل أشكال التعبير أعدها هي أداة توثيق للمجتمع وبوصفي دارسًا لعلم الاجتماع أعد الأدب وكل نص أدبي هو وثيقة اجتماعية فالمجتمع المصري في الخمسينيات والستينيات لا يمكن فهمه إلا من خلال روايات نجيب محفوظ الذي دخل في عمق الحارة المصرية ويصور الحياة الاجتماعية وكيف عاش الناس فالأدب يعطيك فكرة عن تلك الحياة .
*ألا ترى أنَّه حتى في العاطفة يمكن التعرف عليها من خلال روايات عبد الحليم عبد الله أو يوسف إدريس ؟
ـ بالضبط.. حتى الخيال له جذر اجتماعي بشكل أو بآخر وهو انعكاس للواقع الاجتماعي فكل نص أو لوحة أو نتاج أدبي هو بشكل أو بآخر إذا حلله المتخصص بعلم الاجتماع في الأدب أو الفن يجد له أثرًا اجتماعيًا، فالنصوص الأدبية والفنية هي بمثابة وثائق وأدوات تكشف لنا الطبيعة الاجتماعية .
* كيف تنظر إلى الماضي بعد هذه التجربة الحياتية والمسيرة المهنية ؟
ـ أنظر إلى الماضي بغضب، وأريد أن أتجاوزه فجيلنا عاش الألم، أنا من مواليد ١٩٦٢م ، كنت أعشق الرسم وكانت الدنيا تبدو لي كلوحة زاهية الألوان، لكن للأسف فقد قتلت الديكتاتورية أحلامنا ووأدت تطلعاتنا.
لقد عاش جيلي في أسوأ الأزمنة وأصعبها.
لم يكن ماضينا ماضيًا جميلًا، بل كان ماضيًا مؤلمًا، لقد عشنا الحروب والقمع والدكتاتورية ، وقتل الكلمة الحرة، وفقدنا الكثير من أحبابنا واصدقائنا ومعارفنا وكما ذكرت لك فقد أعدم اثنان من أصدقائي لمجرد نقاش، فكيف أنظر إلى الماضي.. نعم هناك أشياء جميلة في الطفولة، وفي مرحلة الصبا، وفي الابتدائية، ولكن للأسف الديكتاتورية قتلت أحلامنا.. إنَّني أنظر إلى الماضي بغضب، وأتمنى أن أتجاوزه بل كل العراق ينبغي ألا ينظر إلى الخلف، وإنَّما ينظر إلى الأمام وكما يقول كاتب بريطاني: (أنظر إلى الخلف بغضب) يعني أتجاوز الماضي ومن الصعب أن يتخلص المرء من الماضي؛ لأنَّ فيه طفولته وذكرياته التي عاشها ومن تجربتي في الحياة أنَّ الإنسان ينبغي ألا يأسى على ما فاته كما يأمرنا القرآن الكريم : (لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم) .
*هذا يشجعني على سؤالك عن روايتك (مرايا الغرام) الصادرة عن دار ضفاف للنشر / ٢٠٢٢ م، فهل يمكن القول : إنَّ سيرتك الشخصية موجودة في هذه الرواية بشكل أو بآخر ؟
ـ (مرايا الغرام) هي روايتي الأولى وقبلها نشرت قصصًا قصيرةً.
عندما يكتب الروائي روايته الأولى عادةً لا إراديًا يكتب عن نفسه، ورواية (مرايا الغرام) هي عن تجربتي في البلد، وحياتي في المهجر وبعد العودة إلى العراق بعد صدمة الاحتلال سنة ٢٠٠٣ م، وقد عكست التناقض الذي عاشه البطل (جواد عبد الكريم) ، وعشته ما بين الفرحة بزوال الدكتاتورية والحزن على ما أصبح عليه البلد بعد الاحتلال.
كانت المشاعر متناقضةً، وكثير من الناس يشعرون بذلك، وروايتي كانت تعبر عن هذا التناقض ما بين الفرح والحزن واليأس والأمل والإحباط والتطلع إلى غد أفضل..لقد وصف البطل جواد عبد الكريم الحرائق سنة ٢٠٠٣ م، وأنَّه وجد الرماد في الشوارع، ويتساءل : (هل تنبثق العنقاء من هذا الرماد، وهل يستعيد البلد عافيته)، وتركت النهاية مفتوحةً، وهي كذلك مفتوحة، وتجربتنا الآن أفضل وأنضج، والعراقيون يتطلعون للأفضل، وعندهم كبرياء فهم وريثو حضارة عريقة أقدم من الحضارة المصرية في بناء الحضارة الإنسانية لذا فالعراقي كثير التطلع، ويبحث عن المُثل لأنَّه من البلد الذي علم البشرية الحضارة والقوانين، وسقف تطلعاته مرتفع فلا يرضى عن الحاكم، ويندر أن يرضى العراقيون عن أي حاكم ومثلهم الأعلى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وهناك صراع بين الحاكم والمحكوم وهو صراع سياسي يكاد يكون سمةً طاغيةً على العراقيين، وهناك قمع وحشي في العراق؛ لأنَّ الناس لديهم نزعة ثورية، وأعد المجتمع العراقي تقليديًا يبذر بذور الثورة في نفوس أبنائه منذ الطفولة فالطفل يتعلم ويتطلع إلى أن يكون الأب والمعلم مثاليًا، وينتقد أي خطأ، وعنده عين ثاقبة يلتقط أبسط خطأ، ومن الصعب إرضاؤه، وهذا يزيد من معاناة العراقيين الذين عليهم أن يتحلوا بالنظرة الواقعية، وأن يكون سقف التوقعات واقعيًا لأنَّ الصراعات السياسية تركت آثارها على المجتمع.
*عملتم في الميدان مراسلًا تلفزيونيًا في سنوات صراع حرجة بعد سنة ٢٠٠٣م فكيف تقيّمون هذه التجربة وما أبرز التحديات التي كنتم تواجهونها؟
ـ كانت هذه أول تجربة لي لأنَّي عملت في مجال الصحافة المكتوبة في كبريات الصحف كجريدة (الأنباء) الكويتية، وجريدة (الشروق) القطرية، ومجلة (الشرق) الإماراتية، ومجلة (المجلة) اللندنية، ومجلة (الأهرام) العربية، فضلًا عن الصحف المعارضة قبل سنة ٢٠٠٣م وحين بدأ عصر الفضائيات صار العراق ساحةً خصبةً ومرغوبةً من قبل كل فضائيات العالم وكانت قنوات (الجزيرة) و(العربية) ، و(العالم) تتنافس في الحصول على السبق الصحفي.
عملت مدةً قصيرةً في قناة (الجزيرة) ثمَّ انتقلت إلى قناة (العالم) ، وكانت تجربتي في قناة (العالم) تجربةً مهمةً فيها هامش أوسع من حرية التعبير. كانت القناة تنقل إلى المشاهد العربي ما يجري، ولم تكن إدارة القناة تفرض علينا أية قيود، فكنا نتكلم براحتنا أنا مع زملائي الكبار المراسلين الدكتور محمد الكاظم، وجواد علي كسار، وسامي حسن، والراحل جبار حاتمي الذي كان مدير المكتب فكان يعطينا الحرية، وكان كاميرته مفتوحة، وحققنا في ذلك الوقت تفوقًا حتى على قناتي (الجزيرة)، و(العربية) في المتابعة، بل حتى على قناة (المنار)؛ لأنَّنا كنا نرصد ما لا يرصده الآخرون، وكنَّا محتكين مع الناس، وقد اخترت
من تقاريري عشرة تقارير وبثثتها على اليوتيوب بعنوان (العراق في حقبة الاحتلال الأمريكي)، وكنت أنقل آراء الناس كما هي : مَنْ هوَ مع الاحتلال أو ضد الاحتلال، ومَنْ يرغب بالتغيير بكل مشاعرهم المتناقضة.
*ما رأيكم بمن يرى انحسار أهمية الثقافة في زمن السوشيال ميديا؟
ـ إنَّ الثقافة أساسية ، وفي كل الدول التي لها حضور قوي فإنَّما خلقته بالحضور الثقافي فمصر انتصرت بالثقافة، وليس بالناصرية، وكذلك أمريكا صنعت لها صورةً قويةً بالإعلام والأفلام السينمائية ، وهناك دول أغنى من فرنسا اقتصاديًا، لكنَّ فرنسا أكثر منها حضورًا بقوة الثقافة.
إنَّنا في العراق أقوياء في الفن التشكيلي، وأنَّ أكبر المهندسين المعماريين من العراق، وكذلك أكبر الشعراء، وعندنا منجم ثقافي بل حتى الغزاة يستوعبهم العراق، فالمغول استوعبتهم بغداد، وذابوا فيها بتأثير قوة الثقافة العراقية.
إنَّ الثقافة هي ما يبقى في الذاكرة عندما يتحطم كل شيء، وثقافتنا هي وجودنا، ورأس مالنا في العراق.
*بودي معرفة رأيكم.. هل هناك إعلام موضوعي أو محايد؟
ـ بصورة عامة، في كل بلدان العالم من أمريكا التي تعد نفسها الأرقى إلى أي بلد آخر لا يوجد إعلام محايد في كل أصقاع الأرض، وانَّما هناك إعلام ذكي، وهذا الإعلام يعرف كيف يغطي على أجندته وأن يبدو حياديًا أو حرفيًا أمام الجمهور والحرفية هي بحد ذاتها تعني أنَّك تنقل تقريرًا أو مادةً إعلاميةً للمتلقي تبدو فيها أنَّك محايد لكن في ثنايا هذه المادة الإعلامية يمكنك أن تطرح وجهه نظرك فأحيانًا تطرحها بصورةٍ غير مباشرة مثلًا تريد أن تعمل تقريرًا عن رضا الناس عن الحكومة العراقية فيلتقي المراسل بأناس كثيرين، لكن في المونتاج ينتقي الناس الذين انتقدوا، وحينما يظهر التقرير لا يبدو رأي المراسل فيه، ويبدو التقرير حياديًا لكن المراسل أصلًا وظَّف هذا التقرير لرأيه ، وقال بصورة غير مباشرة أنَّ الناس غير راضيةٍ عن الحكومة، ولو كان عنده موقف آخر يغير المونتاج،كذلك الصحيفة تعمل الشيء نفسه فالإعلام الذكي ينقل رسالته بصورة غير مباشرة.
*هل ينطبق الحال هذا على الإعلام الحكومي؟
ـ في الإعلام الحكومي يكون ذلك صعبًا على اعتبار أنَّ هناك خطًا واضحًا وتوجهًا واضحًا لدعم الحكومة، وتعزيز ثقتها مع المواطن، وألفت نظرك على هذه النقطة، وأشكرك على إثارتها أنَّ الإعلام الحكومي ينبغي أن يكون صادقًا على الدوام حتى يكسب الناس وإذا لم يكن صادقًا فإنَّ الناس سيبحثون عن مصدر آخر يستقون منه الأخبار، ويكون موقفهم سلبيًا ليس من الإعلام الحكومي فحسب، وإنَّما حتى من الحكومة، ومثال ذلك عندما يحدث انفجار أو حدث ما في منطقة فالإعلام الحكومي إذا قال : لم يحدث شيء، وهناك دعايات وتضخيم، فإنَّ الناس لن تتابعه، وعليه أن يكون أكثر صدقًا، ويقول : نعم حدثت هذه المشكلة أو الحدث، ويوجد عمل كذا لعلاج هذه الحالة.
*هل يمكن لإعلام السلطة أن يكون إعلام دولة؟
ـ إعلام السلطة لا يختلف كثيرًا عن إعلام الدولة فكلاهما يعملان لأجل استقرار السلطة واستقرار الدولة، وأنَّ مهمه هذا الإعلام أن يجسّر العلاقة بين السلطة والناس، وبين الدولة والناس ومن ثمَّ يهتم بالآليات نفسها وأهمها الصدق وأؤكد على الصدق وهو عنوان الإعلام الحكومي، ومن دون المصداقية يفقد الإعلام الحكومي أهميته وأيضًا الحرفية وهناك الكثير من الزملاء الإعلاميين عندما يعملون في ميدان حكومي لا يطورون أدواتهم الصحفية بذريعة أنَّه إعلام حكومي مجرد، يكتب لصالح المسؤول أو الوزير أو رئيس الوزراء. إنَّ الإعلام الحكومي يجب أن يكون مع الناس، ووسط الجماهير حتى يستفيد المسؤول منه، ويعرف ماذا يريد الناس، وهل حقق إنجازًا بمستوى الرضا عن هذا الإنجاز ، واذا لم يحقق الإنجاز ماذا عليه أن يعمل بل يستفيد من ذلك أعضاء مجلس النواب ، ويعرفون مستوى رضا الناس عنهم وعن أدائهم.
وإذا لم يتحقق ذلك في الإعلام الحكومي فمعنى هذا يترك المجال لغيره الذي له أجندة معينة ، فكل الإعلام الآخر عنده أجندة سياسية، أو تابع لدولة أخرى ، ولهذا أؤكد يجب أنَّ تتوفر في الإعلام الحكومي ثلاثة أشياء : يجب أن يطور أدواته، ويكون مهنيًا وحرفيًا، ويتحلى بالمصداقية، وعليه أن يقنع المتلقي ليس بمعنى يجمّل الواقع بل يقنعه بأنَّه إعلام صادق.
إنَّ الصحافة سلطة، وما تزال الناس تثق بالإعلامي لا بالسياسي فالإعلامي ينقل معاناة الناس.
مثلًا أعطيك مثالًا : شائعة تسرب أسئلة الامتحانات، فعلى الإعلام الحكومي أن يصدر بيانًا، ويوضح ذلك بلغة الأرقام واللغة الواقعية ، وإنْ حصلت يبيّن ذلك، فيعزز ثقة المتلقي به، فلا يسمع الأخبار من قناة خارج الإعلام الحكومي،ويجب على الإعلامي أن يتبع أسلوبًا غير تقليدي، ويمكن أن تتكلم صورة واحدة عن الحدث أفضل من ألف صفحة.
*تركزون في أطروحاتكم على أهمية الصورة في الرسالة الإعلامية فهل بقيت لها تلك الأهمية مع تطور الذكاء الاصطناعي والتزييف؟
ـ الذكاء الاصطناعي وبرامج التزييف تمثل تحديًا كبيرًا وخطيرًا في الإعلام، بل حتى قبل الذكاء الاصطناعي كانت هناك تقنيات معينة تغير الصورة والصوت،أو تركّب الصوت على صورة أخرى، وقد شكلت هذه التقنيات الحديثة تحديًا كبيرًا أمام الصحفي لاسيما مع استغلال الكثير من المؤسسات، وأجهزة المخابرات لتلك التقنيات، وعلى الصحفي مواجهة ذلك .
*في رأيك، هل سهّلت الثورة الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي وصول المعلومة إلى المتلقي كما يسميها الدكتور كاظم المقدادي بـ (السلطة الخامسة ـ سلطة الرأي العام) التي أخذت تنغص على السلطة الرسمية احتكار الإعلام أم أنَّها شوشت على المواطن وصول المعلومة الحقيقية؟
ـ واللهِ تعبير جميل من الدكتور كاظم المقدادي بشأن سلطة الرأي العام.
إنَّ الاعلام يعد سلطةً ولكن في أحيان كثيرة تكون هذه السلطة سلطة الوهم، وإنَّ كثيرًا من الأشياء غير الحقيقية يتم قولبتها في هذه الأدوات لتبدو وكأنَّها حقيقية، ومن ثمَّ يتأثر المتلقي ويحصل التظليل أو التشويش والكثير مما يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي يعد من التشويش.
إنَّ هذا المجتمع الافتراضي أصبح قدرنا فنحن نقضي أغلب أوقاتنا في المجتمع الافتراضي أكثر مما نقضيه مع أصدقائنا فأصبح المجتمع الافتراضي يوازي المجتمع الواقعي ونحنُ نلتقي مع أصدقائنا في العالم الافتراضي أكثر مما نلتقي مع أبنائنا وأصدقائنا في البيت أو المقهى أو المنتدى ، هذا هو الواقع ويجب أن نتعايش معه لكن نكون حذرين ونتجنب المزالق الموجودة فيه.
*ما الذي يبقى للصحفي الكلاسيكي وسط الانفجار الإلكتروني الكبير؟
ـ لا يمكن لأي صحفي في عالم السوشيال ميديا أن يكون صحفيًا ناجحًا أو إعلاميًا ناجحًا إنْ لم يكن متحليًا بالقواعد التقليدية الموجودة في الصحافة الورقية لأنَّها هي الأساس، وهي التي تصنع الصحفي الحقيقي، وهذه الأسس هي التي تعلمناها في الصحف الورقية، ولهذا نرى أنَّ الذين نجحوا في العالم الصحافة الإلكترونية هم الأسماء نفسها التي نجحت في الصحافة الورقية مثل جهاد الخازن في صحيفة (الحياة) وله متابعون كثيرون كذلك كل ما يكتبه كاظم المقدادي تجد له آلاف المتابعين فضلًا عن إنعام كجه جي، وخالد القشطيني.. نعم فهم أسماء كبيرة ولامعة.
*كيف يمكن للصحفي أن يكون له صوته الخاص وسط الفضاء الإعلامي المتعدد؟
ـ بالعكس الصحفي الآن يعيش التوسع والانفتاح في المجتمع والفضاء السهل والمساحة الواسعة في الفضاء الافتراضي، ويمكنه أن يكون له صوته الخاص، بل يمكن لكل إنسان أن يكون صحفيًا ناجحًا إذا أجاد اللغة، وكانت له قراءة مستمرة فالصحافة بقدر ما هي علم فهي فن والصحفي ينبغي أن يكون فنانًا في إرسال رسالته، ويجب أن يقدم مادته بأسلوب غير تقليدي، وبتشويق كما فعل الإعلامي الأمريكي اللبناني الأصل (أنتوني شديد) الذي أخذ جوائز عن تغطيته للحرب في العراق، وكانت تقاريره تنشر في (الواشنطن بوست) ، وقد تميَّز بملاقاه الناس، والسكن في فندق متواضع وقد كتب تقارير قبل حرب ٢٠٠٣م وفي أثنائها وبعدها كما كتب عن تفجير شارع المتنبي سنة ٢٠٠٦م، وشكلت كتاباته أكبر إدانة للإرهاب، ومن ذلك تقريره عن مقتل بائع الشاي في المتنبي.
ونستنتج أنَّ أهم شيء في الإعلام الثقافي أن نلتقي الناس في أماكنهم، وكذلك نحاول الخروج من النمط التقليدي للخبر.
*هل هناك تجارب إعلامية ناجحة في دول الجوار لفتت اهتمامك وتستحق الاقتداء بها ؟
ـ أرى في تجربة قطر تجربة ناجحة ومثال ذلك قناة الجزيرة أيًا كان موقف الناس منها، ويرون أنَّ لها أجندةً لكن من الناحية المهنية أعدها أيقونة الإعلام العربي ، وقد استطاعت أن تقف بجدارة في مصاف الـ(سي أن أن) والمحطات الفضائية الكبرى ، وغيرها جاءت بعدها قناة (العربية) .
في العراق عندنا قنوات مهمة ممكن أن ترقى إلى مصاف القنوات العربية والعالمية.
لقد عشت في قطر وعملت أربع عشرة سنة في الإعلام المكتوب، وتعايشت مع زملاء صحفهم جيدة وهو يعطينا رسالة أنَّ قطر استطاعت أن تواكب الصحافة وليس لها تاريخ عريق في الصحافة فالبلدان التي لها تاريخ عريق في الصحافة هي ثلاثة : مصر ولبنان والعراق، وما زالت تتنافس فيها ثلاث مدارس صحفية : المدرسة المصرية والمدرسة اللبنانية والمدرسة العراقية،
والعراق يمكن أن يقدم نموذجًا في الإعلام الفضائي أو المكتوب أو الإلكتروني.
* هل يمكن القول : إنَّ العلاقة بين الصحافة الورقية والصحافة الرقمية كالعلاقة بين الضرتين كما في التعبير العامي؟
ـ نعم الأمر يبدو كذلك وللأسف فإنَّ الزوجة الثانية انتصرت على الزوجة الأولى وأخرجتها من بيت الطاعة !