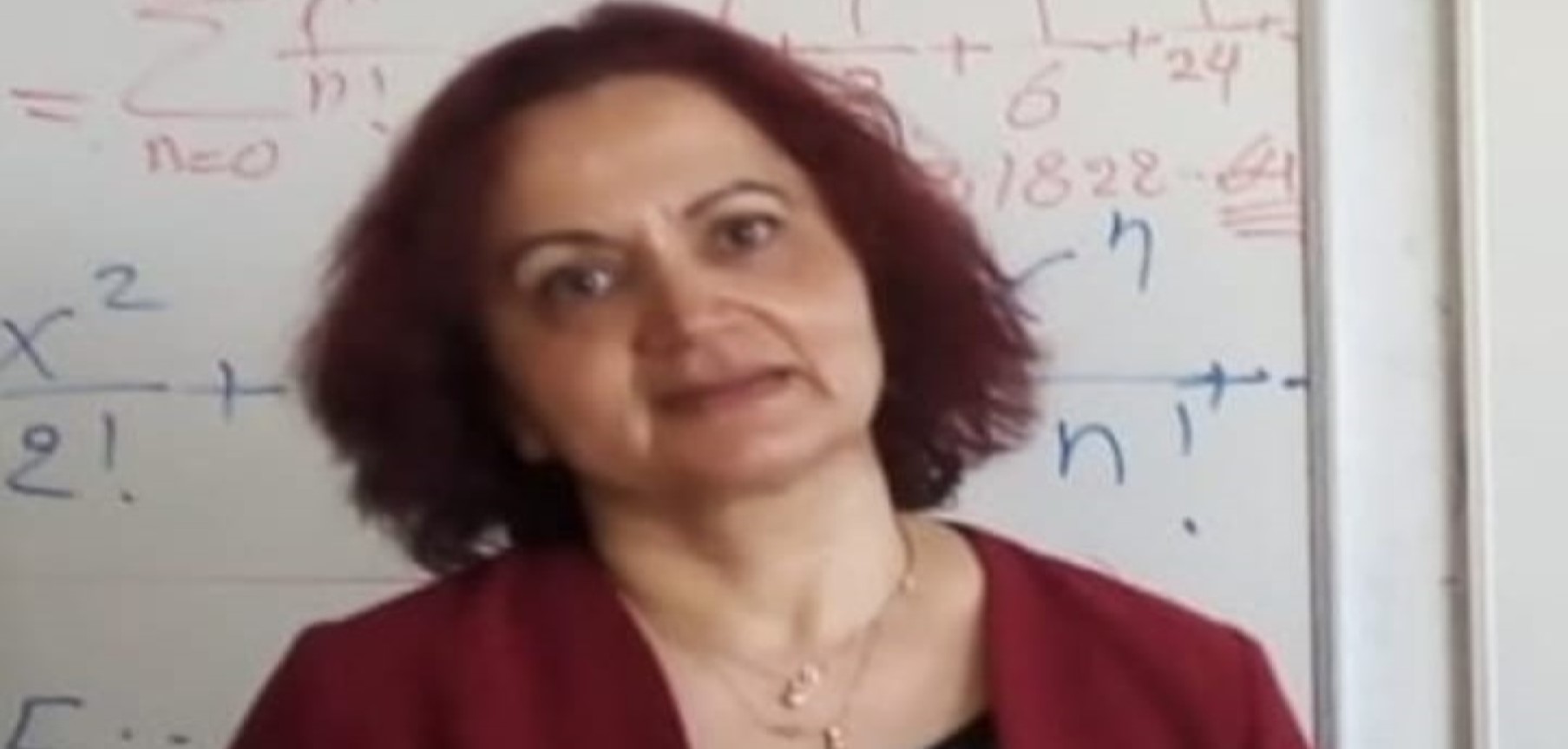د. محمد عبدالله الخولي | القاهرة
مقدمة:
إنّ قصيدة النثر الحقيقية – بمنجزها الإبداعيّ الجاد – استطاعت أن تهشم قانون الشكل الكلاسيكي، وتتجاوزه إلى غيره، حيث انوجدت قصيدة النثر خارج إطار القاعدة التي ارتكزت على الموروث الثقافي (العربي) الذي شكّل ذائقة المتلقي العربي للشعر.
ولكن، هذا التجاوز – الذي مارسته قصيدة النثر – لم يكن تجاوزا من أجل الخروج أو القطيعة مع الماضي، ولكنه الخروج الذي يقتضيه الشعر ذاته؛ فالشعر لا يحده قانون ولا يحيزه إطار الشكل، ولا يخضع لقالب بعينه، فالشعر خارجي مهمته الخروج المستمر على أيّ نظام/ شكل يحاول أن يمارس سلطته عليه، فالشعر سلطة عليا تنقهر تحتها كل السلطات، بل يهيمن الشعر – في حقيقته – على أنظمة التواصل اللغوي شريطة ألّا يخرق قانون اللغة العام، الذي تنضبط به عملية التواصل.
النص الشعري بين سلطة الموروث وتجليات الحداثة:
ظلت القصيدة العربية – ردحا طويلا من الزمن- خاضعة لسلطة الموروث، وكل تحرك ضد سلطة التراث يعد خروجا/خرقا غير مقبول لدى الذائقة العربية، بل تُهاجم كل محاولة للخروج بأقنوم قداسة التراث. لم تكن قصيدة النثر المحاولة الوحيدة للخروج من قبضة التراث إلى فضاءات الشعر المتعالية، فقد سبقتها محاولات لا حصر لها، تتغيا الخروج من قيود النظام، فقد خرج أبو العتاهية على الأسلوب المعتاد في أرجوزته “ذات الأمثال” في العصر العباسي، كما تقولب الشعر في أنظمة الموشحات الأندلسية، وتواءم مع بنيتها الإيقاعية، حيث فرضت البيئة سياقاتها وإيقاعاتها على الشعر العربي لما هاجر إليها، ولم يكن التغيير منصبا على إيقاعات الشعر – وحدها – ولكنه أثر في أدائيات التمثيل اللغوي وتشكلات المجاز في الشعر الأندلسي.
سيظل الشعر – دائما – في حالة خروج مستمر لا تنتهي، ولكن تكمن الإشكالية الحقيقية في اعتراف ذائقة التلقي – المرتهنة بالنموذج التراثي – بتجليات الشعر وأساليبه التي لا تخضع لأي نظام أو سلطة. ولذا، مارس التلقي عنفه على قصيدة النثر التي خالف نموذجها ما انبنت عليه أنظمة التلقي العربي للشعر، حيث انحصر الأخير في قيود الوزن والقافية، وقد خرجت عليهما قصيدة النثر دون تورع، وحلقت بالشعر في فضاءات بعيدة لم تكن تعهدها ذائقة المتلقي العربي.
اتسعت الهوة، بين مؤيد لقصيدة النثر ومعارض لها، وارتكزت الإشكالية على قيود الوزن والقافية، وقد أطّر لذلك “ابن قتيبة” في تعريفه للشعر وتحديد ماهيته، بينما يجعل “ابن رشيق القيرواني” للشعر أربعة محددات: الوزن، والقافية، واللفظ، والمعنى، وتسبقهم القصدية التي عبر عنها “ابن رشيق القيرواني” بــ (النية)، فمن وجهة نظر “القيرواني” أنّ الشعر – في حقيقته – لا يقف عند حدود الوزن والقافية، بل يتخطاهما إلى ما هو أعمق من ذلك: (اللفظ- المعنى)، وتشكل الشعر من ديالكتيك متصاعد بين ما هو جمالي (لفظي)، وبين المعنى (الموضوع) الذي ينبني عليه النص الشعري، فالمعنى قابع في بنية النص العميقة مغيب في عملية التخييل، وتتبدى جماليات النص الأسلوبية في عملية التشكيل اللغوي، فلم يتوقف القيرواني عند حدود الوزن والقافية كما فعل “ابن قتية”، ولكنه ارتكز على سمات بنيوية قارة في بنية النص الشعري تتجاوز حدود الوزن والقافية.
بدأ مفهوم الشعر والبحث عن ماهيته يتوسع من جيل إلى جيل، ومن عصر إلى عصر، فالشعر يستدعي – وفق تشكلاته الأسلوبية المتغايرة – تعريفات متعددة تحاول القبض على ماهية الشعر وحقيقته، ولم نستطع إلى الآن ترسيم حدود نظرية نتعرف من خلالها على الشعر بمفهومه العام، فلم يزل الشعر يتأبّى على جميع التعريفات والأطر النظرية التي تحاول تحييزه في أنماط أسلوبية بعينها. فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا نقصي قصيدة النثر عن النوع الشعري؟ ولماذا نرفض الشكل الكلاسيكي – بوسمه – غير قادر على إنجاز مهمته الجمالية؟
لا يملك أحدنا سلطة تمكنه من إقصاء نص أدبيٍّ عن نوعه، ولا يستند رفضنا – لشكل أدبيٍّ – على دعائم نظرية متحققة تمنحنا حق الرفض والقبول، فالشعر في حقيقته وجوهره خارج سلطة النظرية الأدبيّة، لأنه لا يلتزم نسقا جماليا معينا، ولا تيمة أسلوبية محددة، بل يخترق الشعر – دائمًا – كل هذه القوانين التي تحاول تحيينه في أطر أسلوبية بعينها.
لم ننتصف لقصيدة النثر بشكل موضوعي، ولكنها نظرة الاستعلاء الخطابية المتبادلة بين الجانبين، فمؤيد يمنح قصيدة النثر صكَّ الاعتراف دون مبررات منطقية تسمح بوجودها، ومعارض يرفض النص دون أن يعي حقيقة الشعر، ولكنه جعل من التراث حاكما سلطويا وأضفى عليه مسحة القداسة، ليكون أيّ خروج على سلطة التراث مروقا واستعلاءً على الماضي والهوية العربية، وهذا ما نلحظه في قول محمد علاء الدين عبد المولى، في كتابه: “وهم الحداثة – مفهومات قصيدة النثر أنموذجا”،: ” نحن لسنا قاصرين ولا أولادا في روضة العالم، بل نحن جزء من هذا العالم، فإما أن نكون الجزء الفاعل المشارك، وإما أن نرضى بأدوار الكومبارس فتختفي بذلك أصواتنا وملامحنا ونغدو بذلك موظفين في مؤسسة ضخمة أسسها الغرب، كما حدث في الواقع الذي كرسته فينا (قصيدة النثر) بكتابها ونقادها وسدنتها.”، تمثل مثل هذه الآراء انغلاقا فكريا وتعصبا دون أن ترتكز على مفهومات حقيقية أو دعائم منطقية، ولكنه الهوى الذي يجعل مثل هذه الآراء تبتعد عن مبدأ الحيادية الذي تتجلى عليه حقائق الأشياء. في الجانب الآخر المؤيد لقصيدة النثر تعلو نبرة الاستعلاء الخطابية – أيضًا -، فيقول محمد خالدي: ” بين زمن تآكل وآخر يتآكل ولدت قصيدة النثر على أنقاض هذا العالم الهرم، زهرة وحشية.. جميلة فكانت تخطيا لماض مهزوم وعناقا لمستقبل يزخر بالأمل والحياة والحركة، إنها هندسة لبناء مستقبلي قادر على إيواء أحلامنا الكبيرة، أحلام الملايين التي تنزف الشعر أو تنضح العرق.”، فبين هذا وذاك تخافت ماهية قصيدة النثر وانسربت حقيقتها في الخطاب النقدي العربي.
لم تشكل قصيدة النثر – في حقيقتها – قطيعة مع تراثنا العربي، ولم يكن خروجها عن نمطية الشكل الكلاسيكي ترفًا أو استعلاءً، فقصيدة النثر – منذ بزوغها الغربي الأول – خرجت عن شروط النظرية الغربية ذاتها. أما دخولها على فضائنا العربي مرتهن بتطلعات الذات الإنسانية التي أصبحت ترى العالم وفق شروطه الجديدة، فلم يكن دخولها – كما يدعي بعضنا – تأثرا بالغرب وتوجهاته الفلسفية، فالأمر بعيد كل البعد عن هذه المساحة الضيقة.
تجاوزت قصيدة النثر سلطة الشكل القديم، بعد أن تجاوزت الذات العربية نظرتها الأحادية، وانفتحت على العالم الجديد، وكان من الضروري أن تسائل هذه الذات تراثها، وتجري معه حوارا دون أن تحدث بينها وبينه قطعية، فهو السؤال المشروع الذي من خلاله نستنطق تراثنا العربي ونرتكز على قاعدته باحثين عن أفق جديد يضمن لنا وجودنا واستمراريتنا في العالم، دون مساس بهويتنا العربية، وليس هذا بجديد ولا مستغرب؛ فكل حضارة جديدة لا بد وأن تنبني على قاعدة حضارة أخرى تكون مرتكزا ومنطلقا في آن.
لقد أحدث القرآن الكريم هزة عنيفة لدى العرب حال نزوله، فقد اخترق القرآن أنظمة التواصل الجمالي لديهم، وأطربهم، واعتمل في وجدانهم، وتأثر ببلاغته الجميع دون استثناء، وكان السبب في هذه الهزة العنيفة أن القرآن الكريم أخترق أنظمتهم اللغوية وأسكتهم وأطربهم دون أن يرتكز على إيقاعاتهم، ولا أوزانهم كما اعتادوها، فقد انبنت جماليات النص المقدس على غير مثال معهود لديهم، فالنص المقدس اعتمد أنماطًا عليا من التنغيم الصوتي التكاملي جعلته منغما مرتلًا دون أن يرتكز على إيقاعاتهم الشعرية وأساليبهم البلاغية، وهذا يعني أن البناءات اللغوية/ النصية لا تحدها أطر ولا قوالب ولا أنماط، وكأنّ القرآن الكريم فتح لنا بابًا واسعا يسمح لنا بالولوج إلى كل ما هو مستقر في تراثنا العربي ومساءلته ومن ثم تطويره.
إن كلَّ تجلٍّ من تجليات الأدب يحمل في طياته دلالة، فالشكل وسيلة الشعر وليس غايته، بل كل شكلٍ يحمل بداخله رؤى الذات الإنسانية وتطلعاتها، “فليس خافيا أنّ قصيدة النثر جاءت في سياق ملمح من ملامح الحداثة وهو التجاوز. وتخليها عن الوزن أو الإيقاع الخارجي ربما يكون أهم خطوة في خطوات هذا التجاوز(…) فخروجها من الشكل إلى اللاشكل مع بقائها في حالة الشعرية، يعني تموجها وصعوبة القبض عليها.”، إذن، كلُّ تجلٍّ أسلوبي للشعر يتشكل وفق سياقات العالم وتأثر الذات الإنسانية بمتغيرات الحضارة/الواقع من حولها، “والواضح أن قصيدة النثر تجسد الرفض الذي تحمله الحداثة واحدا من مفهوماتها أو حمولاتها. يقول أدونيس: لابد لهذا العالم، إذن، من الرفض الذي يهزه، لا بد له من قصيدة النثر – كتمرد أعلى في نطاق الشكل الشعري. وللآخرين في المجالات الفنية والأدبية والفكرية أن يختاروا رفضهم وأشكاله.”، فقصيدة النثر تعني التمرد عند أدونيس، ولربما يفهم الرفض على أنّه القطيعة، ولكن باستقراء المشروع الفكري/الشعري لأدونيس، يتلاحظ لدينا: أن الرفض يعني الخروج على سلطة الموروث وبناء فضاءات فكرية تتواءم مع العالم الجديد وما تتغياه الذات الإنسانية في وقتها الآني، دون قطيعة مع التراث، ولكنه التحرر من ربقة السلطة الماضوية، وهذا يعد تحررا تنبني في أفقه هوية عربية جديدة ترتكز على تراثها وتتطلع إلى نموذج إنساني أعلى.
بينما يرى أنسي الحاج أن قصيدة النثر” جزء من مؤامرة على التقليد العربي، ولا نفع لها إن لم تكن هكذا، كما هي خيانة لهذا التقليد الذي لا يعكسنا. ولهذا فهذه الخيانة – في رأيه – ليست شرفا فحسب، بل هي قبل ذلك عمل طبيعي تجاه هذا التقليد الذي يشبه سجنا شرط التحرر منه هدمه على من فيه.”، ربما يحمل أسلوب أنسي الحاج شيئا من التطرف، بسبب ما تعرض له شعراء قصيدة النثر – في بداياتها – من هجوم شرس على توجههم الشعري المضاد للشكل القديم