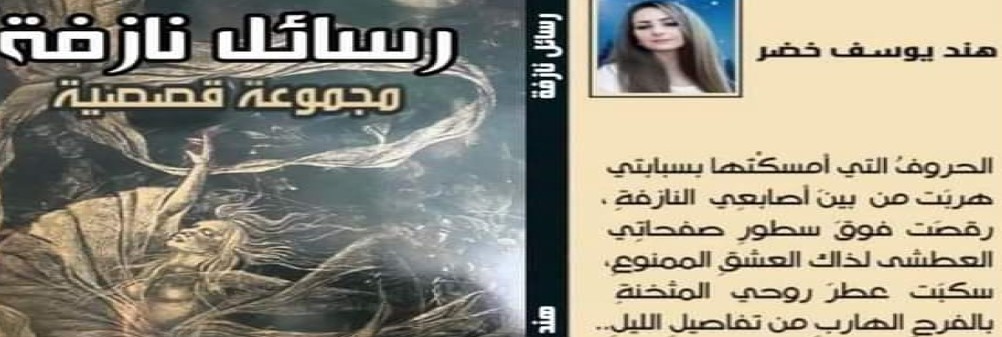من دفتر ذكريات صعيدي في واشنطن
في أواخر ستينيات القرن الماضي ، وبالتحديد في عام 1969 كنت عضواً في الجماعة الأدبية في قصر ثقافة قنا ، ولأنني كنت من الأعضاء المتحمسين للغاية ، فقد كنت دائم التواجد في قصر الثقافة ، وكان من الطبيعي أن ألتقي بأحد عمال القصر ، وهو الشاعر عم العسيري – لا أذكر اسمه كاملاً بدقة .. ولعله : محمد العسيري – ، كان الرجل بائساً في مظهره ، وفي حديثه ، لم يغير الجلباب الذي على جسده ، ولا العمامة الصعيدية ولا (البلغة) العتيقة في قدمه ، ورغم إشفاقي الشديد عليه كان من الصعب علىّ أن أساعده ، لأنني وقتها كنت طالباً في الثانوية العامة ، وأحصل على مصروف بسيط من أسرتي ، وكان الرجل بمجرد أن يلقاني يفتر فمه عن ابتسامة عريضة ، ثم يحضر مقعدين ، ويدعوني للجلوس ، وكنت أنا أجيد الاستماع له لأنه كان شاعراً بحق ، وصاحب آراء مهمة ، رغم أنه كان أمياً ، وكان يقول لي كلاماً مدهشاً عن الإنسان ، وكان ينطقها مبدلاً حرف النون إلى لام ، فيقول (الإلسان) ، وما أن أعزمه على كوب شاي من بوفيه القصر ، ويمسك بكوب الشاي ، بكفيه الغليظتين ، حتى يمارس مسألتين : الأولى تمتلئ عيناه بالدموع الحارة فوق العروق الحمراء التي تغطي بياض العينين ، وقد عملت كل الأساليب والحيل لأعرف سبب البكاء ، ولكنه لايخبرني مهما فعلت ، والمسألة الثانية يسمعني قصيدة له ، ويسميها (شُعر) بضم الشين ، وكان يسمعني بالفعل قصائد صعيدية نقية رائعة ، تتعلق بالحياة وبالإلسان وبطمعه وبانتصاراته ، وبالأصدقاء وكرمهم ، وخيانتهم وخصامهم ، وبالطبيعة والبحر (البحر في مفهومه هو النيل) والصيادين والرزق والخير ، ولكنني لم أحتفظ – للأسف الشديد – بقصائده ، وبالتأكيد فالعسيري قد توفاه الله ، لأن عمره وقت اللقاء كان يقترب من الستين ، أما الطلب المتكرر الذي كان يطلبه مني بعد أن ينتهي من إلقاء (الشُعر) في كل مرة – دون أن ينسى لمرة واحدة – فهو : (ابعثْ بهذا الكلام يا أستاذ لوزير الثقافة ، لأنه لو قرأه سيرسل لي جائزة كبيرة ، سيرسل لي مائة جنيه) ، والمائة جنيه في هذا الوقت كانت أكبر مبلغ يمكن أن يتخيله الإلسان .. كلما تذكرتك يا عم العسيري ، أبكي لأجلك ، لأنك تمثل لي ، حكاية الإنسان في كل مكان وفي كل زمان ، الإنسان بمعاناته وببحثه عن لحظات الصدق ، وعن لحظات الفن والجمال والحكمة ، وبحلمه الدائم بالمكافأة ، وبإحساسه الدائم بأنه يستحق مكافأة .