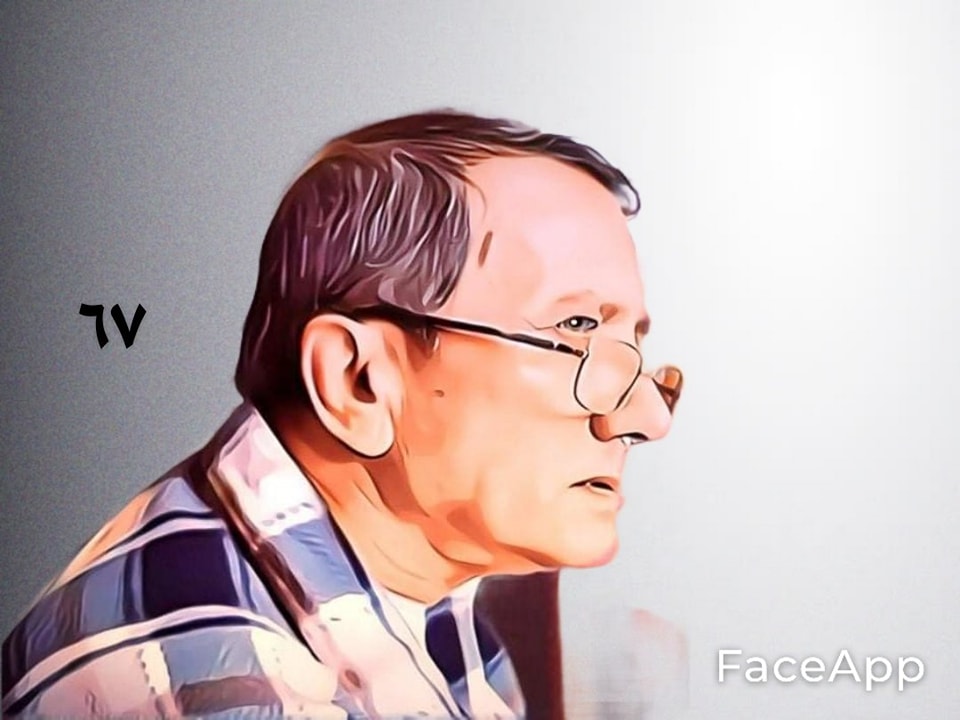قراءة خارج المألوف في عظماء التاريخ
الدكتور خضر محجز | فلسطين
مرات كثيرة تلك التي أكدت فيها على أن التاريخ هو «فعل الناس في الدنيا بشروط الدنيا».ذلك كان تعريفي الخاص للتاريخ، تعريف استقيته من تأمل طويل لحركة العالم.
لا أزعم أن أحداً لم يقل شيئاً مشابهاً، لكنني أزعم أنني أنا من صاغ حركة التاريخ في هذه الكلمات، التي تنبع خطورتها من كونها قيلت في محيط لا يؤمن إلا بالآخرة. كأن الآخرة تأتي إلى قوم من الكسالى، العاطلين عن الفعل، جاهزة لامعة نظيفة، محوطة بعناية المقادير!.
إن تاريخ العالم هو تاريخ الصراع يا أصدقائي، هو تاريخ التضاد بين الإرادات. وإن عظماء التاريخ لم يكونوا يوماً سعداء على الصعيد الشخصي، ففترات السعادة في التاريخ هي مجرد صفحات بيضاء فارغة، كما يقول هيجل.
لقد سعد معاوية الثاني إذ تخلى عن العرش، لكن التاريخ لا يذكره رجلاً عظيماً. ذلك لأن المجد لا ينتج إلا عن إرادة الإنسان. ومعاوية الثاني تخلى عن إرادته في الفعل، وانحاز إلى العالم الآخر حيث الكف عن الفعل أكثر ضمانة للجنة.
وفي المقابل نرى رجلاً بلغ ذروة المجد، إذ خاض الصراع حتى نهايته المقدرة. لقد بلغ أبو بكر المجد الدنيوي، لا لأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد كان يمكن له أن يعيش سعيداً بعد وفاة النبي، ثم يدخل الجنة، ثم لا يكون رجل تاريخ عظيماً. لكنه كان عظيماً لأنه أدرك اللحظة التاريخية واستجاب لها، أدرك أن «الردة» ليست مجرد حركة قبائل متمردة، يمكن إرجاعها بالحوار إلى الجادة، بل فهم ـ بعمق نظرته التحليلية ـ أنه الآن يقف على مفصل هام من مفاصل آلة التاريخ، فإما أن تدوسه العجلات، وتدوس معه أمته التي تعب حبيبه في تكوينها، وإما أن يدير العجلة بطريقة جديرة بالعظماء. فاستجاب لأمر التاريخ، ولأمر الدنيا، ولأمر المجد، وقرر أن يخضع المتمردين بالقوة: إذ لم يكن يجدي هنا غير القوة.
وتصوروا يا أصدقائي لو أن المتمردين عادوا إلى الانصياع للدولة عن طريق الحوار مثلاً، أكان سيكون ثمة دولة قوية فيما بعد، خارج تهديدات «الفيتو» المرتقب كل لحظة، من شيوخ عشائر طامعين في التمرد عند كل بارقة أمل بالفوز؟
ولو شئنا مزيداً من التوضيح، لتساءلنا إن كان لدولة بني العباس أن تستمر وتتعاظم، مع وجود رجل خطر كأبي مسلم الخراساني؟
ولئن كان أبو بكر قد وجد الدافع الأخلاقي والديني لإظهار قوة الدولة، فلقد كان أبو جعفر ـ رجل الدنيا الخالص ـ غير مهتم كثيراً، بالبحث عن المبررات الأخلاقية قبل فتكه بأبي مسلم.
إن عظمة أبي بكر تجلت في كونه أدرك ـ بمنتهى حدة العبقرية ـ أن الدولة شيء آخر غير الدين. لقد أنشأ الدينُ الدولة حقاً، ولكن أدوات الدولة الآن هي التي تعمل، بمراقبة صارمة من الأخلاق. وتلك أعظم عظمة في شخصية الصديق.
تلك هي عبقرية الصديق رضي الله عنه. وتلك عبقرية غابت لحظتها عن عين علي بن أبي طالب عليه السلام فيما بعد. ذلك أن المقارنة بين هذين الجليلين، تدلنا على أن أولهما كان بطلاً تاريخياً، فيما كان الآخر رجل الآخرة المبشر بالجنة فقط.
والنتيجة أنه بإمكان فائزٍ بالآخرة أن يكون بطلاً تاريخياً، شرط أن يستخدم أدوات الدنيا. وإذا لم يستخدم أدوات الدنيا، فلن يكون بطلاً تاريخياً، حتى لو دخل الجنة. وسيرة السلف الصالح تحيلنا إلى كثير ممن يبدو أنهم فازوا بالجنة، دون أن يحققوا عظمة الإرادة البشرية.
لم أتناول عمر بن الخطاب هنا، لأنني سأخرق المألوف إن قلت إنه أقل كثيراً من أن يقارن بأبي بكر. رضي الله عن الصحابة أجمعين.
لا جنسية للعظمة، ولا قومية للعظماء، بل هم رجال الوعي المنتصر. فالعظيم يعرف قدر العظيم بما لا يعرفه الصغار الحسودون، وها نحن نقرأ كيف يغرس العظماء بذرة الوعي في العالم عموماً، وفي أممهم بوجه خاص.
حين دخل نابليون مملكة بروسيا فاتحاً، وقف على قبر فرديريك الأكبر وقال لقواد جيشه: «لو كان على قيد الحياة، لما كنا هنا».
كان فريدريك الثاني، هو الرجل الذي سوف يعتبره نيتشه فيما بعد “السوبرمان”؛ كما كان “الأكبر” كما سماه معاصره فولتير.
كان «فريدريك الأكبر» هذا ملك بروسيا، المقاطعة التي سينوط بها التاريخ قيادة وعي الشعب الألماني بالوحدة، التي لم تتحقق إلا بعد عقود من التاريخ.
ومثل ذلك حدث حين توفي عبد الناصر، وقف الأسطول السادس الأمريكي في عرض البحر، وقد اهتز لموت الزعيم العدو، وأطلق مدافعه تحية لوفاة الزعيم، الذي لم يحقق حلمه.
لم تكن مصر عروبية قبل عبد الناصر، فقد كانت تبحث عن ذاتها، كما ظهر ذلك واضحاً في كتاب طه حسين “مستقبل الثقافة في مصر”، الذي مثل في حينه روح الأزمة.
عبد الناصر هو الذي أدرك حركة التاريخ، وسلطة الجغرافيا، ورأى أن قوة مصر تكمن في محيطها العربي.
ولقد وقفت كل قوى العصر ضده، ولكنه استمر محافظاً على حلمه إلى أن سقط شهيد هذا الحلم.
الآن بعد عقود طويلة من موت ناصر، يمكن القول إنه لا أحد في العالم العربي لا يحلم بالوحدة. حتى الحكام الذين لهم أجندة لاعروبية، ينافقون شعوبهم ويعلنون أنهم يحلمون بالوحدة، يحلمون بحلم ناصر الذي حاربوه.
لقد أدركت الأجيال الآن أن ناصر كان بطلاً تاريخياً، يستلهم عبقرية مصر.
كان نابليون ـ الذي يجمع المؤرخون على أنه أعظم قائد عسكري أنجبته الدنيا ـ هو الذي وهب الثورة الفرنسية إمكان التحقق، حين فتح الدول وأعلن فيها دساتير الحرية، ربما في وقت لم تكن هذه الدول تعي بعد معنى دستور الحرية.
مات نابليون بعد أن هزمه العالم الموحد ضد أحلامه. ونسيته الأرستقراطية الفرنسية العائدة إلى السلطة تحت حراب الأعداء. لكن روح الشعب الفرنسي لم تنسه، لأنها أدركت في أعماقها أنه صانع وعيها الحديث، وعظمتها المستقبلية. لم تنسه روح الشعب الفرنسي، بل كرمته في وفاته، بطريقة جعلت الأرستقراطية المنتصرة تنحني أمام جثة الفتى الكورسيكي العائد من المنفى.
اليوم لا يمكن أن تتذكر فرنسا نابليون المهزوم الأسير، بل انغرس عميقاً في وعيها أنه صانع مجدها وشخصيتها وقيادتها للتنوير في العالم. وهذا هو مشهد العودة الخالد، لأطول جنازة في التاريخ، كما يعرضه ول ديورانت:
نُقلت الجثة إلى الباخرة نورماندي، التي نقلتها بدورها إلى باخرة أخرى، على نهر السين؛ ثم نُقلت إلى سفينة نهرية أقيم عليها معبد، يحرسها في أركانها كبار رجال الدولة. وتحت هذا المعبد كان التابوت الذي يضم الرفات العظيم مُطلاً على النهر، حيث راحت السفينة تتوقف أمام كل مدينة كبرى، للاحتفاء على الشاطىء. وعند كوربفوّى ــ شمال باريس بأربعة أميال ــ نُقل التابوت إلى عربة جنائزية مزيّنة، يحفها موكب من الجنود والبحارة، وذوي المكانة، ليمر تحت قوس النصر، وعلى طول الإليزيه. وكانت الحشود فرحة تصفّق.
وفي وقت متأخر من هذا اليوم اللاذعة برودته، وصل الجثمان أخيرا إلى مكانه، كنيسة مقابر ضحايا الحرب ذات القبة الرائعة. وغصّت الكنيسة بآلاف المشيعين، فيما يحمل أربعة وعشرون بحاراً التابوت الثقيل إلى مذبح الكنيسة. وهناك وقف الأمير دي جونفيل يخاطب أباه الملك قائلا: «سيدي، لقد أحضرت لك جثمان إمبراطور فرنسا». فأجاب الملك لويس فيليب: «إنني أستقبله باسم فرنسا». ووضع بيرتران سيف نابليون فوق التابوت، وأضاف جورجو قبّعة الإمبراطور، وأنشدت الجموع القداس على روحه، بمصاحبة موسيقى موزارت. وأخيرا أصبح رفات الإمبراطور حيث كان يود أن يكون، في قلب باريس وعلى ضفاف نهر السّين.
واليوم ها هو الشعب الفلسطيني يمر بأصعب المراحل، بعد استشهاد مؤسس كينونته المتجددة، ياسر عرفات. لكن لا يطلع صباح إلا ويستذكر الوعي الفلسطيني عظمة المؤسس، ويقرأ الفاتحة على روحه.
لقد نسي الشعب الفلسطيني خطايا عرفات، كما نسي الشعب الفرنسي خطايا نابليون، وكما نسي الشعب الألماني خطايا فريدريك؛ ولم يتبق في وعي الفلسطينيين العميق سوى صورة الفدائي، الذي حول شعبه من قطيع من المتسولين اللاجئين، إلى شعب يطرق أبواب العالم المؤصدة بإصرار.
وأخيراً؛
لا جرم أن يستهدف الحاسدون الصغار العظماء، فتلك هي طبيعة صغار النفوس. لكن مجموع الشعب، ضمير الشعب، الأمهات في البيوت، والرجال في العمل، والأطفال في المدارس، والعذارى في الجامعات، والأجيال الجديدة والأجيال التي لم تأت بعد، يدركون عظمة ياسر عرفات.
وإنني لواثق بأن ذلك اليوم سيأتي بإذن الله: اليوم الذي سيشهد أعداءَ ياسر عرفات يؤدون التحية أمام قبره، في القدس، بعد أن ينقلها الشعب الفلسطيني في موكب يليق بمكانة الأب.
إنها دينونة العالم للعظمة.