في ذكرى مولده؛ محمود درويش ونقيضه ” المفتاح والقفل “
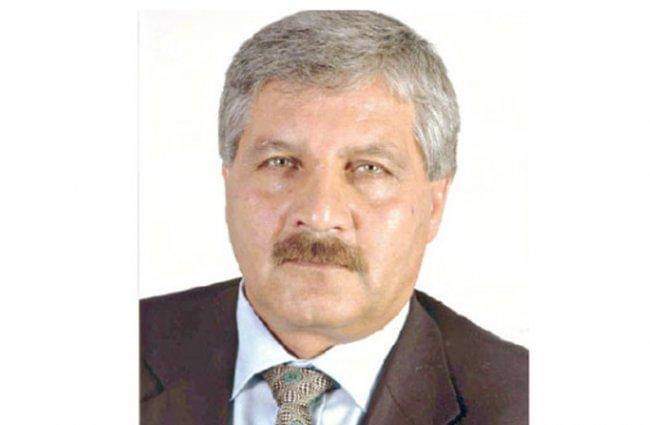
المتوكل طه | فلسطين
لماذا على الشاعر أن يعترف بالواقع أصلاً؟
القصيدة الأشهر التي كتبت خلال الانتفاضة الكبرى كانت لمحمود درويش ونعني بها “مأساة النرجس ملهاة الفضة”، وقبل الدخول إلى عالم القصيدة لا بد من الإشارة إلى أن هذا الشاعر بالذات كان الشاعر الأجرأ في تناول موضوع الآخر العدو، من حيث مواجهته ومجادلته ومناقشته والنزول إلى ساحاته ومناطقه، وهو الشاعر الأكثر انشغالاً بموضوع الآخر على الإطلاق، من حيث تمثّل مقولته وهضمها وإعادة إنتاجها، ومن خلال النظر إليه بوصفه شريكاً أو مساهماً في إنتاج ثقافة المنطقة، من خلال الاعتراف أو الاقتراب من عالمه وأساطيره وخرافاته، ودرويش هو الأكثر إحساساً بالثقة وهو “ينازل” الآخر على “أرضه”. وعلى نقيض المتوقع، فإن محمود درويش لا يعطينا الإحساس بأنه يصطف في أي موقع من مواقع النزال، وإنما يعطينا الإحساس بأنه أرض المعركة نفسها، فهو يبدل مواقعه، ويتحدث باسم الطرفين، ويتفهم الأوجاع والآلام لكلا المتحاربين والمتصارعين، فهو يرى وحدة في تلك الحرب ويرى اندماجاً وتكاملاً بين طرفي الصراع، من منطلق أن أرض المعركة تنتج ثقافتها بهذا الحراك، ويعطينا الشاعر الإحساس بأنه الوارث لكل ما ينتج عن هذه المعركة، وأن مسؤوليته هي حماية الجميع. إنه يقدم نفسه “نبيّاً” بمعنى من المعاني، أوليس القائل “انشروني في القبائل” في قصيدة “مديح الظل العالي”.
في قصيدة “مأساة النرجس ملهاة الفضة” يخلط الشاعر أو يمزج بين طرفي الصراع خلطاً عجيباً، فلا نعود نفرق بين “نحن” و”هم”، فكلا الطرفين وقعا ضحية قدر أعمى، يقول درويش في هذه القصيدة:
تاريخُنا تاريخهم، لولا اختلافُ الطير في الرايات وحَّدتِ الشعوبُ –
دروب فكرتها، نهايتُنا بدايتُنا
وأن الأرض
تورث
كاللغة
لو كان ذو القرنين ذا قرن، وكان الكون أكبر
لتَشَّرق الشرقي في ألواحه، وتغرب الغربي أكثر
لو كان قيصر فيلسوفاً كانت الأرض الصغيرة دار قيصر
تاريخنا تاريخنا
ولنخلة البدوي أن تمتد نحو الأطلسي
على طريق دمشق كي نشفى من الظمأ المميت إلى غمامة
تاريخنا تاريخهم
تاريخهم تاريخنا
لولا الخلاف على مواعيد القيامة.( محمود درويش: الأعمال الكاملة ، مصدر سابق، ص 432-433.)
هذا مقطع شائك وجدلي يحتاج إلى إمعان نظر شديد، ولم يتعود الشعراء الفلسطينيون في المنافي أو في الوطن الإشارة إلى “الآخر” العدو بهذا الشكل أبداً، وعليه فإن درويش هو الأجرأ في تناول مقولة “الآخر”، وهي جرأة كان من نتائجها – ضمن نتائج أخرى – تحويل “الآخر” العدو ليس إلى مجرد ضحية – كما صور في بعض المراحل – وإنما شريك في صنع ثقافة هذه المنطقة، يمكن استيعابه أو عده خيطاً في قميص هذه المنطقة الثقافي والروحي.
يمكن تفكيك المقطع السابق – حسب مضمونه – إلى ما يلي:
أولاً: إن تاريخنا (تاريخ مَن بالضبط ؟ أهم الفلسطينيون الذين جاؤوا من بحر إيجه كما تشير القصيدة، أم هم العرب على الإطلاق ؟! ولكننا نستبعد العرب من دائرة الاحتمال لأن الشاعر يؤكد أن تاريخنا هو تاريخنا، أما تاريخ “البدوي” فله أن يمتد نحو الأطلسي على طريق دمشق). إن تاريخنا – تاريخ جماعة الفلسطينيين – هو ذاته تاريخ جماعة اليهود، هذا الكلام له ما يبرره من عدة مؤلفات ومراجع تاريخية ترى أن جماعة اليهود الذين قدموا إلى أرض كنعان و”تعاركوا” مع العماليق الجبارين الكنعانيين والفلسطينيين أخذوا منهم الكثير حتى التوراة، والشاعر يشير صراحة إلى توراة كنعان في القصيدة التي نحن بصددها(هناك مؤلفات كثيرة تناولت هذا الموضوع، من أشهرها كتاب “إسكات الصوت الفلسطيني” لمؤلفه ويليام كينيث، إصدار عالم المعرفة ، الكويت، ط1، 1999) . إن هذا التطابق المدّعى بين تاريخنا وتاريخهم والعودة إلى نقطة البداية ومحاولة إيجاد قاسم مشترك في البدايات لخلق قاسم مشترك في النهايات يبدو متعسفاً جداً، لإغفاله عمداً المسار التاريخي لجماعات مندثرة أولاً ولجماعات اتخذت مسارات تاريخية مختلفة، ولأن الوعي التاريخي ذو محتوى وجداني وروحي وليس مجرد “معرفي”.
ثانياً: إن الرايات المختلفة تمنع الشعوب من توحيد فكرتها، والرايات هي الأيديولوجيا والأديان والمعتقدات والأوهام والخرافات، والشعوب تتمايز وتتفاضل بهذه السياقات الوجدانية، والشاعر يقول إنه لولا “اختلاف الطير في الرايات” لتوحدت الشعوب حول فكرة واحدة، ما هي الفكرة التي توحّد الشعوب ؟! الله !! حتى فكرة الله – جل وعلا – اختلفت عليها الشعوب! السلام والمحبة !! حتى هذه الرايات اختلفت الشعوب عليها؟!
إذاً، كيف نوحّد بين “عقائد” الشعوب ونضعها في الكفة ذاتها؟!
كيف لا نجعل هناك فروقاً بين “الأيديولوجيات” و”الأوهام” لكل شعب من الشعوب؟!
لماذا لا ينحاز الشاعر إلى معتقدات جماعتة و”أوهامها” و”أساطيرها” ؟؟
لماذا هذا “النزول” أو “التنازل” عن “أوهام” جماعته ليساويها بـ”أوهام” الجماعة الأخرى؟!
ثالثاً: نهايتنا هي بدايتنا، هكذا يقول الشاعر، فإذا عرفنا أن المقصود هو جماعة الفلسطينيين الأوائل، فإن نهايتنا هي العيش المشترك مع الجماعة الأخرى، تماماً كما كان منذ البداية، حيث عاش اليهود مع الكنعانيين والفلسطينيين في أرض كنعان، وقد تزاوجوا وعبدوا آلهة مشتركة وبنوا معابد مشتركة، حتى أن أشعيا وأرميا لعنا جماعة اليهود لهذا العيش المشترك مع الوثنيين، ونهايتنا الآن ستشبه بداياتنا، أي العيش المشترك!
رابعاً: الأرض تورث كاللغة، وهذا جملة إشكالية أخرى، وهي على جماليتها وبلاغتها الشديدة، فإن الانتقال من الحديث عن البدايات (حيث تشابهت وتمازجت الآلهة والنصوص المقدسة واللغة، وحيث تجدر الإشارة إلى أن هناك من يعتقد أن لا فرق يذكر بين اللغة العبرية واللغة الكنعانية القديمة، فإن الكلام عن وراثة الأرض ووراثة اللغة معاً يصلح لجماعتي اليهود والفلسطينيين معاً).
خامساً: إن ذا القرنين لم يكن ذا قرن واحد، ولم يكن قيصر فيلسوفاً، وانتقل “البدوي” من صحرائه إلى “الأندلس”، ولهذا فإن قوانين التاريخ لها منطق غير منطق الأسطورة أو الأحلام، وإن التاريخ “يفرق” ولا “يجمع”، وإن من مهمة التاريخ تقسيم الناس إلى مجموعات وكتل، وإن أحلام بعض “الأبطال” في توحيد العالم فاشلة، إن أحلام ذي القرنين وقيصر و”البدوي” – لنلاحظ كيف وصف درويش العربي المسلم وهو وصف ظالم جداً وغير دقيق وفيه استشراقية ما واستعلائية – في توحيد الأمم كانت فاشلة، هؤلاء حاولوا أن يوحدوا بين شعوب في بقاع مختلفة، أما “نحن” و”هم” فإننا في بقعة واحدة تسمى فلسطين، ولذلك:
سادساً: فإن تاريخنا هو تاريخهم ذاته، فقد عشنا في الأرض ذاتها، وأكلنا من الطعام ذاته، وتشردنا وحلمنا بالحلم ذاته، ولكن الخلاف بيننا هو على “مواعيد القيامة”، فهو خلاف غير أرضي، خلاف لا علاقة له بالتاريخ أو العذاب، أو الحنين الذابح إلى “المكان”. الخلاف على مواعيد القيامة هو الفرق بين ما يعتقده اليهودي عن إلهه الذي عقد حلفاً أبدياً معه، وبين الكنعاني الذي جعل من إلهه خصيباً إلى درجة استغنائه عن السماء ذاتها. على كلٍ، فإن الشاعر يجد هنا اختلافاً بين “نحن” و”هم”، إذ افترق تاريخنا عن تاريخهم بسبب هذا التوقيت المثير .
ولأن الشاعر يقدّم لنا رؤية أو تصوراً عن “الآخر” العدو بهذا التقريب وبهذا التماثل العجيب والمثير للدهشة والتساؤل، فإنه يصيح بصيغة السؤال الاستنكاري في القصيدة ذاتها:
من صاغ سيرته بمنأى عن هبوب نقيضها وعن البطولة ؟!
لا أحد. (محمود درويش: الأعمال الكاملة ، مصدر سابق، ص 433)
وكأني به هنا يبرر مقولته “تاريخنا تاريخهم”، إذ لا يمكن كتابة أو رواية تاريخنا بعيداً عن كتابة أو رواية تاريخهم، فالتاريخان يشبهان هنا المفتاح والقفل، يحتاج كلٌ منهما للآخر لإكمال الحكاية كلها، أي أن الجماعة بحاجة إلى نقيض لترى فيه “جثة أو رماداً” بتعبير تودورف!
إذاً، السيرة تحتاج إلى نقيض، من جهة، وإلى بطولة، من جهة أخرى، لا سيرة من دون بطولة، ولا تاريخ من دون تضحيات، ولكن المشكلة هنا أن الشاعر يساوي بين الأطراف جميعاً، فهو يعطي حق رواية السيرة بما فيها من نقيض وبطولة للطرفين، بمعنى أن “جماعتنا و”جماعتهم” تتساويان وتتشابهان وتتماثلان في صياغة تلك السيرة – وهي متشابهة، أيضاً، باعتبار أن تاريخنا هو ذاته تاريخهم – . ما أريد قوله هنا إن الشاعر كأنه لا يتحمس لسيرتنا ولا ينحاز لها ولا ينفعل ولا يذهب إلى الموقع الذي تتوقعه منه جماعته، فهو، كما قلت، أرض المعركة وليس طرفاً من الطرفين المتنازعين، حتى قصيدته تحولت إلى أرض معركة ليس إلا، ولهذا فإن هذه القصيدة بالذات – أعني مأساة النرجس ملهاة الفضة – اختلط فيها الموقفان، وتبادل الطرفان المواقع، وتحدثا باللغة ذاتها، ومزجا بين تاريخيهما، والشاعر فيها يطلب من بحر إيجة أن يعيدنا إلى حيث كنا، أي إلى اليونان أو بلاد الإغريق، يقول الشاعر:
يا بحر إيجة، عُدْ بنا يا بحر .. قد نبحتْ كلاب العائلات
لتعيدنا من حيث هبت ريحنا .. فالنصر موت
والموت نصر في هرقل، وخطوة الشهداء بيت.( محمود درويش: المصدر السابق، ص 433.)
وإذا كان الشاعر يفصل بين “الفلسطينيين”، من جهة، و”العرب”، من جهة أخرى، فإن المخرج الوحيد لذلك هو البحث عن قاسم مشترك مع جماعة اليهود الذين بدأ تاريخنا معهم في مكان واحد، وينتهي الآن مرة أخرى في المكان ذاته، في جدلية قدرية تثير الضحك والبكاء معاً، يقول الشاعر في القصيدة ذاتها:
كانوا يعيدون الحكاية من نهايتها إلى زمن الفكاهة
قد تدخل المأساة في الملهاة يوماً
قد تدخل الملهاة في المأساة يوماً
في نرجس المأساة كانوا يسخرون
من فضة الملهاة كانوا يسألون ويسألون:
ماذا سنحلم حين نعلم أن مريم امرأة ؟!
وكأني بالشاعر يسخر من أوهام التاريخ كلها، ولا يصدقه، ولا يستسلم لمشيئته أو لأوهامه، إن مريم في نهاية الأمر امرأة، ولكنها لم تعد كذلك بعد أن ولدت سيدنا عيسى – عليه السلام – والشاعر يريد أن يقشر التاريخ كقشرة موز ليصل إلى جوهر الأشياء وأصلها، حيث كل الناس يتشابهون في البحث عن السلام والحب والأمن والمساواة والحرية، ألم يقل الشاعر من قبل “إن كل قومياتنا قشرة موز”، يعتقد الشاعر أن الأوهام هي التي تجعل من التاريخ مقدساً، والمقدس يدفع إلى الفانتازيا حيث تدخل المأساة في الملهاة والملهاة في المأساة، فهل الشاعر يرفض المقدس كونه وهماً يفرّق ويشتت ؟ إن هذا التساؤل الذي يفتح “الأنا” على “الآخر” ويهدم الفوارق والحدود والتمايز يجيب عنه الشاعر في إحدى مقابلاته بالقول: “هناك آخران؛ الآخر الذي هو أنا، حين أقرأ نفسي من خارجها، والآخر هو الغريب، المختلف، الخصم، وهو موجود في مكاني بدلاً منّي، التنقيب أركيولوجياً عن الذات يصطدم بواقع، بحاضر، بتاريخ، بحروب، بتراكم ثقافات، بتعددية، إذاً لا بد من الدخول في سجال فكري مع الآخر الذي احتل المكان، لأنه يحمل الدعوى نفسها التي أحملها أنا، ويدّعي أن هذا مكانه وأنني أنا الغريب فيه، هو، أيضاً، في حيرة لأنه لا يجد نفسه، هناك اصطدام بحثين، اصطدام ذاتين تبحث كل منهما عن ذاتها في الآخر، لكن أنا أجرأ من “الآخر” في البحث عن نفسي فيه، هو لا يملك الجرأة الوجودية على أن يبحث عن نفسه فيّ لأنه ينكر وجودي، وإذا اعترف بأن فيه شيئاً مني يضع وجوده نفسه موضع تساؤل”( مقابلة مع الشاعر درويش أجراها معه الشاعر عباس بيضون، ونشرتها جريدة “الأيام” الفلسطينية بتاريخ 25/11/2003، العدد 2819، المجلد 8 .)
إذاً، فإن بحث الشاعر عن “أناه” في “الآخر” جرأة يفرضها الواقع والحروب وتراكم الثقافات والتعددية، بمعنى أن الشاعر يذهب إلى دعوى “الآخر” – وأوهامه – ليبحث عن ما يمكن تقاسمه أو الحديث عنه أو الانطلاق منه أو التفاهم على أساسه، هو لا ينكر “الآخر” – لأنه الأجرأ –، فيما ينكره الآخر كي يحافظ على وجوده، وهذا محض افتراء ووهم آخر !! فـ”الآخر” ليس واحداً ذا توجه موحد، “الآخر” العدو هو آخر متعدد جداً.
فكرة البحث عن “الأنا” في الآخر أو لدى الآخر جعلت من درويش يتساءل كثيراً عن “أناه” وهذا ما سنشير إليه لاحقاً!
ولكن سؤالي ما يزال قائماً، فإذا كان “الآخر” حائراً في تعريف ذاته – لأسباب موضوعية حقيقية – فلماذا أقع أن أشخصياً في حيرة تعريف الذات ؟! لماذا عليّ الذهاب إلى بحر إيجة، أو إلى البدايات، أو إلى تلك الانغلاقات الإثنية الضيقة الميتة؟! ولماذا عليّ أن أشبّه نفسي بأعدائي، أو أن أتلمس المتشابه وأغمض عيني عن المختلف؟! لماذا عليّ أن أجد “الإنساني” في قاتلي؟! من أجل ماذا؟! ما هو الهدف من ذلك؟!
والسؤال الأكثر أهمية من كل هذا يتعلق بجمهور المتلقين من العرب والمسلمين بالذات، فكيف لهؤلاء الذين يعدون هزيمتهم أمام اليهود في القرن الماضي هي وصمة عار في جبين كل واحد منهم، وأن ذلك دليل الذل والهوان وإهدار الكرامة والأرض والعرض، فكيف لهؤلاء أن يبحثوا عن “أنفسهم” في “عدوهم”، وأن يروا أنفسهم “ضحايا” في “قاتلهم”، وكيف لشاعر كبير مثل محمود درويش – الذي يحدد سقف الذائقة الشعرية – أن يقرر بكامل الثقة أن تاريخنا هو تاريخهم لولا الخلاف على مواعيد القيامة؟! أليس في هذا تجاوز لكل المسلّمات والبدهيات التي أطّرت وثبتت الصورة النموذجية لليهودي على مر التاريخ؟! أليس في هذا هدم للصورة النمطية التي صاغها الوجدان العربي والمسلم؟!
أليس في البحث عن “الذات” في “الآخر” نوع من التسليم بالهزيمة أو تمثل المهزوم بالمنتصر؟! أليس في محاولة المهزوم الاقتراب من المنتصر ومحاولته المشابهة والمقاربة والمقايسة وتنازله عن مميزاته اعتراف كامل “بالواقع”؟!
لماذا على الشاعر أن يعترف بالواقع أصلاً؟!





