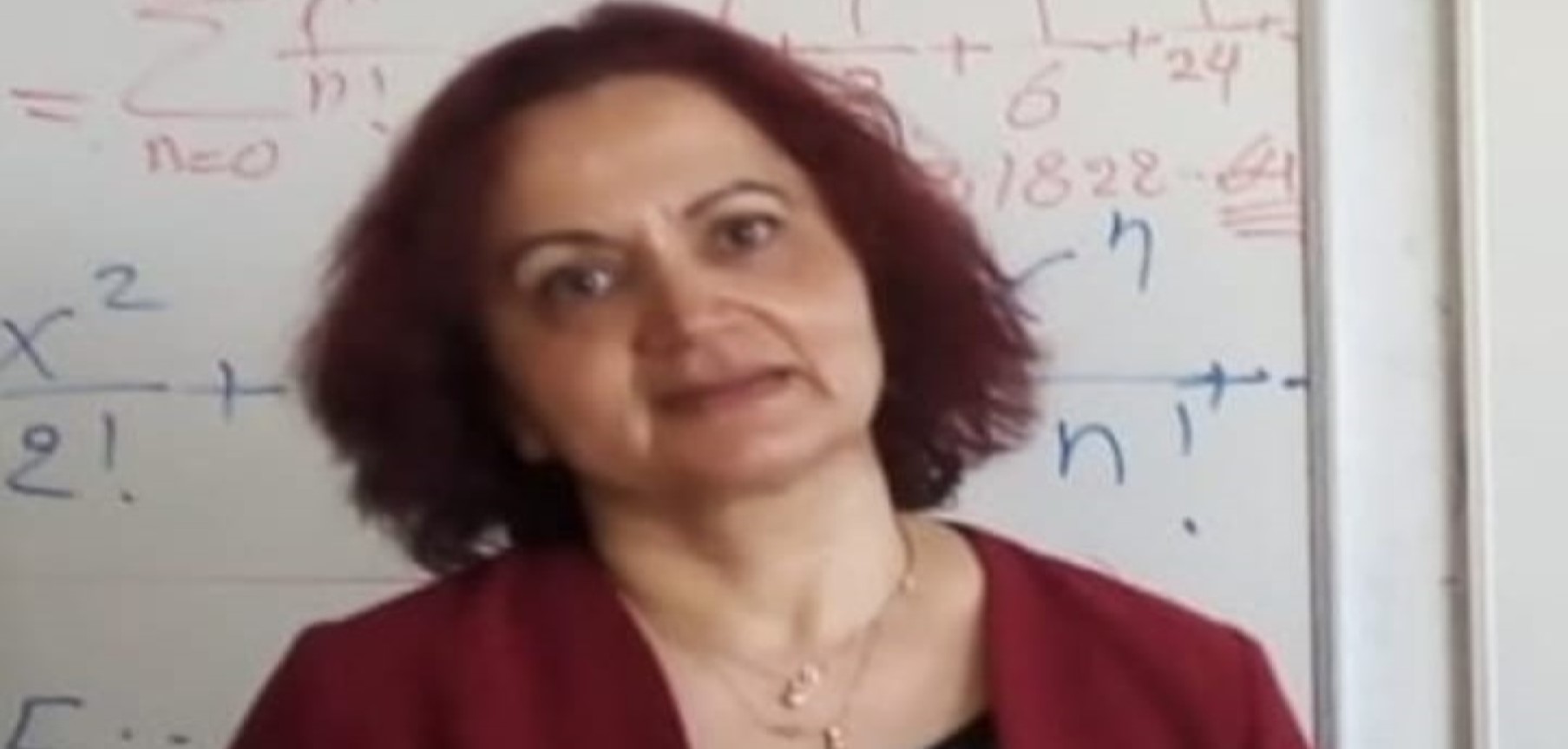مسرحيّة دعني أمت دعني أعش في ندوة اليوم السابع

ديمة جمعة السّمّان| القدس
ناقشت ندوة اليوم السّابع الثّقافيّة الأسبوعيّة المقدسيّة – عبر تقنيّة زووم مسرحيّة “دعني أعش دعني أمت” للكاتب الفلسطيني خيري حمدان، وافتتحت الأمسية مديرة النّدوة ديمة جمعة السمان فقالت:

واقع المواطن العربي المرير بين مطرقة الأنظمة المستبدّة وسندان الضّمير الحيّ
ما كانت مسرحية “دعني أعيش دعني أموت” للكاتب الفلسطيني خيري حمدان، ابن بلدة دير الشّرف في نابلس، المغترب في بلغاريا، سوى وصف دقيق لحياة المواطن العربي الذي يخضع لبعض الأنظمة العربية البالية، التي تفطع لسان الحقّ، وتكسر القلم الحرّ، وتشلّ العقل المفكّر. ولكل متمرّد على القوانين “حساب” يدفعه هو وأسرته، فالثّمن غالٍ جدّا. يعيش المواطن مقهورا، يحاربونه بلقمة عيشه، يقتلون سلامه الداخليّ.. يعيش تناقضا موجعا بين ما هو قائم وما يجب أن يكون. قوانين فرضت على الشّعب، فُصّلت على مقاس أصحاب القرار لتخدم مصالحهم على حساب المواطن المسكين الذي عليه أن يصفّق لهم مستسلما. يطأطىء رأسه ذليلا، فيهبّ الضمير الحيّ تارة مؤنّبا، وتارة معاتبا، خاصة وهو على فراش الموت، يحتضر. يعيش لحظات ندمٍ تزيد من عذاباته.
فلم يكن (سالم) سوى ضمير (محمود)، الذي كان على فراش الموت يحتضر، ينتظر انتقاله إلى عالم الأبديّة. عادت حياته إلى ذاكرته بتفاصيلها القاسية، كشريط يمرّ أمامه، يذكّره بعجزه، يواجهه بحقيقته الجبانة. فهو لم يتغلّب على خوفه. لم يقل لا في الوقت الذي كان عليه أن يرفض.
البيروقراطية الحمقاء حكمت الشّعوب بتفاصيلها المملّة لتزيد من قهرهم وتسرق وقتهم، وتقلّل من إنجازاتهم، تلهيهم عن أمور أخرى، كان لا بدّ أن يكون لهم دورا فيها؛ ليعيشوا إنسانيّتهم، كما هي بعض الدّول الأخرى التي احترمت مواطنيها، وقدّرت فيهم الإنسان.
مسرحيّة من فصل واحد، لخّصت واقع بعض الأنظمة العربية التي تروّض مواطنيها، وتجعل منه لعبة في أياديها.
فمنذ عام 1050 هجريّة، انحرفت البوصلة، وما عاد للعرب مكانة بين الأمم. بعد أن حكموا العالم وكانوا النموذج الذي يحتذى به. أخذه الغرب، واستفاد منه، فبنى عليه، وأصبح يقود العالم.
فبينما تكبر وتنمو الأمم والشّعوب الأخرى، يبقي العرب يعيشون داخل قوقعة الموت، مجمّدين داخل قوانين ابتدعوها لتزيد من شللهم..يجترّون تاريخهم العريق، يعتقدون أنّهم أحياء، ولكنّهم في حقيقة الأمر لا يمكن وصفهم سوى بِ “الأموات الأحياء”. فلم يطولوا الحياة ولم يطولوا الموت.

وممّا قالته د. روز اليوسف شعبان:
في لغة تشوبها الفكاهة ويجنح فيها الخيال، يصوّر الكاتب الحالة النفسيّة التي يمرّ بها محمود بعد أن فارق العالم الدّنيويّ، فيقف أمام سالم وهو شخص من العالم الآخر، الذي يبدأ في استجوابه عن حياته، وأخطائه وعن الأحزاب السياسيّة التي انتمى إليها، ويسجّل ذلك في بروتوكول، وكأنّه في محكمة يحاكم فيها كل من فارق الحياة قبل إصدار القرار بدخوله إلى الأبديّة. فيستغرب محمود هذا الأمر ويسأل سالم بسخرية:” ماذا تفعلون حين تقع الكوارث؟ هل تطلبون من آلاف الضحايا الانتظار طوال هذه المدّة لتسوية بروتوكولات الموت؟
فيردّ عليه سالم:” أنا عبد مأمور لا يمكنني مساعدتك، هل تريد أن ترى بأمّ عينيك الدستور وحزمة القوانين الداخليّة المنصوص عليها في المعاملات الأبديّة؟ هناك طلب كبير على الموت هذه الأيّام؛ لأنه بمنزلة الخلاص من التعب والإرهاق وضغط الدم وفقر الدم والسكري والسرطان”.ص4
ثمّ يحدّث محمود سالم في سخرية عن عدّة مواضيع حدثت في بلاده وفي العالم العربي فنجده يقول:” كيف يمكن لجيش عربيّ أن يكون عبثيًّا؟ المخاطر تحيط بنا من كلّ جانب، والمعارضة تزداد قوّة، ولا بدّ من تلقينها درسًا في الطاعة لاستتباب الأمن”.ص3
ومن خلال الحوار بين الإثنين يتمّ التطرّق إلى عدّة مواضيع ينتقد من خلالها الكاتب الواقع المرير مثل : حقوق الإنسان التي هي حبر على ورق، البيروقراطيّة، غزّة التي يقول فيها محمود ما يلي:” كارثة غزّة ستلاحقني في القبر أيضًا. العالم العربي بين مناصر وشامت لمصير القطاع. هل قتلى غزّة شهداء أم مجرّد عابرين في الحلم الإسرائيليّ؟ بالمناسبة أين تبدأ الدولة وأين تنتهي المقاومة؟ لماذا جبهة المعارضة باردة؟”.ص10
ثم ينتقد محمود الحريّة في الوطن العربي ويقارنها مع الحريّة في الغرب. ثم يدور حوار بين سالم ومحمود عن احتلال العرب لإسبانيا، فيرى محمود أن احتلالها خطأً فلو بقيت دمشق أو بغداد أو القاهرة مركز الحضارة لكان ذلك أفضل. أمّا سالم فيعترض على ذلك ويرى أن احتلال الأندلس كان صائبًا، وأن المشكلة كانت في بذخ الملوك ولهوهم وانشغالهم عن أمور الدولة. وهكذا يستمر الحوار حتى يضيق محمود ذرعًا ويتمنّى أن ينتهي هذا الجدال الذي أرهقه وأتعبه، تحين ساعة الوداع وتسقط ورقة الحياة.
تذكّرني المسرحية برسالة الغفران لأبي العلاء المعرّي، وهي من أعظم كتب التراث العربي النقدي، وقد كتبها ردّا على رسالة ابن القارح، التي أرسلها له، وكتب فيها عن عدّة أمور، خاصّة شكاويه من أهل عصره ومن وزراء وسلاطين زمانه ومن هرمه وشيبه ومن الهموم والأحزان، ومن المصير المأساوي لزنادقة الإسلام وغير ذلك.
فيردّ عليه أبو العلاء المعرّي برسالة الغفران فيصف فيها ابن القارح في موقف الحشر، حيث ينتفض من قبره ليجد نفسه في الساحات يوم القيامة، ليتذكّر أنّ حسناته قليلة وقد لا تنفعه توبته، فيستجدي خازن الجنّة ليدخله لكنّه يرفض، ثم يحصل على الشفاعة من النبي، فيدخل الجنة وفيها يلتقي بالعديد من الشعراء فيحاورهم ثم يزور ابن القارح جهنّم؛ ليتعرف على من دخلها من فلاسفة وشعراء، ثم يعود الى الجنة ليصل الى نعيم الفردوس الذي أعدّه الله تعالى.
أسلوب المعرّي ساخر في رسالته هذه واستطرد فيها إلى عدّة مواضيع ففيها علم كثير بالشعر وروايته ونقده وبالتاريخ وبالأماكن والأفراد والقرآن وتفسيره والحديث وغيرها.
وفي مسرحية “دعني أمت دعني أعش ” نجد استطرادًا للكثير من المواضيع، بعضها وجدته مقحمًا في الحوار بين محمود وسالم، مثل ذكر المتنبي، محمود درويش، نجيب محفوظ، تشيخوف،ادوارد سعيد، ناجي العلي، جوزف كونراد، إضافة الى ذكر عدّة مواضيع تتعلق بالسياسة، الحكّام العرب، الثورات، الحريّة، انتقاد الزعماء العرب، التخلّف الذي يسود العالم العربي، خشيتهم من الموسيقى، هجرة الكثير من العرب إلى الغرب وغرق الكثير في البحر خلال الهجرة، وغير ذلك الكثير..مما يشتت ذهن القارئ ويبعده عن الفكرة المركزية اللافتة في المسرحية، ألا وهي وقوف الانسان أمام القضاء في العالم الآخر.
مع ذلك فإنّ الكاتب ينهي مسرحيته بالأمل فالنهاية بداية لحكاية أخرى .ص14.
والغريب في المسرحية أنّ محمود يكشف عن فلسفة وجدانيّة في ساعة موته فيقول لسالم الذي سأله :” وماذا بعد أن تخيّم العتمة من حولنا؟ يجيبه محمود: ينبلج الضوء من قلب الظلام”.ص15
تنتهي المسرحية برغبة سالم في دخول قصر الجنة مع محمود ويقوم بتمزيق البيانات والبروتوكول الذي سجّل فيه إجابات محمود عند استجوابه له. ثم يموت محمود فيكتب سالم: بدأ النزاع منذ عام 1050هجريّة، ساعة الوفاة ما تزال مستمرّة.ص16.
فهل قصد الكاتب في ذلك أنّ بداية الانحطاط في الأمة العربية بدأت عام 1050 للهجرة والتي يقابلها 1640م فترة الخلافة العثمانية، وأنّ الضمير العربي ما زال ميّتًا إلى الآن؟

وقالت هدى أبو غوش:
نص مسرحيّ من فصل واحد، شخصيتان لروح واحدة، ما بين الواقع المرير والخيال، وبين الحياة والموت، نص تبرز فيه صورة المواطن العربي المقهور والمتعب من بيروقراطية التعامل معه والحدّ من قيمته، ويوجه الكاتب خيري حمدان من خلال شخصية محمود الذي يحتضر وينتظر الانتقال الى عالم الموتى نقده اللاذع للأنظمة العربية -التي لا تحترم المواطن- ولسياسة قمع الحريات.
في هذا النّص برزت نفسية المواطن العربي وصراعه في الحياة، فهو في حالة ضياع وتيه، يبحث عن أجوبة لأسئلة تراوده حول مصيره المقيد تحت نظام مستبد، الذي جعله مواطنا يتنفس الخوف والرعب، وحياته أشبه ببيانات صمّاء لا تعرف الرحمة.
وبرز الصراع النفسي من خلال شخصية محمود الذي يصارع ذاته المتعبة، التي تتمثل في شخصية سالم الذي يحاوره ويستجوبه ويستفزه في انتظار انتقاله للعالم الآخر، يقول سالم:”أنا انعكاسك أنت،أنا ضميرك وربما شيطانك”،وهذا الصراع وحوار الذات ما هو إلا انعكاس لحياة المواطن المكدسة بالضغوطات، فالحوار هو أيضا فضفضة لأرواح ماتت وهي على قيد الحياة.
فسالم هو الضمير الذي يعذبنا ويكشف عن العقل الباطني لأوجاعنا، خاصة الأوجاع السياسية التي تأبى النوم أو الرّحيل؛ فتؤثر على حياتنا أرواحنا وأجسادنا.
الصراع النفسي عند محمود هو في البحث عن الخلاص، خلاصه من المعاناة والتحررّ من الألم، فيبحث عن الأمن السياسي، والعيش بهدوء دون اغتيالات، هو المواطن الذي سئم الإنتظار الطويل، فيرفض أن يكون كغودو،والواقع الأليم رفضه أن يكون كمواطن دائما يقع الضحية، وهو الوحيد الذي يصلب، يرفض تكرار المآسي، توجعه لذا تعلو صرخة محمود حين يتوصل إلى أنه يشبه ناجي العلي، فيتمرد على نفسه بالنفي .يقول محمود:”أنا لست ناجي العلي”
وحتى ضميره سالم يرفض هذا الألم فيصرخ “لا تذكرني به أرجوك”.
صراع محمود مع النفس، وهل هو مذنب في قضية غرق ليلى، لماذا لم ينجح في إنقاذها؟ لكنه يتغلّب على الصراع من خلال مسامحة ليلى لمحمود وتبرئته من أي ذنب.
يظهر الأمل رغم الألم والقهر في وجه نصّ المسرحية في المسامحة مع النفس والآخرين، وفي النظر إلى الأمام وعدم جعل الماضي عائقا أمامنا، في مسامحة محمود للبحر الذي خطف ليلى.
وعلى الصعيد السياسي يبرز الأمل في تمزيق البيانات التي ترمز إلى ظلم السلطة الحاكمة للمواطن في نهاية النص المسرحي؛ لنتساءل هل وجدنا مفتاح الأمل والحلّ، أم هي رسالة الكاتب الذي ينير شمعة ظلام القهر في أنّ لا بدّ للقيد أن ينكسر؟
أمّا العنوان” دعني أعش،دعني أموت” فهو بحدّ ذاته يحمل التناقض والصراع النفسي صراع الحياة والموت، وممكن أن نفهم من العنوان صرخة المواطن العربي إمّا العيش في عيش بكرامة أو الموت وهو الخلاص الذي ينشده الكثيرون.
يشار في نهاية المسرحية أن محمود توفي في عام 1050 هجري أي في فترة العثمانيين، إشارة إلى بداية أزمة انحطاط الشرق نحو الهاوية وبداية مأساة العرب.
جاء الحوار في النّص بلغة بسيطة سهلة، وفيه ملامح الإستغراب والدهشة، والأُسلوب الساخر.
جاءت فكرة النص في النهاية عند تغيير مسار النقد السياسي لنقد الهمّ الثقافي للتعبير والاحتجاج على حالة المثقف، الذي لم ينصفه الشرق، ربما لم لو استغنى عنها الكاتب لكان أفضل؛ لأنها جاءت غير مناسبة في وضعها في النهاية، كأنه انتقل سريعا لفكرة أُخرى تحتاج للتفاصيل.
وكتبت خالدية أبو جبل:
يطلّ علينا الضمير العربي الذي ما فتأ يكتب الشعارات ويتأرجح ما بين حلم وخيبة
وإرادة وخيانة، فما صورة هذا الموظف المسن إلا استحضارا لضمير المثقف العربي، الذي لا زالت الدهشة تحني ظهره، ولا يسعه أمام هذا الذهول إلا أن يكتب ويكتب كلاما لا يسمعه أحد، ولا يزداد هو إلا ضعف نظر بدليل ازدياد سمك النظارة الطبية، هو الضمير العربي الذي ظل قابعا يتغنى ببطولات وفتوحات ما كان قبل عام 1050هجري أي قبل بداية الحكم العثماني وتوالي الانكسارات والهزائم .التي خلّفت الفقر والجهل والتخلف والذعر والتهجير والاحتلال والشتات .
فكان هذا الضمير الذي تمثل في شخص سالم صدى لحلم ورغبة الشعب العربي عامّة والفلسطيني خاصة، والذي قام بدور هذا الشعب المُتعب الذي يتمنى الموت ولا يلقاه محمود عبد الملك وحده، وهو القائل:
فأنا طوال عمري أشعر بأني مئة إنسان في شخص واحد” إذن هو الشعب المغلوب على أمره. المتهم في كل الأحيان وتحت حكم أي كان من الحكام، فهو مدان إن كان علمه أحمر شيوعيا (قلم أحمر )، وهو مدان إن كان علمه أخضر، كناية عن الأحزاب والحركات الإسلامية، وما يلحق بها من وصفها بالإرهاب.
ولا يكون محمودا أبدا إلا إذا كان عبدا للملك!
يأخذنا هذا الحوار الغريب بين محمود” الشعب” وسالم ” الضمير” إلى المسافة غير الكبيرة بين ما يفكر به محمود وطريقة سالم في التعبير عنه .
حيث يلتقيان في حوار يصبُّ في نقد الأوضاع العربية المؤلمة على كل الأصعدة سياسية كانت أم أحتماعية واقتصادية أوثقافية.
من نفاق نابع من الخوف الأبدي من سوط الحاكم وسجنه، ومن خوف على لقمة عيش مرّة المذاق، عسيرة الهضم…
ومن ندم عقيم وتأنيب ضمير قاتل على “لا” لم تُقل في وقتها، ويخصُّ بها الشعوب العربية كافة، يوم ضياع فلسطين من أيديهم التي كبلتها قيود الأنظمة العربية وشُّح السلاح الصدئ أصلا.
هي قصة غرق ليلى ووقوف محمود عاحزا لأنه لا يتقن فنّ العوم! حتى صار يستعجل الموت للقائها في الآخرة؛ ليعتذر لها ويعانقها العناق الأبدي. شعب صار يرى خلاصه في موته كيف سيكون حاله في غزة الأسيرة؟ وما هو حجم التضحيات التي يقدمها لفك القيد؟ فإن لم ينعم بنصر على الأرض فاز بحرية في السماء.(المعتقد الديني في الحياة الأخرى بعد الموت).
ونرى حوارهما يقفز منتفضا لفترات قصيرة، لكنها هامة، مستذكرأن شجاعات من مروا على مرّ التاريخ العربي القديم والحديث، من خلال ذكر المتنبي ودرويش وادوارد سعيد ونجيب محفوظ، فذكر هؤلاء الأعلام بالذات له دلالته الكبرى
لتميّز رسالتهم الأدبية الإنسانية الثورية، على سبيل المثال لا الحصر، رواية أولاد حارتنا لنجيب محفوظ وما تحمله من انتقاد لتناحر الأديان وما تشير إليه أن طريق العلم هو الطريق الوحيد للنجاة.وفي حنظلة ناجي العلي التمرد الأبدي على الواقع المُغتَصِب لحق الانسان الفلسطيني.
وفي قول سالم عن درويش” درويش مضى هو الآخر، لكن قوافيه لم تكن عابرة”
هنا يظهر إيمان الكاتب متجليا، أن تغيير حال الأمّة يبدا بالوعي وهذا مهمة مثقفيها وأدبائها الذين ” يحاولون كتابة الإنسانية مرّة أخرى” كما قال محمود.
هي دعوة صريحة لإنقاذ الإنسان من خلال إنقاذ إنسانيته ومشاعره المحبطة التي باتت متلبدة أمام منظر غرق “المهاجرين غير الشرعيين الباحثين عن السعادة في الغرب البعيد”
ولا يكون هذا الإنقاذ إلا من خلال سكب الموسيقى في أذن البشرية لإعادة بناء الروح الساميّة التي تمكّنها من الرؤيا بوضوح، فلا ينبلج الضوء الّا من قلب الظلام.
” سالم: وماذا بعد أن تخيّم العتمة من حولنا؟
محمود: ينبلج الضوء من قلب الظلام.”
يموت محمود وهو واحد من المئة الذين عايشهم، ليبقى التسعة والتسعين، يستبشرون بصحوة ضمير كان قد شارف على الموت،
فها هي ورقة سالم( الضمير ) لم تسقط، وإن كان يفضل الموت واللحاق بمحمود طلبا للراحة، إلا انه ينهض متمردا ليمزق الأوراق والبيانات؛ ليتحرر من الوهم، فهو من قال :” كل شيء قابل للتغيير”.

وقالت رائدة بو الصويّ:
مسرحية فيها تحليق في الخيال، تفكير ذكي خارج الصندوق.
في المسرحية عرض فلسفي لمواطن مغلوب على أمره . مظلوم
تحت ضغط نفسي كبير، يحلم بالراحة الأبدية والهدوء والسكينة، ولكنه وجد بعد الموت حسابا طويلا، كما جاء بالآية الكريمة:” إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا” صدق الله العظيم.
الكاتب متأثر بالأدب الغربي في المسرحية، مساحة واسعة للتفكير، مزيج دنيوي وأخروي. الكاتب عقد لنا الموت، المسرحية مثيرة وجميلة.