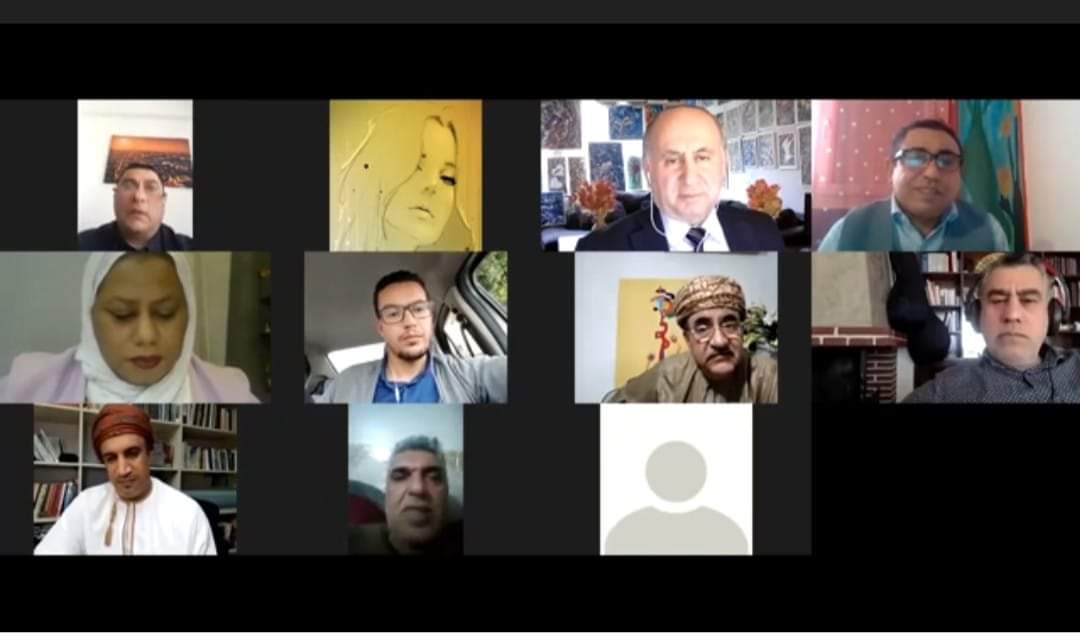مَاهِيَّةُ الإِنْبَاءِ الكَوْنِيِّ: سُفُولُ الغَمِيرِ عِلْمًا أَمْ أُفُولُ الضَّمِيرِ غَلْمًا؟ (2)

د. آصال أبسال | كوبنهاغن (الدنمارك)
مرَّةً أُخرى بعد زمانٍ ليسَ بالقصيرِ ولا بالمديدِ، وعلى ضوءِ ما استجدَّ من «جديدٍ» منذ صدورِ الشكلِ الأولِ من هذا المقالِ «الشَّديدِ»، إنه، بادئ ذي بدءٍ، لَعَيْنُ السُّفُولِ العلميِّ غامرًا غَمْرًا غَمِيرًا على كلٍّ من المستويَيْن الكمِّي والكيفي، قبل أيٍّ من المستويات المعيارية الأخرى، هذا السُّفُولِ العلميِّ الذي يتجلَّى بشكلِهِ الأجلى في فحواءِ الانحطاط الثقافي بالحرف وبالمجاز: وتلك حقيقة سافرة صارخة من حقائق الصحافة العربية «الرسمية» التي لم تعد تحتاج إلى أيما إثبات قطعي، أو حتى غير قطعي، في هذه الأيام العصيبة من زماننا العربي السليب.. فعلى سبيل المثال، لا الحصر هنا، وفي مساء ذلك اليومِ المحزون بالذات قبل حولين ونيِّفٍ، اليومِ السابع والعشرين من شهر كانون الأول (ديسمبر) عام 2019، صدر أيضا في صحيفة «القدس العربي» الغنية عن التعريف بـ«استقلالها السياسي»بالمعنيين النفاقي والازدواجي الصارخين تحديدا، وبانتهاكها الأخلاقي الزَّرِيِّ لحقوق القراء والقارئات في التعليق تصعيدا، صدر تقرير صحافي منضودٌ على شاكلة مقال إنبائيٍّ من مقالات «الرأي الثقافي»، فيما يظهر للعيان، ومسرودٌ تحت عين العنوان التالي متسربلا بسربال طباقي نقدي تهكُّمي، أو يكاد، «رفعت سلام: الشاعر الجميل والدولة المريضة».. والمقرِّرُ الذي تجشَّم عناءَ هذا «التنضيد» وهذا «التسريد»، فيما يبدو كذلك، كاتبٌ صحافي من أسرة تحرير الصحيفة المعنية، صحيفة «القدس العربي» بالذات، كاتبٌ صحافي (ثقافي) ستيني يحمل الاسم المركب، حسام الدين محمد، ويدَّعي، في جملة ما يدَّعي، بطبيعة الحال، بأنه «شاعر» و«ناقد» و«كاتب» في العديد من المجالات الفكرية الأخرى، بما فيها مجالُ الفلسفة (أو، بالأحرى، «التفلسف») وحتى مجالُ علم النفس (أو، بالأحرى، «التنفُّس») بصيغتيه الفرويدية وغير الفرويدية (يُنظر، أيضا، مقالي الآنفُ المعنيُّ: «إشكالية الإعلام الثقافي: غَمْرُ الانحطاطِ الغَمِير دونما وخزِ الضَّمِير!»، من إصدار «عالم الثقافة» في يوم 15 أيلول (سبتمبر) عام 2020)..
وبقولٍ جدِّ وجيزٍ يحاول ألا يغمطَ أيةً من الفكرات الرئيسية المطروحة حقَّها، يقرِّر المقالُ الإنبائيُّ المعنيُّ (بالمعنى التقريري المسطَّح) عن مجريات تلك المقابلة المصوَّرة التي قد أُجريت إبانَئذٍ مع الشاعر والمترجم المصري، رفعت سلام، بصفته «شاعرا جميلا حالته مع الدولة المريضة المصرية [إنما] هي مقطع حاد يلخص كل أحوالنا العربية»، كما ورد في الختام بالحرف، هكذا (مع وجوب ذكر التمنِّي الأخلاقي له، من نافل القول، بالشفاء العاجل من داء السرطان الرئوي، ولو كان أملا إبليسيا في الجنة، وذلك قبل أن وافته المنيَّة في اليوم السادس من شهر كانون الأول (ديسمبر) عام 2020).. وفي هذا الصدد، يشير المقالُ الإنبائيُّ المعنيُّ إلى وقوع اختيار الراحل رفعت سلام على ثلاثة من الكتب التي تتبدَّى، في نظره، من الأهمية الشديدة ما يستحقُّ هذا الاختيار فعليا، وعلى الأخص، وهنا النقل المؤاتي من تقرير حسام الدين محمد، كما جاء بالحرف الواحد أيضا، «كتاب «فجر الحضارة» للكاتب البريطاني جيمس هنري برستيد، وهو كتاب يبين المساهمة الأساسية، التي قدمتها الحضارة المصرية القديمة في تأسيس المفاهيم المرجعية الإنسانية للأخلاق، وباختياره هذا يضع الراحل رفعت سلام الأخلاق، التي هي الفكرة التي نادت بها أغلب الأديان والإيديولوجيات والدول والاجتماع البشري، والصفة التي يفترض أنها تميز الإنسان عن بقية كائنات العالم غير العاقلة».. وهكذا، فإن لدينا هنا في هذا التقرير «الثقافي» اليتيم على الأقل، إذن، دليلين ملموسين دامغين يدلان على مدى سُفُولِ العلم وميداءِ انحطاط الثقافة «القدساويين» اللذين نحن في معرض الكلام عنهما (وذلك نسبةً إلى صحيفة «القدس العربي» بالذات، وتجنُّبا لأيما التباس، أو أيما سوء فهم، كان) – وأيةً كانت، بالطبع، «إنسانونيةُ» الكلام الاستعطافي والاستهجاني، من طرف المقرِّر «الثقافي» ذاته، على مشكلات البؤس البيروقرطي التي اقترنت بالتعامل الرسمي، أو الدَّوْلي، مع الحالة الصحية الخطيرة التي تعتري كتَّابا مبدعين، من أمثال الراحل رفعت سلام، تلك «الإنسانونية» التي لا تعدو، في حقيقة الأمر، أن تكون غطاء تمويهيا، لا بل قناعا إيهاميا، عن مدى السُّفُولِ العلمي وميداءِ الانحطاط الثقافي «القدساويين» نفسيهما.. لدينا، أولا، ما يمكن أن نسميه، في السياق الماثل، بـ«الدليل التوثيقي» Documentational Evidence،الدليل الذي يتعلق مادِّيا بنوعية توثيق المعلومة، أو مجموعة المعلومات، المعنية، من جهة أولى.. ولدينا، ثانيا، ما يمكن أن ندعوه، في السياق المقابل، بـ«الدليل التوصيفي» Characterizational Evidence، الدليل الذي يتعلق معنويا بنوعية توصيف هذه المعلومة، أو مجموعة المعلومات، من جهة أخرى..
فأما من حيث «الدليل التوثيقي»، في القرينة الماثلة ذاتها، فإن القول بوقوع الاختيار المذكور على «كتاب «فجر الحضارة» للكاتب البريطاني جيمس هنري برستيد»، لَقولٌ فيه جهلٌ مطبق كلَّ الإطباق، جهلُ قائله المقرِّر المذكور أيضا، بتوثيق معلومة كلٍّ من شقَّيه الظاهريَّيْن في تعبيره الحالي، معلومة «الكتاب» ومعلومة «الكاتب»، على حد سواء: فعنوان الكتاب هنا، في معلومة الشق الأول، ليس «فجر الحضارة»، كما يُبَيِّن اللصق والنسخ الأعميان، أو ما شابه، من لدن القائل المقرِّر الجاهل، بل «فجر الضمير» بالذات، أو حتى بأسوأ الأحوال «فجر الوعي» كاحتمالٍ آخرَ ممكنٍ، كما يَبِين من أصله الإنكليزي The Dawn of Conscience، أو حتى من مقابله الفرنسي، بقدر ما يخصُّه الأمر كذلك.. وشتَّانَ، والحالة هذه، بين العنوان الأول بمدلوله «العمراني» (على الأدنى، من المنظور التعريفي لهذا الاصطلاح عند ابن خلدون، ومن تأثَّر به من بعده)، من جانب أول، وبين العنوان الأخير بمدلوله «الوجداني» تعميما، أو حتى بمدلوله «النفساني» تخصيصا (من المنظور التعريفي لهذا الاصطلاح عند زيغموند فرويد، الذي قارن اللاوعيَ «البيولوجي» تحت قشرة الدماغ باللاوعيِ «الجيولوجي» تحت قشرة الأرض)، من جانب آخر – هذا إن لم نقل أيَّ شيءٍ مُشَيَّأ عن تحفُّظ الباحث العلمي الموضوعي الجادِّ (على النقيض الكامل من القائل المقرِّر الجاهل، على الأضأل)، حول مسألة التعويل على التقييم «الإنساني»، أو حتى «الأخلاقي»، الذي ينبني على أي شكل مُسَيَّس من أشكال الشعور «القومي»، أو حتى «الوطني».. واسم الكاتب هنا، في معلومة الشق الثاني، علاوة على ذلك كله، ليس «الكاتبَ البريطاني جيمس هنري برستيد»، إن تواجد هذا «الكاتب» حقا في هذه الحياة الدنيا، أو حتى في تلك الحياة العليا، وإنما «عالمُ الآثار و«المؤرِّخ» الأمريكي جيمس هنري برستيد (1865-1935)»، هذا العالمُ الذي قد ركَّز تركيزا خاصًّا، من خلال جهد تأريخي علمي تخصُّصي مديد (يربو عن العقد من الزمن)، قد ركَّز على ما يُعرف بـ«علم الآثار المصرية» Egyptology، والذي بسَّط، أو بالحريِّ أشاع، ذلك المصطلحَ الجغرافي-السياسي المعروف الآن بـ«الهلال الخصيب» Fertile Crescent، لكي يشملَ بالتوصيف أجزاءً معيَّنة مما يُعرف الآن كذاك من العراق وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن وتركيا وإسرائيل (بحسب المدلولات الاستعمارية والإمبريالية التي أُضفيت على هذا المصطلح، على مرِّ الزمان، هذا إن كانت لدى القائل المقرِّر الجاهل أية فكرة عن هكذا إضفاء دلالي بأية هيئة كانت)..
وأما من حيث «الدليل التوصيفي»، في القرينة المقابلة ذاتها أيضا، فإن القول بأن فكرة الأخلاق، كما تمَّ ذكرها أمام كلٍّ من الضمير الفردي (ضمير القائل المقرِّر الجاهل، في هذه الحال) والضمير الجمعي (ضمير القارئ المُجَهَّل، في هذه الحال)، إنما «هي الفكرة التي نادت بها أغلب الأديان والأيديولوجيات والدول والاجتماع البشري، والصفة التي يفترض أنها تميز الإنسان عن بقية كائنات العالم غير العاقلة» لَقولٌ فيه جهلٌ مطبق حتى أشدَّ إطباقا مما سبقه قبل قليل، جهلُ قائله المقرِّر المذكور أيضا، بمعلومة كلٍّ من جانبه السردي، أو «النقلي»، وجانبه الشرحي، أو «العقلي»، في تعبيره الحالي كذلك، معلومة «الفكرة من حيث المبنى» ومعلومة «الفكرة من حيث المعنى»، على حدٍّ سِوًى: فمنظومة الأخلاق هنا، في معلومة الجانب السردي، أو «النقلي»، ليست منظومة أفكار يُفكَّر فيها أو بها حتى «[تنادي] بها أغلب الأديان والأيديولوجيات والدول والاجتماع البشري»، كما يُبَيِّن اللصق والنسخ الطَّلِيسَان، أو ما شابه، من طرف القائل المقرِّر الجاهل، بل منظومة عادات يُعتاد عليها من زوايا سلوكية و/أو قيمية تختلف من مجتمع بشري إلى آخر ومن منعطف زمني إلى آخر، كما يَبِين بنحوٍ أو بآخر حتى من الأصل اليوناني القديم إزاءَ كلمة «خُلق» ἦθος، التي تعني حرفيا «عادة» أو «صفة» أو حتى «ميزة».. وحتى فيما يُسمَّى في الفرع الإنكليزي بـ«الأخلاقيات» Ethics (أو في مقابله الفرنسي كذلك)، شتَّانَ شتَّان، والحالُ هذه، بين البعد القانوني لهذه «العادة»، أو منظومة «العادات»، حين يخصُّ الإنسانَ من أمام سلطة خارجية معيَّنة (كأيَّة سلطة من سلطات الطبقات الحاكمة الاستبدادية، في بلادنا، والأقلِّ استبداديةً، في غيرها)، من ناحية أولى، وبين البعد الأخلاقي لهذه «العادة»، أو منظومة «العادات»، ذاتها حين يخصُّ الإنسانَ من قدَّام سلطة داخلية لا تتجلَّى إلا في «سلطة» الضمير الإنساني، وليس إلا في «سلطة» الضمير الإنساني، في أي مكان وفي أيما زمان كان، من ناحية أخرى.. ومنظومة الأخلاق هنا، في معلومة الجانب الشرحي، أو «العقلي»، فضلا عن ذلك كله، ليست تتمثَّل في تلك «الصفة التي يفترض أنها تميز الإنسان عن بقية كائنات العالم غير العاقلة»، كما يتابع اللصق والنسخ الطَّلِيسَان، أو ما شابه، من طرف القائل المقرِّر الجاهل، وإنما تتمثَّل في هذه الصفة التي تشترك فيها كافة الكائنات الحية من ذوات «العقول» ومن ذوات «اللاعقول»، ودونما الاستثناء، ما دامت منظومة العادات التي يُعتاد عليها من زوايا سلوكية و/أو قيمية محدَّدة لَهي المنظومة القائمة في هذه القرينة المقابلة بالذات..حتى أن زيغموند فرويد المُشارَ إليه أعلاه قد برهن بالبرهان العلمي القاطع، في عدد من القرائن النفسانية، على حقيقة أن «أخلاقياتِ» الحيوان، أيا كان، إنما هي أسمى وأرقى بكثير من «أخلاقيات» الإنسان، أيا كان، كذلك (وتلك مسألة أُخرى سيأتي الكلام عنها من يراع تخصُّصي، في المكان المناسب)..
هذان، إذن، دليلان ملموسان دامغان يدلان على مدى السُّفُولِ العلمي وميداءِ الانحطاط الثقافي اللذين تعمه فيهما صحيفة «قدساوية»مأجورة لا تني تتبجَّح بموقعها «الطيب» من بين خيرة الصحف الأخرى أمام العالم العربي،ولا تني تتفخفخ من ثم بسمعتها «الطيبة» في النقل «الدقيق» وفي التحليل «العميق» للمعلومة أو للخبر المعنيَّيْن قدَّام العالم العربي وغير العربي حتى – ناهيك، مثلاً لا حصرًا، عن تلك المجلةِ السافلةِ المنحطَّةِ التَّبُوعِ المدعوَّةِ بـ«المجلة الثقافية الجزائرية» التي تتحلَّى بذاك الطاقم الوضيع من الذكور الآسِنينَ الوَضِرينَ والجَهُولينَ كـ«فَلِّ تحريرٍ» أوضعَ، وما ينشرونه من موادَّ مكتوبةٍ بمستوًى متدنٍّ أيَّما تدنٍّ من حيث الطرح الفكري و/أو الأدبي، وكذاك من موادَّ مترجَمةٍ (والأردأ من ذلك كلِّهِ) بمستوًى أكثر تدنِّيًا بكثيرٍ حتى من حيث العرض اللغوي و/أو النحوي.. والأشدُّ سُفُولا علميًّا وانحطاطا ثقافيا وإنسانيا وأخلاقيا في الغَمْرِ الغَمِيرِ من ذلك كله حتى أن القائل المقرِّر الجاهل الدعي، حسام الدين محمد هذا، يختتم تقريره «مستنكرا» بما يدَّعيه من «العدل» من خلال الاقتباس من التصريح المستنكِر لحقيقة ذلك الجحود التمويلي الرسمي، أو الدَّوْلي، إزاء الوضع الصحي الخطير الذي ابتُلي به الراحل رفعت سلام آنئذٍ، وأنه (أي القائل المقرِّر الجاهل الدعي، حسام الدين محمد هذا)، في الوقت نفسه، يغفل، أو يتغافل (دونما أية غلمةٍ، أو وخزةٍ، من الضمير يتيمةٍ)، عن حقيقة ذلك «السخاء الحاتمي» التمويلي بالملايين من الريالات القطرية (بالعشرات وحتى بالمئات، وبغيرها) من أجل سير صحيفة «قدساوية» مرتزقة بكل ما يحتويه «الارتزاق» من معنى زري، صحيفة تنشر هكذا سُفُولا علميًّا وهكذا انحطاطا ثقافيا يندى لهما الجبين، ومن خلال تمثيل هكذا قائلٍ مقرِّرٍ جاهلٍ دعيٍّ ليس من كل ما يدَّعيه بأنه «شاعر» و«ناقد» و«كاتب» في شيء.. كما علمتُ حينَها من شيءٍ من التعليق التهكُّمي الساخر، ها هنا، «قَزَمٌ زِمِكٌّ وأَكْچَلُ فاقعٌ وقبيحٌ يتكلَّم اتِّجارا دنيئا دَنِيًّا بالأخلاقيات وبالجماليات عن شاعر جميل»!!..
وعلى فكرةٍ، في الأخيرِ هنا أيضا، فإن السُّفُولَ العلميَّ والانحطاطَ الثقافيَّ المبتَنَيَيْنِ بهكذا أسلوبٍ وضيعٍ بَخْسٍ ليسا مقصُورَيْنِ مقتصرَيْنِ على معشر هؤلاء الكتبةِ الصحافيين و/أو الإعلاميين وحدهم، بل هما جدُّ فاشيَيْنِ متفشِّيَيْنِ كذلك بين معشر أولئك الدَّجَّالين الأدعياءِ من أشباهِ «الطبابيِّين»(أو، بالأحرى، معشر أولئك الدَّجَّالين الأدعياءِ الذين يدَّعونَ طَفَالةً وجَهَالةً بأنهم «طبابيِّون» لا أشباهُهُمْ).. فعلى سبيلِ المثالِ لا الحصرِ، في هذا السياق، يظهر الآنَ، كما كانَ يظهرُ من قبلُ، على السطح لاجئٌ (أو، بالحَرِيِّ، منتهزٌ غسيفٌ لقيطٌ «عَكُوفٌ» للِّجُوءِ في ألمانيا) عسيفٌ نقيطٌ عَتُوفُ الحاجبينِ تنطُّ أيَّما نطيطٍ إرسالاتُهُ «الفيسبوكية» المكتظةُ بالعباراتِ المسروقةِ عمدًا من هنا أو من هناك، تنطُّ فجأة من آنٍ لآنٍ، لاجئٌ (أو منتهزٌ غسيفٌ لقيطٌ «عَكُوفٌ» للِّجُوءِ) عسيفٌ نقيطٌ عَتُوفُ الحاجبينَ يكتبُ عن نفسهِ بكلِّ ثقةِ نفسٍ بأنه «طبيب نفسي»، وكلُّ ما يخطلُ به من خطلٍ أجوفَ أعجفَ عن «نفسية» المرأةِ وعن «نفسية» الرجلِ وعن ماهيةِ الكذب عند كلٍّ منهما وعن كيفيةِ «إيقاع» أحدهما بحبال الآخر، وما شابهَ من هذا، بتعميماتٍ جارفةٍ جوفاءَ عجفاءَ ما أنزلَ اللهُ بها من سلطانٍ، خطلٍ لا يعدو أن يكونَ خطلاً عنصريًّا ذكوريًّا متخلِّفا قميئًا مقيتًا بكل ما تحتويه هذه الكلماتُ من معنى ومن حتى ظلالِ معنى، وحتى قبل أن ينأى كذلك كلَّ النأيِ عن أيِّ شيءٍ آخَرَ له مساسٌ بما يُسَمَّى بالاصطلاح المغلوطِ أصلا بـ«الطب النفسي».. والأنكى من ذلك كلِّهِ، فوق كلِّ ذلك، أن هذا اللاجئَ النغيلَ (أو المنتهزَ اللُّجُوءِ نُغُولَةً) بوصفِهِ مثالاً مَرَضيًّا نفسيًّا نموذجيًّا من أمثلةِ ما يُعرفُ اصطلاحًا كذاك في علمِ النفسِ تعيينًا وتحديدًا بـ«الشخصية الشرجية»، بالحرفِ، أو حتى بـ«الشخصية الإستية» Anal Character،بالمجازِ، يكتبُ عن نفسِهِ مفخورا ومتباهيًا ومتبجِّحًا بأنه عينُ «المدير الطبي للهيئة العامة لمستشفى ابن سينا سابقا»، راغيًا كلَّ الرَّغْوِ كذاك بالترويجِ على صفحتهِ المكتراةِ بين إرسالٍ وآخَرَ لما رُوِّجَ، في الأساسِ، من قبلُ عن كلِّ أولئك السفلةِ الوصوليِّين والانتهازيِّين من أسيادِهِ ذواتهِمْ حينما كان، كما عهدِهِ ولمَّا يزلْ بعدُ، كالعبدِ الذليلِ السفلِ والفسلِ الحقيرِ ينفِّذ تنفيذًا بالحذافيرِ كافَّةَ الأوامرِ والنواهي التي كانت تأتيهِ إتيانًا منهم بالشخوصِ، بعدَ أن كانوا هم أنفسُهم كالعبيدِ الأذلَّاءِ السُّفَلاءِ والفُسَلاءِ كذلك قد نفَّذوا تنفيذًا بالحذافيرِ سَائرَ الأوامرِ والنواهي التي كانت تأتيهم مأتاةً، وأكثرَ منها حتى، من أولئك السفلةِ الوصوليِّين والانتهازيِّين من أسيادِهِمْ، بدورِهِمْ هُمُ الآخرون!!..
———–
تعريف بالكاتبة
ولدتُ في مدينة باجة بتونس من أب تونسي وأم دنماركية.. وحصلتُ على الليسانس والماجستير في علوم وآداب اللغة الفرنسية من جامعة قرطاج بتونس..وحصلتُ بعدها على الدكتوراه في الدراسات الإعلامية من جامعة كوبنهاغن بالدنمارك.. وتتمحور أطروحة الدكتوراه التي قدمتها حول موضوع «بلاغيات التعمية والتضليل في الصحافة الغربية» بشكل عام..ومنذ ذلك الحين وأنا مهتمة أيضا بموضوع «بلاغيات التعمية والتضليل في الصحافة العربية» بشكل خاص..