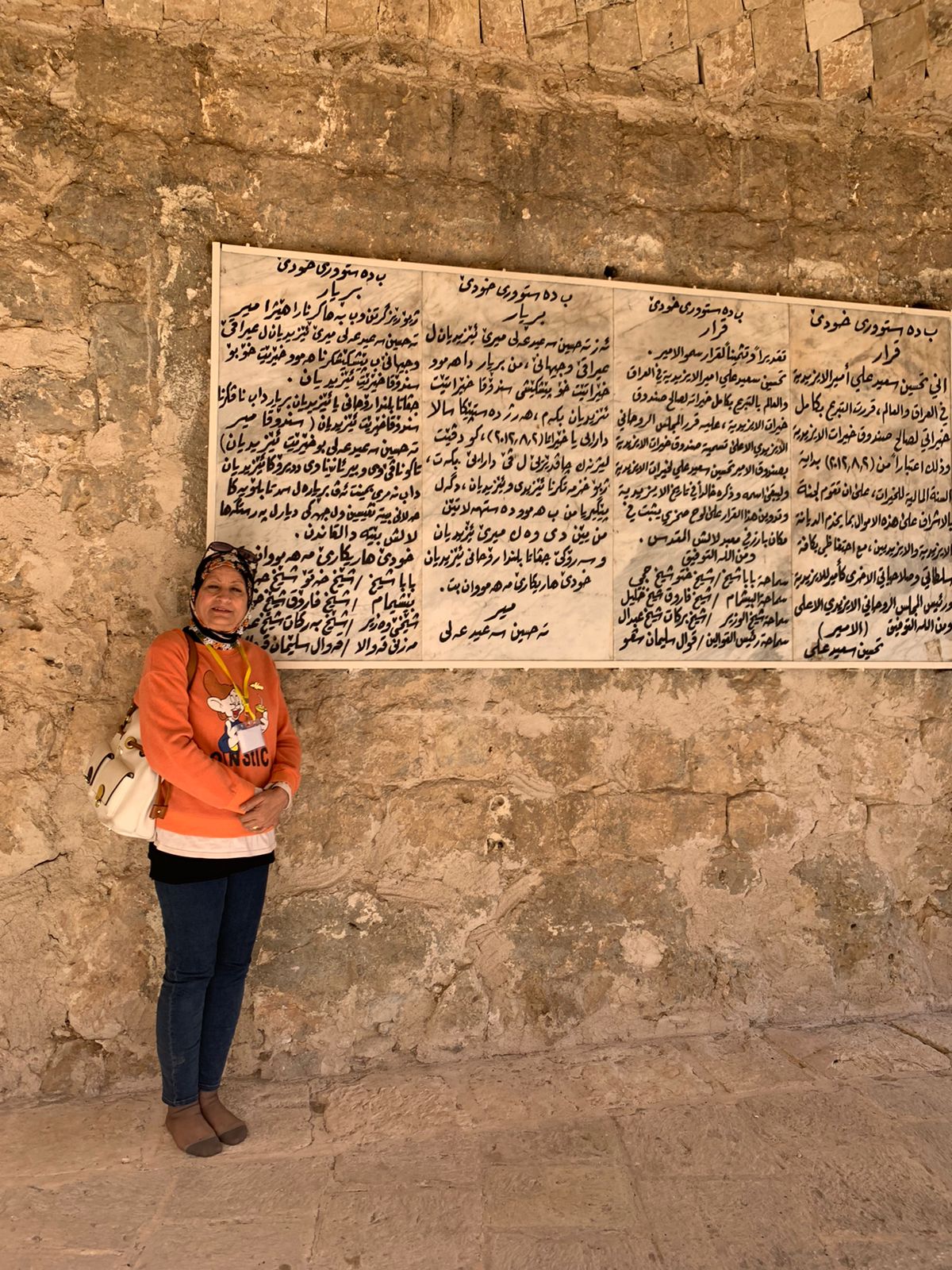الشاعرة السورية ريما حمزة والإعلامي الأديب خالد دريك وجهًا لوجه
ريما حمزة: نجاحي مُوغِلٌ في الرؤية والوعي.. وصوتي لا تصنعه الرغبات العابرة

(ريما): أنا ابنة التجربة لا التنظير.. والكتابة نداءٌ لا مفرَّ منه
بين صرامة التفكير المنطقي ورهافة الحس الموسيقي، تشيد الأديبة السورية معمارًا إبداعيَا فريدَا، لا يكتفي بملامسة السطح بل يغوص في ماهية الكينونة والوجع الإنساني. هي الأكاديمية المسكونة بأسئلة الفلسفة، والعازفة التي تدرك لغة الأوتار، والشاعرة التي طوعت الحرف ليكون مرآة لنضجها وتأملاتها الطويلة قبل أن تقرر الانعتاق نحو فضاء النثر. وفي مسيرتها، ورغم تعدد مشاربها، تنحاز لعمق التخصص، مدفوعة بوعي حاد ومسؤولية تجاه الكلمة التي لا تراها مجرد ترف، بل فعل مقاومة وجودية، هي القائلة بكبريائها الأنثوي: “أنا الكلمةُ التي لم تُكتبْ بعدُ.. أنا امرأةُ اليقينِ واختبارُ القلوبِ التي لا تعرفُ المجازَ.. أنا الأُنثى التي لا تنتظرُ، بل تُضيء.. تروّضُ جُرأةَ العاصفةِ إلى طِفلةٍ تقطفُ الفراشاتِ والضحكاتِ معاً.”
تتعدد مساراتها الإبداعية لتشمل الشعر والمقال والقصة والرواية، ولها حضور لافت كإدارية ومحررة في العديد من المنصات والصحف الأدبية الدولية. تنتظر المكتبة العربية حاليَا ولادة عملين جديدين لها: مجموعة شعرية بعنوان (الخيط الذي صار وترَا)، ورواية قيد الطبع، بالإضافة إلى كتاب يضم دراسات نقدية تناولت تجربتها الخاصة. شاركت في العديد من الكتب الجماعية والأنطولوجيات الدولية، كما ترجمت نصوصها لعدة لغات، مما منح صوتها جواز عبور نحو الجغرافيا العالمية، لتمضي في لغتها كمن يعيد صياغة الوجود، وهي القائلة في إحدى قصائدها: “يجرُّ الجمالَ إلى مأمن ظلهِ.. ويعلّمُ الوترَ طعمَ أصابعهِ.. ويقفُ على شرفتهِ لغةً مكتملةً، ومدىً لا يُترجم.”
ريما حمزة، شاعرة وكاتبة سورية، تجمع في خلفيتها العلمية والإبداعية بين ماجستير العلوم الفلسفية، ودراستها الموسيقية الأكاديمية في المعهد العالي للموسيقى اختصاص (وتريات).
حاورها: خالد ديريك
بين رهف الروح وجموح السؤال
عن تكوينها الذاتي وانصهار “ريما” الإنسانة في “ريما” الشاعرة الأديبة، ترسم لنا ملامح تلك الهوية قائلة:
“اسمي “ريما” يحمل طبعي، وفطرة الله فيهِ خفّة الغزالة وجموحها، وامتداد الظل، ورمزيّة النقاء المَشوب بالقلق، من طفلةٍ لا تريد أن تكبر إلى مراهقة سرقتها عوالم الكتب، ودهشتها الأولى أمام فتنة اللغة؛ حتى اصطدمت بأسئلتها الخاصّة والكبرى في آنٍ واحد ، وعوالمها التي تشكّلت عبرَ الألم والفَقد والنضج، فغدت ابنة التجّربة والواقع لا التنظير، الّتي تؤمن أنَّ الألم ليس عثرةً، بل معبراً، وأنَّ الخسارات الفادحة تُهدينا البصيرة، أنتمي للصمت أكثر مما أنتمي للكلام، وللتأمل أكثر من الانفعال، وأشدُّ أزر روحي لتكون حاضرة في دائرة النبض الشعري الحقيقي.”
بواكير القلم … فلسفة الصمت والتريث
بدأت رحلتها مع الحرف في عمر مبكر، مختارة النضج الهادئ بعيدَا عن أضواء النشر، حيث استحضرت تلك البدايات قائلة:
“منذ أيام الدراسة الأولى، كان قلمي يكتب، لكنّه لم يكن يصرخ، كنت أكتب خواطرَ، وشعرًا، وتأملاتٍ فلسفيةً تنغمس في عمق الإنسان، تنقّب عن جوهر الوجود، لم أنشر تلك النصوص؛ ليس لأن الخجل تملّكني أو لاتساع مساحة الخوف عندي، وإنّما كنت أكبر مع تجربتي بعيون الحرص والتريّث، ولأنني كنت أراقب بصمت نضج التجرّبة فاللغة عندي جرحٌ يستحق الوقت ليندمل ثم يشفى، والشعر وِجهة روحي قبل أن يكون كلمات تُقرأ.”
لحظة التحول … من الشغف الصامت إلى “نداء النص”، وعقب مرحلة من التأمل، انعتقت ريما من صمتها لتدخل فضاء التحقق الإبداعي الفعلي:”في هذه المرحلة من الصمت المُنتظر جاءَت نصوصي الشعرية التي كانت علامة تحوّل حقيقية، وعلى سبيل المثال؛ فإن نصّ (نغادرها ولا تغادرنا بيوتنا القديمة) كتبته كمن ينفجر من الداخل بذاكرة لا تذوب، وأنا أعلم أنّي خرجت من مرحلة الشغف الصامت إلى مرحلة الفعل والتحقق، ومن دائرة الانتظار إلى نداء النص نفسه.”
مرافئ الدعم … البيئة الحاضنة للانطلاقة، وتعزو ثبات خطواتها الأولى إلى الملاذ الأسري الذي منحها أدوات الثقة والعبور:”كل ما تقدّم تهيأ لي في جو أُسريّ حميميّ داعم، وبيئة حاضنة تزرع الثقة وتعزز الدوافع، وتهيأ الأسباب والأدوات لانطلاقة واثقة.”
الجمع بين العلوم الفلسفية والوتريات
تتقاطع في تجربتها صرامة الفلسفة مع رقة الأوتار، وعن هذا التمازج الفريد توضح الشاعرة ريما كيف تنصهر هذه العوالم في بوتقة قصيدة:
“لا تمضي آفاق السؤال الفلسفي في جنوح عندما تنضوي في تفاصيل الغموض الشعري، فالشعر والفلسفة لغتان انزياحيتان تتداخل بينهما المعارف الإنسانية وتساؤلاتنا المشروعة، اللغة الشعريّة الغنيّة والصور البلاغية القويّة تعبران عن الأفكار الفلسفية العميقة، وكذلك الفلسفة والموسيقى تتقاطعان في دراسة طبيعة الوجود والجمال، وتأثير الفن على النفس البشرية، واستكشاف المعاني العميقة.”
وعن الشعر بوصفه منطقة الالتقاء الوسطى بين العقل واللحن، تضيف:
“الفلسفة والموسيقى متكاملتان؛ فبينما تحاول الفلسفة فهم الموسيقى بعقلانيّة، تعمل الموسيقى على إيصال ما يعجز العقل عن إدراكه، وكلاهما يسعى إلى البحث عن الحقيقة والارتقاء بالإنسان، وهنا يأتي الشعر ليكون (المايسترو) الذي يناغم هذا (الهارموني) في هيئة قصيدة.”
الشعر.. “مقاومة ناعمة” في وجه الفوضى
لا تعتبر الشاعرة ريما الشعر ترفَا فائضَا عن الحاجة، بل جرس إنذار يعيد صياغة الوعي في زمن الأزمات، وحول قدرة اللغة على إرباك الواقع وتغييره، تجيب:
“اللغة الشعرية تُعيد تشكيل وصياغة الواقع عبر الإيحاء والرمز وإثارة الوجدان العام، وتقدّم رؤى جديدة للحياة من خلال تعبئة القرّاء وتحفيزهم على التفكير والتأمل والمواجهة، ومن جهة أخرى فإن تقاطع التجربة الذاتية مع الوعي الجمعي يسائل المعنى؛ فحين يكتب الشاعر هو لا يوّثق أفكاره فقط، بل يعيد تشكيل ذاكرة الناس وإيقاظها من سباتها، فكل كتابة هي بحث عن المعنى في فوضى الوجود.”
بين الوجع وصوت “النابض الخاص”
عن الانعتاق من سطوة المرجعيات الأدبية الكبرى وتشكيل هوية مستقلة في زمن الصخب، تؤكد ريما تمسكها بصوتها الذي لا يقبل أن يكون نسخة مكررة:
“منذ البداية أدركتُ أن الشاعر إن لم يكن في قلب الوجع؛ فلن يصل إلى قلب اللغة؛ فتحوّلتُ من حالة التأملٍ الطويل في الهامش إلى مواجهة مباشرة في المركز، ولم أعد أكتب لأنّي أُجيدُ الكتابة، بل أكتب لأني وجدتُ نفسي مسؤولة عن صوتٍ يُطالبُ بأن يُسمَع في زمنٍ أُصيبَ الشعر فيه بالارتباك، وهذا الزمن تتشابه فيه الأصوات كما تتشابهُ أجناس الحداثة فوق سفينة نوح، زمنٌ صار فيه الضجيج أكثر من الشعر، وصارت القصائد أقرب إلى الإعلانات المموّلة منها إلى الانخطاف الحقيقي بالكلمة، وفي هذا الزمن تبرز الحاجة إلى كتابةٍ لا تُعنى بإرضاء المتلقّي إنّما تحقق له قيم التغيير، لذا اتخذتُ لنفسي صوتًا يُشبهني وحدي حتّى لا أكونَ شاهد زور على عصري، أو مجرّد صدفة على طاولة قِمار ثقافي، أو واحدة من النُسخ الكربونية لأشباه الشاعرات والشعراء.”
التخصص والأجناس الأدبية
حول تعدد القوالب الإبداعية في تجربتها، وكيفية المفاضلة بين الأجناس الأدبية للتعبير عن الفكرة، تبين وجهة نظرها:
“التنوّع يُثري التجربة الأدبية بلا شك، وفطرة المُبدع تدفعه لاختيار الجنس الأدبي الذي يُلبي متطلبات الفكرة، فالتنوّع يصل لشرائح أوسع، ويحقق الاستيعاب لتجارب مختلفة، ولا بأس في التجريب لتطوير المهارات والأدوات وتفريغ الأفكار إلا أنني أفضّل التخصص، لأنه يقود للتمايز والاختلاف والفرادة.”
“تقاسيم على فجر قريب”… قصيدة عابرة للحدود
عن وصول نصوصها إلى لغات أخرى، وتحديدَا قصيدة “تقاسيم على فجر قريب” التي حققت انتشارَا عالميَا، تستقرئ الشاعرة ريما سر هذا السحر الوجداني قائلة:
“ما يميّز قصيدة (تقاسيم على فجر قريب) أنّها تُقدم نموذجًا للتعامل مع الفكرة المركزية الّتي تتفرّع منها ومضات تمثّل انعكاسات متعددة ومتنوعة لهذه الفكرة. لكل ومضة شخصيّة مستقلّة رغم ارتباطها الوثيق بالمحور الرئيس، ولكل ومضة مدلول يرتبط بزاوية كاميرا تصوّب لحظتها نحو المشهد حيث تضخ قوّة الرمز في استنطاق الوقائع، وكل ومضة تضيف رؤية وبُعدًا جديدًا للنص مما جعله لوحة متكاملة تعبّر عن تجارب إنسانية وروحانية متنوّعة بالربط بين الأفكار والجمل وصور مبتكرة صاغت نمطًا جديدًا من تفريغ الومضات.
ومع الترجمة الاحترافية التي يصفها جورج ستاينر بـ (الشكل الأسمى للقراءة) تحوّلت القصيدة إلى كائن عابر للحدود، يُعيد تشكيل هويته في كل عبور، ويُظهر قابليته لأن يكون منتميًا لكل العالم، لا إلى جغرافيا بعينها.”
بين رحابة السرد وامتحان “الوتر”
عن انتقالها إلى عالم الرواية، وما يمنحه النثر من مساحات تتجاوز كثافة القصيدة، ترى الكاتبة ريما:
“في الرواية خروج عن قواعد السير وتجاوز للإشارات الحمراء، فالسرد النثري الطويل يسمح بتصوير معقّد للشخصيات وتطورها واستكشاف عميق للحبكات والأحداث في سياق اجتماعي أو تاريخي، ويسمح بتعدد الأصوات السرديّة، وهذا يخلق عالمًا متكاملًا غنيًا بالتشويق يُبنى بخيوط سردية طويلة تصل لأعماق النفس البشرية مما يجعلها فنًّا أدبيًّا غنيًّا ومؤثرًا.”
أما عن ملامح مجموعتها الجديدة (الخيط الذي صار وترَا). والرسالة الكامنة في أوتارها، فتؤكد:
“أما (الوتر) في مجموعتي فهو امتحان جديد للصدق، وبحث عن المعنى في تلافيف الذات، وتجربة امرأة تفكك العالم وتعيد ترتيبه على طريقتها، وفي كل قصيدة يجد القارئ عزاءه، وأسئلتهُ، وملامحه المخفية؛ فالوتر انحيازٌ للعمق على حساب الاستعراض.”
النقد .. القراءة التي تستولد النص من جديد
حول أثر المتابعات النقدية الأكاديمية في قراءة تجربتها وفك شيفراتها الجمالية، تراه على الشكل التالي:
“الاحتفاء النقدي في تقييمه للتجربة الشعرية وتحليل أبعادها الخفية وتفكيك بُناها الجمالية، يفتح آفاقًا جديدة لفهم عمق النص وتقدير فنيّات الشاعر، بل ويستولد حالة وصياغة جديدة للشعر؛ فمن خلال فك شيفرات الرموز وتحديد السياقات التاريخية والثقافية، يتم ربط النص بتجارب القارئ الذاتية.”
وعن ملامح “منهج الحفر الثقافي الجدلي” الذي تناول أعمالها تحديدَا، تبين:
“لقد قام منهج الحفر الثقافي بعملية تفكيك وتحليل دقيقة لبعض نصوصي، لافتَا إلى أنَّ الكلام لا يتحرّك على السطح، والمفردات لا تعالج بصفتها أدوات وصف عابرة بل تتحرك اللغة كأنها كائنً يتنفّس، يختبر آلامه، ويُعيد ترتيب ذاكرته.”.
انضباط الإدارة وتمرد الإبداع
وحول التوفيق بين روح الشاعرة المتمردة وانضباط المناصب القيادية والتحرير الصحفي، وما إذا أضافت لها هذه المهام شيئَا، قالت:
“الالتزام طبعي، والتحرير الصحفي كان امتدادًا لجو الابداع وإن اختلف الأسلوب والمُعطيات، فهو بيئة محفّزة تفتح آفاقًا جديدة لتتلاقى الأفكار وتتحاور الثقافات، وقد منحني فرصة النظر إلى عوالمي الأدبية من زاوية جديدة وصقل رؤيتي البعيدة، ومنح تجربتي الشعرية تقديرًا وجوازًا للعبور بدون تأشيرة.”
فوبيا المسؤولية وقدوة “الفينيق”
وبسؤالها عن مساحات الخوف وهواياتها وموسيقاها، أجابت:
“مخاوفي لا تتجاوز حدود الحرص والإحساس بالمسؤولية فقط،، لدي شغف مشبوب بالمطالعة وفضول استكشاف عوالم جديدة والتَّنزّه في عقول الآخرين وأفكارهم، بالإضافة إلى عالمي الأم (الموسيقى) الذي يأسر حواسي، فذائقتي الموسيقية منفتحة على كل ما هو فن حقيقي ويمسك بخيط روحي ولا ينحدر لمستوى (التطبيل)”.
حكمتها: أتبنى في حياتي كلمات الكاتب الإيرلندي الساخر ( جورج برناردشو) ” القاعدة الذهبية في الحياة أنّه لا توجد قاعدة ذهبية”. لأنها تختزل النسبية التي أؤمن بها.
قدوتها: كل امرأة خرجت من تحت الرماد كطائر فينيق.”
كلمة الختام
وفي ختام هذا الحوار، لخصت الشاعرة والكاتبة ريما حمزة رؤيتها للقراء وللمشهد الثقافي بكلمات مؤثرة:
“أنا أكتبُ في زمنٍ يموتُ فيه الشعر في ساحات الإعلانات ومواقع التواصل، حيث يُقاس فيه تأثير الكاتب بعدد المتابعين لا بعُمق النص، في زمنٌ تُستهلك فيه القصائد كأزياء تتغيّر مع الريح، في زمنٌ صار فيه الكثيرون يحاولون الحفاظ على نجوميتهم لا على جوهرهم، لكنني أؤمن بإن نجاحي لم يكن للصدفة فيه أدنى حِصّة أو فرصة، بل كان نجاحًا موغلَا في الرؤية والوعي، ونتاج صبر طويل على بلورة الصوت لا تصنعه الرغبات العابرة.
كتبت عندما صار النص يطاردني ويطالبني بالخروج، صار يقول لي: (أخرجيني للعالم لكي لا أموت في داخلك)، ومعي صارت الكتابة نداءً لا مفرَّ منه، تحوّلت من رغبة إلى فعلٍ قائمٍ بذاتهِ.
آمل أن تقع كلماتي موقع القلب عند مَن يقرأني، وأشكر استضافتكم الكريمة التي شرّفتموني بها.”