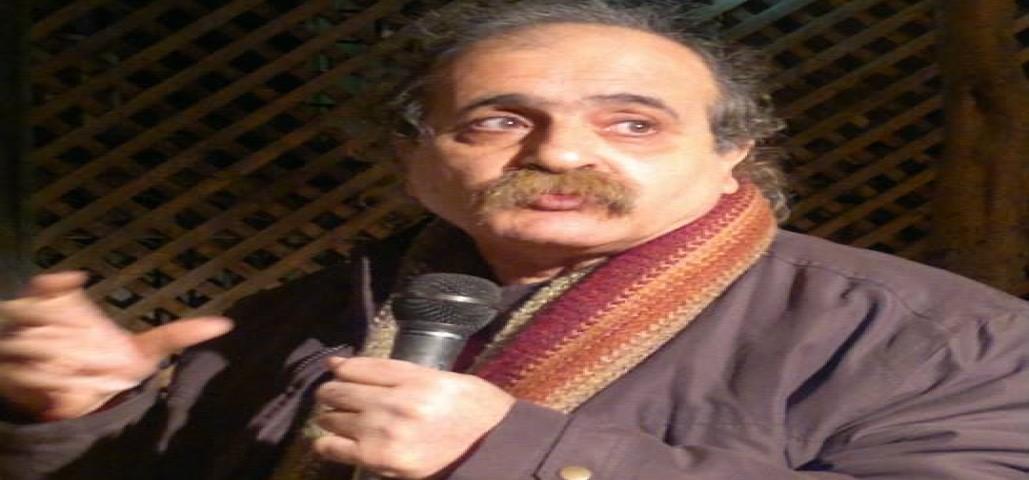في أركيولوجيا البحتري.. علم الآثار من خلال نفائس الأشعار

منتصر لوكيلي | المغرب

في مدرجات الجامعات وقاعات الدرس بالمعاهد العليا في المغرب (وحتى باقي بلدان العالم العربي) يتم تدريس علم الآثار على أنه علم مساعد لعلم التاريخ، علم يهتم بدراسة ما خلفه بنو الإنسان من بقايا مادية، بدءا بمقاربة ما صنع من أدوات منذ القدم. يتم تطبيق منهاجه عبر الدراسة العلمية الدقيقة لمخلفات الإنسان، فيسلط الضوء على حياة الشعوب القديمة وطرق عيشها؛ أيا كانت هذه المخلفات: معمارا أو فخارا، عظام بشر أو حيوانات، مشغولات معدنية أو غير معدنية، فيتم جمع مختلف المعطيات، ويشرع في رسم صورة عن معالم الحياة للمجتمعات السابقة، وربما أدى وصف أداة حجرية إلى معرفة طبيعة إن كانت فأسا وكيف صنعت، أو مكنت رحى من حجر إلى فهم نوعية الحبوب، أو شكل معصرة إلى معرفة إن كانت تعصر زيتونا أو عنبا، فتحصل زيتا أو خمرا… وإن كان هناك جانب رومانسي في هذه المعرفة، فربما يتم التعاطي معه بشيء من التجاهل، لا سيما وأن الأركيولوجي يلبس بذلة العلوم الحقة، ويحملق في المجهر، ولا يسمح لنفسه أن تتحلى بغير الموضوعية، وربما تمنى في قرارتها لو كان الأمر يتعلق بعلم دقيق يعفيه من مجاراة شطحات بعض العلوم الإنسانية.
إن الأمر قبل كل شيء هو نبش في الماضي، هو تساؤل عن الزمن الذي مر ولن يعود، هو استقراء لمكون مادي يحمل في دواخله أسرارا يتمنع عن البوح بها، ولعمري، يكاد الأثري يبدو أشبه ما يكون أحد اثنين: إما محقق بوليسي يحلل كل كبيرة وصغيرة، فيتتبع الآثار وكأنها آثار جريمة، ويمضي في عمله وكأنه مطالب بتقرير يرفعه لقاضي التحقيق ولسان حاله يقول: لقد أخفوا كيت وكيت، ولكن هيهات ولك هيت (أي هيت لك، وما تغييرنا لمواضع الكلم إلا دليل على الاستسلام لجبروت السجع)، أو مسافر في الزمن تجمعه بمن مضى مشاعر لا يمكن أن يمحوها الزمن، فالحب والوفاء والكرم والإيثار لا يمكن أن تترك وراءها أثرا ماديا يوضحه مجهر أو تكشفه تحاليل مختبر.

ولقد أعجبنا بعلم الآثار (في صيغته البوليسية) حتى تناسينا حمولته الإنسانية، علما أن الدافع في كل الحالات هو الشغف بالماضي، وربما كان نفس الشغف الذي دفع بالإنسان إلى الحلم بالخلود. وإن كانت قاعات الدرس ومدرجات الجامعات قد ركزت دائما على كون هذا العلم علما (غربيا) بامتياز، وأن قصب السبق يعود فيه للأنوار التي تلت عصر النهضة الأوروبية، فامتلأت كتب تاريخ الأركيولوجيا بأسماء يوهان يواخيم فينكلمان وشامبوليون وغيرهما، في وصف متسق متناسق، وكأن لم يكن قبل ذلك من شغف بالماضي ولا تساؤل عنه…. حتى إذا استسلمنا لمسلمات ما قرانا، عدنا فتساءلنا: ألم يملأ شعراء العرب في الجاهلية قصائدهم بأوصاف الأطلال؟ حتى اقترنت مقدماتها بها فصار يطلق على كل منه “المقدمة الطللية”، … هذا النوع من الأسئلة كان يحاصرني منذ كنت في معهد الآثار بالرباط، ولا أتجرأ أن أفاتح بها أحدا خشية أن يؤدي الأمر إلى متاهات النقاشات الإيديولوجية… لكن ضوءا بعيدا شدني منذ البدء إلى الشاعر العربي الكبير أبي عبادة البحتري، الذي عاش في القرن الثالث الهجري. وقد قيل أن المعري سُئل أي الثلاثة أشعر؟ المتنبي أم أبو تمام أم البحتري؟ فقال أما المتنبي وأبو تمام فحكيمان، وأما الشاعر فالبحتري..
ولعل القارئ يعتقد في الأمر شوفينية، أو نزوحا نحو عرفان للأدب العربي والثقافة العربية ببعض السبق، فيكون مخطأ في الأولى ومصيبا في الثانية، فالشاعر البحتري أطلق العنان لقريحته فخلد في العالمين قصيدته التي مطلعها:
صُنتُ نَفسي عَمّا يُدَنِّسُ نَفسي
وَتَرَفَّعتُ عَن جَدا كُلِّ جِبسِ
وَتَماسَكتُ حينَ زَعزَعَني الدَهـرُ
التِماساً مِنهُ لِتَعسي وَنَكسي
وهي قصيدة عُرفت في الأدب العربي باسم السينية، وفيها وقف الشاعر ليخاطب الأزمنة والأمكنة، ووقفنا معه خشوعا في محرابه المقدس، أمام إيوان كسرى، هذا الصرح المعماري الرائع الذي كان مضرب المثل في الفن المعماري، معلمة ضمت قاعة عرش كسرى في عاصمة بلاد فارس الساسانية المسماة المدائن، فما الذي دفع شاعرا عربيا من قبيلة طيء إلى أن يحط الرحال به وتهتز نفسه فيصفه وصفا حسيا.. لا بد من التذكير بكون هذا الأثر الخالد الذي شكل لشاعرنا البحتري شاهدا ماديا على عبر الماضي، قد شُيد في عهد كسرى الأول أو كسرى أنوشِروان (وتعني بالفارسية الروح الخالدة)، بعد حملته العسكرية على أعدائه البيزنطيين في أواسط القرن السادس الميلادي، ويتكون هذا الإيوان من كتليتين رئيسيتين، فمن جهة هناك المبنى الشاهق، ومن جهة هناك القوس الذي يحاذيه بارتفاع يربو على أربعين متراً، وقد حوله العرب المسلمون الفاتحون سنة 637 م إلى مسجد، لكن البحتري وجده أقرب إلى الخراب ينعق فيه البوم والغراب. ومن الجدير بالتذكير كون “مدائن كسرى” ضمت إيوانين، بنى الأول منهما سابور الأول ابن أردشير، في القرن الثالث الميلادي، وتسميه كتب التاريخ مثل كامل ابن الأثير بسابور ذي الأكتاف. وذكر ابن خلدون أن المنصور العباسي لما عزم على بناء بغداد أراد هدم هذا الإيوان، وبعث إلى عامله خالد بن يحيى يستشيره في ذلك، فقال: يا أمير المؤمنين لا تفعل واتركهُ ماثلاً يستدل بهِ على عظيم ملك آبائك الذين سلبوا الملك لأهل ذلك الهيكل، فاتهمه في النصيحة، وقال: أخذته النعرة للعجم. والله لأصرعنه. وشرع في هدمهِ ..، واتخذ لهُ الفؤوس وحماهُ بالنار، وصب عليهِ الخل، حتى إذا أدركه العجز بعد ذلك كله وخاف الفضيحة، بعث إلى خالد بن يحيى يستشيره ثانياً في التجافي عن الهدم، فقال: يا أمير المؤمنين لا تفعل، واستمر على ذلك، لئلا يقال: عجز أمير المؤمنين وملك العرب عن هدم مصنع من مصانع العجم! فعرفها المنصور وأقصر عن هدمه.
وبالعودة إلى البحتري، فقد كان شاعر الخليفة العباسي المتوكل، فلما اغتيل الخليفة حزن عليه البحتري ورثاه في شعره وذلك وما أن امتلأت نفسه همًّا وغمًّا، حتى ذهب إلى آثار المدائن عاصمة بلاد الفرس الساسانيين (وهي بالمناسبة لا تبعد عن العاصمة العراقية بغداد إلا 33 كلمترا)، ووقف أمام الإيوان يصفه ويغوص في تفاصيله، قبل أن ينقله الوصف المادي إلى وصف تاريخ الأمة الفارسية وعظمتها. وهكذا انتقل من حزنه ومشاعره إلى العمارة ورسائلها المكنونة، فقال:
حِلَلٌ لَم تَكن كَأَطلالِ سُعدى
في قِفارٍ مِنَ البَسابِسِ مُلسِ
وَمَساعٍ لَولا المُحاباةُ مِنّي
لَم تُطِقها مَسعاةُ عَنسٍ وَعَبسِ
نَقَلَ الدَهرُ عَهدَهُنَّ عَنِ الـ
ـجِدَّةِ حَتّى رَجَعنَ أَنضاءَ لُبسِ
فَكَأَنَّ الجِرْمازَ مِن عَدَمِ الأُنـ
ـسِ وَإِخلالِهِ بَنِيَّةُ رَمسِ
لَو تَراهُ عَلِمتَ أَنَّ اللَيالي
جَعَلَت فيهِ مَأتَمًا بَعدَ عُرسِ
وَهوَ يُنبيكَ عَن عَجائِبِ قَومٍ
لايُشابُ البَيانُ فيهِم بِلَبسِ
وَإِذا ما رَأَيتَ صورَةَ أَنطا
كِيَّةَ اِرتَعتَ بَينَ رومٍ وَفُرسِ
وَالمَنايا مَواثِلٌ وَأَنوشِر
وانَ يُزجى الصُفوفَ تَحتَ الدِرَفسِ
في اخضِرارٍ مِنَ اللِباسِ عَلى أَصـ
ـفَرَ يَختالُ في صَبيغَةِ وَرسِ
وَعِراكُ الرِجالِ بَينَ يَدَيهِ
في خُفوتٍ مِنهُم وَإِغماضِ جَرسِ
مِن مُشيحٍ يَهوى بِعامِلِ رُمحٍ
وَمُليحٍ مِنَ السِنانِ بِتُرسِ
تَصِفُ العَينُ أَنَّهُم جِدُّ أَحيا
ءَ لَهُم بَينَهُم إِشارَةُ خُرسِ
يَغتَلي فيهِم ارتِابي حَتّى
تَتَقَرّاهُمُ يَدايَ بِلَمسِ
وفي هذا البيت بالذات، يصل البحتري إلى حقيقة علم الآثار فيلمس الأثر المادي بيديه ليعلم حقيقة ما يرى، حتى إذا لمسه انتقل من المأساة إلى الخمرة التي صار يعاقرها رفقة كسرى أبرويز وساقيه، البلهبذ، وكأنه سافر في الزمن حقا، وحكى ما رأى في رحلته صدقا، حتى إذا عاد من سفره الذي أسدل عليه ستار الحلم، لم يجد بدا من التشبت بالإيوان من جديد، فقال:
وكأن الإيوان من عَجَب الصَّنعــة
جَوفٌ في جَنب أَرعَنَ جَلس
يَتَظَنّى من الكآبة إذ يبـدو
لعيني مُصَـــبِّحٌ أو مُمَسّي
…ذاكَ عِندي وَلَيسَت الدارُ داري
باقتراب مِنها وَلا الجِنسُ جِنسي
وعلى أي، لم يكن البحتري الشاعر الوحيد الذي وقف أمام معلمة الإيوان واصفا متبصرا معتبرا، بل إن شعراء فارس قد فعلوا بلغتهم، وكان من بينهم الشاعر الفارسي الخاقاني، ولا نزعم من خلال هذه الأسطر أن أبا عبادة البحتري قد سبق علماء الآثار في الغرب إلى هذا العلم… إلا أننا لا يمكن أن نضرب صفحا عن أن مقصد الأركيولوجيا هو استنطاق أسرار الماضي ودفعه إلى البوح بها، ولما كانت الأمور بمقاصدها فإن أبا عبادة قد أصاب كبد الحقيقة، فجمع بين الحسنيين، الغوص في أسرار الماضي والعبقرية في التبليغ والبلاغة، فكم من الأسرار يضمها تراثنا العربي؟ نمر أمامها مرور الكرام، ولا نكاد نلتفت إليها، ربما فعلنا عندما يُقيض الله رجلا أشقر ذا عينين زرقاوين مترجما لهذه الأسرار من لغة الضاد إلى غيرها، فنهتم بها اهتماما، ولسان الحال يقول:
أيا حجر الشحذ حتى متى تسن الحديد ولا تقطع