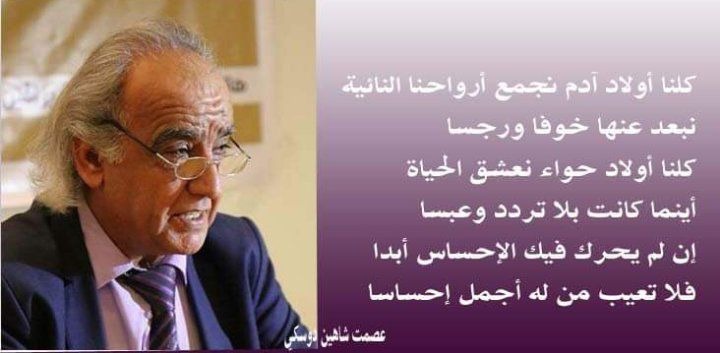حين يشتاق نضال أبو عكر للدالية وللكرمل

المحامي جواد بولس | فلسطين
كنت بحاجة لجرعة أمل صاف وحقيقي تعيد إلى روحي بعضًا من توازنها المفقود قبل وخلال وبعد معركة الانتخابات للكنيست الاسرائيلي. لم أفكر طويلًا؛ تقدمت بطلب، لإدارة سجن “عوفر” ، لزيارة الأسير الاداري نضال أبو عكر بعد أن تواصلَت معي أسرته وطلبت أن أزوره كي يطمئنوا عليه.
أمضيت ليلتي، كما في الآونة الأخيرة، وأنا أعارك العتمة لأستنشق من بطنها حاجتي من الهواء؛ محاولًا طرد القلق عن وسادتي. لم أنتبه متى غفوت، لكنني أتذكّر أنني سمعت صوت أذان الفجر يعلن، من مساجد حييّ ضاحية البريد و بيت حنينا، أن القدس تصحو لتواجه مجهولها يومًا آخر. لم أنم كما يستحق كهل أتعبه السفر وراء سراب العدل وزيغ الحقيقة. خفت ألا أصحو قبل الساعة التاسعة وأخسر ميعاد زيارتي للسجن.
في التاسعة، كانت مركبة تابعة لمصلحة السجون تنتظرني عند مدخل سجن عوفر؛ طلب مني سائقها أن ألحق به بسيّارتي. وصلنا الى ساحة رحبة ووراءنا وأمامنا اسوار اسمنتيه عالية. أشار السجان الى مكان في الساحة، فركنت سيارتي هناك مقابل باب حديدي صغير. بعد لحظات فتحوا الباب فأدركت انني قريب من الغرفة التي كنا نجيء اليها للزيارات من بوابة السجن الرئيسية قاطعين ساحاته الداخلية على أقدامنا. طلبت مني السجانة أن أنزع ساعة يدي وحزامي، وأن أخرج من جيوبي كل شيء معدني، وأن أعبر من بوابة الفحص الكهربائية. دخلت البوابة واثق الخطى ومررت منها بنجاح. فأنا بعد سنيّ خبرتي الطويلة صرت أعرف كيف آتي من دون “زوائد” أو “مقبلات” لهذه الزيارت. أختار حذاءً “كاشيرًا” مجربًا، لا يستفز باطنه مجسات البوابات الحساسة، ولا أحمل معي سوى بضعة أوراق بيضاء وقلمًا شفاف القالب كي يستطيع السجان رؤية الحبر في معدته.
دخلت غرفة الزيارات بلهفة ولد يفتش عن مطرح يلوذ به ليكبر. كان الجو باردًا، لكنني لم أعره انتباهًا، والغبار يغطي دكة الباطون والكرسي الذي سأجلس عليه. لم أحاول ازالة الغبار، فهو من ضرورات الجو.
كان المكان يضجّ بالصمت وبالوحدة. حاولت أن أرسم ملامح نضال كما أتذكره ومن صوره الأخيرة في الاعلام؛ فسمرة وجهه كفجر مخيم برتقالي داكن خارج من تنور الكون. شعره فاحم يندفع قليلًا الى الامام عند صدغيه وينحسر عند طرفي راسه، وعلى الجبين ما يشبه الغرة تجعل الناظر اليها يرى شكل قلب يبتسم.
حاولت أن أتذكر متى بدأت بزيارة أسرى الحرية في هذا المكان، لكن نباح كلاب الحراسة قطع علي تركيزي. تذكرت عندما سمعت نباحها ما قالته مرافقتي السجانه عندما مررنا بها: هذه الكلاب متوحشة ولا يمكن أن تترك إلا حبيسة في الدهاليز. لم أسألها عن وظيفة الكلاب هناك.
سمعت طرطقة المفاتيح فسررت. دخل نضال ونظر نحوي فشعرت براحته. أزالوا الاصفاد عن يديه، فتقدم، بهدوء جوري، وجلس قبالتي. وضعت كفي على الفاصل الزجاجي السميك الذي بيننا، فقابلتها كفه من الجهة الاخرى. رفعنا سماعتي الهاتفين ومضينا معًا نحو غايتنا. كانت قسمات وجهه بلون الشوق وأجمل مما تخيلتها؛ حاجباه أسودان عريضان، كخنجرين يمانيين، يربضان فوق عينين سوداوتين غائرتين تصران أن تتحدثا معي بلغة العزة والفرح.
اعتقل نضال أول مرة وهو في الصف الثاني الاعدادي، ومن وقتها تتالت اعتقالاته حتى بلغ مجموعها ستة عشر عامًا، قضى منها كأسير اداري ما مجموعه أربع عشرة سنه بشبهة انه ناشط في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ولأن ضابط المخابرات الاسرائيلي، كما أخبره قبل اعتقاله مرّة، لا ينام مرتاحًا اذا كان نضال خارج السجن.
تحدثنا طويلًا ولم أسمع منه أي شكوى أو تردد بل اصرارا وقناعة بدوافع تضحيته ومعانيها؛ فهو ورفاقه الأسرى يناضلون كي يحقق أبناء شعبهم أحلامهم الآدمية، وهي بسيطة: أن يعيشوا في كنف أولادهم بسلام ويفرحوا كما يفرح البشر ، اذا دخل طفلهم روضة، أو تخرج ابنهم من مدرسة أو جامعة، وأن يشاركوا ابنة خطبتها او زواجها. قال ذلك بصوت ناي وبحنين القصب، فقد تمت خطبة ابنته دالية مؤخرا وهو أسير.
لم يبدُ على نضال انه طوى من عمره خمسًا وخمسين عامًا، فربما هكذا، بالنضارة الحاضرة والروح العالية، يقاوم الفلسطيني قهر المحتل ويروّض قساوة الدهر. فنضال وأمثاله يعرفون ان الاعتقالات الادارية هي من أقسى وسائل الردع والتعذيب التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين؛ ويعرفون أن الاحتلال بلجوئه الى هذه الوسيلة القاهرة، يريد أن يخلق نماذج فلسطينية عاجزة ومستسلمة وضعيفة ويائسة، كي تشكلّ تجاربها أمثلة لترهيب الأجيال الفلسطينية الجديدة. أو كما قال لي: “إنهم يريدون أن يرفعوا كلفة من يعمل في العمل الوطني والمجتمعي كي يرهبوا من خلالنا النشطاء والمناضلين الآخرين” ، لكنه أضاف مطمئنًا: “أنا على قناعة بان الأسير يعيش في وجدان مجتمعنا، وبالرغم من تراجع الكثير من القيم ومحاولات ضرب مفاهيم الوطنية الحقيقية، ما زال الخير موجودًا عندنا”. أقاطعه، كي أسأله بماذا يعمل، فيجيبني بجدية وبعفوية مدهشة ” أعمل أسيرًا” ثم يضيف: “وعندما أكون خارج السجن أعمل بالصحافة والاعلام أيضًا”.
أحاول أن ألتقط أنفاسي من وضوح هذه القناعة، خاصة عندما أخبرني بأن سلطات الاحتلال منعت وتمنع عنه على الغالب زيارة أبناء عائلته، باستثناء حصول مفارقة موجعة معه عندما اعتقلوا ابنه محمد اداريًا ايضًا ، لمدة أربع سنوات، فصار، منذ العام 2015، يلتقيه داخل السجن؛ وهكذا حصل مع أخيه التوأم رأفت الذي أمضى، هو أيضًا، في السجن الاداري مدة سبعة أعوام.
تساءلت بهدوء: أوَ قد تكون هذه هي طريقة لمّ شمل الملائكة في السماء، أو على الاقل الملائكة التي تحمي فلسطين ؟
سألته عن أحلامه ومعنى الشوق لديه وراء القضبان؟ فتقدم بصدره قليلًا نحو الزجاج، وكأنه يريد ألا يُسمع أحدًا ما يقوله، ثم رفع جبينه فلمع كنجمة، وقال: “أحلامي بسيطة. أريد أن أحيا مع زوجتي وأولادي، وأن أكون بجانب أمي. أريد أن أقبّل يد أمي وجبهتها وأن نأكل معًا، كعائلة بسيطة وكريمة وأن نفرح ونحزن معاً.. أكثير أن يحلم الانسان بأن يعيش مع أولاده وأمه وعائلته بسلام وبحرية ؟”
سكت.. فسألته: هل أنت نادم على هذه الأعوام ؟ أرجع رأسه إلى الوراء قليلًا واتكأ على حزمة نور كانت تتسلل من شباك عال وراءه، ووضع يده على الزجاج وكأنه يريد أن أشعر بنبضات قلبه تقفز من صدره وقال: “أبدًا، أبدًا، لا وجود لحسرة ولا لندم؛ فنحن نسير على سيقان من أمل، وننام على وسائدنا، كي نربي عليها أنفاس الوطن وحسب، ونضمّ أحلامنا ضلوعًا في صدورنا ونزرعها خناجر في خواصر الهزائم واليأس. نحن، يا استاذنا، قددنا من حب ومن شوق سرمديين، ونعرف، بيقين ماسيّ، أن معاناتنا زائلة وستصبح يومًا مجرد نثار في الذاكرة، ونعرف أن أيامنا القادمة هي الأجمل، فأرواحنا ضمانات مستقبلنا وهي له وعود وعهود ونور وضياء”. سمعنا صوت أقدام تقترب منا. فتح أحد السجانين الباب، وسألني اذا ما أنهيت الزيارة؟ فأفهمته أنني هنا في رحلة شفاء روحاني وليس في زيارة أسير؛ فخرج كما دخل.
ألا تتألم على هذا البعاد ؟ سألت نضالًا. وبدون أن يتردد أندفع صوته عبر الهاتف كشريان سيل سماوي وأجاب: “طبعًا أتألم، ولكن ليس من البعاد نفسه، فهذا تضحية وثمن نحن ندفعه برضا وعن قناعة تامة. أشدّ ما يؤلمني هو العيش بقلق دائم وبشعور أنني ملاحق. هذا ما يرمي إليه الاحتلال من تكرار اعتقالاتي الادارية، أن أتألم كي أرتدع.. ويؤلمني عندما يقتحم جنود الاحتلال بيتنا ليعتقلوني ويقيدوني أمام أبناء بيتي، ويقيدون أيدي ابنتيّ، كرمل ودالية، فاضطر أن أودّعهم ونحن جميعنا مقيدون، ثم أنظر نحو زوجتي، التي أصيبت في أحداث الانتفاضة الاولى، فأرى دموعها تنهمل وهي تتدافع مع الجنود كي تحميني. يؤلمني حين يتعمدون ضربي أمام افراد الأسرة وأنا مصفد بالتمام..”. يسكت هنيهة ويكمل على ايقاع الوجع ويقول: “إنه عجز جسدي، ولكن ارادتي وارادتهم فولاذية وأقوى من عنجهيتهم”. لم أرفع عيني نحوه، فقد كانت صور أفراد بيتي تملأ، كالماء، مقلتي.
لن يكفي مقال واحد للحديث عن زيارة تمنيت الا تنتهي؛ فلئن جئت السجن معاضدًا خرجت منه وأنا ممتلئ عزة وأملا وكرامة.
يمثل نضال أبو عكر- الذي خبرني أن عائلته هُجّرت، قبل أن يسكنوا مخيم الدهيشة، من قرية تقع غرب مدينة القدس، اسمها “راس ابو عمار”- شريحة فلسطينية كبيرة يحتفظ أفرادها تحت جلودهم، ببذرة/جين البقاء الفلسطيني؛ ورغم شدة المعاناة من استهدافهم المتكرر كأسرى اداريين (يناهز عدد الاسرى الاداريين في هذه الايام ثمانمائة أسير) يعيش معظمهم بلا ندم ولا حسرة؛ بيد أنهم يتمنون أن يناموا ويصحوا كما يفعل أبناء البشر: على غنج الداليات، وعلى صياح الديك، وعلى نداءات الباعة المتجولين في أتربة مخيماتهم وعلى ثغاء الغنم؛ وأن يشربوا القهوة مع زوجاتهم وعلى نداء كرمل في الصباح وهي تدلل أباها في يوم ميلاده وتعايده بجملة “بحبك بابا”، فهذه كلها عندهم أعلى درجات السعادة.
نضال ورفاقه لا يندمون؛ لكنهم، كما فهمت منه قبل مغادرتي، يخافون أن يمتلئوا، هم وأولادهم، حقدًا على أعدائهم، فالحقد ليس من طبائع النبلاء الاوفياء والاحرار الشرفاء.
تركت السجن، وكنت أعرف أنني سأواجه فيه الحقيقة، وأشعر بالحرية وأمتليء بالأمل. في السيارة كانت محطات الراديو تنقل أخبار ما بعد الانتخابات الاسرائيلية. لم أسمع إلّا آخر النشرة، وكان كلامًا عابرًا عن مناكفات العرب وخصاماتهم حول معاني الوطنية والكرامة والتأثير.