رؤية المنهج التاريخى للنصين المُقدسين وعلومهما

بقلم : د. محمد عبد العظيم حبيب
المنهج التاريخى له عظيم الأثر في فهم النصين المقدسين إلى جانب العلوم المساعدة كعلم أسباب النزول الذى يعد ضرورة من ضرورات فهم النص القرآنى. مع العلم أن هناك آيات غير مرتبطة بسبب خاص للنزول إلا السبب العام الذى نزل من أجله القرآن: الهداية، والدعوة إلى الإسلام، والعمل الصالح. وهناك آيات مرتبطة بسبب خاص أو معين .
ومعرفة أسباب النزول للمؤرخ تعينه على تتبع المراحل التي نزل فيها القرآن، وتبين له المناسبات التي ارتبط نزوله بها، وتساعد المفسر على معرفة المعنى الصحيح المقصود من الآيات. فعلى سبيل المثال ظن بعض الصحابة أن الخمر أبيحت حينما نزل قوله تعالى: “ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طَعِموا… ” مع أن للآية سببا للنزول، وهو حينما حرم الله الخمر سأل بعض الصحابة: كيف بمن ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فنزلت الآية متضمنة حكما خاصا للذين شربوا الخمر وماتوا قبل تحريمها ، فالحكم هنا خاص، وليس عاما.
ومعرف أسباب النزول يكون بالنقل الصحيح عن الصحابة الذين عاصروا نزول القرآن، فقول الصحابة في حكم الحديث المرفوع لامجال فيه للاجتهاد. وإذا روى تابعى سببا من أسباب النزول فلا يقبل إلا بشرطين:
أولا: يجب أن يكون عالما بالتفسير آخذا من قول صحابى.
ثانيا: أن يؤيد القول تابعى آخر ثبت روايته عن صحابى .
أما التفسير فظهر مع نزول القرآن، فرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فسر ما استشكل على الصحابة ، فمثلا حينما سألوه عن معنى الظلم في قوله تعالى ” الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ” فسره بالشرك، واستدل على ذلك بقوله “إن الشرك لظلم عظيم”. ومن هنا يتبين حرص النبى على تفسير ما استشكل من آيات القرآن، وحرص الصحابة على سؤاله انطلاقا من حرصهم على تدبر معانى القرآن الكريم .
وبعد وفاة النبى حمل الصحابة مهمة التفسير كعبد الله بن عباس والخلفاء الراشدين من بعد رسول الله. ولعبد الله بن عباس منهج في التفسير، فكان القرآن مصدره الأول، فإن لم يجد فيه ما يطلبه من تفسير مضى إلى مصادره الأخرى: أحاديث النبى، والشعر العربى، وأحاديث الصحابة، وتاريخ الدعوة الإسلامية، وتاريخ نزول القرآن، وأسباب النزول، والإسرائليات معتمدا على اجتهاده الشخصى في تصفية هذه المادة التفسيرية الكبيرة .
حدث اختلاف كبير بين علماء التفسير حول الأخذ بتفسير التابعين ، فبعضهم رفض الأخذ بتفسير التابعين وجلهم قبل الأخذ من تفسير التابعين. كان هذا الأمر مع بداية ظهور الخلافات المذهبية وخصوصا مدرسة العراق، حيث خاض الحسن البصرى وقتادة في مسألة القضاء ، والقدر، والجبر، والاختيار .
وجاءت مرحلة تابعى التابعين، فقد أصبح التفسير جزءا من نشاط الحديث، ولم يكن لهم كتب خاصة بالتفسير، فجاء التفسير ضمن أبواب كتب الحديث.
ظهر التفسير النقلى أوالتفسير بالمأثور الذى يمثله الطبرى، والذى قام منهجه على الاعتماد على النقل محاولا الاستنباط وإعمال العقل. أخذ الطبرى بالإسرائليات؛ لأنها تعتمد على التاريخ الذى يعد أكبر اهتماماته .
وهناك العديد من المفسرين الذين اتبعوا منهج الطبرى كالبغوى في (معالم التنزيل)، وابن كثير في (تفسير القرآن العظيم)، والسيوطى في (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) .
ظهر اتجاه آخر للتفسير، وهو التفسير العقلى أو التفسير بالرأى. انقسم المفسرون إلى قسمين: قسم أعمل العقل دون الارتباط بالمذاهب والفرق التي ظهرت في تلك الفترة، وقسم انحرف بالنص القرآنى عن دلالته اللغوية والاستعمال الأدبى خدمة لمذهب أو فرقة معينة.
يجب على المفسر ـ في رأيى ـ أن يمازج بين التفسير النقلى والتفسير العقلى حتى يقدم فهما متكاملا للنص القرآنى . فالاجتهاد مطلوب في إطار اللغة العربية والثوابت الفقهية والشرعية. مع ضرورة أن يتسلح المفسر بمعرفة علوم اللغة، والبلاغة، والقراءات، وأصول الدين، وأصول الفقه، وأسباب النزول، والتاريخ، والقصص، والناسخ والمنسوخ ، والحديث إلى جانب علم الموهبة.
ويعد تفسير أبى السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) وتفسير الألوسى (روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى) آخر التفاسير في المكتبة القديمة.
أما عن اتجاهات التفسير الكبرى فيمكن إجمالها في تفسير المعتزلة، وتفسير الشيعة، وتفسير المتصوفة. فالمنهج الاعتزالى يقوم على الطابع العقلى والجدل الكلامى، وقد دفعهم ذلك إلى عدم قبول النقل عند تعارضه مع العقل وعدم قيول الأحاديث الصحيحة طالما تعارضت مع أفكارهم ومعتقداتهم. ويعد تفسير الزمخشرى أشهر تفاسيرهم وأكثرها اعتدالا.
أما منهج الشيعة خاصة الاثنا عشرية، والإسماعيلية أو الباطنية، والزيدية فيقوم على أخذ النص القرآنى وسيلة لإثبات معتقداتهم من خلال تحميله ما لا يحتمل من معانٍ. واختلف المنهج بعد ذلك عند الفرق الثلاثة، فالاثنا عشرية أعطوا لأئمتهم تفويضا لتفسير القرآن وتأويله، واعتقدوا أن ظاهر القرآن الدعوة إلى التوحيد والرسالة، وباطنه الدعوة إلى الإمامة . ولذلك أوّلوا ما يخالف مذهبهم من الآيات، وأخذوا بقراءات شاذة .
ولنأخذ مثالا على ذلك من تفسير الطبرسى الذى يعد الأكثر اعتدالا عندهم، وهو تفسيره لقوله تعالى: ” الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درىّ يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار…” فالمشكاة عنده هي الشيعة، والمصباح هو النبى ، والزجاجة هي صدر على، والشجرة المباركة هي نور العلم، وأنها لا شرقية ولا غربية أي ليست يهودية ولا نصرانية، “يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار” أي يكاد العالم من آل محمد يتكلم بالعلم قبل أن يُسأل . ” نور على نور ” أي إمام مؤيد بنور العلم والحكمة في إثر إمام من آل محمد إلى أن تقوم الساعة ، وينتهى من ذلك إلى أن الشجرة المباركة هي دوحة التقى والرضوان، شجرة أصلها النبوة وفرعها الإمامة وأعضائها التنزيل ، وأوراقها التأويل ، وخدمها جبريل وميكائيل .
أما الباطنية فليس لهم تفسير كامل للقرآن؛ لعجزهم عن تفسير القرآن وفق منهجهم الذى يعتمد على تأويل الآيات تأويلا يبتعد بها كثيرا عن دلالتها اللغوية المتعارف عليها. ويعتقدون أن ظاهر القرآن تدل عليه اللغة ، وإنما المراد الباطن كشأن الثمرة التي يراد باطنها لا ظاهرها. أوّلوا الآيات على هذا الفهم؛ فاعتقدوا أن طوفان نوح هو طوفان العلم ، ونار إبراهيم هي غضب النمرود عليه، وإحياء عيسى للموتى رمز للعلم بعد الجهل.
أما الزيدية فهم أقرب فرق الشيعة لأهل السنة إلا أنهم كانوا يشترطون الاجتهاد في أئمتهم. لا يقبلون الأحاديث التي وردت عن الصحابة إلا آل البيت منهم، تأثروا كثيرا بالمعتزلة ، فإمامهم زيد بن على زين العابدين كان تلميذ واصل بن عطاء. ويعد تفسير الشوكانى أهم تفاسير الزيدية، واعتمد منهجه على العقل والنقل في آنٍ واحد .
أما تفسير المتصوفة فيقوم على مدرستين: مدرسة التصوف النظرى الذى يبحث عن التصوف ويدرسه، ومدرسة التصوف العملى الذى يقوم على الزهد والفناء في طاعة الله .
خرج المتصوفة على حقيقة النص القرآنى، واتجهوا إلى نظريات الفلسفة محاولين لىّ عنق النص القرآنى لآرائهم وشطحاتهم .
ويعد تفسير ابن عربى أهم تفسير يمثلهم، يقوم على وحدة الوجود ، فليس هناك إلا موجود واحد، وما عداه ظواهر وأوهام ، وتأثر الحلاج بذلك حتى أباح لنفسه أن يقول : أنا الله. آمن ابن عربى بوحدة الأديان الأرضية والسماوية، فكل المؤمنين يعبدون الإله الواحد المتجلى في صورهم وصور جميع المعبودات. فسر ابن عربى القرآن اعتمادا على أبحاث الفلاسفة القدماء في الطبيعة وما وراء الطبيعة .
والمتأمل في تفسير ابن عربى يجد أنه يقوم على تأويل الآيات على خلاف الظاهر بمقتضى إشارات خفية ، ولا يعنى هذا عدم إرادة المعنى الظاهر ، فكل آية عندهم لها فهمان: فهم باطنى وهو التأويل وفهم ظاهرى وهو التفسير .
يشترط العلماء شرطين في قبول هذا التفسير :
الشرط الأول: دلالته الباطنية لا تخرج عن واقع اللغة .
الشرط الثانى: يجب أن يكون له شاهد صريح في موضع آخر في القرآن يشهد بصحته دون تكلف .
وطالما أننا نعرج على اتجاهات التفسير يجب أن نتحدث عن مدرسة التفسير التي اعتمدها الإمام محمد عبده وتلاميذه الذين نظروا إلى التفسير نظرة حرة غير متأثرة بمذهب معين من المذاهب القديمة.
أما عند الخوض فى رؤية المنهج التاريخى للحديث الشريف فيجب أن نحدد مفهوما لبعض المصطلحات كالحديث، والسنة، والأثر، والخبر ، والحديث القدسى ، والمتن، والسند . الحديث هو كل ما نُسب إلى النبى من قول أو فعل أو تقرير أو صفة بالتقرير، وهى تعنى كل ما أقره النبى من فعل الصحابة. أما السنة فهى طريقة النبى في الحياة الخاصة والعامة. وهناك من أطلق اسم السنن على كتب الحديث كسنن ابن ماجة، وسنن أبى داود، والنسائى. أما الأثر فهو مرادف للحديث، ولكن بعض العلماء يضيقون دائرته عند أحاديث الصحابة والتابعين. أما الخبر فهو يتسع ليشمل كل الأخبار التاريخية. أما الحديث القدسى فهو الحديث الذى تحدث به النبى منسوبا إلى الله، فاللفظ للنبى، والمعنى لله. أما المتن فهو الأخبار المتضمنة فى الحديث، والسند يراد به الرواة الذين نقلوا الحديث .
وإذا تحدثنا في إطار الرؤية التاريخية لمصادر الحديث فهى أفواه الرواة من الصحابة ثم تلقتها طبقة التابعين إلى تدوين الحديث في عصر لاحق .
أما عن تاريخ تدوين الحديث فلم يفكر الصحابة في تدوين الحديث، وإن كان البعض يكتبون لأنفسهم الأحاديث التي يسمعونها رغم وجود أحاديث تنهى عن الكتابة . يقول ـ عليه الصلاة والسلام ـ في صحيح مسلم: ” لا تكتبوا عنى ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه وحدثوا عنى ولا حرج، ومن كذب علىّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.” ومع ذلك سمح النبى للبعض بكتابة الحديث خوفا من النسيان ، فعن أبى هريرة أن رجلا من الأنصار يجلس إلى رسول الله ـ صلىالله عليه وسلم ـ فيسمع منه الحديث يعجبه ولا يقدر على حفظه فشكا ذلك إلى النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال له: استعن بيمينك .”
هناك أحاديث تنهى عن الكتابة، وأخرى تبيح. بالعودة لما قاله العلماء في هذا الأمر، فمنهم من يرى أن أحاديث النهى منسوخة بأحاديث الإباحة، وأن النهى كان في أول الأمر حيث خيف انشغالهم عن القرآن، وذهب فريق إلى أن النهى كان عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، وذهب فريق ثان إلى أن النهى كان خاصا بقوى الذاكرة حتى لا يهمل الحفظ، والإباحة كانت لمن لا يوثق في حفظه، وذهب فريق ثالث إلى أن النهى كان عاما، والإباحة موجهة لحالات خاصة ، فالنبى كان حريصا على سلامة النص القرآنى في هذه الفترة الحساسة من عمر دعوته.
فكر عمر بن الخطاب في أثناء خلافته في جمع الحديث إلا أنه لم يجرؤ على تنفيذها ؛ فدعا الناس وقال لهم: “إنى ذكرت لكم عن كتابة السنن ما قد علمتم ثم تذكرت فإذا أناس من أهل الكتاب من قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتبا فأكبوا عليها ، وتركوا كتاب الله ، وإنى لا ألبس كتاب الله بشىء .”
ومع بداية عصر التابعين واتساع الدولة دخل كثير من غير العرب الإسلام، وكانوا يهتمون بالتدوين على حساب الحفظ ؛ فبدأ جماعة من التابعين يكتبون لأنفسهم أيضا .
حاول عمر بن العزيز جمع وتدوين الحديث إلا أن المحاولة لم تنجح ، ولكنها أزالت الحرج الذى كان عالقا بنفوس العلماء من هذه الناحية ، ومهدت الطريق، وفتحت الباب أمامهم؛ فجاء محمد بن شهاب الزهرى صاحب أول محاولة يقينية لكتابة الحديث، فجمع ودوّن الحديث. قام بذلك مكرها لاستشعاره شيء من الحرج في جمع الحديث وتدوينه.وانتشرت المحاولات بعد ذلك في سائر الأمصار الإسلامية لحاجة الفقهاء للحديث؛ لأنهم كانوا يضعون في هذه الفترة أصول الفقه الإسلامي .
أما عن تاريخ الوضع في الحديث فقد بدأ مبكرا ، ففي الحديث الذى يرويه الإمام مسلم أن رجلا جاء إلى ابن عباس يحدثه عن رسول الله ، وابن عباس لا يصغى إليه ، فلما أنكر الرجل عليه موقفه قال ابن عباس : ” إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ابتدرته أبصارنا ، وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف .”
فابن عباس يشير في هذا الحديث إلى أن الوضع بدأ مع اتساع رقعة الدولة الإسلامية وما ترتب على ذلك من كثرة مشكلات الناس ، واختلاف حاجاتهم ومطالبهم ، وتعدد وسائلهم وغاياتهم .
والوضع في الحديث يعود إلى أيام الفتنة التي حدثت بعد مقتل عثمان ، فكل فريق يحاول إثبات موقفه حتى لو وصل الأمر إلى الكذب على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ .
وهناك العديد من العناصر الأجنبية لم يتعمق الإسلام في قلبها ، وكانوا يضمرون العداوة والبغضاء للنبى الكريم والإسلام . فكل هذه العناصر مجتمعة ساهمت في الكذب على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ .
وهناك عوامل أخرى أثرت في انتشار ظاهرة الوضع في الحديث كالخلافات الفقهية والمذهبية، ومحاولات التقرب إلى الخلفاء والأمراء طمعا في عطائهم ، ومحاولة الزنادقة النيل من النبى والعرب لأهداف شعوبية تتمثل في القضاء على الحضارة الإسلامية، وحرص بعض القصاص على حشد قصصهم بأحاديث منسوبة للنبى، وذلك للتكسب والرزق، وتسامح بعض الزهاد والصوفية في قبول الأحاديث الموضوعة ترغيبا للناس في العمل الصالح وترهيبا من العمل الطالح، وهناك من فعل ذلك متعمدا ، وهناك من فعل ذلك جهلا بالسنة وقلة العلم بها على نحو ما قيل عن عبدالله بن المبارك إنه ثقة صدوق ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر .
كل هذه الأشياء دفعت العلماء إلى وضع مقاييس لبيان صحة الحديث من ضعفه أو وضعه منها: أن يعترف الواضع بالوضع . وأن يِعرف بفساد الدين. وأن يكون في سند الحديث ما يدل على الوضع ، ويظهر ذلك من مقارنة تواريخ الرواة، فالراوى ولد بعد وفاة الذى زعم أنه روى عنه، أو قد توفى والراوى طفل لايدرك علم الرواية . وأن توجد ركاكة في متن الحديث وهذا لا يتفق وكلام النبى الذى أوتى جوامع الكلم . وأن يتضمن الحديث مبالغة ، كأن يتضمن وعيدا شديدا على أمر صغير أو وعدا عظيما على أمر وضيع. ومن هنا يتبين حرص العلماء على امتحان السند والمتن حرصا على الدين من عبث العابثين؛ فألفوا كتبا في الجرح والتعديل، وكتبا في الرواة ورجال الحديث، وكتبا في المجروحين والوضاعين، ووضعوا علم الحديث ومصطلحه، ووضعوا كتبا في الأحاديث الموضوعة والضعيفة .


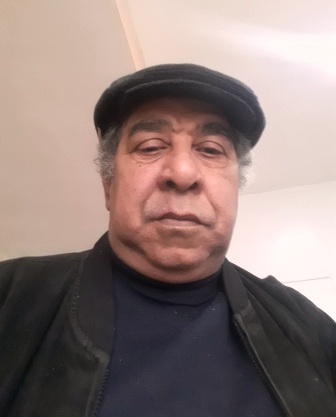



جميل كعادتك دكتورنا الغالي المحترم ..لا فض فوك