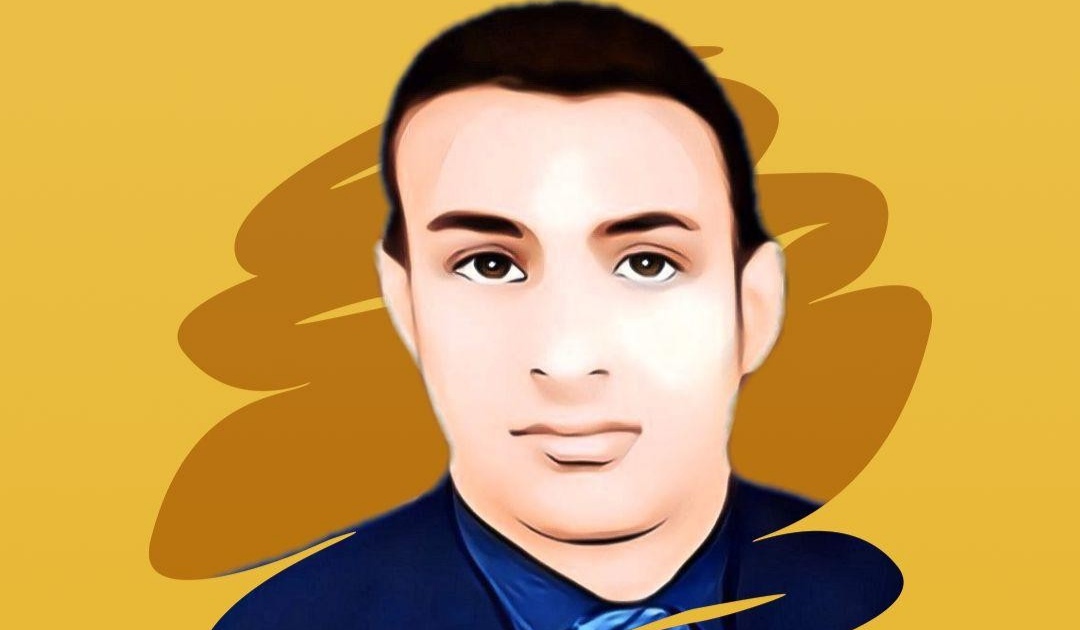ثعلبة.. وجوه في طريقي (6)

منى مصطفى | روائية وكاتبة تربوية مصرية
لم تكن هذه هي المشكلة وحدها، فالمشكلة كانت فيما يجب حسمه من قرار: هل أعود إلى العمل بالكويت أم لا؟
لم أستمع لأحد ولم يَعنيني أحد، فليس لدي شيء أفقده بعد الذي فقدتُه، كان بيت خالي مناسبًا للتفكير، وقد اجتهدوا معي لأَعبر مِحنتي بأقل الخسائر، ولكن أقل هذه الخسائر كانت هي أنا!
لم يبق إلا أيام على موعد السفر، أوصى الطبيب أن أخرج للمشي ساعتين في اليوم على الأقل، فكنت أسير في كل مكان لأجد رضا ماثلًا أمام عيني، هنا تغدينا في هذا المطعم، من هذا المحل اشترى لي حقيبة سفري، من هذا البائع أتى لي بقِلادة محفورٍ عليها اسْمانا، في هذه السينما اختارنا أسماء أطفالنا في المستقبل، عند هذا البائع اختارنا ألوان غرفتنا التي ستكون، بين سنبلات القمح تواعدنا على الوفاء والعِفة وحُسن المعشر!
كنت أرى الأماكن تشتاقنا معا، تردد حديثنا، أحلامنا، ضحكاتنا، تسألني الأماكن: ألا يعود إليك؟، أكان كل حديثكما سرابا؟، أكان حبكما وهماً؟
ما أقسى صوت المكان في أذن عاشق خسر إلفه، وما أعتى عواصف الاضطراب على محب عندما تعزف الذكرى على أوتار قلبه، فيصبح فمه باسما، وعينه دامعة، وقلبه نازفا في آن واحد، وما أوهن القلب الذي قُدّرت عليه الوحدة بعد طيب الوصال ولذته!
وجدتني محاصرة به في واقعي وخيالي، وكلما تخيلتُ أنه يفعل كل هذا الآن مع أخرى ناسيًا أو متناسيًا أن هذا كان لي أنا، شبَّت نيران قلبي، فانتكست صحتي، وبقيت الحيرة حتى تركت بيت خالي، وعدت إلى بيت أبي، فاكتشفت أنني لن أستطيع ما حييتُ أن أنظر في وجهه، فحزَمت حقائبي، وعدت إلى هنا أجترُّ همومي وحدي، راضيةً بحكم الله فيّ!
انتهى حديثها
مرَّ العام الدراسي وقد جعلتها كأختي أو ابنتي، آخذها إلى بيتي متى حانت الظروف، تأنَس مع صغاري، ونخرج للمتنزهات، حتى حان موعد العطلة الصيفية، وكان عليها أخذ قرار مهم، هل تستطيع العودة إلى بيتهم أم لا؟ وبعد تفكير وتصوُّر للألم المتوقع، وإقرارها أنها لا تستطيع النظر في وجه أبيها إلى الآن – ذهبنا لاستشارة طبيبها المتابع لحالتها، فنصح بألا تعود لمكان الأحداث إلا بعد استجابة كاملة للعلاج؛ أي: إن عودتها إلى بيت أهلها فيه انتكاسة لا محالة!
قضيتُ معها عطلة ذلك العام بالكويت ولم أسافر إلى مصر أنا وأسرتي كما كانت عادتنا، واستبدلناها بعمرة، وبذلنا جهدًا كبيرًا، حتى استخرجنا لها تأشيرة؛ حيث إن سنها صغيرة وليس معها أحد من المحارم، لكننا تعهَّدنا بصُحبتها وتولِّي أمرها، وقدر الله لنا جميعًا أن نقضي شهرًا كاملًا من عطلة الصيف في مكة – زادها الله تشريفًا ومهابةً – وعلِمت منها أنها على عهدها تُحوِّل كل مدخراتها إلى والدها إلا ما كان ضروريًّا، وكنت أتعجب من موقفها هذا، فتقول: إنه استبدلني بالمال، فليأخذ المال مقابل خسارته لي ابنةً محبة له حانية عليه بارَّةً به، مر العام الدراسي الثاني وكان للعمرة أثر عظيم في نفسها، وقد كرَّرتها مرة أخرى في عطلة منتصف العام الثاني لها بعد المِحنة، وبدأت حالتها الصحية تتحسن، ثم في نهاية العام فاجأتنا بقرار خطير جدًّا لم نتوقعه منها أبدًا، وهو تقديم استقالة نهائية من العمل بالكويت، وعودتها إلى مصر بلا رجعة!
لماذا يا سعيدة هذا القرار دون استشارة ومناقشة؟!
قالت: لقد استشرت ربي واستخرته في مكة وهنا، وانشرح صدري للعودة، فقررت أن أكون اسمًا على مسمى كما قال لي والدي يومًا، قررت الزواج من أجل طفلٍ، سأعود وسأتزوج، ولن يحرمني الله فضله!
وذهبت ولم تكن ثورة الاتصالات كما هي الآن، فانقطعت رسائلها وأخبارها عني بعد فترة من الزمن، وما زلت أذكرها بالخير، وأدعو لها بالزوج الصالح والولد الصالح الذي يكون لها خير عوض من رب كريم عما خسِرته مِن عمر وحبٍّ!
لكن هناك سؤال يصيح في ضميري كلما تذكرتُها وحتى الآن: بأي ضمير يعيش أبوها؟! وبأي وجه يَلقى ربه، خاصة لو لم يُقدر الله لها الزواجَ بعد هذه المحنة، فستعيش محرومة من طفل تَضج بحبه حناياها، أو مِن زوج تأوي إليه عندما تُعربد السنون بشبابها؟!
ولو تأنَّى قليلًا لوجَد أن ستر ابنته أهم بكثير مِن حَفنة الدنانير التي حظِي بها، وخسِر مقابلها قلبًا بارًّا به، فربما لو ترَكها تتزوَّج، ثم تَجتهد في عملها، لحظِي بالاثنين معًا – قلبها وبرها ودعائها ومالها – غير أن الإنسان خُلِق عجولًا، فيه من الجهالة والطمع أحيانًا ما يُعميه عن سواء السبيل، نعم كل شيء بقدرٍ، لكن الله خلَق لنا العقل والسبب!
تُرى عزيزي القارئ – حفظك الله وأسعدك – لو عاد الزمان بهذا الأب مرة أخرى، أيتبصر، أم على قلوب أقفالها؟!