شاهد واستمع قراءة نقديّة في مجموعة سمرقند القصصيّة: “دبّان صغيران”
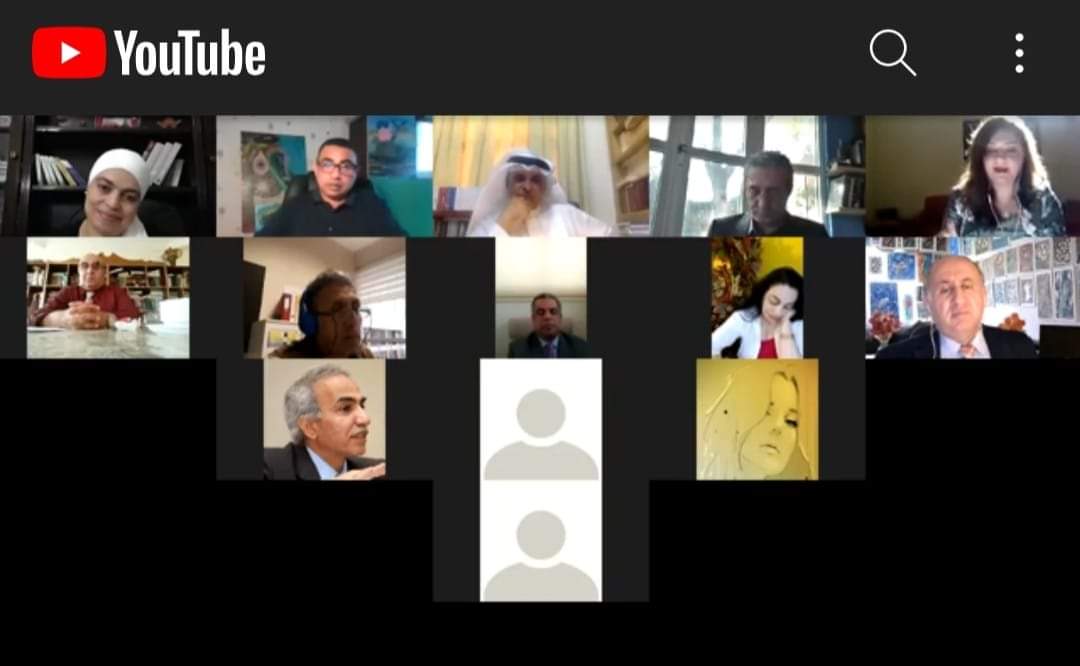
بقلم د. دورين نصر
حاكت قِصَصها من الخضرة والأزاهير، وضمّخت نسيجَها بعطر التراب، بَحثت عن صفحة بيضاء تستريح عليها أجنحتُها المتعبة من سفر الأحلام، لتًسجِّلَ الفرح الحزين. فتمكّنت بحنكةٍ جذّابة أن تأخذ أجمل ما في الشّعر وأحلى ما في القصّة، فخرج عملُها إلى القارئ بهذا المزيج البهيّ الذي يُسمّى بالقصّة القصيرة المعاصرة.
سَمَرقند الجابري، تنقلنا في مجموعتها القصصيّة “دبّان صغيران”، الفائزة بالمرتبة الأولى لمسابقة دبي للإبداع سنة 2007 إلى عالم يمتزج فيه الواقعي بالمتخيّل ويأخذ فيه العجائبي بعدًا رمزيًّا. ها نحن نجدُها متسلّحةً بكثير من تقنيّات الكتابة القصصيّة، تُصرُّ على إقناع القارئ وإهدائه لذّة القراءة من خلال حكايات مشوّقة.
من المعروف استنادًا إلى قول اسماعيل عزّ الدين أنّ “عالم القصّة هو عالم يحمل استمرار إمكانيّة إطلالة على عالم واسع”(). ويرى النّاقد الإنجليزي والتر ألن (Walter Allen 1911-1995) أنّ القصّة من أكثر الأنواع الأدبيّة فعاليّة في عصرنا الحديث. وهي عند فورستر (Edward Forster 1879-1970) حكاية فحسب تَتَتابع أحداثُها في حلقات مثلما تتسلسل فقرات الإنسان(). وتُعدًّ القصّة القصيرة من الفنون السرديّة ذات الصلّة الوثيقة بحياة الناس الواقعيّة، بأحداثها وشخوصها.
وقد انبثقت من متن النّصّ الحكائي بسرديّته، لكن بإيجاز وتكثيف واختزال للفكرة بما يناسب طبيعة العصر وميله إلى السرعة ،ويتيح للمتلقّي قراءة القصّة في بضع دقائق.
وقد ظهر هذا الجنس الأدبي في منتصف القرن الماضي متأثّرًا بمجموعة من الظروف الثقافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة. إذ إنّ الرغبة الملحّة في التغيير لا بدّ أن تقف خلفها دوافع مهمّة نابعة من متغيّرات الحياة نفسها.
ومن الضروري للقصّة حتّى تكون ناجحة، أن تتماسك عناصرُها من أحداث وشخصيّات ونسيج لغوي وأسلوبي، إضافةً إلى عنصري الزمان والمكان؛ بحيث يكون كلّ عنصر كاللّبنة في البناء اللّغوي يؤدّي وظيفته في اكتمال العمل الفنّي، “وإنّ ضعف أيّ عنصر يؤدّي إلى اهتزاز بقيّة العناصر” ().
نظرًا لضيق الوقت، سأحصر دراستي بتناول “بناء الحدث”، لا سيّما أنّه التحليل الذي يتناول “هيكل البنية التي تكشف أسرار اللّعبة الفنيّة، لأنّه يتعامل مع التقنيّات التي تستخدمها الكاتبة في إقامة النّصّ”(). يُعَدّ الحدث من العناصر المهمّة في القصّة القصيرة، فهو “كلّ ما يؤدّي إلى تغيير أمر أو خلق حركة أو إنتاج شيء”(). وقد تعتمد القصّة على حدث رئيسي واحد، وربّما تكتفي بتصوير لحظة شعوريّة واحدة نتجت من حدث، وقد تعتمد حدثين رئيسيين، أو أكثر من ذلك. مع هيمنة لحدث أو أحداث ثانويّة بإمكانها أن تؤدّي أدوارًا بارزة في مسار القصّة.
فكيف تجلّى “بناء الحدث” في مجموعة سمرقند القصصيّة؟
إنّ نصوص المجموعة تبدو مختلفة ومتعدّدة، مع أنّها تشكّل في مسارها العام وحدةً كليّة تعبّر عن طفولة الكاتبة ووجعِها، عن وحدة الوجود حيث لا انفصال بين الأنا والآخر، بين الذات والعالم.
تبدأ الكاتبة قصّة “أربعة” باستهلال مميّز تُعبّر فيه عن العلاقة التي تربطها بأخيها بدر واِبنَي الجيران: “أربعة كنّا، فلا فجر دون استيقاظنا معًا، ولا طريق دون خطانا، نرمّم البيوت تارةً، ونعمل في النّجارة تارةً أخرى”.
ولكن سرعان ما يتغيّر مسار الحدث في القصّة، إذ تعلن الكاتبة انفصالَها عن أصدقاء الطفولة، فتختار طريق العلم. وتتدرّج الأحداث إلى أن تأتي القاصّة بحدث ثانوي سابق للحدث المركزي وهو اختفاء أخيها “بدر” بعد أن صَفَعها وبَصَقَ على أمّه التي أصيبت بالهذيان بسبب غيابه.
يتطوّر الحدث الدرامي ليأتي الحدث المركزي في القصّة، إذ نتج عن ملاحقتها لأخيها تعرّضَها للضرب بسبب شعور أفراد العصابة بوجودها. فتقول: “شعروا بوجودي، فركضوا خلفي… تعثّرت بدهشتي، فسقطت بين أيديهم”.
لقد استطاعت الساردة من خلال البناء المُحكم للقصّة لجهة تنامي الحدث الدرامي واللّغة المُقتَصدة، من إدخال القارئ في عالم يجمع بين الحلم من جهة والواقع الضاغط من جهة أخرى، حيث تمحو الرذيلة عطر الطفولة. ما يشير إلى حالة إنسانيّة تعيشها وتُؤرّقها، وما يدفعها للبحث عن الخلاص الذي يتمثّل في نهاية غير نمطيّة، فيشعر المتلقّي بتصدّع جدار الطفولة في حياتها.
وتستثمر القاصّة تقنيّة المشهد الذي يحتلّ “موقعًا متميّزًا في العمل القصصي وذلك بفضل وظيفته الدراميّة في السّرد وقدرته على تخفيف رتابة الحكي”().
ففي قصّة “أمّ الكُبود”، ترسم الكاتبة صورة نبش القبر وانتزاع كبد الميّت الذي سيتحوّل إلى قوّة فاعلة وقادرة على وَهب الحياة، تقول القاصّة:
“كانت تأخذ العواقر إلى بيتها… تتوجّه بهنّ في الليالي المقمرة إلى المَقبرة لنبش قبر رجل دفِن حديثًا.. تشقّ بطنَه بالسّكين لإخراج كبده… تضعه في مقلاة وتحرّكه على النّار وهي تتلو طلاسمَها”. ثمّ يتطوّر الحدث الدرامي في القصّة من خلال استعانة الكاتبة بحدث تالٍ للحدث الرئيسي، وبهذا الحدث الثانوي، تضفي نوعًا من التشويق على الجوّ العام الصاخب الذي يحيط بالقصّة، إذ تعرّضت عشيرة “أمّ الكُبود” للإبادة، وهنا نلتمس جرأة الكاتبة في تسمية العشيرة باسمها،متحدّيةً بذلك الأعراف في بلادها. ولم ينجُ من تلك المذبحة إلاّ هاشم اليمعان الذي تميّز بطباع غريبة، وراح يمارس مهنة السّحر، ولكنّه سرعان ما وُجد ميتًا ملتفًّا بعباءته الرّماديّة.
أمّا الحدث في قصّة “ألوان”، فتؤسّس له القاصّة في الجزء الأوّل منه عن طريق الحوار مع الأمّ التي تحاول أن تُسكت صرخات الألم التي تعتمل في داخل أبنائها من خلال الرّسم على الجدار، فتُشرق الشمس عليه بعد أن غابت عن حياتهم.
ويتطوّر الحدث في القصّة عن طريق المونولوج الداخلي، والذي من خلاله تكشف عن الصراع النفسي الذي تعاني منه بسبب الوضع المزري الذي تعيشه العائلة، إذ تقول: “وبقي ذهني يحدّثني بوجع: لماذا لا يبيع أحدٌ أثاثَه غيرُنا، في هذا الشارع”. هكذا تعزف هذه القصّة على إيقاع الوجع، فيتسرّب إلى المتلقّي بخفّة، إذ يدرك حجم الألم السّاكن في أعماقها.
أمّا قصّة “جدّي” فتصدم القارئ، وتحاول القاصّة أن ترسم ملامح شخصيّته الجسديّة والنفسيّة بدقّة لا متناهية.
تصف شكله الخارجي بهذه الكلمات: “جدّي طويل كما الجمال في وادي النيل، كمساء يأتي بهدوء”، كما تقول عنه: “يُحدّث أشخاصًا لا نراهم ويكتب أشياء لا نفهمها”.
ومن الواضح أنّ أحد الروافد المعرفيّة لبناء هذه القصّة هو علاقة الساردة بجدّها الذي تخافه وتحبّ أن تلازمه في الوقت عينه: “عمرُه ثمانون عامًا، وأنا عشرة ولكنّي ظلّه… ظنّ الجميع بأنّ اللّعنة تُخرسنا”.
وتردف قائلة: “أعطاني قلمًا من فضّة وأوراقًا سمراء كوجهي، علّمني حرف الباء وبعد أسابيع صرت أتقن جداول فلكيّة”. وكأنّه بذلك، يحاول أن ينمّي عندها الحسّ الماورائي بالأشياء.
أمّا قصّة “دبّان صغيران”، فحظيت عند الكاتبة بمكانة خاصّة إذ جعلتها عنوانًا لمجموعتها القصصيّة، ما أحدث عند المتلقّي نوعًا من التداعي مع ما قاله الكاتب الفرنسي La martine:
“Objets inanimés, avez vous donc une âme qui s’attache à notre âme et la force d,aimer”?
وتعني: “أيّتها الأشياء الجامدة، هل لديك روح مرتبطة بأرواحنا، فتمنحنا الحبّ؟”
تقول القاصّة: “الدبّ ينظر إليّ بنفس السعادة التي دخل بها إلى هذه الغرفة…” وأنا أحاورهما… أدرت وجه الدبّ الكبير إلى الجدار لأنّه يفضحني…”
إنّه الجدار الذي أقامت معه الكاتبة علاقة منذ الصغر، هو الذي شهِد إشراقة شمس غابت عن الحياة وشهِد وجعًا سال من الرّوح، فصار عابقًا بالجراح.
في الواقع، نسجت سَمَرَقند هذه القصص بعناية لافتة تظهر ثقافتها وسعة معرفتها. فأقامت القصّة بذلك علاقة مع الخارج، وكلّ ذلك بأسلوب شعري مميّز، لأنّ كلّ عمل قصصي يتشكّل من لغة مميّزة تضفي عليه صفة التمايز، والكاتب عندما ينسج لغة قصّته إنّما يمنحها بعضًا من أسلوبه وذوقه، فتنطبع تلك اللّغة بطابعه الخاصّ الذي يمتدّ إلى كتاباته القصصيّة الأخرى:
هكذا أَلفيْنا الكاتبة تكتبُ بإيجاز يتركنا في حَيْرة. إيجاز ينتسب إلى جماليّات النحت، وكأنّ القصّة تنتظر الأخرى. فتتوازى الحالة الفكريّة مع الحالة الشعوريّة، بل تبدو الحالة الشعوريّة كأنّها وليدة الحالة الفكريّة.
بالتوازي مع توظيف الإيجاز، يتجلّى التكثيف واضحًا من خلال مَيْل القاصّة إلى الجمل القصيرة الموحية من جهة، وفي الاقتصار على عدد محدّد من الشخصيّات من جهة أخرى. وتركيز الحوار والاستغناء عنه أحيانًا، والعناية الخاصّة بالاستهلال لجذب المتلقّي، والحرص على جعل النهاية غير مُرتقبة.
كما نجحت سمرقند في إبراز أفكارها بتوظيف تقنيات قادرة على إنتاج قصص قصيرة تحوي غموضًا شفّافًّا وتعتمد على الصورة الفنيّة. فتتخلّى عن العبارات الإنشائيّة والوصف الفضفاض، تعتمد الكلمة الدالّة الموحية. كما تطرح اللّغة السرديّة عندها، قضايا فلسفيّة تتعلّق بالبحث عن الحقيقة، ومن هذه القضايا علاقة السرد بالحياة، والزمان، والمكان، والذات. وفي هذا الصدد، يطرح بول ريكور Paul Ricoeur سؤالاً مهمًّا وهو: أفلا تصير حياة الناس أكثر معقوليّة بكثير حين يتمّ تأويلها في ضوء القصص التي يرويها الناس عنها؟ وهو بهذا السؤال يحاول الدمج بين السّرد التاريخي والسّرد التخييليّ ليصل إلى النتيجة القائلة إنّ القصص تروى، ولكنّها أيضًا تعاش على نحو متخيّل مستندًا إلى مقولة أرسطو في أنّ “التخيّل لا يمكن أن يكون أحد الأمور الصادقة دائمًا، كالحال في العلم أو التعقّل، لأنّ التخيّل قد يكون كاذبًا أيضًا”().
فبالرغم من الدور البارز للخيال، نجحت سمرقند في تصوير واقعيّة الصراع التي يعيشها الإنسان مع ذاته، ومع الآخر في ظلّ التحوّلات السريعة والمعقّدة التي يشهدها العالم.
سمرقند: أنتِ جعلتنا نشعر بأنّ طعنة الضوء لا يسيل منها دم ولا ملح، بل تقطر شهدًا في شعاب الرّوح.
الملتقى الأول للابداعات السردية في رحاب المنتدى العربي الأوربي للسينما والمسرح





