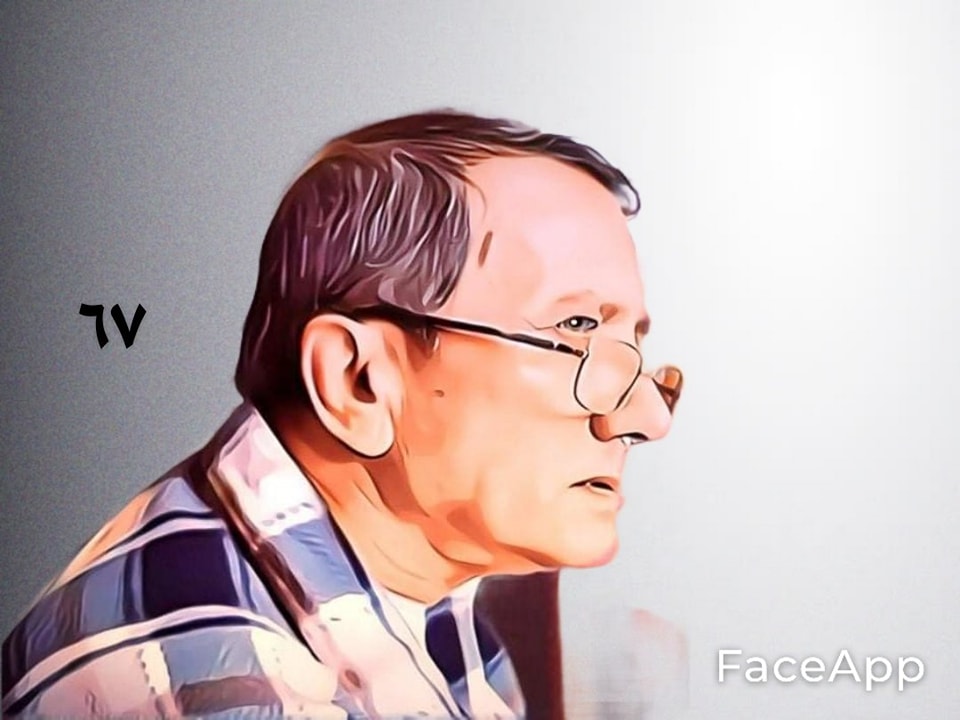ورُبَّ لحدٍ صار موقفاً للمركبات
سهيل كيوان | فلسطين
خفّف الوطء فما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد.
يقال إنّ الفيلسوف المعري قصد بهذا مجازاً مخاطباً المتكبرين، بأن النهاية هي التراب، فعلام التكبر وقد تساوى الفرح بالحزن والمتعة بالألم والمتكبر بالمتواضع؟
في قصيدته هذه يقول «رُبَّ لحدٍ صار لحداً مراراً ضاحكٍ من تزاحم الأضداد».
القبور الجماعية معروفة في زمن الحروب والكوارث الطبيعية، حيث يقوم المنتصر في الحرب بدفن جثث الأعداء دون انتظار للتدقيق بمعرفة أصحاب هذه الجثث، لكن لا أظن أن الشّيطان يتخيّل إقامة موقف سيارات معبّد بالإسفلت، فوق قبرٍ جماعي لمئات من المدنيين العزل الذين قتلوا ظلماً.
جميع المتابعين لتاريخ النكبة الفلسطينية وأحداثها يعرفون أن مجازر وقعت في معظم القرى والمدن الفلسطينية، الجميع يعرفون أن قبوراً جماعية موجودة، بعضها في مقابر البلدات نفسها، وبعضها ما زال مجهولاً، وأقيمت فوق بعضها حدائق عامّة متعة للناظرين، لكن يبدو أن حجم مجزرة الطنطورة أكبر من غيرها بالنسبة لقرية عدد سكانها 1730 نسمة في عام النكبة، قُتل منهم في المجزرة حوالي 230 نفَراً وشُرّد الباقون، في هذا السّياق من المفيد قراءة رواية الطنطورية للراحلة رضوى عاشور.
عندما تتحدّث الضحية عن نفسها، تبقى هناك إمكانية لعلامة سؤال حول مصداقيتها، فقد تخطئ وتهفو إلى زيادة عدد الضحايا لكسب التعاطف، فتزيد عشر جثث أخرى، ربما بهدف إعلامي لتبرير اضطرار الناس إلى الهجرة للنجاة بأرواحهم، وكأن عشرين ضحية لا تكفي لاعتبارها مجزرة، وقد يجد المُجرم ثغرة من عدم الدِّقة ليدحض من خلالها وقوع الجريمة أو للتشكيك في مصداقية الضحية، وقد ينجح في إخفائها إلى حين.
الضحية الفلسطينية ما زالت تجتهد لإثبات أنها الضحية، وبأن بعضها دُفن في مقابر جماعية، وعليها أن تُشهر أعضاء جسدها المبتورة، وتثبت في تحليل دي أن إيه أن هذه أطرافها من لحم ودم وعظم، وليست من البلاستيك، وأن هذي دماؤها وليست عصير توت أو بندورة، وعليها أن تبرهن بأن جنازة بعضها حقيقية وليست تمثيلاً، وأن الذي شُيّع لم يكن ممثلاً يقفز من نعشه بعد أداء دوره أمام الكاميرا، وأن الصّور حقيقية وليست مفبركة بواسطة تكنولوجيا الحديثة، وأنها في فلسطين وليست من فيلم يوناني، ولا من مكان آخر في هذا العالم.
تأخذ الضحية شيئاً من حقِّها عندما يعترف القاتل بجريمته على رؤوس الأشهاد: نعم أنا قتلت، ورأيت زملائي يقتلون الكثيرين من الرجال العُزل! ثم يحكي تفاصيل جريمته! تشعر الضحية براحة بعض الشيء، تشعر بأن التّراب والقار والحجارة التي دُفن بعضُها فيه قد خفّ عن الرُّفات ولو قليلاً، إنه شعور الضحية والمرشحة لأن تكون ضحية المستقبل المناوبة، فمنشار السّفاح لم يتوقف، لأن المشروع الذي أسَّس على المجازر لم يستوف هدفه بعد.
كان معروفاً أن تحت موقف السَّيارات على شاطئ الطنطورة يوجد قبر جماعي، طبعاً ليس لكل الناس، وخصوصاً من الأجيال التي لم تعاصر النكبة، وبالذات من جانب القاتل الذي أنكر وقوعها، وإذا اعترف بشيء فليس بالحجم الذي تتحدث عنه الضّحية.
إنّهم يتقبّلون روايتهم الرّسمية، لأنهم جزء منها، ولأن مصلحتهم بالإنكار والتجاهل، وإقناع أنفسهم بأن هذه الأرض باتت من حقهم لأن أصحابها انضموا إلى جيش العدو، وذنبهم على جنبهم، فلا مكان لأي تأنيب ضمير، لأنها الحرب، وفي الحرب يسقط ضحايا، دون أن يعترفوا بالقتل المنهجي للمدنيين الهادف إلى تفريغ البلاد من أهلها.
يستلقون على رمال الشاطئ، يبتردون في المياه الفيروزية، تلك المياه التي كانت في يوم ما تعجُّ برجال ونساء وأطفال من الفلسطينيين بملابسهم التقليدية، يزفّون عرسانهم على صخرة مُشرفة على البحر، يعتاشون من صيد الأسماك ومن التجارة عبر مينائهم الصغير، ومن زراعة البطيخ، وبعض الصناعات اليدوية من القصل مثل الحصر والكراسي وأدوات العمل، ومن بعض السائحين القادمين للاستجمام على شاطئ قريتهم الوادعة.
يتسفّع المستجمون على الرمال البيضاء الناعمة الدافئة، يتناولون طعامهم، يلعبون التنس وكرة القدم، يسترقون قبلات ولمسات، يمارس بعضهم رياضة الصَّبابة على الأجساد المستلقية بملابس البحر، هناك مقهى كبير، ومظلات من القصب وحمامات ومياه عذبة للاستحمام، وسيارات الجميع تقف فوق مئتين وثلاثين جُمْجمة لأناس مدنيين وقعوا أسرى.
لم يبق في الطنطورة أحدٌ من أهلها، قُتلوا أو شرّدوا في كل جهات الأرض، لكن شاطئها الجميل لا يخلو من المستجمّين العرب، معظمهم لا يعرفون أن رُعباً وأنيناً ما زال مقيماً منذ سبعة عقود تحت موقف السيارات.
أعتقد أن من يعرف هذه الحقيقة، خصوصاً من أبناء الشعب الضحية، لن يهنأ ولن يستمتع برمل وشمس الطنطورة إذا عرف أن سيارته تقف على قبر جماعي لإخوانه من الأبرياء، بينهم الكثيرون من أبناء الأسرة الواحدة.
الاعتراف بمجزرة الطنطورة من قبل مشاركين بتنفيذها أو شاهدي عيان على تنفيذها من جانب القتلة، ضربة مِعْولٍ صغيرة لنفض الرُّكام الثقيل عن كثير مما دُفن في أرض النكبة وما تلاها ولم يُكشف بعد، فمواقف السيارات والحدائق العامة وأحراش الصنوبر التي استخدمت لإخفاء الجريمة لا تقتصر على الطنطورة، بل على المئات من أخواتها أحْصِيت فيها خمسةٌ وثلاثون مجزرة.
قبل بضع سنوات، اشتركت في مسيرة العودة التي أقيمت على شاطئ الطنطورة التي باتت تقليداً سنوياً.
كان على الشاطئ بضع عشرات من المستجمّين في آخر النهار، نظروا بدهشة إلى المسيرة التي رفَع فيها المشاركون أعلام فلسطين، وارتدى عشرات الفتية والفتيات من فرقة كشافة من القدس ملابس تراثية فلسطينية.
أذكر بين من وقفوا جانباً ينظرون إلى المسيرة، رجلاً عجوزاً ذا ملامح أوروبية بدا لي كأنه في حالة هذيان، ينادي على المارّين من أمامه.. أخمد أخمد.. كأنما يسخر ويقصد استفزازهم، لا أنسى عينيه الصفراوين اللتين كانتا نافرتين بدهشة وعدائية.
انتهت المسيرة على الشاطئ، حيث كان هناك معرض عن النكبة، وخيام وشموع وعروض فنية، كان هذا في رمضان، فرُفع أذان المغرب لأول مرة في هذه البلدة منذ النكبة.
معظم المشاركين يعرفون أن مجزرة وقعت في الطنطورة، لكن أكثرهم لم يكونوا يعرفون أن السّيارات والحافلات التي أقلتهم، وقفت بالضبط على رفات حوالي مئتين وثلاثين من رفات أهلهم وأخوتهم الطنطوريين، إنه أشبه بفيلم رعب.
إنها مجزرة مستمرة، وعارٌ طويل الأمد لكل من شارك في المجزرة ولمن عمل على إخفائها ولمن يستمر في الصمت على بقاء الرفات تحت موقف سيارات، يجب العمل على حماية هذه الرفات من هذا التدنيس اليومي.
«وقبيحٌ بنا وإنْ قدُم العهدُ هوان الآباء والأجداد»
«سِرّ إن استطعت في الهواء رويداًـ لا اختيالاً على رفات العباد».