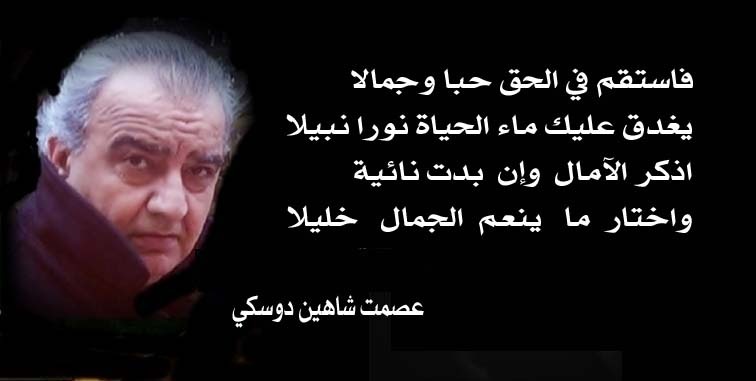قراءة سيميولوجية في كتاب (ممكنات الشعرية في القصيدة العربية المعاصرة) النظرية والإجراء للدكتورة أنسام محمد راشد

د. مصطفى لطيف عارف | ناقد وقاص عراقي
هذه محاولة في ارتياد أفق من آفاق الشعرية ، هو الأفق الذي يربط الشعرية بالسيمياء والتوصيل وفك شفرات أو إشارات النص ورموزه وطرائق تكثيفه وترميزه ، عبر اعتماد آلية التأويل وتلقي النص الأدبي للكشف عن المعنى الغائب أو معنى المعنى ـ كما يقول الجرجاني ـ وهو أفق رأينا ألا نختار معه منهجية محددة بعينها ـ كما اقترح احد النقاد ـ وإنما سنعمد إلى جمع شتات نظريته من مظان كثيرة ، تصب كلها في خانة واحدة هي محاولة الوصول إلى معنى المعنى أو المعنى الغائب للإشارات والعلامات السيميائية ، ومما لا شك فيه أن البحث في العلامة والإشارة قد ارتبط تاريخيا بمناهج ما بعد البنيوية ، ولاسيما المنهج السيميائي بمرجعياته المختلفة ومدارسه المتنوعة ، سواء أكانت أوربية مع دي سوسير أم أمريكية مع بيرس ، وهذا جعلنا أمام منهج متشعب ومتعدد الاتجاهات ، ومما زاد الأمر التباسا وتشعبا تداخل هذا المنهج مع مناهج وتصورات واتجاهات نقدية أخرى متساوقة معه ، كالتأويلية والتوصيلية ، فضلا عن اتجاهات القراءة والتلقي ، ولأن البحث يتطلب حضور كل تلك المناهج والتصورات والاتجاهات النقدية ـ ولو بدرجات متفاوتة ـ كان لابد لنا من الأخذ منها بما يخدم قضيتنا في كتاب (ممكنات الشعرية في القصيدة العربية المعاصرة النظرية والإجراء ) للناقدة الكبيرة الدكتورة أنسام محمد راشد , واجتناب التعمق فيها ، لأن خلاف ذلك سيفضي إلى متاهة يصعب الخروج منها ، ولا مناص من القول هنا إن هذا الأفق النقدي قد حظي ـ الآن ـ باهتمام النقاد والباحثين العرب ، ولاسيما في جانبه النظري ، إلى درجة طغى فيها جهدهم النظري على بعض المحاولات التطبيقية المتواضعة ، ربما بسبب عدم اهتمام النقد بما تقوله النصوص الأدبية ، بل بالكيفية التي تقوله بها ، وانسجاما مع ما تتطلبه المنهجية العلمية والأكاديمية في مثل هذه المواقف ، فقد هيأت لنا افتتاحية هذا الكتاب من الخوض في ذلك الجهد النظري والتطبيقي ، على أننا لا نأتي بجديد هنا غير ما يحسب لنا من إمكان الخروج بجهد نظري هو في الواقع حوارية نظرية تسمح بتكامل المناهج الداخلية والخارجية في تفاعل وتداخل وهذه المقدمة النظرية لا تدعي التعمق في استقصاء أطرافه تلك الخلطة كافة،إنما هي وقفة أملتها المنهجية ,ومثل هذه النهاية تضع الكتاب أمام تساؤلات وتأويلات عديدة فيما إذا كان الأمر مقصودا للإشارة إلى حالة المتاهة التي قد يدخلها الإنسان في مجتمع غريب , ويضع أثره نهائيا , أو الإيحاء بان الحضارة تمتلك القدرة على افتراس الغرباء وتدخلهم في متاهات قاتلة , يمكنهم الفكاك منها ,وترى الدكتورة أنسام محمد راشد في مقدمة كتابها لتوضيح ما تريد الحديث عنه بقولها يطل هذا الكتاب على جدلية يود متابعتها أفكارا وإجراءات تمسك بطرفها الأول سلطة النظرية وتعاليها المفرط واعتدادها بفلسفتها حال التعامل مع أفكارها ومقرراتها وما تمليه من ثم على مريديها والمؤمنين بها , وان لها معايير تبعدها عن غيرها من المناهج والنظريات التي دقت إطنابا ثابتة في جذور المشهد النقدي العالمي ,إن ما يجمع النظريات النقدية الحديثة هو اعتراضها على الرأي القائل إن المعنى كامن كليا في النص وملفوظه اللساني ، فالمتلقي بفاعلية الفهم قادر على تشقيق وجوه لا نهائية لمعنى النص بإعادة بنائه وإنتاجه وتلقيه، أي إن هذه الاتجاهات أو النظريات النقدية الحديثة كالقراءة والتلقي ترفض حصر المعنى بالنص وتميل إلى الاعتقاد بأن القارئ هو الخالق الحقيقي للمعنى ، ذلك لأن أبسط مفهوم للقراءة هو دمج وعينا بمجرى النص، وعلينا التأكيد هنا على أن هذه النظريات النقدية الحديثة هي جهد علمي متميز ـ وليست هرطقة كما يتصور بعض الناس ـ يولي اهتماما بالمضامين وصولا للمصطلحات بإزاء ما يفرزه الزمن من تحديات جديدة ، ويمكن أن نطبق هذه النظريات على ثلة من الشعراء الذين تم اختيارهم عينة لهذا الكتاب النقدي الرائع من قبل الناقدة المبدعة الدكتورة أنسام راشد ومنهم ( السياب , وأمل دنقل ومحمود درويش , واحمد مطر , ولميعة عباس عمارة , ومحمد الماغوط , ونزار قباني , والناقد عبد الله الغدامي فنكتشف حينها شيئا جديدا لم نسمع به في التحليل النقدي الفذ ، ويبدو جليا أن الأساس الذي اختلفت فيه اتجاهات ما بعد البنيوية مع البنيوية ، هو المعنى وبكلمة أوضح هو التأويل أو استنباط دلالة النص ، وفي هذا الصدد نجد من الواجب الإشارة إلى أن علم التأويل ( الهيرمينوطيقا ) الذي اختلفت النظريات النقدية في فهم آليته الإجرائية ، كان مدار حديث النقاد والفلاسفة منذ آلاف السنين وهو لم يكن من بدع زماننا هذا ، منذ أرسطو والسفسطائيين مرورا بمعنى المعنى عند الجرجاني ، بيد أن الذي حصل الآن هو أن ( الهيرمينوطيقا ) بوصفه دراسة معنى المؤلف في كلماته وتعابيره ـ كما في الفهم الكلاسيكي أو التقليدي ـ قد تحول إلى دراسة المعنى الناتج من عملية فهم المتلقي بعد أن كانت البنيوية تحيله إلى مرجعيات معجمية ، ولكن الأمر يزداد تعقيدا ، ولاسيما مع النصوص التي تربك القارئ أو المتلقي ، تلك النصوص التي سميت في عصرنا الحديث بـ ( الخطاب أو النص ) ، ففي هذا النص نلمس صعوبة في التوصل إلى دلالة واحدة محددة ، كأن ينطوي على دلالة إيحائية وأخرى تقريرية ، وعلى أية حال ، فليس كل النصوص واضحة جلية تقدم نفسها للقارئ من دون وجود مشكلة في التوصل إلى دلالتها الحقيقية ،ومن ثم لا تكلف القارئ جهدا وعناء ,أن ما يميز الناقدة المبدعة الدكتورة أنسام محمد راشد في تحليلها للنماذج العربية المختارة على وفق الشعرية الجمالية أن تشرك القارئ/ المتلقي معها في التحليل وأن تعتمد على ذكر المصطلحات النقدية الحداثوية وتشرحها أثناء تحليل النصوص المختارة في كتابها (الممكنات الشعرية في القصيدة العربية المعاصرة النظرية والإجراء ) وتدخل المناهج النقدية النصية في التحليل الأسلوبيات , وعلم النص , ونظرية التلقي , والنقد النسوي فضلا عن شرحها وتحليلها لبعض المفاهيم ,والمصطلحات النقدية الحداثوية كالتناص , والمحايثة , والمثاقفة وغيرها,وكتابها يحتاج إلى قارئ مثقف ومتمكن من اللغة والنقد حتى يفهم تحليل النماذج المختارة من الشعراء المشهورين ,فمثلا تناولت السياب بقولها : عند عتبة شعر السياب سيكون هو احد طرفي مزدوجة يمثل العراق طرفها الاخر وبين الطرفين يمكننا متابعة دينامية حركة منجزه ولنضف او نرفع احد الاسمين لنضع بدائل مناسبة عنهما او متطابقة معهما فسنحصل على نتائج واحدة دائما ,وهو ما اسماه هيرش بـ ( المعنى ) ، ويعني به المعنى الحرفي الموجود في النص الذي وضعه المؤلف فيه وقصده ، فهناك نصوص ( خطابات ) يحتاج فهمها إلى تأويل ، وهو ما أطلق عليه هيرش بـ ( المغزى )،وبعبارة أدق إن التأويل يعمل على الخطابات التي تحتمل دلالتين فيبرز الثانية البعيدة على وفق قرينة من جهة الأخرى،وبالتأكيد أن ذلك يشمل الخطابات الشعرية ، بوصفها أكثر أنواع الخطابات احتفاء بالرموز والإيحاء والغموض ، ذلك لأن أهم وظائف الخطاب الشعري هو خلق الالتباسات وجعل الوعي لاعبا يقظا وهو يقوم بتنفيذ اللغة التواصلية ، فالنص الشعري لا يهدف إلى تقديم معنى محدد ، إنما يسعى إلى تقديم حالة متكاملة ذات أبعاد تصويرية نفسية جمالية ، فيجعل الجزم بمعنى واحد أمرا صعبا لا تطمئن إليه أذهان المتلقين ، فيصبح التأويل ضرورة لا مفر منها ، أي إن النصوص التي تحقق قدرا كبيرا من الانزياح عن حدود الفهم ، فقد يظن قارئ ما انه استنفد كل ما فيها من دلالات ومعان ، ويأتي آخر فينمي فيها علائق ودلالات جديدة لم يفطن إليها القارئ الأول ، ومن ثم فان التأويل حاجة تتطلبها النصوص التي تحقق قدراً معقولاً من العمق وتعاند المتلقي وتستعصي عليه دلالاتها ومقاصدها ، فيفضي إلى تحفيز القارئ للمشاركة الفاعلة في تأويلها ، وعلى أية حال ، فالنقاد بوصفهم متلقين توصلوا إلى تأويلات كثيرة للخطاب ، وفي بعض الأحيان يكون التأويل أفضل من توجيه المؤلفة نفسه ، لأن المؤلفة قد تنصرف إلى مقصدية أحادية تتنافى مع الوجوه الجمالية الأخرى التي يمكن أن يكتشفها الناقد ، ومن ثم تلغى تداعيات اللاشعور التي لم يكن المبدع يعيها حينما أبدع النص ، حتى قال أحد النقاد علينا أن نفهم المؤلفة أفضل مما فهمت هي نفسها, فنراها تقول في الإهداء : أنت رؤيا طافت منذ ألاف بقلبي لمست غفلته , فارتد أسيرا وأنت جرح استوطن خاصرة الروح وأنت أنا ووووو ), إهداء فلسفي يحتاج إلى تأويل كبير لفهمه وجمالية نقدية لتذوقه , وشعرية عالية للتعبير عنه ,وفي هذا الصدد يرد قول الشاعر الفرنسي الشهير ( بول فاليري ) لأشعاري المعنى الذي تحمل عليه ، فليس ثمة حقائق في الأدب ـ كما يقول نيتشه ـ بل هنالك تأويلاتيعتمد الوصول إليها على ثقافة المتلقي وبراعته وهذا ما نادت به نظريات ما بعد البنيوية، فالتفكيكية تعتمد في الأساس على تصورات فلسفية معينة ، وعليه يمكننا القول ، إن الفكر النقدي هو فكر فلسفي لأنه يفسر الوجود المتمثل بالنص الأدبي ، ولا تُخرج الانطباعية والذاتية النقدَ عن تلك الساحة ، لأن من الطبيعي أن يصطبغ النقد بوصفه تحليلا بصبغة ذاتية حتى يكون فنا أيضا، فالقول إن النظريات النقدية ما هي إلا صدى لنظريات فلسفية فكرية صحيح، لأن ما من تجربة نقدية أو تيار نقدي إلا وصدر عن جذر فلسفي ،ولو استقرينا كل المناهج النقدية لتبين لنا أنها تميل مع الفكر الفلسفي الطاغي في وقتها ، فكلما مال بندول الفكر الفلسفي صوب المادية والتجريب والشك ، ظهرت نظريات نقدية متساوقة مع هذا الفهم الفلسفي ، والأمر كذلك مع المثالية واليقين الفلسفي ، وبعبارة أخرى إن تجريب لوك وشك نيتشة يتكرر بالقدر نفسه في مناهج النقد الأدبي ونظرياته، ففي بداية عصر التكنولوجيا تحرك الفكر الفلسفي صوب المعرفة اليقينية المعتمدة على الحواس وعلى المنهج العلمي التجريبي ، فظهرت البنيوية في أحضان التجريب ، وبعد أن لمس الناس الدمار الذي خلفه الاستخدام السيئ لآخر حلقة من حلقات التطور التكنولوجي ممثلة بالقنبلة النووية ، آثار ذلك الدمار إحساسا بالرعب وتأكد للناس أن العلم قد أخفق في تحقيق السعادة وجلب الآمان لهم ، فتحرك الفكر صوب الذاتية ، فارتمى في أحضان الذات الأمر الذي مهد لظهور مناهج أو نظريات نقدية ـ نظريات ما بعد البنيوية ـ تعتقد أن للذات قدرة على تحقيق السعادة والمعرفة ، إلا أن هذا الارتماء في حضن الذات لم يكن شاملا كما اعتدنا ذلك في الدورات الفكرية والفلسفية التي مرت بها الإنسانية، ذلك لأن موجة الشك الجديدة كانت أكثر شمولا وعمقا ، فقد خلفت إحساسا بالخديعة من العلم والذات معا ،حتى صار الإنسان يشك بهما معا ـ العلم والذات ـ وبقدراتهما على إسعاده.