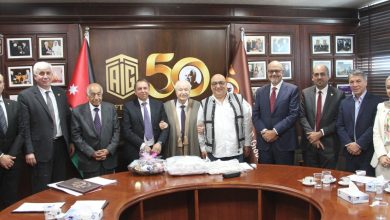العقل والقلب بين القرآن والفلسفة والعلم

القاهرة | خاص
إذا كانت النفس البشرية هي اللطيفة التي ركبت فيها فطرة التعلم بعد أن لم يكن للإنسان من العلم شيئا مذكورا، وهي التي أخذ عليها عهد الذر، وأودع فيها الأسماء كلها،حتى ترى بعد ذلك من خلال الكون هذه الأسماء فتعلم عن الله ما لم تكن تعلم؛ فإن العقل البشري هو الذي يثبت هذه الحقائق والمعاني ويجليها، وهو المترجم عن الكون للنفس الفطرية، وهو كذلك المحقق بين علم الفطرة في النفس وفي الكون بالبحث والاستقراء والتجربة العلمية والعملية .
لذلك لا يكون حوار ولا وصال بين الإنسان والكون إلا بهذا العقل، ولاينعقد وثاق الحقيقة العلمية والشرعية إلا به، فهو المتلقي عن الوحي العلوي، وهو المطمئن لما يلقى: أمن وحي الحق، أم من دعوى الشيطان والوهم؟!!
وهو المؤدي لما يتلقى من صدق التحقيق بين فطرة النفس وبدعة الكون، وهو الذي أنيط به التكليف استنادا لما استقبل من علم الوحي، وما ألزم من الشرع مما قد ثبت نقله، وهو الذي ألهم مهارة الاستخلاف في الأرض ليعمر ويعبد، وليحقق عين علم الألوهية فيه “إني أعلم مالا تعلمون”.
طوى العقل صفحات من الزمان، يشقى به أقوام، ويسعد به آخرون، ويكدى به أهل له، وينعم بدونه غيرهم سادرين في غيابات الجهل، ويرفع لأهله منزلة في الورى، ويخفض بين طبقات الحياة من تشاغلوا عنه بغيره فهم مغمورون، ثم لم يزل العقل يطغى حين يرى نفسه بالعلم والمال قد استغنى، ويناطح أسباب السماء بوهم أن ينفذ من أقطارها، باحثا عن سلطان!!
قد ضل به أقوام فجعلوه إلههم الذي يحتكمون إليه وشرعتهم التي يهتدون بها ــ وهم بذلك يقذفون بالغيب من مكان بعيد ــ ومرجعهم الذي يستدلون به في الخير والشر والخطأ والصواب؛ وغالى فيه آخرون فقدموه على النقل مع إقرارهم بالنقل (المعتزلة مثالا)، وذلك حين يبدو تعارض (ظاهر) النقل مع العقل، ولم يقروا منه إلا ما يقره العقل.
ثم جاء آخرون فادعوا الوسطية؛ فقالوا إن العقل يبلغ بفكره مبلغ الوحي من الاهتداء للتوحيد والأخلاق، وربما التشريع (ابن طفيل والفلاسفة)؛ ونجا به أخرون حين وضعوه حيث أراد خالقه له أن يكون، فاستعانوا به على فهم الشرع وتحقيقه والإقرار بالعجز والتسليم للأمر حين يبدو من ظاهر الأمر ثمة تعارض بين العقل والوحي.
شاد العقل هذه المنظومة من خبرة العلم التي سخر فيها الكون والعلم والطبيعة، وبلغ من بناء التجارب في الكون منزلا ـ ظنه ــ ليس بالقليل، وهو لايزال يسبح في ضحالة من الفهم والعلم، وهو يظن أنه يغوص إلى الأعماق، ويخيل إليه أنه بلغ من العلم مبلغا، وما أوتي منه إلا القليل، إذ لم يرق أن يُسخّر “بعوضة فما فوقها”، أو يخلق “ذبابا ولو اجتمعوا له”؛ ويتوهم أن أمر الحياة أصبح بيده، ثم يحصده الموت في كل لحظة فلا يرده عن نفسه، وتتخطفه رسله من كل فج وهو يظن أنه يهرب منه فإذا هو ملاقيه!! فأنى يؤفك هذا العقل، بل أنى يسحر؟!
جٌعل هذا العقل على نفسه بصيرة بعدما ألهم من الفهم، وتلقى من الوحي وتحقق من الكون فأقام على نفسه الحجة بين يدي خالقه، وليس له من عذر يتعذر به، وما له من الورود عليه من مفر، وهذه البصيرة جعلت له من الحكم والعلم ما يملك به زمام الأمر ، وما يرد به النفس إلى الصواب، يحدو بها إلى الخير، ويصرفها عن الضر، وينتقي لها من الخُلق ما يقوم به أمرها ويصلح به حالها، ويعينها به على دفع غوائل الشياطين من الخارج، والشهوات من الداخل.
ولا يهتدي العقل بفطرته الأولى فقط إلى كل ذلك، لكن لا بد له من حادي الوحي ومظلة الشرع، وعلم الدين والدنيا، يستعين بذلك على القيام بعمله، وبلوغ أمره، وقضاء وطره، ولا يعترض دين الفطرة الإلهية الداخلية التي توحي إليه بصدق الوحي مع دين الوحي الإلهي الذي أتت به الرسل وصدق به المرسلون.. يقول السفاريني “لو كانت العقول متسقلة بمعرفة الحق وأحكامه، لكانت الحجة قائمة على الناس قبل بعث الرسل وإنزال الكتب، واللازم باطل بالنص “وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا”؛ فكذا الملزوم.. لكن ليس النفي على إطلاقه، ولا تستقل العقول على سبيل التفصيل، أما على سبيل الإجمال فإن الله فطر الخلق على ملة التوحيد.
ويقول الغزالي : “فالشرع يأتي تارة بتقرير ما استقر عليه العقل، وتارة بتنبيه الغافل حتى يتنبه لحقائق المعرفة، وتارة بتذكير العاقل حتى يتذكر ما فقده، وتارة بالتعليم وذلك في الشرعيات وتفصيل أحوال المعاد.. وعلى العقل والشرع أشار بالفضل والرحمة، فقال “ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا”.(معراج القدس في معرفة أحوال النفس . الغزالي).
فقد قامت على العقل الحجة من خارجه (علم الوحي)، وقامت عليه كذلك من داخله (فطرة الخلق)، ولم يبق أمامه إلا التسليم والإذعان، ثم الاستسلام لأمر الشرع الذي هدي إليه “قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني”.. “فاستقم كما أمرت ومن تاب معك”..
هكذا جاء القرآن يخاطب العقل على اختلاف مشاربه ، المذعن منه والمنكر، والمجادل والمعاند، والمتسائل منه والمتغافل.. والمؤمن منه والكافر، ليقيم الحجة على المنكر والمتسائل، ويدحض حجة المعاند والمحاجج، وينبه الغافل، ويثبت المؤمن الموقن على صراط الله المستقيم “هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون”(الجاثية)..
كما حمل لواء الرحمة للبشرية جميعها، البر منها والفاجر، إذا قد حمل لهم منهج الإصلاح ودعاهم إلى صراط الله المستقيم، ونقل لهم نبأ الأمم من قبلهم لتكون لهم العبرة والفكرة، وليعمل كل منهم عقله فيما دعى إليه من منطق العلم والعقل والآيات البينات من النفس والكون حتى لا يكون لصاحب عقل حجة على الله بعد العلم، وهو من صميم الرحمة أن تكون الدعوة التي تحمل البشارة والنذارة، والعلم “آيات محكمات”، حتى ينطلق العقل من قيود الغرور والجحود إلى رحاب التوحيد والخلود.
” سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53) أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ (54)”.(فصلت).