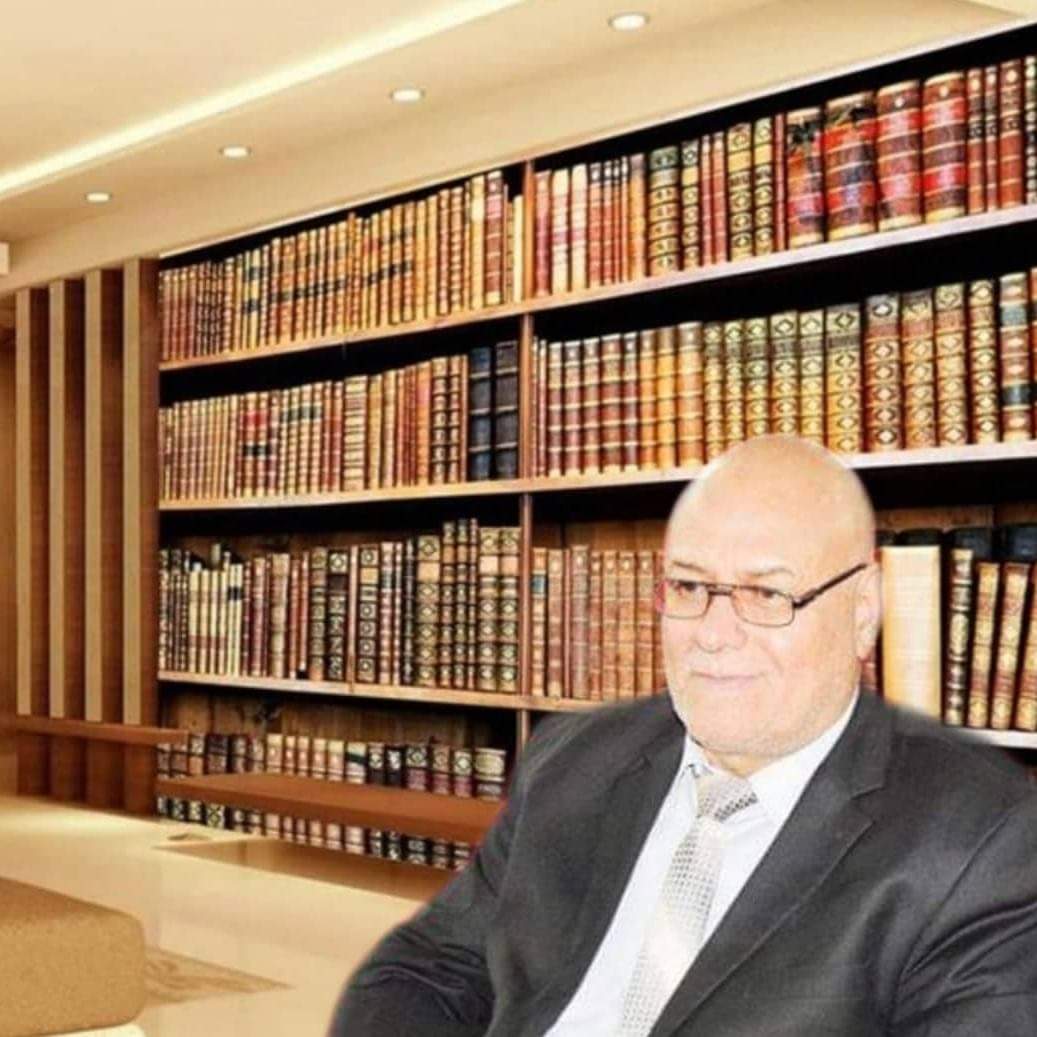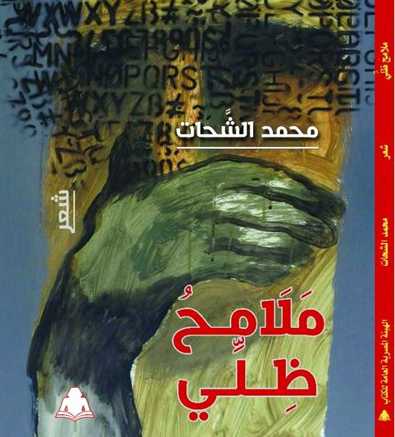لماذا يكرهوننا؟

د. إيهاب بسيسو | فلسطين

تمثال مشغول بأسلاك النحاس للشهيد محمد الدرة
سؤال النزاعات والحروب والدولية …
قبل أكثر من عشرين عاماً كان السؤال الذي رسم ملامح خارطة علاقات دولية جديدة ومضطربة: لماذا يكرهوننا؟ …
السؤال الذي جاء مباشرة بعد جريمة الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ٢٠٠١، ليصبح خطة عمل ممنهجة فكانت الحرب في أفغانستان ٢٠٠١ والعراق ٢٠٠٣.
واستمر البحث عن إجابة بالسلاح وسطوة الفولاذ في كل مدينة وضاحية وقرية وحيِّ وزقاق في الشرق “البني” وافريقيا “السوداء”
منذ ذلك السؤال أصبح الكل في تلك المنطقة الممتدة في جنوب العالم متهم ضمناً بتهمة عامة تتلخص باختلاف الهوية الناجم عن لون البشرة ولون العينين …
ثم جاء تطوير السؤال إلى خطة عمل ممنهجة وسلوك سياسي يدعي في ظاهره دعم المَدنية والحضارة متمثلاً في تعزيز ونشر “الديموقراطية”.
المصطلح الذي أعفى دولة مثل دولة الاحتلال في فلسطين من أي عقوبات دولية أمام الجرائم ضد الانسانية المقترفة بشكل يومي ضد الشعبي الفلسطيني، كون دولة الاحتلال “الديموقراطية الوحيدة” في المنطقة.
استمرت ماكينات الحذف والإضافة والتضخيم والتحريض في عملها الدؤوب لاختصار الشرق في كينونة مصطنعة وتعميم صورة مقصودة ومشوهة عن هذا الشرق، ثم ظهرت أعراض “الاسلاموفوبيا” في كثير من دول العالم “المتحضر”، تلك الظاهرة التي وجدت فيها الكثير من الأحزاب اليمبنية والقومية المتطرفة مبرراً لنشر رسالاتها وخطاباتها العنصرية كنوع من “الديموقراطية” واختلاف الرأي، الأمر الذي دفع إلى ارتكاب الكثير من الجرائم نتيجة التحريض الممنهج والعنصرية المقيتة، الجرائم التي تم وصف منفذيها “البيض” في سياق “الاختلال العقلي والنفسي” دون بحث جاد أو مقنع عن أسباب اقتراف تلك الجرائم.
كأن حضارات الشرق القديم وأفريقيا قد اختفت فجأة من مناهج الدراسة الأوروبية والأمريكية المتخصصة، ليحل محلها الخطاب العنصري المشحون بالتجييش العاطفي والظاهر في العديد من وسائل الإعلام …
لم يعد هناك مجال في الحيز الدولي العام للحديث عن حوار حضارات بل أنماط مختلفة من “صراع حضارات” كما أراد صمويل هنتجتون أن يصف مسيرة البشرية.
اقتصرت رؤية الشرق وأفريقيا من منظور عام سطحي وسياحي في كثير من الأحيان تمثل في صور إجازات وعطلات ومناسبات وفعاليات ترفيهية و ثقافية معقولة لالتقاط الصور في كثير من الأحيان كنوع من التواصل البشري خارج “عقدة لون البشرة والعينين”.
ثم ازدهرت ورشات العمل الدولية والحملات الانسانية المعولمة “لتعليم” الشرق وافريقيا أصول التمدن الغربي اللازم لمواكبة التطور وعصر النهضة الحديث المبني على تقنية الاتصالات الرقمية …
تم تدريجياً استبدال صورة الشرق وافريقيا الحضارية بالحروب والنزاعات الأهلية والمجاعات والديكتاتوريات التي وللمفارقة العجيبة شكلت الحليف الاستراتيجي في كثير من الحالات للقوى الغربية المركزية في نشر “الديموقراطية” وفرض العقوبات الدولية المختلفة على “الدول المارقة” باستثناء دولة الاحتلال في فلسطين.
لا يعني ما سبق أن هناك أصوات جادة في “الغرب المركزي” كأفراد ومؤسسات وأحزاب حاولت بشكل كبير من مواقعها الثقافية والأكاديمية والسياسية والفنية والإعلامية المختلفة أن تعدل من مسار البوصلة المشوهة والمضطربة نحو العدالة والانسانية الحقيقية، لا تلك التي تم صناعتها في مختبرات الغطرسة الاستعمارية.
غير أن الكثير من تلك المحاولات الجادة والهامة كان يتم تهميشها وتجفيف حضورها الإعلامي والشعبي تدريجياً بل ومحاربتها والهجوم عليها في احيان أخرى واتهامها الجهل أو التعاطف مع “الارهاب”.
خلال العشرين عاماً الماضية انشغلت الكثير من النخب الفكرية والروحية والإعلامية في الشرق وافريقيا في الدفاع عن “الهويات المختطفة” ضد مختلف أشكال الاضطهاد والخطابات العنصرية ومحاولة عقلنة الاختلال الذي قسّم العالم إلى نصفين: “إن لم تكن معنا فأنت ضدنا” غير أن الكثير من هؤلاء دفعوا الثمن غالياً سواء بالاغتيال أو الاعتقال من الكثير من القوى السياسية والديكتاتوريات التي هي في الأساس حليف استراتيجي في “التحالف الدولي لنشر الديموقراطية” …
لا أحد يستطيع إنكار مشاكل الشرق المتعددة والناجمة في كثير من الأحوال عن صراعات سياسية وأهلية وطائفية تدفع إلى مختلف أشكال الاستنزاف الاقتصادي والمجتمعي والسياسي التي تدفع بدورها إلى ظهور الديكتاتوريات المتعددة كنوع من “الاستقرار” المؤقت، الاستقرار الذي أصبح تاريخياً ورقة مساومة سياسية دولية لضمان بقاء فاعلية الديكتاتورية كعامل “استقرار” وظيفي.
فتتحول بهذا المنظومات السياسية إلى “جهاز وظيفي” ضمن معادلة دولية معقدة يكون ظاهرها البرَّاق “التمنية” وتمكين “الديموقراطية” ولكن في باطنها التحالف الاستراتيجي مع الديكتاتورية عبر انتزاع مسببات “اللا ستقرار” الناجمة عن نضالات حرية التعبير لتثبيت ديموقراطيات فعلية، ولكن تلك حكاية أخرى …
لم تبتعد الحرب القائمة في أوكرانيا عن ذاكرة الحرب الباردة خلال النصف الثاني من القرن العشرين، بل اقتربت كثيراً من الذاكرة الحديثة للحروب ونزاعات القوة في “الشرق الأوسط” والعمق الافريقي المهم دولياً اقتصادياً وسياسياً.
خلال الحرب القائمة في أوكرانيا يعود سؤال لماذا يكرهوننا مرة أخرى إلى العلن ولكن هذه المرة ليس موجهاً من “الغرب المركزي” ضد أي من أطراف الحرب في أوكرانيا، بل نحن الذين نتساءل أمام شاشات الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وبعد الاستماع إلى خطابات سياسية وتغطيات إعلامية رثة تقارن بين اللاجئين الأوكرانيين وغيرهم من حروب سابقة في أفغانستان والعراق وسوريا من حيث لون البشرة والعينين كمقياس للتحضر والاختلاف والحق في معاملة انسانية لأنهما “يشبهوننا” أي يشبهون الغرب المزدهر الحضاري الديموقراطي المتمدن.
“إنهم يشبهوننا” بلون بشرتهم الأبيض ولون أعينهم الزرقاء، عبارة بعثرت كل المفاهيم التي انتشرت خلال العشرين عاماً الماضية كنوع من الدعاية لمختلف أشكال التدخل السياسي عبر “الفوضى الخلاقة” وصياغة “شرق أوسط جديد” مناسب لمصالح وسياسات مركزية القوى الغربية في شمال العالم.
أما نحن أبناء الوجع اليومي فنتساءل: لماذا يكرهوننا؟ إلى هذا الحد الذين يفرقون فيه علانية بين اللاجئين ويفرقون فيه علانية بين الضحايا ويفرقون في علانية بين الألم، كأن لا مشكلة انسانية لديهم في حروب سابقة شُنت على بلاد الشرق وافريقيا باسم الاستعمار القديم والديموقراطية “الحديثة”.
الحرب حرب والضحية ضحية، أما التمييز بين دم ودم وجثة وجثة وضحية وضحية يمثل نوعاً بشعاً من أنواع العنصرية والتمييز والازدواجية البغيضة.
لماذا يكرهوننا؟
سؤال نرفعه بكل ما لدينا من ذاكرة مثقلة بالحروب والخوف منذ الولادة وحتى اندلاع حرب أخرى مفاجئة بين أضلعنا قد يشنها ديكتاتور أو تشنها ميليشيا أو يواصلها جنود احتلال أو مستعمرين من بلاد بعيدة ..