المترجم علي عبد الأمير صالح والشاعرة نادية الدليمي وجهاً لوجه
علي عبد الأمير صالح قاص وروائي ومترجم للأعمال التي تلهم الأفكار وتحرك المخيلة وتحفز العقل وتطرح الأسئلة

عالم الثقافة | بغداد
أبحث دوماً عن وسيلةٍ أعبّر فيها عن ذاتي وعن طريقةٍ لاكتشاف العالَم
لولا انغماسي في القراءة والكتابة والترجمة لظللتُ أعيش في ظلام دامس

الترجمة فن ومهنة ورسالة ولا يمكن إغفال أهميتها ودورها الفعال في نقل الثقافات والأفكار والحضارات من شعب إلى آخر والمترجم هو أداة الوصل والجسر الذي تنتقل عبره الثقافات والمعارف من ضفة إلى ضفة أخرى، وحري بالمتصدي لهذه المهمة الخطيرة والدقيقة أن يكون على درجة عالية وموثوقة من القدرة والمعرفة والإيمان بأهمية هذه الرسالة ودقة هذا الدور، ولعلَّ المترجم الدكتورعلي عبد الأمير صالح خير مَنْ يمثل هذا الدور فهو قاص وروائي ومترجم من الإنكليزية إلى العربية. ولد في الكوت عام ١٩٥٥ تخرج في كلية طب الأسنان جامعة بغداد عام ١٩٧٨ ، شُغف بالأدب ودفعه حبه المفرط للقراءة ومنذ سن مبكرة إلى تشييد صرح معرفي وتمكّن لغوي ما لبث أن تطور لينتقل به إلى القراءة باللغة الإنكليزية حتى تمكن منها ليبدأ مشواره الترجمي بترجمة القصص القصيرة، ونشرها في الصحف والمجلات صعوداً نحو حصد جوائز الإبداع في حقول الترجمة والأدب الروائي والنقد، يبحث عبد الأمير في الترجمة عن الأعمال التي تلهم الأفكار وتحرك المخيلة وتحفز العقل وتطرح الأسئلة ويرى في المترجم أن يكون قادراً على سبك المضمون بإسلوب عربي سليم..

عن الترجمة وشجونها كان لنا هذا الحوار الشائق معه..
* ما العوامل التي أسهمت في توجيه مسارك الإبداعي في المجالات التي مارستها، وفي أيها تجد نفسك أكثر؟
ـ أول العوامل التي ساهمت في تشكّل مسيرتي الإبداعية هو حبي المُفرَط للقراءة منذ سنّ مبكرة. أنا قارىء نهم منذ سنوات المراهقة وحتى يومنا هذا. ولمّا تطوّرت لغتي الإنكليزية أصبحت أقرأ بالعربية والإنكليزية، تصوّري أني قرأت روايات جرجي زيدان وكتب المنفلوطي ورواية (زوربا اليوناني) وأنا طالبٌ في المدرسة الثانوية، ومنذ ذلك الحين شغفت بالأدب. وفي منتصف سبعينيات القرن العشرين، في أثناء دراستي الجامعية، بدأت أكتب قصص الأطفال والقصص القصيرة. وتالياً في النصف الثاني من سبعينيات القرن العشرين، بدأت أترجم القصص القصيرة وأنشرها في الصحف والمجلات المحلية. وفي الأعوام اللاحقة واصلت مشروعي. حتى في أقسى الظروف واصلت القراءة والكتابة والترجمة. كنت أعرف أنه ليس بالضرورة أن تتوافر ظروف مثالية من أجل هذا كلّه. عشرات الشعراء والروائيين والفلاسفة قرأوا وكتبوا وترجموا في السجون والمعتقلات والمنافي، ومنهم دويستويفسكي وناظم حكمت وعبد اللطيف اللعبي ونابوكوف وموسونيوس وسينيكا. وطوال هذه الأعوام كلّها أدركت أنّ فضولي الفكري والمعرفي هو الذي دفعني في هذا الاتجاه. كنت أبحث دوماً عن وسيلة أعبّر فيها عن ذاتي، وعن طريقة لاكتشاف العالَم، ومن ثم كي أتغيّر أنا نفسي، وبعدها أُغيّر قرائي. لقد تحدّيت ظروفاً إنسانية قاهرة، ومنها مرض أولادي في سنوات الحصار، والإهمال والتهميش من قبل المؤسسات الثقافية والإعلامية. أنا بعيدٌ كلّ البُعد عن أولئك الذين يركضون وراء الشهرة الفارغة والمجد الأجوف. واصلتُ مشروعي، بهدوء وبلا ضجيج، في كتابة القصة والمقالة والدراسة النقدية من دون انقطاع. ويبدو أنّ غواية الترجمة متأصلة في نفسي، ولعلها انتصرت على موهبتي في الكتابة طوال الأعوام الخمسة الأخيرة، فأرجأت كتاباً نقدياً بدأت العمل عليه منذ عشر سنوات، ناهيك عن مواصلة الكتابة السردية، بعد روايتين ومجموعتين قصصيتين صدرت بين 2000 و2009. في الترجمة أبحث دوماً عن الأعمال التي تُلهِم الأفكار، تُحرّك المخيلة، وتُحفز العقل، وتطرح الأسئلة. لا زلت أميل لفن القصة القصيرة والرواية والنقد الأدبي، إلا إنّ هذا لا يلغي شغفي بالكتب السياسية والفكرية والفلسفية، والمذكرات والسِير.

* ما هي السمات الأساسية والتكميلية الواجب توفرها في المترجم الناجح؟
ـ المترجم الناجح ليس فقط ذلك الذي يُجيد اللغتين المنقول منها والمنقول إليها فقط، بل هو الذي يتمتع بالقدرة على (سبك المضمون بأسلوب عربي سليم ليكون الكتاب كأنما كُتب باللغة العربية)، كما يذكر الجاحظ. زيادة على ذلك، لا بد أن يحترم المترجم حرية المؤلف في التعبير عن آرائه ومعتقداته وفلسفته. أيّ بمعنى أنه لابدَّ أن يضع في الاعتبار أنّ الآخر مختلفٌ عنا في الدين، والأخلاق، والتوجه الفكري، وأسلوب الحياة، وفلسفتها، والذائقة الجمالية. وليس من حق المؤلف أن يُحاكم المؤلف باسم الدين، أو الأخلاق، أو الأيديولوجيا. وبالطبع، ليس من حقه أن يُغيّر، أو يحذف، أو يعترض، طالما أنّ النص ليس نصه، والكِتاب ليس كِتابه. ونحن نُدرك جيداً أنّ الترجمة تزدهر دوماً في المجتمعات الديمقراطية، حيث الحرية الفردية، والجماعية، والتنوّع العِرقي والديني والقومي واللغوي، والاختلاف الثقافي والفكري. في هذه المجتمعات الجميع لهم الحق في التعبير وإبداء الرأي، وممارسة الطقوس التي تعبّر عن انتماءاتهم الدينية، والقومية، والسياسية، وليس من حق أحد أن يُكمم أصوات الآخرين ويُصادر حريتهم، ويحرمهم من كشف [الحقيقة]. طالما (أنّ الكتابة العظيمة هي فِعل كشف [الحقيقة]، والكُتّاب شهودٌ على [الحقيقة]) ، كما تقول آذر نفيسي.
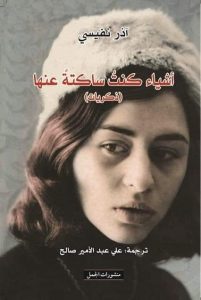
* ما الآلية التي تُمكّن المترجم من الحفاظ على صوت المؤلف أعلى من صوته في النص المُترجَم؟
ـ نعم، الترجمة لا تعني النقل الحرفي للكلمات والجُمل، بل لابدَّ من الحفاظ على السمات اللغوية والأسلوبية للنص. كأن يكون النص أو الكِتاب ظريفاً أو ساخراً، أو مكتوباً بلغة شعرية، في سبيل المثال. وينبغي للمترجم ألا يُحافظ على النص الأصلي فحسب، بل يُحاول أن يرتقي به ويجوّده. ومن مسؤوليته أيضاً لا أن يُترجم الكتاب بدقة وسلاسة فحسب، بل أن يجعل اللغة العربية جذابةً أكثر، وعذبةً أكثر للأجيال الجديدة من القرّاء. نحن لا نترجم الكتب والروايات، نحن نعيش مع الكُتاب والروائيين، نجالسهم، نحاورهم، نسمع نبضات أفئدتهم، نمشي معهم في الشارع المشجر نفسه، ونحتسي القهوة معهم، والآن صرنا نعبر الحدود معاً. إنّ مسؤولية المترجم مساوية لمسؤولية الكاتب. ونحن كلّنا لسنا أشخاصاً معزولين عن واقعنا وعالَمِنا، نحن في تماس مباشر مع أصغر حَدَث في مدينتنا وبلادنا. عرفنا ما فعله الأوغاد بالنساء الإيزيديات في سنجار وسواها من مدن شمالنا الحبيب بعد 2014، وما فعله رجال حركة (طالبان) بالنساء الأفغانيات؛ كيف فرضوا عليهن قيوداً لا إنسانية، ومنعوهن من العمل والتعليم، وآذوهن وضربوهن.

* ترجمتَ عن اللغة الألمانية من اللغة الإنكليزية،فهل تؤثر اللغة الوسيطة على روح النص الأصلي؟
ـ لا أعتقد أن الترجمة عن لغة ثالثة تؤثر على مسألة استقبال النص. بخاصة إذا كان المترجم حاذقاً، ومتمرساً. أنا لم أدرس اللغة العربية وآدابها، ولا اللغة الإنكليزية وآدابها، لكن موهبتي الأدبية وسعة إطلاعي وجديتي ودقتي في العمل، هذه كلّها مكنتني من تجاوز العقبات الكثيرة وتقديم أعمال مترجمة جيدة نالت استحسان القراء العراقيين والعرب.
* النص العربي المنقول إلى لغات أخرى هل يأخذ صداه وتأثيره؟ وهل لك تجارب في هذا المجال؟
ـ التقيت خلال العامين الماضيين بمُستعربتين إحداهما ألمانية (لاريسا بندر) والثانية إسبانية (نويمي فيرّو)، وكلتاهما شكتا من صعوبة ترويج وانتشار الأدب العربي المنقول إلى الألمانية والإسبانية، على سبيل المثال. عملية ترجمة ونشر الأدب العربي باللغات الأخرى عمليةٌ معقدة، وتخضع لمتطلّبات السوق، وليس كلّ ما يحقق النجاح في لغته وثقافته الأُمّ يلقى صداه في اللغات والثقافات الأخرى. غالباً ما يكون النص المُترجَم أفضل من النص الأصلي. النسخة الإنكليزية من (سيدات القمر) للكاتبة العُمانية جوخة الحارثي بترجمة مارلين بوث في الأرجح أفضل من نسختها العربية الأصلية (المنشورة في [دار الآداب])، فحازت الرواية على جائزة البوكر العالمية العام 2019. لم يسبق لي أن ترجمت نصاً أو كتاباً إلى الإنكليزية، للعلم.

*رغم اختصاصك العلمي كطبيب أسنان إلا إنّ توجهكَ في عملك الترجمي نحو الأدب، بِمَ تعلل ذلك؟
ـ منذ سنوات شبابي أدركتُ أني لا أستطيع أن أعيش حياةً واحدةً. ستبدو عندئذ حياة مملة، ومُحبِطة، ومُحزِنة. أعطاني الباري موهبةً في الكتابة والتأمل وسبر معنى الوجود، وحب التعرّف إلى الآخرين، واكتشاف العالَم. لولا انغماسي في القراءة والكتابة والترجمة لظللتُ أعيش في ظلام دامس، ولظلّ عقلي محدوداً، وحياتي عقيمة وخاوية حتى لو كنتُ ثرياً أو مُترَفاً. كما أني أحسستُ أنّ الترجمة مسؤولية إبداعية وإنسانية، ولا بد أن أُسهِم في هذا المعترك الباسل، وأعني الترجمة، باعتبارها (مصدراً من مصادر النمو والتطوّر، أيّ أنّها ضرورية لتقدّم البشرية)، كما تقول نويمي فيرّو، أو لكونها (تنطلق من اقتناع راسخ، يرى فيها (أيّ الترجمة) مشروعاً تنويرياً حقيقياً)، كما يذهب الأكاديمي والمترجم المغربي الدكتور مزوار الإدريسي. وتقول أولغا توكارتشوك (نوبل 2018): (المترجمون يُحررون الأدباء من الوحدة العميقة المتأصلة في عملهم الذي يقضون ساعات أو أياماً أو شهوراً في إنجازه) . أشعرُ الآن، بعد ترجمة 52 كتاباً، أني قمتُ بدوري في هذا المجال، وساهمتُ في معركة القضاء على العزلة الناجمة عن الحواجز اللغوية بين الشعوب والأمم والثقافات واللغات المختلفة.
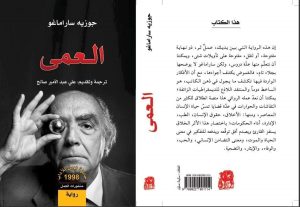
*مهنة الترجمة عمل تخصصي دقيق يتطلّب مهارات في الكتابة والقراءة والمحادثة والاستماع، فهل ترى أنّ الدراسة الأكاديمية تؤهل المترجم في جميع هذه المهارات؟
ـ ليس بالضرورة أن توفر الدراسة الأكاديمية سائر المهارات في الكتابة والترجمة. بالطبع، هي ضروريةٌ ومُهمة بلا ريب. إنما لابدَّ من الانكباب على العمل وتوظيف ما يكتسبه الطالب الجامعي من معارف ومهارات وخبرات تزوّد بها خلال دراسته الأولية أو ما بعد البكالوريوس. كلّ إنسان يستطيع أن يطوّر نفسه ومهاراته، إذا كان شغوفاً بمهنته، وجاداً في تحسين أدائه، ووضعَ هدفاً مُسبقاً لحياتِه، أو خطّطَ لمشروعِه المستقبلي. وفي الحق، هذه المهارات لا تُكتسَب بسهولة، ولابدَّ من بذل جهود جبارة ومُضنية، تستغرق وقتا طويلاً، وتعززها ثقة المترجم بنفسه، وسِعة إطلاعه، وصقل مواهبه، وتفتح عقله، والاستفادة من تجارب زملائه المترجمين، وزميلاته المترجمات.
*كانت الترجمة التحريرية عبر التاريخ مصدراً بالغ الأهمية في تأسيس ثقافة الشعوب ورفدها بالمعارف والأفكار، هل ما زالت الترجمة تحقق هذا الهدف في عصر التقدّم والعولمة؟

ـ نعم، الترجمة التحريرية ضرورية لتقدّم الشعوب ورُقيها وازدهارها. الترجمة في كلّ زمان ومكان ضرورية ومهمة. العالَم واسع، والمعارف والعلوم والآداب والملاحم والأساطير والأشعار والكتب الفلسفية والفكرية كثيرة جداً، ولابدَّ لنا أن نوّسع مداركنا ونطوّر حياتنا باستمرار. نحن لا نستطيع أن نحقق أيّ تقدّم إن ظللنا منكفئين على أنفسنا، ومن دون أن ننفتح على العالَم الأرحب ونتعلّم من الشعوب والأمم الأخرى. وحتى إننا بهذا المسعى سوف نفهم أنفسنا أكثر، ونُدرك سُبل النهوض ببلادنا، وكيفية تطوّير أدائنا في مجال التعليم والطب والاقتصاد ووسائل المواصلات إلخ. لأننا نُريد أن يعيش شعبنا حياةً أفضل، حياةً كريمة، خالية من الظلم؛ حياة تسودها العدالة والسلم الاجتماعي، وتختفي فيها مظاهر البطالة، ويختفي اضطهاد النساء، وممارسة العنف ضدهن. وبحسب ما تقول آني إرنو (نوبل 2022) في كتابها (أنظر إلى الأضواء يا حبيبي): (عندما لا ندافع عن حقوقنا نفقد الكرامة).
* ما الفرق بين الترجمة البشرية والترجمة الآلية؟ وهل أثرت الترجمة الآلية على تقانات الترجمة البشرية؟
ـ أعتقد جازماً أنّ الترجمة البشرية أدق وأعمق من الترجمة الآلية. لأنّ النصوص تحتوي على معانٍ خفية أو مستترة. هنالك إحالات، وتشبيهات، وأمثال وحِكم ومقولات سائدة لا يُمكن أن يُدركها أو يفسرها الحاسوب أو برامجه. كيف يستطيع الحاسوب، مثلاً، أن يوضح أنّ (الحرية تقود الجماهير) هي لوحة فنية للرسام الفرنسي يوجين ديلاكروا، رسمها إحياءً لذكرى ثورة يوليو الفرنسية العام 1830. توجد إشارة إلى هذه اللوحة في رواية (العمى). المترجم غير البارع يستعين بالترجمة الآلية أو ترجمة الغوغل أو سواه في ترجمة النص نفسه، أما المترجم المتمرس فيعتمد على مخزونه اللغوي والفكري والمعرفي وفهمه العميق في نقل النص إلى اللغة المصدر. من ناحيتي ممارستي الكتابة قبل الشروع بالترجمة أفادتني كثيراً. (الترجمة شكل من أشكال التأويل) ، كما يقول إمبرتو إيكو، وأعتقد أنّ الترجمة الآلية لا تستطيع أن تؤول وتفسر مثل الترجمة البشرية. ناهيك عن أننا، نحن أنفسنا، نتطوّر من يوم إلى آخر، ولا نرضى بما ترجمناه قبل عام أو خمسة أعوام. ولهذا يقول إيكو: (الترجمات تشيخ. هاملت، شكسبير يبقى هو نفسه، لكن علينا أن نعيد ترجمته من دون توقف).
* ترجمتك لرواية (طقوس فارسية)، هل هي اختيار أم تكليف من مؤسسة ما؟
ـ (طقوس فارسية) وعنوانها الأصلي (سووشون) رواية شهيرة تُرجمت إلى 17 لغة عالمية، ونالت مديحاً كبيراً عند ترجمتها إلى اللغات الأجنبية. وحتى نسختها الفارسية الأصلية بيع منها نصف مليون نسخة لمّا نُشرت في العام 1969. ناهيك عن كونها أول رواية تكتبها امرأة في إيران، وهي سيمين دانشور. للعلم، هي كاتبة قديرة، كتبت القصة القصيرة والمقالة والرواية، كما ترجمت لتشيكوف وبرناردشو وهوثورن. أنا الذي اقترحت ترجمة الرواية على ناشر مؤسسة (المدى)، ووافق على الفور. غالباً ما يقترح المترجمون العرب على الناشرين الأعمال التي يُودون ترجمتها إلى لغة الضاد.
* هل ترى أنّ على المؤلف أن يشذّب الخطاب المنقول ليناسب ثقافة الشعب الموجه إليه؟
– يقول الأكاديمي والمترجم وليد السويركي:
( الترجمة لا تحدث في الفراغ، وهي ليست دائماً فعلاً تقنياً محايداً وبريئاً، يقع خارج السياق الثقافي والتاريخي، أو خارج علاقات القوة، بل هي تندرج في سياق مُعولَم، لا يزال يشهد آثار التجربة الاستعمارية الماضية، وأشكالاً جديدة من الهيمنة الثقافية والاقتصادية) . نعم، المترجم والناشر كلاهما ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الأشياء كلّها. إلا إنه ليس من حقه أن يُشذّب أو يحذف أو يشوّه النص كي يكون مناسباً لتوجه دار النشر أو سياسة وزارة الثقافة. غير أنّ هذا، للأسف، لا يزال يحصل في بعض بلداننا العربية. في معظم الأحيان، الناشر هو الذي يتلاعب بالنص ويشذّبه، وليس المترجم. لأنَّ معظم المترجمين عميقو التفكير، متفتحو العقل، ومؤمنون بقيم الاختلاف.
* ما هي سمات النص الذي يدعوك إلى ترجمته؟
ـ أهم سمات النص الذي أرغب بترجمته أن يؤثر فيّ، يستفزني، أو يصدم أفق توقعي، باعتباري قارئاً نموذجياً. أو أنه حقق حضوراً جيداً في ثقافته، ونال تقديراً وثناءً من القراء والنقاد على السواء. وليس بالضرورة أن يكون الكِتاب من فئة الكُتب الأكثر مبيعاً في بلده أو البلدان الأخرى من خلال الترجمة. الكُتاب الأجانب لم يحققوا الشهرة ويحصدوا الجوائز إلا بعد عشرات المسوّدات، ورفض دور النشر نشر كتبهم ورواياتهم مراراً وتكراراً، ناهيك عن جهود المحررين والأخذ بنصائحهم. هم كُتاب مُميزون باستحقاقهم ومثابرتهم. من ناحيتي، كنتُ ولا أزال أبحث عن الروايات والكُتب ذات المعاني العميقة. أو لنقل التي تحفل بالأسئلة لا الأجوبة، لأنّ الأجوبة عمياء، الأسئلة وحدها التي ترى.
* كيف استطعت الحفاظ على هويتك في الترجمة وبصمتك الواضحة رغم تنوع الأساليب في النصوص التي قمت بترجمتها؟
ـ لا أعرف كيف حافظت على هويتي وبصمتي. لكني أقول :إني تعلّمت من كلّ الكتاب العرب والأجانب الذين قرأتُ لهم، وترجمت لهم، باللغتين العربية والإنكليزية. أطوّر أدواتي الإبداعية باستمرار، وأحاول أن أفهم النص جيداً، وأراسل الكاتب أو الكاتبة بشأن العبارات والجُمل الغامضة كي أقدّم عملاً ناجحاً، وكي لا يتصيد الحاقدون أخطائي أو هفواتي هنا أو هناك. راسلتُ صوفي ماكنتوش، وآذر نفيسي، وضياء حيدر رحمن، وعبدي نور إفتين.
* رغم توجهك الأدبي في الترجمة إلا إننا لم نرَ لك ترجمة لأعمال شعرية، فهل تتهيّب من الخوض في هذا المجال؟
ـ لم أترجم إلا قصائد قليلة أعجبتني فنشرتها منذ سنوات طويلة. أعتقد أنّ الشعر يترجمه شاعرٌ حاذق وموهوب، عندئذ لن تكون الترجمة خيانة. وبحسب الكاتب الأميركي كيت بوتسفورد، هذا الشاعر(يخلق قصيدة جديدة كاملة بلغة أخرى) . هذا ما شعرتُ به حين قرأتُ ترجمات سعدي يوسف لوالت ويتمان، وكفافي، وريتسوس. لا أتهيّب من ترجمة الشعر، لكني أجد نفسي أكثر في ترجمة الأعمال السردية، والمذكرات والسِير الذاتية، وحتى الكتب السياسية والفلسفية.
* كيف ترى واقع الترجمة في العراق قياساً إلى البلدان الأخرى؟
ـ الترجمة في العراق تتطوّر باستمرار، ولدينا مترجمون أفذاذ وقديرون، يترجمون عن الإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية والألمانية والدنماركية والبولندية والسويدية والفارسية والتركية والكردية والأفغانية. وهؤلاء كلّهم يثرون باستمرار المَشهد الثقافي العراقي والعربي، وينوّرون قرّاء العربية بمزيد ومزيد من الأعمال المترجَمة المنقولة من لغات العالَم، ويتحدّون ظروفهم في سبيل خدمة الإنسان أينما كان، عبر مدّ الجسور مع الشعوب والأمم، والانفتاح على كلّ ما هو جديد في الثقافات والمعارف والعلوم في أرجاء الدنيا.
* حدثنا عن مشروعك للتعاون مع (دار المأمون للترجمة والنشر)؟
ـ مشروعي الأول مع (دار المأمون للترجمة والنشر) هو مجموعة قصصية لكُتاب وكاتبات من ثقافات ولغات مختلفة حققوا سمعة طيبة، ونالوا جوائز مرموقة، من مثل أولغا توركاتشوك، وجوزيه ساراماغو، وألكسندر سولجينتسين، وسلمان رشدي، وتوني موريسون، وإلسا مورانتي، وخوليو كورتاثار، وراوي حاج، وسواهم. والكتاب الثاني، إذا ما حُسِمت مسألة الحقوق مع الناشر الأجنبي فهو كتاب إدوارد سعيد المعنون (البدايات: القصد والمنهج) ، وقد ألفه قبل كتابه الشهير(الاستشراق) . وحجمه كبير، إذ يقع في أكثر من 400 صفحة.




