
د. أسامة محمد | القاهرة
تُعدُّ مجموعة إذن مرور إلى الآخرة للكاتب سيد غلاب عملًا قصصيًا متقنًا يمزج بين الواقعية والفانتازيا، مقدمًا تجربة سردية فريدة تتناول موضوعات اجتماعية وإنسانية عميقة.
من خلال القصص المختلفة، يعكس غلاب صراعات الفرد في مواجهة المجتمع، وينسج نصوصًا تتأرجح بين الواقع والحلم، الموت والحياة، الحب والخذلان، مستخدمًا لغة سردية مكثفة، مشبعة بالإيحاءات الرمزية.
البنية السردية واللغة
يتميز السرد في المجموعة بأنه متعدد الطبقات، إذ يعتمد الكاتب على البناء الدرامي المتوتر، ويستخدم تقنيات مثل تيار الوعي، والاسترجاع الزمني، والحوار الداخلي، مما يجعل القارئ متورطًا في الأحداث كأنه يعايشها.
اللغة تتراوح بين الشعرية العذبة والجمل الجافة المباشرة التي تعكس قسوة الحياة وعبثية المصير.
كما أن العناوين المختارة للقصص توحي بمضامينها العميقة، فكل عنوان يعمل كمفتاح رمزي يكشف عن جوهر القصة.

الموضوعات والمحاور الرئيسة
١. الموت بوصفه تحوّلًا وجوديًا
يظهر الموت في القصة الرئيسة إذن مرور إلى الآخرة ليس كنهاية بل كبوابة لعبور الشخصيات إلى فضاء آخر، حيث تتداخل العوالم، وتتصادم الحقائق مع الأوهام. مثلًا، في المشهد الذي يتحدث فيه البطل مع والده بعد موته، يعكس النص فلسفة جدلية حول ماهية الرحيل، وما إذا كان الموت راحة أم مجرد انتقال إلى مأساة أخرى.
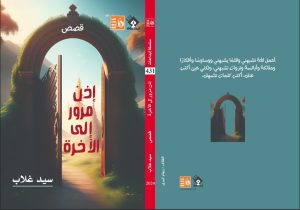
٢. المرأة بوصفها محور الصراع النفسي والاجتماعي
تمثل قصص مثل إيروسية السرير ويعسوب العسل نقدًا حادًا للعلاقات الزوجية التقليدية، حيث تتحول المرأة إلى قوة مهيمنة تدفع الرجل نحو الانهيار.
في إيروسية السرير، يعاني البطل من زوجة مستبدة تتحكم في تفاصيل حياته، بينما في يعسوب العسل، يستعير الكاتب نموذج مجتمع النحل ليعكس التفاوت في الأدوار الجندرية، إذ يُستخدم الذكر لمجرد التخصيب ثم يُلقى به إلى الموت.
٣. التراث والصعيد بين الحتمية والتمرد
تحمل بعض القصص، مثل حرب الجواسيس، ملامح صراع الفرد مع الجذور، حيث يعاني البطل من انتمائه لثقافتين متناقضتين: الصعيد المحافظ والعاصمة المنفتحة.
هذا الصراع يظهر بوضوح في اللغة التي يستخدمها الكاتب، إذ يمزج بين الفصحى واللهجة الصعيدية، مما يضفي واقعية على النصوص.
٤. الواقع والفانتازيا
توظف المجموعة عنصر الفانتازيا بشكل مميز، حيث نجد في قصة لعنة العصفور مثالًا على ذلك، إذ يدخل البطل في حالة من الهلوسة نتيجة لعنة قديمة، ويتحول الطائر الصغير إلى رمز لقدر لا يمكن تجنبه.
هذه النزعة الفانتازية تعزز الطابع الأسطوري لبعض القصص، مما يمنحها بعدًا فلسفيًا عميقًا.
البنية السردية ورؤية العالم
تقوم البنية السردية في المجموعة على خلق تداخل بين الأزمنة، فتظهر الذكريات كأنها حاضر مستمر، والموت كأنه امتداد غير منتهٍ للحياة، مما يجعل النصوص تنتمي إلى ما يمكن تسميته بـ”الزمن النفسي”، حيث لا يسير الزمن وفق المنطق التقليدي، بل وفق منطق التجربة الذاتية للشخصيات.
هذا المنظور الزمني يضع المجموعة في إطار “الوجودية السردية”، حيث تعكس القصص قلق الإنسان أمام الموت، وأمام فقدان المعنى في عالم تسوده المصادفة والحتمية معًا.
في قصة إذن مرور إلى الآخرة، الموت ليس فقط حدثًا بيولوجيًا، بل هو عبور إلى مرحلة أخرى من الإدراك، وهو سؤال فلسفي حول المصير، إذ نجد أن البطل يواجه ذاته في لحظة النهاية كما لم يفعل طيلة حياته.
الفلسفة النقدية للمجموعة
يمكن تحليل هذه المجموعة من منظور نقدي فلسفي يرتكز على ثلاث قضايا أساسية:
١. الحتمية والحرية: جدلية المصير الإنساني
تكشف القصص عن صراع دائم بين الإرادة الفردية والحتمية القدرية.
في إذن مرور إلى الآخرة، يتحرك البطل داخل عالم يبدو أنه مسيّر بالكامل، حيث تتحكم الأقدار في مصائره.
ومع ذلك، تبرز لحظات التمرد الداخلي، حيث يحاول الإنسان أن يخلق معنى خاصًا به داخل هذه الحتمية.
هذه الجدلية تتماشى مع فلسفة سارتر التي ترى أن الإنسان “محكوم عليه بالحرية”، فهو يملك خياراته حتى في أكثر المواقف حتمية، لكنه في الوقت ذاته مسؤول عن نتائجها.
٢. جدلية الذكورة والأنوثة: الصراع الأبدي
تتعامل المجموعة مع العلاقة بين الرجل والمرأة من منظور نقدي حاد.
في إيروسية السرير ويعسوب العسل، تتحول المرأة إلى سلطة خفية تفرض قوانينها على الرجل، في إعادة إنتاج لأسطورة ليليث، حيث تظهر الأنثى ليس فقط كمصدر للإغواء، بل ككيان يسعى إلى إعادة تعريف موقعه داخل النظام الاجتماعي.
هذا التناول يعكس رؤية نيتشه حول “إرادة القوة”، حيث يتم تصوير العلاقة بين الجنسين كصراع إرادات، وليس كتكامل.
٣. العبثية والبحث عن المعنى
يظهر العبث بوضوح في عدة قصص، حيث تبدو الشخصيات تائهة، تتصارع مع أوهامها الخاصة، مثلما نجد في لعنة العصفور، حيث يتم تفكيك الواقع بطريقة سريالية تعكس عدم القدرة على الفهم الكامل للوجود.
هذا المنظور يتوافق مع فلسفة كامو التي ترى أن العالم لا يقدم إجابات جاهزة، بل هو مساحة للبحث المستمر عن المعنى، حتى لو كان البحث نفسه عبثيًا.
البعد الفلسفي في السرد
يمزج سيد غلاب بين الواقعية الفلسفية والفانتازيا النقدية، ليخلق عوالم لا تخضع لمنطق واحد، بل تسائل القارئ عن حدود الإدراك، وعن حقيقة ما نعتبره يقينًا.
في قصة إذن مرور إلى الآخرة، يواجه البطل موته كأنه تجربة عبور إلى عالم جديد، لكنه لا يجد أجوبة، بل يجد مزيدًا من الأسئلة، تمامًا كما وصف هايدغر تجربة القلق الوجودي بأنها مواجهة مع “العدم الحي”.
في النهاية
يمكن قراءة هذه المجموعة بوصفها تفكيكًا للسرد التقليدي، حيث لا تقدم نهايات واضحة، ولا حلولًا نهائية، بل تضع القارئ في مواجهة مع أسئلة وجودية كبرى. في هذا السياق، تشكل المجموعة مثالًا على الأدب الذي لا يقدم قصصًا وحكايات فقط، بل يقدم رؤى فلسفية حول معنى الوجود، والهوية، والقدر، والحرية.





