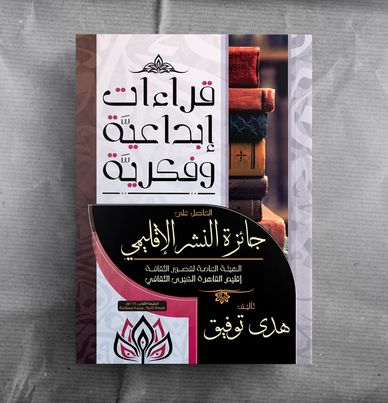حين يحلّق النص الإبداعي في سماوات الرموز..بكل حرية
محمد المحسن | ناقد وكاتب تونسي

اللوحة للفنان النمساوي: فريدريش فون
الكتابة تُعطيك فرصةً لاكتشاف نفسك حتّى وأنتَ في قمّة ألمك، تُساعدك على تفسير الأمور والحياة، بطريقة لم تكن لتدركها لولا أنّك خطَطْتَ أحاسيسك على الورق،ليست وصفة علاجيّة بالتأكيد، ولا يُمكن لها أنْ تمسح آلامك أو تنهيَها،ولكنّها تجعل لألمك معنًى وتضعه في مكانه الصحيح كامتحان قاسٍ من امتحانات الحياة الذي قد لا تخرج منه على قيد الحياة لكن تبقى على قيد ذاكرتها.
معظم الكتّاب نجَحُوا في استخلاص مادّة جيّدة للكتابة مِن حياتهم البائسة،كنوع مِن التصالح بين الكاتب والحياة، على شكل نصوص خالدة تحفظ اسم كاتبها للأبد، لم يكُن الألم وحده مَن صنَعَها لكنّه مَن صقل الموهبة وكمّلها.فأفضل الأعمال العالميّة كتبَها مُتألِّمون كفعل مقاومة،وأحيانًا كفعل ثورة.وأحيانا أخرى..كفعل تمرّد..
ولكن..
يحيّرُني أحيانًا ما يقوله البعض عن كون الكُتّاب يعانون، أو أنَّ مجموعةً منهم مِن ثقل العبءِ عليهم، وصلوا مرحلة الانتحار! لكنّها معاناةٌ مستساغة. الأمر عجيب، حتّى لا يُمكن تشبيهُه. قد يكون مثلًا كخوضِ مغامرة، تسلّق جبلٍ بلا حبل، غوصٌ بين سمكات قرش، دخولُ غابة، شيءٌ من هذا القبيل لكنّه ممتعٌ ما يزال. كما يقول حمّور زيادة: “الكتابة هي أجمل ما يتمنّاه الإنسان لنفسه،وهي أسوء ما يعاني منه الإنسان”.
الكتابة لا تقتصرُ على محدوديّات،نضعُها في إطار فوائد،أو نقاطٍ في كتابٍ مدرسيّ. (الكتابةُ الإنسان.الكتابةُ التاريخ.الكتابةُ الحياة)،أو كما يقول هرمان هيسه: “دون كلماتٍ أو كتابةٍ أو كتب لم يكن ليوجد شيءٌ اسمه تاريخ،ولم يكن ليوجد مبدأ الإنسانيّة”.
..ما بين تجاذب الأكاديمي والإبداعي قد تتموقع الذات الكاتبة حسب المقاوم وشروطه.ذلك أنّ الكتابة الأكاديمية تحيل على صرامة شروطها ومحدداتها،فالسسيولوجيا علم له ضوابطه الصارمة التي قد تقدّم نصا أكثر ميلا للموضوعية،لكن النص الإبداعي هو تعبير عن الإنفلات من برودة”العلمي” نحو دفء الأدب وانزياحاته الفنية الرائعة.هو محاولة للتحليق في سماوات الرموز بكل حرية وتمرد أحيانا.ومما لا شك فيه أن التلاقح يحضر بهذه الدرجة أو تلك علما أن الكتابة هي نوع من الرحيق الروحي الذي هو بمثابة عصارة شاملة للذات الكاتبة فكرا ووجدانا وتكوينا ومزاجا حتى..
الكتابة بمعنى آخر..بلسم للرّوح حين تتشظى