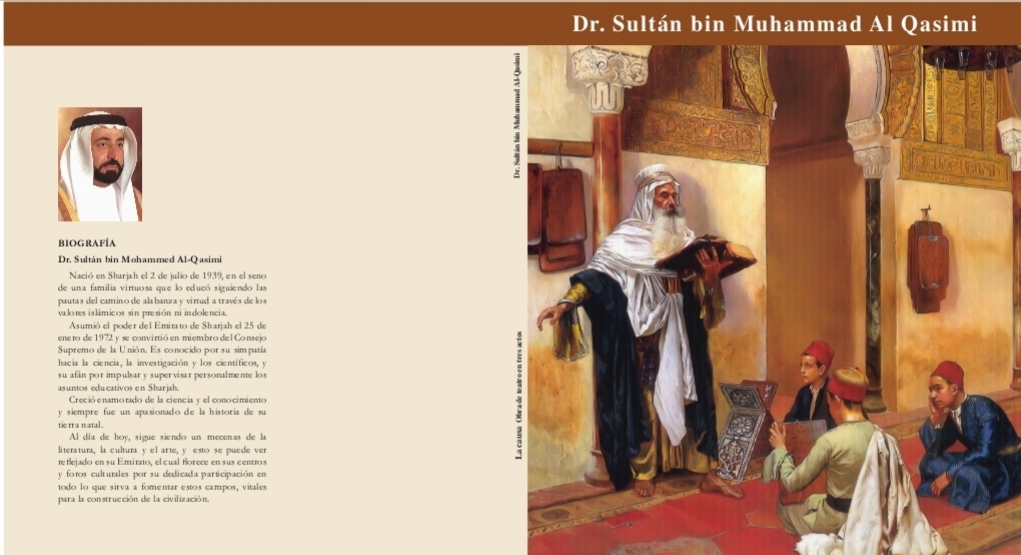زينب الهاربة من الهويات القاتلة

د. موج يوسف| أكاديمية وناقدة – العراق

أخذ مفهوم الهوية والانتماءات المتعددة قسطاً كبيراً من السرديات الروائية، وذلك يتمثلُ أكثر في المنجزات الإبداعية التي تدور حول واقع المغتربين في المنفى، كما أنَّ طبيعة الكيانات الاجتماعية المطبوعة بالتنوع الإثني والديني تحولت إلى ثيمة بارزة للأعمال الروائية، ولعلَّ أمين معلوف هو أشهر من تناول هذا الموضوع، سواء في أعماله الروائية، أو في منجزاته الفكرية، فبرأيه أنَّ اللغة هي مكون في تركيبة الهوية إضافة إلى الدين، وقد يكون الاختلاف على هذا المستوى عاملاً للتناحر والتنابز.
والسؤال الذي يفرض نفسه لماذا الاختلاف في الانتماءات الفرعية يفتح باب الحرب والاقتتال؟ ولماذا عندما يأتي دين جديد ينازع أتباعه مع الذي سبقه؟ وماذا عن أرض كالعراق متعددة الديانات والقوميات شقَّتْ أنهارُ الدَّمِ طريقها فيه وحميت الصراعات بسببه؟ وهل يمكن أن نستبدلَ الدين ما دام أنه هويّةٌ وهذه الأخيرة متغيرة لا ثبات فيها؟ الشاعر عارف الساعدي في روايته «زينب» الصادرة عن دار الرافدين، وهي باكورة تجاربه في السرد، يضعنا أمام تساؤلات الهويّة وصراعاتها في العراق.
كتب الرواية بتقنية الراوي المشارك، والبتالي يكون التبئير داخلياً بمعنى أن الشخصية البطلة زينب كانت تشترك مع الراوي بالسرد ووجهة النظر. ويفتتحُ الرواية بمشهد لعائلة زينب وأمها (سعاد) الشخصية الثانوية، التي يكون لها دور في تغير مسار الحدث، والأخوة (سارة ودانيال) عندما يطردهم جدهم بعد إعدام محسن الأب الشيوعي على يد النظام السابق، فهو الجنوبي من الناصرية وسعاد الأم البغدادية. بعد الإعدام تنتقلُ العائلةُ إلى مدينة كربلاء المقدسة بعيداً عن عيون النظام. زنيب التي زُرعت فيها جينات الأب الشيوعي، تبدأ برفض مظاهر دينية، لاسيما وأن أُمها اعتنقت كلّ طقوس الديانات ونذروها، زينب حالها كحال بنات البيئة الجديدة تلتحفُ الزي الذي يلغي هوية جسدها بالكامل، وتسلك طريقها لزيارة الرموز الدينية في كلِّ أسبوعٍ، لكنّ ذلك لم يمنعها من إتمام دراستها في كلية الفنون الجميلة في مدينة بابل.
تتحول أحداث الرواية مع التحول السياسي في العراق بعد 2003، ويتغير وضع الأسرة المادية إلى الأفضل، بعدما قبضوا ثمن إعدام والدهم، فتبدأ تساؤلات زينب عندما تتحدث مع شخصية حازم الذي يحرك فعل السرد والحكي، فتناقضات الحياة والدين تجتمع في الإنسان نفسه، فتقول لصديقها عن أمها التي تصنعُ النبيذَ وترسله إلى أخيها كامل في بغداد: «كنت استغرب كيف لامرأة متديّنة مثل أميّ تزور الأئمة يومياً، وتعقد النذور لهم وتدير المجالس والعزيات في بيتها. كيف لها أن تصنع مشروباً مسكراً في الوقت نفسه؟ رغم إنني وبعض صديقاتي نقوم بحفلات سكرية داخل كربلاء، وفي ليلة العاشر من محرم». أغلب الأماكن التي ترتدي ثوب المقدس لا تمارس حياتها بشكلٍ طبيعي، بزعم أنه حرام، فلو جاء أحد وقام بتعريتها من ثيابها لتمّ نفيه تحت ذرائع مختلفة، وإذا أخذنا النصّ السابق على واقعيته لأنَّ القصة انطلقت من حدث حقيقي فيعني أن تلك المدن موبوءة بالأنساق التي تَحرمُ وتحرّم على الإنسان حقوقه، وهذه الأنساق لابد من مراوغتها، لكن كيف وأهلها لا يرون الصح، بل الجنة إلا من خلالها؟ فهل الخطاب الأدبي كاف لزعزعتها؟ المرأةُ وقعتْ ضحيّةَ التشريع الفقهي المتاجر بجسدها، وهذا ما يكشفه الساعدي عن ظاهرة سادت في تلك المدن المقدسة فيقول الراوي عن زنيب التي طلقها زوجها «يلّفها ليلُ المدينة الموحشة ينتظرها عمل في الصباح، فالمطلقة في تلك المؤسسات مشروع عظيم لزواج مؤقت يستمتع فيه الطرفان بسرية عالية».
النصُّ يفرشُ بساطَ الحقيقة المعروفة عند الأغلبية والمسكوت عنها، فالمرأة المطلقة والأرملة في المجتمعات الشرقية المتّدينة تُسّلب حقوقها باسم الله، بل حتى جسدها، وزواج المتعة وما يضاهيه من المسيار والعرفي، من الظواهر الاجتماعية التي هشمت المرأة، فهو ليس زواجاً بالمعنى القانوني والشرعي؛ لسبب كونه يمنع الإشهار ومحكوم بمدة معينة.
المفهوم الخاطئ والالتباس بين الدين ورجال الدين الذين يمثلون الله في الأرض، في رأي عامة الناس، فاتبعوهم كالقطيع في حين أنَّهم موظّفون في المسجد أو الكنيسة، ومن ثم تتفاقم المشكلة أكثر، عندما يرتدي الحاكم أيضاً حلة المقدس.
ولأنَّ رجال الدين احتلَّوا عقل الأمة وأباحوا (الجنس) المقنن بالشرع، فصار الكلّ يسير وفق (أخلاقية القطيع) كما سمّاها نيتشة فقال «الناس مستعدون عبر اتباعهم الأعراف والتقاليد المجتمعية، ويخشون الخروج عن المألوف، وأنهم مثل قطيع الغنم» فهل الإشهار بهذه الظواهر يحررُ النّاسَ من عبودية الإتباع؟ وعبر تقنية الاسترجاع يعود الراوي بشخصية مهند الذي كان زوجَ زينب فيروي ظاهرةً أخرى عن رجال الدين في المدينة وهم ملقبون بـ(السّادة) في تسعينيات القرن الماضي، ومع الحصار، فرأى طابوراً من الناس ظاناً أنه لتوزيع المواد الغذائية، لكنّه امتعض عندما رأى أن الطابور لغرض الوصول إلى يد (السيد) وتقبيلها، لكن المشكلة «أن السيد تعب من رفع يده فاضطر أن يضعها على مخدّة لتقبيلها، والأغرب من ذلك أنه كان بجانبه أحد أصدقائه يتحدث معه في ما يمد يده الأخرى مرفوعة فوق المخدة والناس في طابورها الطويل تقبّلها».
المفهوم الخاطئ والالتباس بين الدين ورجال الدين الذين يمثلون الله في الأرض، في رأي عامة الناس، فاتبعوهم كالقطيع في حين أنَّهم موظّفون في المسجد أو الكنيسة، ومن ثم تتفاقم المشكلة أكثر، عندما يرتدي الحاكم أيضاً حلة المقدس. ومن المناسب هنا الإشارة إلى موقف فليسوف الوجودية كغارد، عندما قارب الموت سأله طبيبه إن كان يريد التلقين فقال: نعم لكن ليس من قسّ بل من إنسان عادي ، إن الكهنة موظفون رسميون في الكنيسة. بهذا المفهوم الوجودي يمكن أن نحرر عقول البشر. وهذا المشهد يرصدُ ظاهرة تقديس رجل الدين، وقمع الذات، وذكر هذه الظواهر الاجتماعية ورفع النقاب عنها ما هو إلا ثورة عليها، ومحاولة لتحرير الناس منها. تبدأ رحلة الهروب من الهوية عندما تتشابك خيوط الرواية وتتعقد بعد ما تنفجرُ الأمُ سعاد بالسر الذي حملته لسنوات، لاسيما بعد 2003 والفوضى العارمة، فتخبرهم الأم بهويتها قائلة: «آني يهودية» فتسألها زينب «والصلاة والصوم والزيارة وأم البنين؟، أي في البداية جنت أسوي هاي الأشياء كلها حتى أحافظ عليكم، وديني في داخلي وصلاتي اليهودية وعبادتي جنت أسويها من أكون وحدي بالبيت، وكلت نصير حالنا حال الناس بكربلاء».
مع شخصية سعاد نلحظ غياب الزمن الداخلي (المونولجي) لشخصيتها، الذي يعالج من خلاله علاقتها بين (اليهودية والعقيدة الإسلامية) والازدواجية التي عاشتها سعاد. والنصّ يوضح تقلبات الهوية، لافتا إلى خيار الهروب من قدّسية المدينة وطقوسها إلى أوروبا، ومن ثمّ إلى ما يسمى بدولة إسرائيل التي استقرت فيها سعاد وأبناؤها على أمل احترام الإنسان لإنسانيته، لكنَّهم وجدوا التميّز العنصري والنظرة الفوقية فتقول زينب للضابط عن تلك المعاملة «يهود أوروبا غير يهود الشرق وهذا التعامل الطبقي، نحن غير مضطرين أن نبقى تحت خيمته طيلة عمرنا» فمن المؤكد أن يجدوا هذه المعاملة عند دولةٍ تأسستْ على إقصاء أصحاب الأرض الأصليين. الهروبُ من الهويّات القاتلة إعلان لمفهوم ما يسميه المفكر التونسي فتحي المسكيني لمابعد الملة، حيث يتمتع الإنسان بكرامته وهذا ما يؤكده عارف الساعدي.