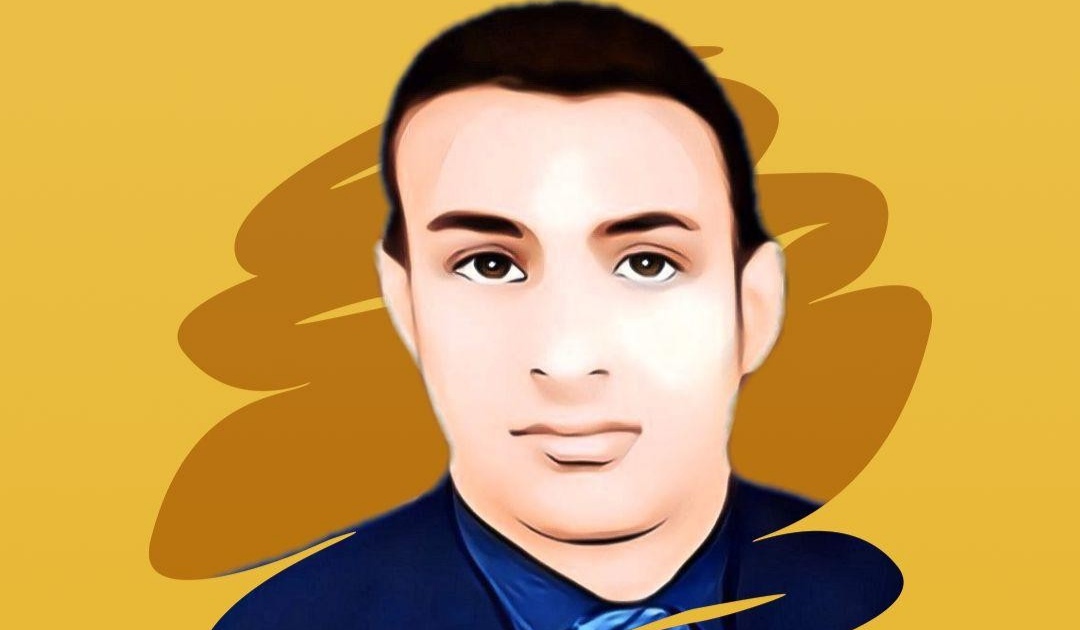نقد الدولة الحديثة .. حتى لا نقع في الفخ

محمد المجذوب | السودان
إن النظر للحياة السياسية، من وراء مفهوم الدولة الحديثة، وان استطاع خلق العديد من الإنجازات الحضارية المادية الأداتية التطبيقية، التي تجسدت بتطور العلوم والتقنيات والتطور العقلاني والمنظم لأدوات الإنتاج أن ترسم حدود الحداثة وتخومها -كما شرحها “ماكس فيبر”- فإن هذه المنجزات المادية الرأسمالية في تكثيف العمل الإنساني، التي هي خاصة أغلب المجتمعات الحداثية، قد أدت إلى تغيير عميق وشامل في شروط الحياة والتفكير في آن واحد، فانتهت شروط الحياة إلى أحوال الهيمنة على الإنسان والمجتمع والطبيعة، وما مثله هذا التأثير من الانتقال بالحضارة الغربية لاحقاً من حضارة العمل والتقدم إلى حضارة الاستهلاك والفراغ.
إن المنحى العام نحو الشمولية والهيمنة للتنظيم السياسي والقانوني والإداري، – وفقا لمنطق الدولة الحديثة- عاد ليضخم المعنى البيروقراطي والحيوي لمؤسسة الدولة في الفكر الحداثي، وهو ما يتعارض في طبيعته وقداسة فرضية الحرية الفردية التي جاءت الحداثة لأجلها، حيث يجد الإنسان نفسه ممزقاً بين ضرورة ضمان فاعلية التسيير والمراقبة، كونها الضامنة الضرورية لاستمرارية الدولة والحكم ومن يشرف عليه، وبين التمسك بما يرى أنه من صلب الحرية الفردية، كونها تضمن الشرعية الأساسية للحكم. بمعنى أن جهاز الدولة الإداري البيروقراطي كونه الأداة المهمة للتقدم والسبيل الوحيد لإحداث عملية التحديث الاجتماعي والسياسي والاقتصادي … الخ.
فقد قادت هذه الخاصية للدولة الحديثة إلى الهيمنة على الأوضاع الاجتماعية والثقافية والفكرية، وبالتالي الهيمنة على الحريات الفردية والعامة في المجتمع، مما أدى ويؤدي إلى أنواع من الصراعات والانقسامات الاجتماعية والحروب السياسية، ليست الحروب الأهلية الكثيرة داخل الدول وكذا الحروب الإقليمية والحربين العالميتين إلا تعبير عنها. مما فتح الباب امام الدعوات الى مفاهيم المجتمع المدني لمواجهة هيمنة الدولة الحديثة وجهازها البيروقراطي.
ان مفهوم الدولة الحديثة قد حول جهاز الدولة البيروقراطية إلى قيمة نهائية مطلقة تتخطى كل المطلقات الأخرى، بما في ذلك مطلقات الدين والله، بوصفها المعبرة عن العلمانية والعقلانية والضامن الأساسي للحرية الفردية الابتدائية التي كان عليها الإنسان في حالته الطبيعية، وعندئذ يصبح من المنطقي أن يتكيف الدين وتتكيف الأخلاق مع منطق أخلاق الدولة في الهيمنة والمجد والبراغماتية وأخلاق المصلحة والأنانية، لا أن تخضع الدولة لمنطق الدين وللقيم الأخلاقية في العدالة والكرامة الإنسانية، وهذا هو جوهر الفكرة العلمانية في فصل الدين عن الحياة الإنسانية، لاسيما عندما نتحدث عن السياسة العليا أو عن المصلحة العليا أو عن الأمن القومي للدولة … الخ.
والحق إن قبول وتبني المبدأ المؤسسي للدولة “الحديثة”، لشرح وتفسير مضمون السياسة والولاية في الفقه الإسلامي أمر فيه نظر، ذلك أن الجانب المؤسسي والهيكلي فيه لا يمكن فصله نظرياً أو عملياً عن “الرؤية” الفلسفية المادية النهائية للوجود الإنساني، فالعقد السياسي الذي يؤسس العلاقات والروابط واحد في كليهما، كما إن المبدأ المؤسسي هو في الأساس نظرية فلسفية قبل أن تكون جهازاً تنفيذياً “للمصالح” التي تسمى عامة.
بمعنى إن اتجاه قبول البني المؤسسية الليبرالية من جهة، ومحاولة “أسلمتها” من أعلاها من جهة أخرى، اتجاه محكوم عليه بالخطأ العلمي مسبقاً من الناحية النظرية، لقوة الربط بين الرؤية والأداة التي تعبر عنها، مما يقود في نهاية المطاف إلى غلبة القيم البيروقراطية العلمانية الخاصة بتلك الأطر المؤسسية، وطردها من ثم للقيم الإسلامية التي يراد إقحامها أو المزاوجة بينها وبين القيم “الليبرالية”، لاسيما في ما يتعلق بقضايا مثل وظائف وغايات وحجم الدولة ومقاصد التنظيم الاجتماعي وعلاقاته الارتضائية، فضلاً عن قدرة جهار السلطة في الهيمنة والتوسع والاستحواذ للفضاء الاجتماعي، وعندها فإن محاولة “الأسلمة” تصبح محاولة لا تتجاوز “توفيقية” حدود رسم السياسات العامة الهادية، لا تتعداها إلى مضامين ومقاصد البرامج العملية وعلاقاتها التفصيلية.
وهنا يظهر الإشكال النظري، في علاقة مرجعية أنموذج الأسلمة السياسي في نظرته للدولة، وفقاً للمذهب الأصولي في أنموذج المقاصد الشرعية والمصالح المرسلة، ذلك أن مرجعية السياسة في الرؤية الإسلامية وفي الواقع السياسي والاجتماعي والتشريعي ونحوه، هي الرسالة الإلهية وهي تأخذ طابعاً أممياً وعالمياً، فضلاً على إنها لا تجعل من العقل، أي الشعب وحده مصدراً لمبادئ الدستور والتقنين والتشريع، وإنما يهدي الأفراد في الجماعة السياسية بتعاليمها ويلتزمون تكاليفها.