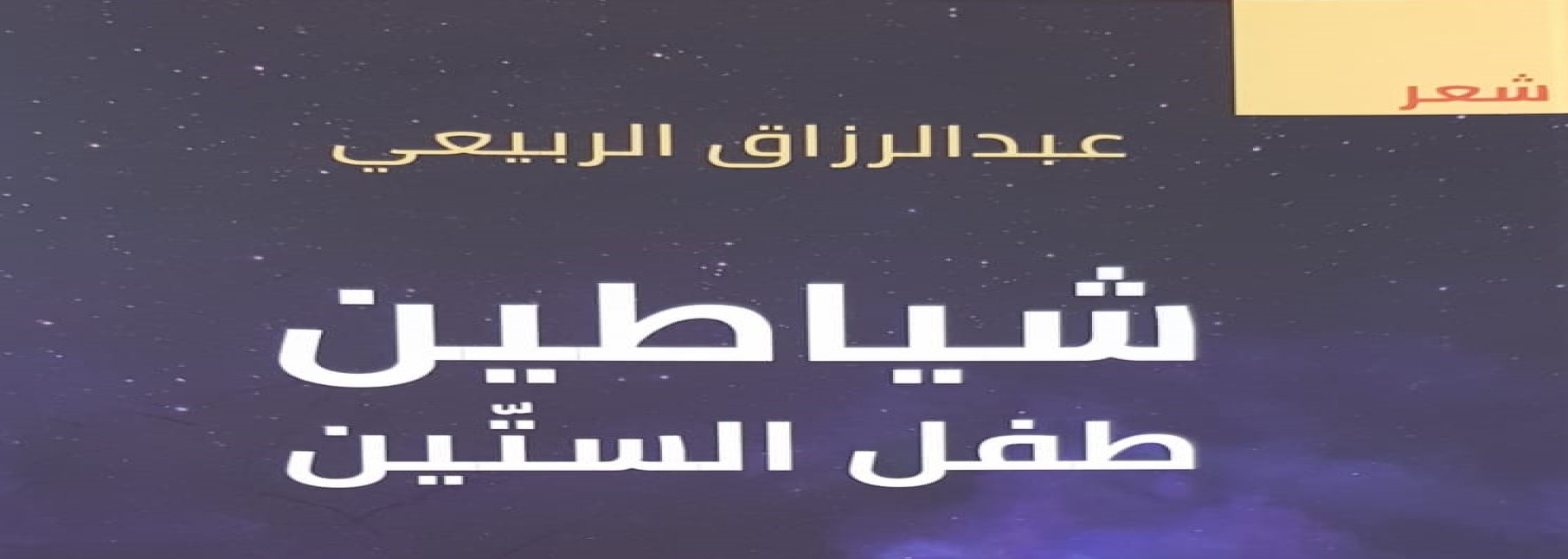تفسير سورة يوسف (2)
د. خضر محجز | فلسطين
﴿قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآَنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾
الآن تقدمت امرأة عاشقة أضناها العشق والبعد، لتقول بكل صراحة وطهارة: ﴿الْآَنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ﴾ ـ تًبَيَّن وظهر بعد خفاء ـ ﴿أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾.
ولا تتوقف العاشقة عند هذا الاعتراف المفاجئ، بل تبثُّ لوعتها شِكايةَ حزنِ مُلَوَّعٍ، في اعترافٍ مفاجئٍ أقوى وأشد إدهاشاً، فتقول:
﴿ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ* وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
قالت السيدة: أقول ذلك ليعلم المحبوبُ أنّي لم أَخُن ذكراه، ولم أَكْذِبْهُ في حبي، فلم أقل ما يسوؤه. فإن كان في كلامي من سوءٍ، فلنفسي السوء لا للحبيب. وإني لأرجو من الله أن يغفر لي لوعةَ القلبِ وهَمَّ اليد، بعد أن آمنتُ بما آمن به يوسف، فصار ربُّه ربّي. و﴿رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.
يا لله! إنه ليس عشقاً من قلبٍ مُوَلَّهٍ فقط، بل هو انتحار الماضي رجاء المستقبل، موت الرِّجس طمعاً في الطهارة. إنه ليس عشقاً فحسب، بل إيمانُ عابد بما يعبد المحبوب: بإلهه ودينه وشريعته.
فيا للحب العظيم كيف يطهر أرواح أهله!
ولا تقول امرأة طاهرة هذا، أمام الله وفي حضرة الملك، بهذه الكلمات المضيئة، إلا وتكون غير ذات بعل، مما يُرَجِّح لدينا ما يقوله القُصّاص من موت زوجها العِنِّين.
وعندي أنّ هذه السيدة قد تابت ولا ريب. ولكن هل فازت بما أمّلته طويلاً من وصال المحبوب؟ لا يعلم الغيب إلا الله. ولو كان كلام القُصّاص ينفع لقلنا به. ولكننا أحببناه لِحُبِّنا حبَّ هذه السيدة، ولِما سما به حبُّ امرأةٍ نبيَّاً طاهراً من أنبياء الله.
يقول المرحوم سيد قطب:“إنها امرأةٌ أحبَّتْ. امرأةٌ تُكبر الرجلَ الذي تعلَّقتْ به في جاهليتها وإسلامها؛ فهي لا تملك إلا أن تظلَّ معلَّقةً بكلمةٍ منه، أو خاطرةِ ارتياحٍ تُحسُّ أنّها صدرت عنه! وهكذا يتجلى العنصر الإنساني في القصة، التي لم تُسق لمجرد الفن، إنما سيقت للعبرة والعظة. وسيقت لتعالج قضيةَ العقيدة والدعوة. ويرسم التعبيرُ الفني فيها خفقات المشاعر، وانتفاضات الوجدان؛ رسماً رشيقاً رفيقاً شفيفاً، في واقعة كاملة تتناسق فيها جميع المؤثرات، وجميع الواقعيات في مثل هذه النفوس، في ظل بيئتها ومؤثرات هذه البيئة كذلك”.
وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴿54﴾ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴿55﴾
﴿وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي﴾:﴿وَقَالَ الْمَلِكُ﴾: معطوف على ما سبق. وقوله: ﴿ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي﴾ أمرٌ وجوابه. وكذا هي أوامر الملوك، تواقيع قليلة الألفاظ واضحة المعاني. فكأن قد قال: «أحضروه أجعله مستشار الدولة». فنحن في عهد كان فيه الملك هو الدولة. قبل أن نصير إلى عهد يتولانا فيه صغارٌ يقولون إن الحكم للشعب، وهم أكفر من فرعون، وأفسد من دنيء تولى سلطة، وأقسى من والٍ عثماني في بلاد النصارى.
﴿ائْتُونِي بِهِ﴾: أنفع به الدولة. هكذا يقول الملوك الحقيقيون، وكانوا خلاصة تربية طويلة منذ سن الطفولة، لا كولاة ارتفعوا من طبقات منحطة لا تعرف العيب.
إنه ملك حكيمٌ، هذا الذي يرى في يوسف رجلاً مختصاً بتأويل الأحلام، فيدعوه إليه ليخرج من السجن. وإذ أبى يوسف تلبية الدعوة، قبل أن تظهر براءته؛ لقد أثار ذلك فضول الملك، فعقد مجلس التحقيق، فظهرت براءة يوسف، فاستيقن الملك أنه ليس بين يدي مجرد سجين يعلم تأويل الأحاديث، بل سجينٌ طهارته لديه بكل هذا العالم، عليم كريم لا يخرج من سجنه بأي ثمن.
فلا جرم يضنّ بمثل هذا الملوك، الذين يستحقون أن يكونوا ملوكاً. وللملوك الحقيقيين أخلاقٌ، تضنُّ بهم أن يستخلصوا الحمقى والمرائين والصرّافين والأصهار.
فتأمل الفرق بين دعوتين كلتاهما ابتدأت بجملة: ﴿ائْتُونِي بِهِ﴾، لكن الثانية كانت إلحاحاً مُعَلَّلاً من الملك، فيما كانت الأولى مجرد طلبٍ غُفْلٍ.
وأما ما روته التفاسير من حكايات تشبه قصص «ألف ليلة وليلة»، منسوبة إلى من يروون تفاصيل ما حدث ـ كأنهم كانوا في المكان، أو سمعوا من المعصوم صلى الله عليه وسلم ـ فمسخرة تليق بالخطباء الشعبويين، الذين يحبون هذا اللون من الكلام، لأنه يقرب إليهم قلوب العوام، ويُبعدهم عن عين الله. ولقد تعالى الله أن يفسر كلامه الحمقى والجاهلون، بقوة ما تعالى عن قبول من يطلب من الناس القبول.
﴿فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾
﴿فَلَمَّا كَلَّمَهُ﴾: الفاء عاطفة على محذوف، وهي للتعقيب السريع، تشير إلى مضمر في الخطاب تقديره: «فأْتُوْا به». وذلك مؤذنٌ “بسرعة الإتيان به، فكأنه لم يكن بين الأمر بإحضاره والخطاب معه، زمانٌ أصلاً”.
ولقد تشاحن الناس في المتكلم من هو؛ فقال السمين الحلبي: “يجوز أن يكونَ الفاعلُ ضميرَ المَلِك، والمفعول ضميرَ يوسفَ ـ عليه السلام ـ وهو الظاهر. ويجوز العكس”.
قلت: والمقصود من كلام السمين أن الملك هو من كَلَّم يوسف، اتباعاً للقاعدة التي تقول بعودة الضمير عَلَى أَقْرَبِ مَذْكُورٍ. وهو مقتضى كلام شيخ المفسرين، وعنه أخذ الجمهور.
والكلام هنا هو أول الامتحان، فالملك يكلم يوسف ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيرد عليه يوسف، فيكون حوارٌ، ويعرف كلاهما مقدار الآخر. وقديما قال سقراط: “تكلم لأراك”.
﴿قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾
القائل هو الملك. وقد قال هذا بعد انتهاء الحوار بينهما، جزاءً لِما علم من قبل وسمع الآن. و﴿مَكِينٌ﴾: ذُو مَكَانَةٍ، بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِمَّا يُرِيدُهُ مِنَ الْمَلِكِ. و﴿أَمِينٌ﴾: مؤتمن على ما ائْتُمِنَ عليه.
﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾
القائل يوسف. و﴿خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾ ظاهره: خزائن القوت في مصر. وهو ما سوف يُسَمَّى من بعد في العصر الإسلامي: «بيت المال». ويُقال له اليوم: «وزارة المالية». لكن سياق الآيات يشير إلى أن ذلك كان منصب كبير الوزراء، أي: منصب «العزيز»، الذي كان يشغله سيد يوسف السابق، ويشي السياق بموته.
﴿إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾
وصف سيدنا يوسف نفسه بالعلم والحفظ، دلالة على جواز أن يصف الفاضلُ نفسه بما فيه، إن رأى أنّ في ذلك مصلحةً عامة، يُخشى فواتها دون ذلك. وليس هذا من تزكية النفس المذمومة في قوله تعالى: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ (النجم/32).
قلت: لأن النهي ـ في أصل التنزيل ـ مُنْصَبُّ على الكفار، الذين يزعمون الهداية، ويقولون: «لا حاجة بنا إلى الرسول والرسالة، فنحن مهتدون».
أما في العموم؛ فتزكية النفس هي: المنُّ على الله بالفضل، والتقديم بين يديه، والاقتراح عليه بأن يمنح المُزَكِّي نفسه ما يطلب. ولا دلالة فيه البَتَّة على ما يزعم المتدينون الجدد اليوم، من إباحة التصارع على المناصب، لِما يقولون: «إنه الإصلاح». والله يراهم أفسد الفاسدين.
فلمثل هؤلاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إِنَّا لَا نُوَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ”.
وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴿56﴾ وَلَأَجْرُ الْآَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴿57﴾
﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ﴾
هذا بعض تأويل قول الأب الصابر يعقوب ـ صلى الله عليه وسلم ـ حين قال لابنه منذ البدء: ﴿وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آَلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (يوسف/6).
وفي قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ﴾: جاءت الواو عاطفة على ما سبق. والكاف حرف تشبيه، بمعنى مثل. و«ذلك» اسم إشارة يحيل ما حدث ليوسف. والتقدير: «ومثل ذلك التمكين، الذي أحدثناه ليوسف ـ حين نجيناه من الجُبِّ والعبودية ـ مكنّاه الآن في الأرض إذ آتيناه الملك».
فالخطاب يُشَبِّه التمكين بالتمكين. ورغم ذلك فليس هذا التمكين الثاني بأقل من الأول، بل هو منه. وهكذا تبلغ البلاغة القرآنية حدَّ أن تعجز القواعدُ عن وصفها: فلئن قيل بأنّ للتشبيه ركنين هما المُشَبَّه والمُشَبَّه به، لا يستويان بحيث لا يشبه الأول الثاني تماماً، لقد قالت الجملة القرآنية هنا: ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ﴾، أي: مكنّا ليوسف تمكيناً لا يشبهه شيء سوى نفسه، كما قال النابغة ذات مرة:
نُبِّئتَ زُرْعَةَ والسفاهةُ كاسمها
يُهْدي إليَّ غَرائِبَ الأشْعارِ
قال ابن عاشور: فكان ذلك من الآية “تنويهاً بأن ذلك التمكين بلغَ غايةَ ما يُطلَبُ من نوعه، بحيث لو أُرِيد تشبيهُهُ بتمكينٍ أتمَّ منه، لما كان”.
قلت: و«زُرْعَةَ» هذا هو ابن عمرو بن خويلد، يجعله النابغةُ السفاهةَ شخصياً، فلا يُشَبِّهُهُ بها لأنّه هو السفاهة نفسها. وإنما احتججنا بهذا الشعر الجاهلي، لتقريب معنى تشبيه الآية، تمكينَ الله ليوسف الآنَ، بتمكينه إيّاه من قبل. فهما تمكين واحد، فهذا هو ذاك، فهو هو.
وقوله تعالى: ﴿مَكَّنَّا لِيُوسُفَ﴾ هو على الحقيقة: فالله هو الذي مَكَّنَهُ، ولا أحد له مع الله فعلٌ. ولكنّ الملك كان ستاراً لفعل الله. ولئن قيل إنّ في الكلام محذوفاً تقديره: «قال الملك: قد مَكَّنْتُك»؛ فلا بأس به، بناء على ما جرت عليه عادةُ الناس، من نسبة الفعل إلى السبب. فإن قيل: إن الله تعالى هو الذي مكَّنه في الأرض ـ كما تنص الآية ـ فأحسن. فقد سأل يوسف الملك التمكين في الأرض، فألقى الله في قلب الملك الاستجابة. وكذلك يفعل الله ما يشاء.
﴿يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ﴾
“كناية عن قدرته على التصرف والتنقل في جميع أرض مصر، كما يتصرف ويتنقل الرجل في منزله الخاص”.
و«التَّبَوُّؤ» هو: السكنى. فالمرء يَبُوْءُ إلى مسكنه، أي: يعود إليه. وأكثر ما يُقال «التَّبَوُّؤ» لما فيه تَّمَكُّنٌ. وأما «البَوْءُ» في قوله تعالى: ﴿وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ﴾ (البقرة/61)، فسخريةٌ كقوله إنهم: ﴿أَصْحَابُ النَّارِ﴾ (البقرة/39). إذ يجعلهم التنزيلُ العزيز يعودون إلى بيوتهم، كما لو قال: هم أصحابها ومالكوها الحصريون لا ينازعهم فيها أحد.
والنكاح «باءة»: لِما فيه من اعتلاءِ الرجلِ المرأةَ، وتَمَكُّنِه مما بين ساقيها، حتى إنّها لَتُسَمَّى «أهله» أي: بيته الذي يبوء إليه ويسكنه ويتمكن منه.
فمصر ـ بهذه المشيئة الإلهية، المغلفة بقرار ملك دنيوي ـ صارت مُوَطَّأَةً ليوسف ـ صلى الله عليه وسلم ـ يسكن أي ركن فيها، ويفعل ما يشاء. والمقصود: يحكمها.
﴿نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾
تذييل يختصر ما سبق ويُعَلِّلُه ويُكَثّف معانيه.
وتأويل قوله: ﴿نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا﴾: «ننال برحمتنا». كما يصيب الرامي الهدف. قال الراغب: “والنصيب: الحظُّ المنصوب أي: المُعَيَّن، قال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ﴾ (النساء/53)”. فكأن الذي أصابه الرَّمْيُ، نالَ حظَّه المقدورَ منه. فلو أطلق رجلٌ الرصاص على جَمْعٍ، لما أصابهم منه إلا ما كان مقدوراً في الكتاب.
وإذن ففي قوله تعالى: ﴿نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا﴾ معنى القلة. ذلك لأن رحمة الله غير محدودة، لينالها شخصٌ كلها، بل ينال نصيبه المفروض منها. فبدا لي أن جعل الآيةِ الرحمةَ «إصابةً»، إنما لما فيها من خفيفِ المَسِّ، كما نقول: «أصبتُ القليل من الحلوى»؛ وإلا فرحمةُ الله لا تُحَدّ ولا توصف، فكيف يُمنح كلُّ ما لا حدَّ له؟
وفي قوله تعالى: ﴿وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ استدراك على ظنِّ السوء، الذي قد يتمكن من شقيٍّ، فيرى أن المحسن يستحق الكثير من الرحمة، لا مجرد إصابة القليل منها: فكأن طمأن الخطابُ محسناً على نصيبه المحفوظ كاملاً.
﴿وَلَأَجْرُ الْآَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾
قد قال الله إن ما منحه ليوسف نصيبٌ قليلٌ من رحمته الأبدية السرمدية، التي لا توصف. فكأنْ كانَ بإمكانِ شقيٍّ أن يرى، أن قد نال يوسفَ نصيبُهُ من الرحمة، فلم يتبق له حظٌّ منها في الآخرة. ثم يستدل على كفره بالقرآن ـ كما يفعل القرآنيون اليوم ـ فيقول: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾ (الأحقاف/20). فقال الله: ﴿وَلَأَجْرُ الْآَخِرَةِ خَيْرٌ﴾ أي: أجر الآخرة أفضل، وأوسع خيراً، من كل ما ناله يوسف في الدنيا، فهو محفوظ له ولكل الذين ﴿آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾، أي لكل مؤمن اتقى ربه وراقبه في سره وعلانيته.
وفي الآية تأكيد على أن عقد القلب يستدعي العمل، وإن لم يكن جزءاً منه: فهم لم يؤمنوا فحسب، بل كانوا يخشونه ويَتَوَقَّون غضبَهُ في كل ما يفعلون.
وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ﴿58﴾
الواو في أول الجملة هي واو الاستئناف النحوي ـ التي يُقال لها واو الابتداء ـ ومهمتها عرض بداية فصل جديد، سبقته فصول أخرى، فهو من باب عطف القصة على القصة، أو عطف ما هو الآن على ما سبق مما كان.
والزمن المحكي هو زمنٌ تالٍ لما قصته علينا الآيات السابقة؛ بما لا يقل عن ثماني سنوات من تمكين يوسف. فنحن الآن في زمنٍ نرى فيه بعض ما يحدث بعد انقضاء السنوات السبع الخصاب، وحلول سنوات المحل، التي لا نعلم أيّ سنة منها هذه التي يسردها النص، عن مجيء إخوة يوسف إلى مصر؛ وإن كنا نُرَجِّح أنها السنة الأولى، لِما نعلم من أن الناس يسعون إلى التزود بالقمح، منذ أول وقوع المحل: فلا يُعقل أن يتوقف المُسْنِتون في السنوات العجاف عن السعي إلى طعامهم سنوات، وهم يسمعون بأن ثمة طعاماً في مكان قريب، مُخَزَّناً لمثل هذه المحنة.
لكن الزمن في السرد غير الزمن في الواقع، لأن فنون العرض تقتضي أن تقفز بنا لغة السرد، بما يستطيع المتلقي أن يستكمله من الأحداث. ولولا ذلك لما انتهت قصةٌ أبداً.
وإذن فقد قفز بنا الزمن فوق كل هذا، من الأمكنة والأحداث والشخصيات: فلم نَرَ ـ مثلاً ـ كيف جَدَّ الفلاحون المصريون ﴿دَأَباً﴾ طوال سبعٍ من سِنِيِّ الخصب، ولم نَرَ علميات التخزين تجري في مصر القديمة على قدم وساق. ولم نعلمْ إن كانت فلسطين إقليماً من الأقاليم التابعة للدولة المصرية: فتلك حقائق وأحداث يطويها الخطاب، لأنها ليست مُرادةً في ذاتها. بل إننا حتى لا نرى امرأة العزيز، بما كان لحضورها من أهمية في السابق؛ ولا نرى الملك بما كان لحضوره من مهمة حل عقدة القصة.
فإذْ حقق حضورُ تلك الشخصيات الهدف منه، لقد كان عليها أن تتوارى، لتفسح المجال لشخصيات أخرى، عرض الخطاب لها في الأوَّلِ، ثم غابت قبل أن تعرض ما لديها من أقوال وأفعال. فالآن تعود لنرى ما حدث لمن غابوا؛ خصوصاً والعرض كله يهدف إلى تسلية قلب النبيّ الأُمّي محمدٍ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأُمَّتِه، بذكر فوائد الصبر وعاقبته.
﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ﴾
قد جاؤوا يشترون من القمح المخزون، الذي علموا أنه في خزائن مصر. وتلك إشارةٌ قوية لما لم يتطرق إليه المفسرون، من أن البلاد التي قدموا منها ـ فلسطين ـ كانت تتبع مصر سياسياً واقتصادياً، لأن الملوك لا يفتحون مخازنهم في سنوات المجاعة لغير المواطنين.
ونحن إذ نشهد عرض الجملة لقدوم إخوة يوسف، بقولها: ﴿فَدَخَلُوا عَلَيْهِ﴾ بما اقترنت به من عاطف الفاء، الذي يفيد التعقيب السريع؛ نعلم أنهم دخلوا عليه فور قدومهم. لكنا نستغرب دخول «البدو» الغرباء على «عزيز مصر»، ونحتاج من ثم إلى تفسير ذلك. فلما أن قالت الجملة التي بعدها:
﴿فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ﴾
تم التفسير، وعلمنا أنه عرفهم من قبل أن يعرفوه، لهذا استقبلهم فوراً.
ولقد كان من حق شخصيات القصة، التي تتقمص الأقنعةَ اللغوية لأخوةِ يوسف، أن ينكروا أخاهم، بعد هذه السنوات الطوال، كما كان من حقه أن يعرفهم، لما نعلمه من حكم الواقع الذي يقول بتَغَيَّر شكل يوسف الصغير عما كان عليه، وبقاء شكل إخوته الكبار على حاله. لذا فلا نرى أنفسنا محتاجين ـ في تفسير إنكارهم أخاهم ـ إلى روايات مكذوبة ينقلها لنا إخباريون وقُصّاص، عن ابن عباس، كنّا سنردّها لو صحَّ إسنادها، فكيف ولم تصح، وتذكرنا بقول الشافعي رضي الله عنه: “لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيهٌ بمائة حديث”؟
وتلكم هي الرواية كما ينقلها لنا الطبري ـ رحمه الله ـ بإسناده، نعرضها كما هي:“حدثني الحارث، قال: حدثنا عبد العزيز، قال: حدثنا صدقة بن عبادة الأسدي، عن أبيه، قال: سمعتُ ابن عباس يقول: لما دخل إخوة يوسف فعرفهم وهم له منكرون، قال: جيء بالصُّوَاع، فوضعه على يده، ثم نقره فَطَنَّ، فقال: إنه لَيُخبرني هذا الجَامُ أنّه كان لكم أخٌ من أبيكم، يُقال له يوسف، يُدنيه دونكم، وإنّكم انطلقتم به فألقيتموه في غيابة الجب. قال: ثم نَقَرَهُ فَطَنَّ: فأتيتم أباكم فقلتم: إن الذئب أكله، وجئتم على قميصه بدَمٍ كذب. قال: فقال بعضهم لبعض: إن هذا الجَاَمَ لَيُخبره بخبركم. قال ابن عباس: فلا نرى هذه الآية نزلت إلا فيهم: ﴿لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (يوسف/15)”.
قلت: وهذا الأثر عن ابن عباس يحمل دلائل كذبه فيما يحمله من غرائب، تَعَوَّد الوعاظ الحمقى على صناعتها وروايتها. أضف إلى ذلك كونه منكراً سنداً ومتناً:
فمن حيث السند، رأينا فيه عبد العزيز وهو ابن أبان: متروك الحديث. كذبه ابن معين.
ومن حيث المتن، قال فيه العلامة أحمد شاكر: “فالخبر ـ عندي ـ غير مستقيم. وكفاه اختلالاً أنّه مخالفٌ لصريح القرآن. ولو وافقه، لكان أولى به أن يكون: قال لهم ذلك، لما دخلوا عليه، فقال لهم: ﴿هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾ (يوسف/89)، في آخر السورة”.
وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴿59﴾ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ﴿60﴾ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ﴿61﴾
﴿فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ﴾: هذه حقيقة ينطق بها صريح النص. وأي تفسير لكلام الله عليه أن يقدم تبريراً لمنطق يوسف في هذا السؤال. أو بمعنى أوضح: إذا كان عزيز مصر قد عرف هؤلاء البدو الفلسطينيين ـ الذين لا يعرفون أنه عرفهم، ويحرص على ألا يعرفوا أنه عرفهم ـ فكيف أمكنه أن يطلب منهم أن يأتوه بِأَخٍ لَهُمْ مِنْ أَبِيهمْ، دون أن يسمح لهم بأن يعرفوا أنّه عرفهم؟
وذلك سؤال يستدعي تدخل السُّدي، الشيعي المغرم بنقل الإسرائيليات، ليقول ـ كما ينقل عنه تلميذه أسباط، الذي هو ليس أحسن حالاً منه ـ أو فيقول الأخير وينسب إلى الأول:
“أصاب الناسَ الجوعُ، حتى أصاب بلادَ يعقوب التي هو بها؛ فبعث بنيه إلى مصر، وأمسك أخا يوسف بنيامين. فلما دخلوا على يوسف، عرفهم وهم له منكرون. فلما نظر إليهم، قال: أخبروني ما أمركم، فإني أنكر شأنكم؟ قالوا: نحن قوم من أرض الشأم. قال: فما جاء بكم؟ قالوا: جئنا نمتار طعاماً. قال: كذبتم، أنتم عيون. كم أنتم؟ قالوا: عشرة. قال: أنتم عشرة آلاف، كل رجل منكم أميرُ ألفٍ. فأخبروني خبركم. قالوا: إنّا إخوةٌ بنو رجل صِدِّيق، وإنّا كُنّا اثنى عشر، وكان أبونا يحبّ أخاً لنا، وإنّهُ ذهب معنا البرية فهلك منا فيها، وكان أحبَّنا إلى أبينا. قال: فإلى مَنْ سَكَنَ أبوكم بعده؟ قالوا: إلى أخٍ لنا أصغرَ منه. قال: فكيف تخبروني أن أباكم صدِّيق، وهو يحب الصغير منكم دون الكبير؟ ائتوني بأخيكم هذا، حتى أنظر إليه ﴿فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ* قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ﴾. قال: فضعُوا بعضكم رهينة حتى ترجعوا. فوضعوا شمعون”.
فأنت ترى كيف يصنع السُّديُّ هذه القصة، بطريقةِ من يحاول إقناعك بصدق ما تقوله الإسرائيليات. فهو يأتينا منها بما لم يقله النص القرآني، رغبةً منه في زيادة جرعة الإقناع لدينا، إذ يقول: إن يوسف قال لإخوته حين وعدوه بمراودة أبيهم عن أخيهم: «فضعُوا بعضكم رهينة حتى ترجعوا» فوافقوا ووافق شمعون. «فوضعوا شمعون» رهينة.
ولم نكن محتاجين لهذه الزيادة، لولا شعور السُّدي ـ أو تلميذه أسباط ـ بضرورة أن نصدق ما اختلق من الأكاذيب، لما يعلمه أمثاله من قدرة التسلية على التخدير. فهو يشعر أن لولا التخدير لسألناه: «فمن أتى على سيرة شمعون هذا، والتنزيل لم يذكر رهائن هنا ولا ما يحزنون»؟
ثم ما هذا الإسراف في اعترافات الإخوة بدقائق الأمور تبرُّعاً، مثل مناضل حقق معه ضباط الشاباك فانهار، وأدلي لهم بمعلومات لم يطلبوها؟ ألم ترَ إلى غرابة قول إخوةٍ سألهم غريب عن حالهم: «وكان أبونا يحبّ أخاً لنا، وإنّهُ ذهب معنا البرية فهلك منّا فيها، وكان أحبَّنا إلى أبينا»؟
والأغرب من كل هذا، سؤالُ عزيز مصر هؤلاء البدو: «فإلى مَنْ سَكَنَ أبوكم بعده»؟ ثم مسارعتهم إلى إجابته، دون أن يخطر ببال أيٍّ منهم أن يشكَّ في دوافعه: «إلى أخٍ لنا أصغرَ منه».
لكنها الصناعة غير المتقنة، لقصة يحاول مختلقها أن يقنعنا بأنها حدثت، كما أوردها القرآن الكريم. وليس أغرب من تصديقنا للسُّديّ في هذا، إلا تصديقنا إيّاه فيما قاله عن يوسف، في تفسير هَمِّهِ بامرأة العزيز، حين قال: “فدخلا البيت، وغلَّقت الأبواب، وذهب ليحلّ سراويله”.
فإن قلتَ: فَفِيْمَ أنْكرتَ على السُّدي قوله في حلِّ السراويل، ولم تُنْكر على ابن عباس وقد قال أفحش من هذا؟
قلتُ: لأن النقل عن ابن عباس في هذا لم يصح، فكان قولاً مكذوباً عليه. أما هذيانات السُّدي هذه، فقد صحَّ نقلها عنه بالإسناد المقبول عن مثله.
فإن سألتَ: فما تفسيرك لقوله لهم: ﴿ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ﴾ دون أن يستغربوا ذلك منه ولم يعرفوه؟
قلتُ: لقد استمر يوسف في التظاهر بأنه لم يعرفهم، إذ قال: ﴿بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ﴾ ولم يقل: «بأخيكم من أبيكم» ـ بإضافة الأخ إليهم ـ كأنه يَتَبَنّى ما يعتقدونه، من نقصِ عاطفة الأخوة بينهم وبين «أخيهم من أبيهم»؛ كما تقول لرجل: «كلمت امرأتك» و«كلمت امرأة لك»، فأنت في الأولى تراها امرأته، وفي الثانية تراها مجرد امرأة من نسائه.
أَمَا وقد رددنا روايةَ السُّدي، لقد بقي علينا أن نفسر كيف أمكن ليوسف أن يطلب من إخوته أن يأتوه بأخ لهم من أبيهم، وهو مُصِرٌّ على مواصلة تَقَنُّعِهِ بقناع العزيز، دون أن يخشى أن يروا منه ما وراء القناع؟
فأقول بحول مولاي:قد قال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ﴾ ففهمنا من هذا أن يوسف ـ صلى الله عليه وسلم ـ أشرف على تجهيزهم بالمؤونة بنفسه. ولأن ليس حكم العادة أن يفعل ذلك عزيز مصر مع بدو غرباء، مع وجود موظفين لهذا الغرض؛ لقد حُقّ لنا أن تستنتج أنهم صاروا يرون أنفسهم في نظره غير غرباء، كما لم يعد هو في نظرهم غريباً؛ مما يُرَجِّح أنهم تعارفوا عن قرب، فاستضافهم ـ كما أسلفنا آنفاً ـ ولَاْيَنَهُمْ وأكرمهم وأحسن إليهم، فباحوا له بمكنون قصتهم، وصار بمقدوره الآن أن يُذَكَّرَهم بما قالوه، من أن لهم أخاً من أبيهم لم يحضر. فيقول لهم ما قال، ثم يُتْبِعُهُ بإغراءٍ قوي في مثل هذا الوقت من قوله: ﴿أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾؟ أي: ألا ترون أني أمنحكم ما تطلبون وأكثر منه أكرمكم؟ فمِمَّ تخشون إذ تمنعون أخاً لكم من الحضور لينال ـ له ولكم ـ نصيباً إضافياً من القمح في زمن المجاعة؟
وهكذا بدا للإخوة أنّ طلب العزيز ليس مثار شك، الأمر الذي لم يستهجنوا معه قوله لهم: ﴿فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ﴾. فكان جوابهم أن: ﴿قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ﴾.
أي: سنحتال على أبيه ليرسله معنا.
وفي التعبير إشارة إلى صعوبة تحصيل ذلك من يعقوب، الذي يضنُّ بولده؛ وتذكيرٌ لنا ـ من الخطاب ـ باحتيال امرأة العزيز ـ الذي لم ينجح ـ على يوسف قبل سنوات.
فها هنا مراودة كما هناك.
لكنهم أَتْبعوا وعدهم بالمحاولة، بتوكيدٍ جازم، من قولهم بالجملة الإسمية: ﴿وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ﴾.
وهو توكيد من شأنه أن يُقنع العزيز، بأنهم سيواصلون المحاولة مع الشيخ، حتى يقتنع بإرسال ولده معهم.
وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴿62﴾ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴿63﴾ فقَالَ هَلْ آَمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴿64﴾
﴿وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ﴾
«الفتيان»: جمع «فتى»، وهو من كان في بداية الشباب.
ويبدو أن هؤلاء كانوا من موظفي الدولة، الموكلين بكيل القمح للممتارين. والأغلب أنهم من العبيد، يقال لهم فتيان تلطفاً، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا يَقُلْ أحَدُكُمْ: عَبْدِي، أَمَتِي. ولْيَقُلْ: فَتايَ، وفَتاتي”.
﴿رِحَالِهِمْ﴾: جمع «رحل»: المتاع. وهو ـ في الأصل ـ ما يُوضع على ظهر البعير تحت الراكب. ولذا سُمِّي البعيرُ: «راحلةً». ويقابله «البرذعة» على الحمار. ومعلوم أن للرحل شقين كما للبرذعة خرجان. ثم توسعوا في «الرحل» فصاروا يطلقونه على البيت، كما في الحديث: “صَلُّوا في الرِّحالِ”. ثم امتد ذلك إلى كل ما كان على ظهر المركوب أو في البيت. وهو المقصود في الآية.
﴿بِضَاعَتَهُمْ﴾: البضاعة في الصحاح هي: “طائفةٌ من مالِكَ تبعثُها للتجارة. تقول: أَبْضَعْتُ الشيءَ واسْتَبْضَعْتُهُ، أي جعلتُه بضاعَةً”.
قلت: والمقصود في الآية: الثمن؛ ماليّاً أو عينياً. وقد كانت بضاعة أبناء يعقوب التي يشترون بها قمح مصر، هي ما تنتجه البادية، من الجلد والنعال والألبان المجففة، وربما اللحوم المجففة.
فإن قيل: وكذلك ما توفر لديهم من الدراهم والدنانير الذهبية كذلك؛
قلنا: يجوز ذلك. لكن لا يُقال له: بضاعة، خصوصاً والدنانير لا تُوضع في الرحال، بل يُحتفظ بها في أكياس الملابس وجيوبها.
ولا ريب أنها كانت بضاعة بائسة، مقارنة بالقمح الذي صار نادراً في هذه السنوات.
فإن قيل: من أين للبادية هذه البضاعة والأعوام محل؟ قلنا: إن المحل في بلاد الأنهار، غيره في بلاد المطر؛ فهو في مصر ينتج عن انخفاض مستوى النهر، أما في الشام فالمحل يعني انحباس المطر. ويبدو أن المطر لم ينحبس في الشام بما يمنع استمرار الحياة، فبقي القليل من المراعي، بخلاف مصر التي توشك ألا تعرف المطر. وسواء كان محلٌ في صحراء النقب أو خصب، فلا ريب أن سكانها كانوا يعتمدون في طعامهم على قمح مصر، مما يعني أن بضاعتهم كانت ما وصفناه.
والمقصود أن يوسف أمر العاملين لديه بأن يردوا على هؤلاء الممتارين البدو أثمان ما اشتروه من القمح. فدسه الفتيان في متاعهم دون أن يعلموا به.
ثم قال:﴿لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾
قال ذلك في نفسه دون شك، إذ لا يُعقل أن يفشي سرّه لفتيانه.
فكأن قد قال: «لعلهم يعرفون أننا لم نقبض منهم ثمن ما بعناهم من القمح، فيتأثموا من إمساك ما ليس لهم، فيرجعوا إلينا ليردّوه».
قلت: فكأن خشي يوسف ألا يرجع إخوته من فلسطين، فأراد أن يتأكد من عودتهم، لشراء القمح مرة أخرى.
فانظر إلى آثار حكمة الله في الجينات: ودونكَ هؤلاء الذين ارتكبوا جريمة القتل الكبرى، برمي أخيهم الصغير في الجُبِّ؛ يتأثّمون من إمساكهم القليل من مال الغير، بقوة ما سوف ترى أنسالهم في المستقبل، يتأثّمون من مواصلة إمساك حلي المصريين المستعارة، فلا يهديهم الشيطان إلى وسيلة للتخلص منها، سوى أن يصنعوا بها عجلاً ليعبدوه من دون الله، ثم يعتذرون عن ذلك بما حكاه التنزيل العزيز من قولهم: ﴿حُمِّلْنَا أَوْزَاراً مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا﴾ (طه/87).
فأيُّ جِبِلّة هذه، وُلدت من خير الناس!
لكنها حكمة الله لا إله إلا هو!
لكنّ الله قلّما خلق الشرَّ في الدنيا محضاً، فها هو يوسف يرى في إخوته هؤلاء أمانةً يرجو أن تدفعهم إلى ردّ ما ليس لهم. فكأن قد قال في نفسه: «فإن لم يردوه، فلا شك سيأمرهم أبوهم بِرَدِّهِ فور علمه بما كان».
﴿فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ﴾
أبلغوه بما كان من قول العزيز: ﴿ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ﴾، ﴿فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ﴾ (يوسف/59، 60): لأنهم إذا أُنذروا بمنع الكيل، فقد مُنع الكيل.
فكأن قد قالوا: «يا أبانا، قد حكم العزيز بمنعنا الكيل، في المرة القادمة، إن لم نذهب إليه بأخينا الصغير».
ثم أتموا:﴿فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾
وهذا شرط وجوابه: ﴿فَأَرْسِلْ﴾، ﴿نَكْتَلْ﴾: فأنت ترى الفعلين مجزومين.
فكأن قد قالوا: «إن لم ترسله معنا فلن نكتال».
ثم شجعوه على إرسال أخيهم معهم فقالوا: ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾. وهو نفس ما قالوه له ـ قبل دهر بعيد ـ حين طلبوا منه أن يرسل معهم أخاهم يوسف ﴿يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ﴾، وقالوا: ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (يوسف/12)؛ الأمر الذي هيَّج قلب النبي الصابر، صلى الله عليه وسلم،
﴿فقَالَ هَلْ آَمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ﴾؟
وتساؤله هذا توقيفٌ وتقريرٌ واستنكارٌ وتألُّمٌ.
فكأن قد قال: «قد قلتم لي مثل هذا من قبل، حين طلبتم مني أن أرسل يوسف معكم، ووعدتم يومذاك بحفظه، كما تعدونني اليوم بحفظ أخيه، فهل يحدث الآن غير ما حدث في الماضي»؟
قلت: وهذا القول هو من نبيٍّ موصول ـ صلى الله عليه وسلم ـ فلا تعليق عليه، إلا بما سيقوله بعد قليل: ﴿وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (يوسف/86). ولو كان هذا القول من غير نبيٍّ، لأعدنا التَّمَثُّلَ بالقول المأثور: “إن البلاء موكل بالمنطق”: فقد نطقوا الآن بذات ما نطقوا يوم ضيعوا أخاهم الأول، فالآن سيضيعون الثاني.
لكن النبي الذي يخاف من كيد الإخوة لأخيهم، يضطر إلى إرساله معهم، وقد استودعه الله، وهو يقول: ﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾
وإذن فقد سمح لهم بأخذ الصغير، مصحوبين بدعواته ووصاياه.
وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ﴿65﴾ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴿66﴾
﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾
هذا الخطاب معطوف على سابقه، الذي عرض رفض أبيهم إرسال أخيهم معهم ليكتالوا. فهم الآن يراودونه عنه، كما وعدوا عزيز مصر حين قالوا: ﴿قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ﴾. وها هم يفعلون.
وقد تَرَدَّد المفسرون في توجيه ﴿مَا﴾ هذه التي في قوله تعالى: ﴿مَا نَبْغِي﴾: فقال بعضهم: هي النافية، وقال آخرون: هي الاستفهامية. وذكر القولين جارُ الله، ووجّهَ لكلٍّ على عادته. وأما شيخ المفسرين، فأشار إلى الاختلاف إشارةً موجزة، ثم لم يَعرِضْ لغير الاستفهام، ونَقَلَهُ عن قتادة. وإليه ذهب جمهور المفسرين.
فإن اخترنا قول الجمهور وكانت ﴿مَا﴾: اسم استفهام، فهي في محل نصب مفعول به للفعل ﴿نَبْغِي﴾. وإنما قُدم المفعول على فاعله، لأهميته في توجيه ما يأتي بعده.
فكأن قد قال: ولما وصل أبناءُ يعقوب بلادهم، وأنزلوا الأحمال، وجدوا بضاعتهم ـ التي دفعوها ثمناً لما امتاروا من القمح ـ باقيةً في رحالهم، لم يقبضها فتيانُ العزيز، كأنّهم نسوها. فقالوا لأبيهم: أيَّ شيء نبغِي زيادة على ما نلناه من العزيز، وقد أكرمنا، وكال لنا الكيل الوفير؟ ثم هبك منعتَ أخانا من الذهاب معنا، فما نفعل في بضاعتنا هذه، التي نسيها العزيز وقد صارت بضاعته؟ وكيف نَرُدُّ الحق إلى أهله دون أن نسافر إليهم؟ ثم كيف نسافر إلى العزيز وقد اشترط علينا أن نحضر أخانا معنا عند أي اكتيال فقال: ﴿فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ﴾ (يوسف/60)؟
﴿وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ﴾
﴿نَمِيرُ أَهْلَنَا﴾ فنحن مائِرُون، نَمْتَارُ الطعام فنجلب «المِيْرَةَ» إلى أهلنا لنطعمهم. قال الشاعر:
بَعَثْتُكَ مَائِراً فَمَكَثْتَ حَوْلاً مَتَى يَأْتِي غِيَاثُكَ مَنْ تُغِيثُ؟
والكلام ـ في هذا العرض للحوار بين الوالد والأولاد ـ معطوفٌ عَلَى كلام سابق محذوف، لا بد من تقديره مما يدل عليه خطاب الآيات التي سبقت.
فكأن قد قالوا: ﴿هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾ تدعونا إلى الرُّجُوعِ لنجلب الطعام إلى أهلنا، ونعدك بأن نَحْفَظ أَخانا مِمَّا تَخَافُهُ عَلَيْهِ، وَنَزْدادُ به حِمْلَ بَعِيرٍ من القمح، فنعود لك بأكثر مما جئنا به هذه المرةَ.
ولسائل أن يسأل:
فإن كانت حاجتهم إلى الميرة ملحّةً إلى هذه الدرجة، فكيف أمكنهم أن يصفوا كيل البعير بأنه ﴿كَيْلٌ يَسِيرٌ﴾؟
فنقول بإذن مولانا سبحانه:
هو يسير على الملوك وخزائن الملوك، وهذا عزيز مصر من الملوك، وقد وعدهم بأن يوفي لهم الكيل، مع إضافة كيل لأخيهم إن أحضروه معهم. وليس الوفاء من ملك بوعدٍ كهذا صعباً والمخازن ملأى بالقمح.
﴿قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ﴾
الموْثِق: مصدر ميمي على وزن «مَفْعِل» بمعنى: «الثقةِ» جاء هنا مفعولاً ثانياً للفعل ﴿تُؤْتُونِ﴾ الذي كانت ياء المتكلم فيه المفعول الأول. وهو العَهْدُ الذي يُوثَق به.
فالتعبير القرآنيُّ يمنح المَوْثِق ـ وهو شيء معنوي ـ معنى حِسيّاً، كما لو كان يُمنَح ويُؤخَذُ باليد، مثل أي شيء مادي؛ زيادة في استحضار الموقف المشهود، فكأنك ترى الأبناء واضعي أيديهم في يد أبيهم، يمنحونه موثقهم. وهذا مجاز من أبواب الاستعارة.
﴿لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾
هذا جوابٌ للقسم المضمرِ في قوله: «مَوْثِقاً»، لأنه في معنى قوله: حَتَّى تُعْطُونِي مَا أَثِقُ بِهِ وَأَرْكَنُ إِلَيْهِ، مِنْ جِهَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ: وَهُوَ الْحَلِفُ بِهِ. فجعل الحلف بالله موثقاً، لأن الحلف به ـ سبحانه ـ مما تُؤَكَّدُ به العهود.
فكأن أخذ منهم أبوهم الموثق بأن يبذلوا كل طاقة ليرجعوا بأخيهم، إلا إن أحاطت بهم ظروف قاهرة. فكأن هذ النبيَّ الصابر الموصول، كان يعلم أن ذلك سيحدث، فاستثنى. فصلى الله عليه وسلم، وجَمَعَنا به ومَنْ نُحِبّ.
وذلك في ذاتِ الإلٰهِ وإن يَشَأْ
يُبارِكْ على أوصالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ
﴿فَلَمَّا آَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾
أي: بعد أن آتوا أباهم ما طلب من مغلظة الأَيمان، قال لهم مُذكّراً بما أقسموا عليه: ﴿اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾. فالرجل ما يزال يحمل في قلبه ذكرى غدر أبنائه السابق به، يوم ضيّعوا أخاهم يوسف، وقد وعدوا أن يحفظوه كما يعدون اليوم بحفظ أخيه. لكنه لا يستطيع منعهم من السفر، لإحضار الطعام في زمن المجاعة.
فلله نبيٌّ نتأمله من وراء ستر الغيب، فنتعلّم منه ما تمتلئ به قلوبنا ثقةً بمولانا، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴿67﴾
﴿وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ﴾
﴿يَا بَنِيَّ﴾: صيغة تصغير تفيد التَّحَبُّب. فالشيخ قبل أن يأمرهم يناديهم ـ وهم جمع كبير ـ بما يثير فيهم ذكريات طفولتهم، حين كانوا صغاراً محتاجين، وهو شاب قوي يرعاهم. وأصل التعبير: «يا أبنائي». ولم يخاطبهم بهذه الصيغة إلا مرتين: هذه أولاهما، والثانية في الآية السابعة والثمانين: ﴿يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ﴾.
فإن أمعنت التأمّلَ في الخطابين، رأيتَ الشيخ يرجو الأبناء، فهو يَتَحَبَّبُ إليهم خشية ألّا يستجيبوا وقد علم مكرهم؛ بخلاف ندائه المماثل لابنه الصغير: ﴿يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً﴾ فهو رجاء المُشفق. وشتان بين المعنيين.
ولا أرى في هذه النداء إلا ضعفَ الشيخ وشَكَّه في إخلاص أبنائه، حيت يمس القرآن هذا المعنى مساً لطيفاً يدعوك إلى التأمل.
وكانوا عشرة إخوة لأب واحد. ويبدو أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة، فجمال يوسف من جمال أبويه، وإن لم يكن على نفس المستوى. فلا يُعقَل ـ والحالة هذه ـ أن يكون إخوته أقل جمالاً من الناس العاديين. ويعلم نبيّ الله الصابر الموصول ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنّ كل هذا مدعاة للحسد. والقرآن والآثار يؤكدان وجود الحسد وأن له آثاراً، وإن أنكر ذلك المتكلّفون. وسورة الفلق واضحة. وحديث النبيّ الأُمِّيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ في صحيح مسلم، فوق كل إنكار: “الْعَيْنُ حَقٌّ، ولو كانَ شيءٌ سابَقَ القَدَرَ سَبَقَتْهُ العَيْنُ”.
وقد قال جار الله فأحسن:“وإنما نهاهم أن يدخلوا من باب واحد، لأنهم كانوا ذوي بهاء وشارة حسنة، اشتهرهم أهلُ مصر بالقُربَةِ عند الملك، والتَّكْرِمَةِ الخاصة التي لم تكن لغيرهم. فكانوا مظنَّةً لطموح الأبصار إليهم من بين الوفود؛ وأن يُشار إليهم بالأصابع، ويُقال: هؤلاء أضياف الملك، انظروا إليهم ما أحسنهم من فتيان! وما أحقَّهم بالإكرام! لأمرٍ مّا أكرمهم الملك وقرّبهم، وفضلهم على الوافدين عليه. فخاف لذلك أن يدخلوا كوكبةً واحدة، فيعانوا ـ لجمالهم وجلالة أمرهم ـ في الصدور، فيصيبهم ما يَسُوؤُهم. ولذلك لم يوصهم بالتفرق في الكرّة الأولى، لأنهم كانوا مجهولين مغمورين بين الناس”.
وهذا التأويل لِعِلَّةِ النهي في كلام يعقوب، هو قول جمهور المفسرين من الصدر الأول. نقله عنهم شيخ المفسرين ـ رحمه الله ـ واختاره، ولم يحكِ غيره. وإليه ذهب الحافظ ابن كثير.
وأما قول المرحوم ابن عاشور، بأن أباهم خشي أن يسترعوا أعين حُرّاِس أبواب المدينة، فيعتقلوهم بتهمة التجسس؛ فمنقولٌ من التوراة. وهو عندي لا يستقيم: إذ لو كان ذلك كذلك لحذَّرهم من ذلك في المرة الأولى. وليس في مصادرنا ما يدلُّ على أن يوسف شكَّ في أمر إخوته في المرة الأولى، لِيُصارَ إلى جعل ذلك مظنَّةَ التفسير في المرتين.
وأما ما أخرجه ابن أبي حاتم، عن إبراهيم النخعي، من أنّ يعقوب علم أن يوسف سيلقى بعض اخوته على باب من الأبواب، فضربٌ من الظنّ من إبراهيم ـ رحمه الله ـ لا يصلح في التفسير ولا يستقيم في الواقع.
﴿وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾
قال جار الله رحمه الله: “إن أراد اللّه بكم سوءاً، لم ينفعكم ـ ولم يدفع عنكم ـ ما أشرتُ به عليكم من التَّفَرُّقِ، وهو مصيبكم لا محالة”.
قلت: وفيه إشارة إلى الشيء في ذاته، لا إليه في علاقاته: فالأشياء في ذاتها هي لله ومنه وإليه. أما في علاقاتها، فمرتبطة بالأسباب: فمهما حضرت الأسبابُ، والشيء في ذاته ممتنعٌ لم يحضر. وقد تحضر الأشياءُ دون أسبابها، وإن كان ذلك نادراً، وقد يعرض للبشر آياتٍ معجزةً للأنبياء أو كرامات للأولياء. مثل ذلك أنك مأمور بالاستطباب، لأن تناول الدواء سبب للشفاء. لكن بعضاً من الأولياء يأبونه، توكلاً على ربّ الأسباب. وإن شئت فتذكر السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب، تَرَ أنهم: “لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ”؟
وبذا فقد عَلّمنا هذا النبي الصابر الموصول ـ صلى الله عليه وسلم ـ علماً هو جوهر التوحيد، حين أمر أبناءه بأن يأخذوا بالأسباب، ولا يلتفتوا إلى قوتها، بل يلتفتوا إلى التَّوحيدِ المحض، الذي لا يكون إلا بالبراءة من كُلِّ شيءٍ سوى الله تعالى. فأوصاهم بالأسباب وإهمالها.
فإن سألت: كيف؟
أجبناك: بأن يجعلوا الأسباب في أيديهم، ويهملوها بقلوبهم. وذلك سر لا يعلمه إلا المخلَصون. وتكل عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا هو المعنى الحقيقي للتوكل، في قول يعقوب لأبنائه:﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾
في أسلوب قصر ينفي احتمال أن يكون حكمٌ في ملك الله لغيره. يشير بذلك يعقوب لبنيه ـ رمزاً ـ إلى أنه يعلم من الله ما فعلوه وما يفعلونه، وأن ما جرى ـ بما هو من فعل الله ـ فهو راضٍ به تمام الرضا، وبما أنه جرى على أيديهم، فهو منهم حزين بالغ الحزن. ومع ذلك فعليهم أن يعلموا أنهم في هذا المكر بأبيهم وأخيهم كانوا الأدنين، كما يقول قوله:﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾
وكيف لا أكون الأعلى، وقد بلغت من القوة أن استيقنت أنه لن يصيبني إلا ما شاءه لي مولاي.
﴿وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾
ولو كنتم مثلي، لما سعيتم لتغيير الغيب، الذي أعلن إشارته في رؤيا الكواكب الساجدة لأخيكم. فأنا مستسلم لله، وأنبهكم إلى ضرورة أن تستسلموا لحكمه، حتى وأنتم تحاولون تجنب ما تكرهون.
تلك كانت كلمات توديع يعقوب لأبنائه المسافرين بأخيهم إلى مصر. فهل كان يعلم يعقوب ما سيحدث؟ ثمة إشارات متعددة في السورة إلى ذلك. فنحن في حضرة نبي موصول. فاللهم إن كنت تعلم أننا نحبه فاجعلنا معه.
وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴿68﴾
﴿وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾
أطاعوا أباهم، ودخلوا المدينة من أبواب متفرقة، ولربما لم يعلموا ما يعلمه أبوهم، من أن كلَّ الحرص الممكن، لا يستطيع أن يمنع قليلَ القدر المكتوب. ولكنّه أوصاهم، فلم تُغْنِهم وصيتُه، أن يصيبهم بعضُ ما لم يتخوّفه عليهم. فكأن الله يريد أن يقول لنا ولنبيه: أوصهم ما تشاء، مع أنك تعلم أنك لن تعلم الغيب، بأنني قد أصيبهم ببعض ما لم تحذرهم منه، لأعلمهم أن الإنسان لا يحيط علمه بمشيئتي.
﴿إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا﴾
وبعد أن عرضنا لأقوال المفسرين في معنى هذه الحاجة، طرأت لنا حاجة نقضيها، اقتداء بنبي الله يعقوب، وقلّما باح المرء بحاجته في كثير من المواطن، لكننا نبوح فنقول بأنه يبدو أن حاجة يعقوب، هذه، كانت سرّاً بينه وبين مولاه: فلئن كانت للأولياء أسرارٌ؛ فللأنبياء أسرارٌ أعظم. ولم لا تكون حاجةُ يعقوب هذه من الأسرار القرآنية، التي أبى رسول الله أن يفسرها، ففسرها غير المعصومين، مما نقلنا بعضه في السطور السابقة، لِنُعرض عنه الآن ونقول ما قاله المرحوم سيد قطب:“فيمَ كانت هذه الوصيّةُ؟ لِمَ قال لهم أبوهم: ﴿لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ﴾؟ تضرب الرواياتُ والتفاسير في هذا وتُبدئُ وتعيدُ، بلا ضرورة؛ بل ضد ما يقتضيه السياق القرآني الحكيم: فلو كان السياق يحب أن يكشف عن السبب، لقال. ولكنه قال فقط: ﴿إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا﴾. فينبغي أن يقف المفسرون عند ما أراده السياق، احتفاظا بالجوّ الذي أراده. والجوُّ يوحي بأنه كان يخشى شيئاً عليهم ، ويرى في دخولهم من أبواب متفرقة اتقاءً لهذا الشيء، مع تسليمه بأنه لا يُغني عنهم من اللّه من شيء، فالحكم كله إليه، والاعتماد كله عليه. إنما هو خاطرٌ شعر به، وحاجةٌ في نفسه قضاها، بالوصية، وهو على علم بأنّ إرادة اللّه نافذة. فقد علمه اللّه هذا فتعلم… ثم ليكن هذا الشيءُ الذي كان يخشاه هو العين الحاسدة، أو هي غَيْرَةُ الملك من كثرتهم وفتوتهم، أو هو تَتَبُّعُ قُطّاعِ الطريق لهم. أو كائناً ما كان؛ فهو لا يزيد شيئاً في الموضوع؛ سوى أن يجد الرواةُ والمفسرون باباً للخروج عن الجوِّ القرآني المؤثّر، إلى قال وقيل”.
وأما في التأويل الإعرابي للاستثناء في قوله تعالى: ﴿إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا﴾؛ فقد قال فيه جار الله بأنه منقطع. ولقد أحسن رحمه الله: فما من استثناء يمكن أن يُخرِج بعضاً من عموم قوله: ﴿مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ فلا يمنع كثيرُ فعلِ المخلوق، أقلَّ القليل من المكتوب.
﴿وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ﴾
يقول الله عن عبده يعقوب: ﴿وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ﴾، فكأن كان المعنى: وإنه لذو حفظٍ لما استودعنا صدره من العلم اللَّدُنّي، الذي بينه وبين الله ـ تعالى ـ وليس مسموحاً له بَثُّهُ في الناس، لأنه فوق مداركهم، وقد يضرهم إذا فقهوه. ألم تَرَ كيف كتم الخضر علمه عن الناس، ولولا أن من هو أفضل منه، موسى صلى الله عليه وسلم، سأله ـ وكان سؤاله عن أمر الله، إذ أرسله ليتعلم ـ لما أجابه الخضر عليه السلام؟
وفي بعضِ هذا يقول بعضُ أهل البيت عليهم سلام الله:“إن الله تعالى يفعل المصالح بعباده، على حسب ما يعلمه من الصلاح لهم ـ في تلك الأفعال التي يفعلها ـ فغيرُ ممتنعٍ أنْ يكونَ تغييرُهُ نعمةَ زيدٍ مصلحةً لعمرو. وإذا كان يعلم من حال عمرو أنه لو لم يَسلِب زيداً نعمته، أقبلَ [زيدٌ] على الدنيا بوجههِ، ونأى عن الآخرة بِعِطفِهِ، وإذا سلب نعمةَ زيدٍ ـ للعلة التي ذكرناها ـ عَوَّضَهُ فيها، وأعطاه بدلاً منها عاجلاً أو آجلاً؛ فيمكن أن يُتَأَوَّلَ قولُهُ صلى الله عليه وسلم: «العين حق» على هذا الوجه. على أنه قد رُوي عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما يدلُّ على أن الشيء، إذا عَظُمَ في صدور العباد؛ وضع الله قدرَهُ، وصَغَّرَ أمرَهُ. وإذا كان الأمر على هذا، فلا يُنكَر تغييرُ حال بعض الأشياء، عند نظر بعض الناظرين إليه، واستحسانه له، وعِظَمِهِ في صدره، وفخامتِهِ في عينهِ، كما روي أنه قال لما سُبقت ناقتُهُ العضباءُ، وكانت إذا سوبق بها لم تُسْبَقْ: «ما رفع العباد من شيء إلا وضع الله منه»”.
فأنت ترى في هذه السورة أن سيدنا يعقوب ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد حفظ سرَّ ربّه ،فلم يَبُحْ به، على كثرة ما ابتُلي به من البلايا، حتى ﴿ابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴿84﴾. فإذا لاموه ﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴿86﴾.
فأيُّ مولى هذا من أولياء الله، يثني عليه مولاه فيقول: ﴿وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ﴾! فيا للمديخ! ومِمَّنْ! من الله! فأيُّ إلهٍ! وأيُّ كرم! وأيُّ مولى!
تِلْكَ المَكَارِمُ لَا قَعْبَانِ مِنْ لَبَنٍ
شِيبَا بِمَاءٍ فَعَادَا بَعْدُ أَبْوَالا
﴿وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ﴾
فحفظ ما علمناه فاستحق ثناءنا.
فماذا فعل العبد كي يستحق هذا الثناء؟ وما من واجبٍ على الله أن يُثني على وليٍّ أو نبيٍّ؛ لكنه كرم الله هنا، مثل كرمه هناك حين قال: ﴿كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ (الأنعام/12). وإلا فهو الرب ونحن العبيد.
﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾
إلا قليلاً من ظاهر الأمر، فلا يعلمون ما يوحي الله إلى أنبيائه، وما يلهم أولياءه. بل لا يعلمون إن علمناهم، ولا يحفظون إن استحفظناهم.
ولعل الله يقدرنا على أن نستعرض بعضاً من أسرار هذا، في كيد يوسف لإخوته فيما بعدُ ـ مما يخالف الظاهر ـ ولا يستطيع العقل فهمه.
فالله لا إله إلا هو يعلمنا ما يشاء، ويغلق عن عقولنا علم ما يشاء، فما علَّمنا وما لم يُعلِّمنا إن هو إلا فتنة الدنيا. نسأل الله أن يخرجنا منها بسلام. وإن شئت فاقرأ قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آَيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ* لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ (الحج/52 ــ 53). وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (المدثر/31)
وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آَوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴿69﴾ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴿70﴾ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ﴿71﴾ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴿72﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ﴿73﴾ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ﴿74﴾ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴿75﴾ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴿76﴾
اللهم إني أعوذ بك من فتنة القول وفتنة العمل. وإلا تسدد لي ما أقول أكن من الخاطئين.
في هذه الآيات من الأسرار ما الله به عليم. أما أنا فَيَصدُقُ في مثلي قولُ المُتَلَمّس:
فَأَطرَقَ إِطراقَ الشُجاعِ وَلو يَرَى
مَساغاً لِنابَيهِ الشُجاعُ لَصَمَّما
وقد قال العلماء والفقهاء في هذه الآيات، ما شاء الله لهم القول، فما بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آَتى الله الأنبياء، من الوقوف عند ما علّمهم الله فلم يفسِّروا، ولو كان للتفسير هنا مساغٌ لفسروا، حتى قال الشوكاني: كلاماً يمحو آخرُه أوَّلَهُ فقال: “وَفِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّوَصُّلِ إِلَى الْأَغْرَاضِ الصَّحِيحَةِ بِمَا صُورَتُهُ صُورَةُ الْحِيلَةِ وَالْمَكِيدَةِ إِذَا لَمْ يُخَالِفْ ذَلِكَ شَرْعاً ثَابِتاً”.
ثم نسي أنه يتكلم عن أفعال وأقوال لو كانت في شريعتنا لخالفتها مخالفة بَيِّنة.
وفعل مثلما فعل الشوكاني المفسرون من قبل ومن بعد، إلا قليلاً ممن توقف ولم يتكلم في هذا بكثير ولا قليل.
فليت الناس صمتوا في الغيب، حيث صمت النبيُّ صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف وقد خُلِقَ ﴿الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً﴾ (الكهف/54)؟
قد صمت النبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن بيان هذا، وصمت الصحابةُ رضي الله عنهم، ونطق الناس، وليتهم ما نطقوا.
لقد قال ظاهرُ الآي: إن يوسف قد كذب، حين اتهم إخوته بالسرقة، فأقام فيهم حكم السارقين، وهو يعلم أنهم لم يسرقوا. ولا تنفع في تغيير حرمة هذا ـ في شريعتنا ـ معاذيرُ ولا حِيَلٌ.
ولقد قال ظاهرُ الآي: إن يوسف استرقّ أخاه ظلماً، بما تسبب بالألم لأبيه، فاستذكر بالفقد الجديدِ الفقد القديمَ حتى ذهب بصره. ولا تنفع في تغيير حرمة هذا ـ في شريعتنا ـ معاذيرُ ولا حِيَلٌ.
ولقد قال ظاهرُ الآي: إن الله هو الذي كاد ليوسف، بما لو كاد اليوم مسلمٌ لمسلم، لامتنع عليه ذلك بأمر شريعتنا. وفي هذا نقول ما قال الله، ونقف عند ما قال الله، ولا نعلل أفعال الإله العلي الأعلى.
وقد حاول ابن القيم، فيما قاله ونقله عن شيخه ابن تيمية ـ رحمهما الله ـ أن يجد لذلك مساغاً، فكتب ونقل عن شيخه الصفحات المطولة، فما زاد على أن قال ما لا قيمة له ولا حجة فيه.
ولو أن شيخه شيخ الإسلام رحمه الله، اكتفى من كل ما قال ـ مما نقل تلميذه عنه ـ بقوله: “وإنما هو أمرٌ أَمَرَهُ اللهُ به، لِيبلُغَ الكتابُ أجله، ويتمَّ البلاءُ الذي استحق به يعقوبُ ويوسفُ كمالَ الجزاء، وتبلغَ حكمةُ الله ـ التي قضاها لهم ـ نهايتها”. لكان ذلك بلاغاً. ولو أن المفسرين صمتوا ها هنا، لكان ذلك بلاغاً. ولكن الله يفعل ما يشاء.
أما أنا فقد تحيّرت، وتردّدت، حتى أوشكتُ أن أقول: إنّ هذا من شريعة يعقوب المنسوخة، لولا أني وجدت كتاب الله يقول: إن شريعة أنبياء بني إسرائيل لعنت أصحاب السبت لأقلَّ من هذا، في قوله تعالى من سورة الأعراف:
وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴿163﴾ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴿164﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴿165﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴿166﴾
وكيف يمكن أن نفهم إباحة الكذب لنبيٍّ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع مقام النبوة عن أدنى من ذلك حيث يقول: “لاَ يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيُنِ”.
فلم أجد إلا أن أقول بحول مولاي:قد قال الله هنا بأنه كاد ليوسف هذا الكيد. وللهِ ـ سبحانه ـ أن يفعل ما يشاء، ويقول ما يشاء، فذلك مقتضى كونه لا تقيده الشرائع، التي هو خالقها لتنظيم الكون، فهو لا يخضع لما خلق، وأنّى للشرائع المخلوقة أن تحكم أفعال الأول والآخر، المطلق الذي لا تقيده الحدود! وقد أفِكَ مخلوقون يحاكمون أفعال الله الأزلية، وفق قوانين تشريعية مخلوقة، يغيّرها لكل أمّة بما يناسبها. وتعالى الله أن تغيّره الأشياء، أو تحكمه الحوادث. والله لا يحتاج ـ لكي يكيد ليوسف ـ أن يضبط كيده وفق شريعة يعقوب! تعالى الله عما يرى الناس من قياس الخالق على المخلوق.
وحاصل الكلام عندي أن هذا من فعل نبي عن أمر الله لا نعلم حكمته.
﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾ (الكهف/29).
والآن إلى تفسير الآيات دون تقييم كلام الله.
﴿وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آَوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾
فلما وصل إخوة يوسف من فلسطين ومعهم أخوهم، عرّفَ يوسف نفسه لشقيقه، وضمه إليه، وواساه فاكتمل السرور.
﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾
الـ﴿مُؤَذِّنٌ﴾: المنادي. و﴿أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ﴾: نادى مًنادٍ. و﴿الْعِيرُ﴾: الرواحل وهي في الأصل الإبل المسافرة محملة بالمتاع. ثم توسعوا فيها فصارت كل دابة مسافرة محملة بالمتاع.
فلما جَهَّز يوسف إخوته محملين بالقمح، حتى تهيأوا للسفر، دسّ صواع الملك خفية في رحل شقيقه. ثم أمر فتيانه بأن يصيحوا في القوم قبل الرحيل: ﴿أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾. فأشار بالمركوب إلى الراكب. والتعبير من المجاز المرسل علاقته المجاورة، كما في قول القائل: “يا خيل الله اركبي”.
﴿قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ﴾
الضمير في ﴿قَالُوا وَأَقْبَلُوا﴾ يعود على إخوة يوسف، فهم القائلون. والواو في ﴿وَأَقْبَلُوا﴾ للحال. فكأن قد قال: «قَالُ إخوة يوسف، وَقد أَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ: مَاذَا تَفْقِدُونَ»؟
﴿قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾
﴿صُوَاعَ الْمَلِكِ﴾: الكيل الذي يكيلون به القمح، وسمَّاه قبل قليل ﴿السِّقَايَة﴾. ونسب الصواع إلى الملك، بقصد القول إنّه ملك الدولة، فنحن في زمن الملك فيه هو الدولة، كما سنرى فيما بعد.
أما لم سُمّيَ الصواع بالسقاية، فقد قالوا: إن الملك كان يشرب فيه. قلت: ولا يستقيم أن يشرب الملك في مكيال يُكال به القمح، حتى لو كان من ذهب. فالمكيال صواع، أي: يتسع لصاع من القمح. ومن يمكنه أن يشرب في إناء يتسع لصاع من القمح؟ ولهذا فربما سُمّيَ الصواع سقايةً لأنها كَانَتْ تُسْقَى بِهَا خيل الملك، فجيء بها ليُكَالُ بِهَا القمح. فهذا أقرب إلى المعقول.
﴿زَعِيمٌ﴾: كفيل أو ضامن، يغرم في حالة فقدان المضمون. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: “وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ”.
والضمير في ﴿قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ﴾ لفتيان يوسف. والقائل: ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ المؤذن، فكأن قال: «وأنا بحِمل البعير كفيل». والمقصود حمل بعير من القمح جائزةً لمن اكتشف السارق.
فكأن أجاب فتية يوسف السائلين: «نفقد مكيال الدولة ولمن جاء به أو دلّ عليه، جائزة حمل بعير من القمح، نتعهد بهذا ونضمنه».
﴿قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ﴾
القائلون هم إخوة يوسف. وفي: ﴿تَاللَّهِ﴾، قال السمين: “التاءُ حرفُ قسمٍ، وهي عند الجمهور بدلٌ من واو القسم، ولذلك لا تدخُل إلا على الجلالةِ المقدسة، أو الرب مضافاً للكعبة، أو الرحمن في قولٍ ضعيف… وزعم السهيلي أنها أصلٌ بنفسها، ويلازِمُها التعجبُ غالباً، كقوله: تعالى: ﴿تَالله تَفْتَؤُاْ﴾ (يوسف/85)”.
قلت: فكأن قد قالوا: «والله لقد علمتم ـ من سيرتنا ومعرفتكم إيانا ـ أننا ما جئنا لنسرق، ولم نكن يوماً سارقين». فاستشهدوا القوم بما يعلمون من صدقهم. أو: أشاروا إلى ما قد يكونون أخبروا به العزيز، من أخبارهم وأصلهم الكريم، وكونهم أتباع نبي، وأصحاب شريعة.
قال الشوكاني: “وَجَعَلُوا الْمُقْسَمَ عَلَيْهِ، هُوَ عِلْمُ يُوسُفَ وَأَصْحَابِهِ بِنَزَاهَةِ جَانِبِهِمْ، وَطَهَارَةِ ذَيْلِهِمْ عَنِ التَّلَوُّثِ بِقَذَرِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، الَّذِي مِنْ أَعْظَمِ أَنْوَاعِهِ السَّرِقَةُ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ شَاهَدُوا مِنْهُمْ فِي قُدُومِهِمْ عَلَيْهِ ـ الْمَرَّةَ الْأَوْلَى وَهَذِهِ الْمَرَّةَ ـ مِنَ التَّعَفُّفِ وَالزُّهْدِ، عَمَّا هُوَ دُونَ السَّرِقَةِ بِمَرَاحِلَ؛ مَا يُسْتَفَادُ مِنْهُ الْعِلْمُ الْجَازِمُ، بِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِمَنْ يَتَجَرَّاُ عَلَى هَذَا النَّوْعِ الْعَظِيمِ مِنْ أَنْوَاعِ الْفَسَادِ. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا رَدُّهُمْ لِبِضَاعَتِهِمُ، الَّتِي وَجَدُوهَا فِي رِحَالِهِمْ… ثُمَّ أَكَّدُوا هَذِهِ الْجُمْلَةَ الَّتِي أَقْسَمُوا بِاللَّهِ عليها بقوله: ﴿وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ﴾”.
﴿قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ﴾
الضمير يعود على فتية يوسف المحققين في السرقة. ومن الواضح أنهم يسألون إخوة يوسف بتلقينٍ منه، لأنه الذي يعلم جزاء السارق في شريعة أبناء يعقوب، فهو يستدرجهم لِيُحَكِّمَهُمْ بشريعتهم في السارق. فكأن قد قال: «فما العقوبة إن وجدنا السقاية معكم وكذبتم في قولكم: ﴿وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ﴾»؟
وهذا منتهى الاستفزاز، من سائلٍ يسأل من يعلمهم أبرياء أعزةً شرفاء، ليستنطقهم فيقولوا ما يرغب فيه، مما لا يقولونه في الوضع العادي. وقد كان، كما هو في الآية الآتية:
﴿قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾
وهكذا ابتلع أخوةُ يوسف الطُعم ـ بعضاً من الكيد الذي كاده اللهُ ليوسف ـ فحكموا بقبول أن يُحكَم في سارقهم بشريعتهم، فيُسْتَعبَدَ عبدَ ما سرق. أي عبدَ صاحبِ المسروق.
وفي إعراب هذه الآية وجوه عدة، اخترنا منها أحد قولي الزجاج ـ رحمه الله ـ وهو الآتي:
جملة: ﴿هو جَزَاؤُهُ﴾ مبتدأ، خبره جملة: ﴿مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ﴾. وأما قوله: ﴿فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾ فتوكيد، قال الزَّجّاج: “كما تقول: جزاء السارق القطع، فهو جزاؤه”.
قلت: وفي تكرير ضمير المشار إليه ثلاث مرات في الآية: ﴿هو جَزَاؤُهُ﴾، ﴿فِي رَحْلِهِ﴾، ﴿فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾؛ دلالة على التوكيد، كما قال عديّ بن زيد:
لَا أَرَى الْمَوْتَ يَسْبِقُ الْمَوْتَ شَيْءٌ نَغَّصَ الْمَوْتُ ذَا الْغِنَىٰ وَالْفَقِيرا
﴿فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ﴾
الضمير هنا يعود على يوسف، سواء كان يفتش بنفسه أو بفتيانه، لأنهم يَصدُرون عن أمره. وقد بدأ بتفتيش أوعية إخوته، قبل وعاء شقيقه الذي في رَحلِهِ الصواعُ، زيادةً في التمويه على الأخوة، كي لا يشكّوا في أنّه يعرف مكان الصواع مسبقاً قبل التفتيش.
﴿ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ﴾
العطف بالحرف ﴿ثُمَّ﴾ لإفادة الترتيب والتراخي. وأنَّثَ الضمير في قوله ﴿اسْتَخْرَجَهَا﴾ إشارةً إلى السقاية، التي ذُكرت قبل قليل وقلنا: إنها الصواع. والمقصود أنه استخرجها من متاع أخيه، فقام الدليل على أنه هو السارق. فأخذه يوسف رقيقاً، حسب حكم شريعة يعقوب، المشروطة قبل التفتيش. وبذا التأم شمل الشقيقين، عن توافق بينهما.
﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ﴾
هذا من الله بيانٌ كي يفهم الناس، أن هذا الفعل من يوسف، كان بأمر الله وتعليمه.
﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾
ذكرَ عِلَّةَ الكيد، بأنه لهدف استعادة يوسف أخاه، ولو بالاسترقاق. لأنه لم يكن في قانون مصر أن يُسْتَعْبَدَ السارق.
و﴿دِينِ الْمَلِكِ﴾: هو شريعته التي يحكم بها مصر، وهو القانون بلغة اليوم. وقد أسكَرَ هذا التعبير سيد قطب، فَحَرَفَهُ عن الجادة. وسأعرض لشيء من هذا بعد إتمام تفسير هذا المقطع، إن شاء الله.
﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾
الاستثناء هنا منقطع، حيث جاءت ﴿إِلَّا﴾ هنا بمعنى: لكن. فكأن قد قال: لكن يحدث أن يأخذ يوسف أخاه ـ إن شئنا ـ رغم دين الملك.
وقد جيء بالاستثناء هنا، كما جيء به في مواقع أخرى من التنزيل، لتأكيد ما ينساه الناس، ويصعب عليهم تصوره، من كون مشيئة الله لا تَحُدُّها قوانينه.
﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ﴾
“توضيح لقوله: ﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ﴾ وبيانٌ: لأن ذلك من باب الرفع إلى الدرجات العالية من العلم، ومدحٌ ليوسف برفعه إليها”.
﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾
تذييل لما سبق. كما لو قال: نرفع إلى الدرجات العالية من العلم، من نشاء رفعه إليها، ليُعلَمَ أنّ فوق كلٍّ عليمٍ من الناس، عليمٌ أعلى منه درجات. قال شيخ المفسرين رحمه الله: “وإنما عنى بذلك أنّ يوسف أعلم إخوته، وأنّ فوق يوسف من هو أعلم من يوسف، حتى ينتهي ذلك إلى الله”.
وقد رووا في رد هذا المعنى، الذي قاله شيخ المفسرين، كلاماً ظاهر التكلّف عن ابن عباس، لولا أنه لم يصح عنه. ولو صح عنه، لما نقل الرواية شيخ المفسرين وقال بخلافها. وقد وجدت كل طرق هذا القول مدارها على «عبد الأعلى الثعلبي» وهو ضعيف جداً.
والآن أعود لما وعدت قبل قليل من الرد على ما أسكر المرحوم سيد قطب في قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾ حتى حَرَفَهُ عن الجادة. فأقول ـ بحول مولاي ـ كيف كان ذلك:
قد قال سيد قطب بأن كلّ قانون هو دينٌ، من أطاعه كان متديناً به، من دون شريعة الله، ولم يفرق في ذلك بين حاكم ومحكوم، ومكره ومطيع. وذلك انطلاقاً من مقولته في الحاكمية، التي نسبها إلى الله، وأخرج من لم يوافقه فيها من دين الله.
ولو لم يتعجل سيد قطب، لرأى أنه يُكَفِّر بهذا القول يوسف نفسه، فهو يتحاكم إلى شريعة الملك في مصر، لا إلى شريعة الله. لكن دافع الغضب المحمل بالأيديولوجيا أعمى. وإليك بعض ما يقوله سيد قطب، في مفهوم كلمة الدين الواردة في هذه الآية.
قال:
“إن مدلول «دين اللّه» قد هزل وانكمش، حتى صار لا يعني ـ في تصور الجماهير الجاهلية ـ إلا الاعتقاد والشعائر. ولكنه لم يكن كذلك يوم جاء هذا الدين، منذ آدم ونوح إلى محمد عليهم صلوات اللّه وسلامه أجمعين. لقد كان يعني دائما: الدينونة للّه وحده، بالتزام ما شرعه ورفض ما يشرعه غيره. وإفرادُهُ ـ سبحانه ـ بالألوهية في الأرض، مثلُ إفرادِهِ بالألوهية في السماء، وتقريرِ ربوبيَّتِهِ وحده للناس: أي حاكميته وشرعه وسلطانه وأمره. وكان مفرقُ الطريق دائماً بين مَنْ هم في دين «اللّه» ومَنْ هم في ﴿دِينِ الْمَلِكِ﴾: أنّ الأولين يدينون لنظام اللّه وشرعه وحده، وأن الآخرين يدينون لنظام الملك وشرعه. أو يشركون فيدينون للّه في الاعتقاد والشعائر، ويدينون لغير اللّه في النظام والشرائع. وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، ومن بديهيات العقيدة الإسلامية تماماً.
فانظر في قوله: “وكان مفرقُ الطريق دائماً بين مَنْ هم في دين «اللّه» ومَنْ هم في ﴿دِينِ الْمَلِكِ﴾: أنّ الأولين يدينون لنظام اللّه وشرعه وحده، وأن الآخرين يدينون لنظام الملك وشرعه. أو يشركون فيدينون للّه في الاعتقاد والشعائر، ويدينون لغير اللّه في النظام والشرائع”.
وقد ألف المرشد العام الثاني للإخوان المسلمين ـ المرحوم حسن الهضيبي ـ كتاباً كاملاً في دحض هذا الضلال المنحرف عن عقيدة أهل السنة والجماعة، في كتابه الذي ألَّفَهُ لهذا الغرض: «دعاة لا قضاة». وفرض على الإخوان قراءته، قبل قراءة كتب سيد قطب. واستمر ذلك مطبقاً في الجماعة، حتى حدث الانقلاب الكبير فيها، بموت المرشد الثالث المرحوم عمر التلمساني، وتولِّي الخوارج زعامة مكتب الإرشاد، فتم إقصاء الكتاب من اجتماعات الأسر، حتى نشأت أجيالٌ في الإخوان المسلمين، لا تسمع بهذا الكتاب.
وهذان مثالان من الكتاب في الرد على سيد قطب:
المثال الأول من: الفصل الخامس بعنوان: الحاكمية:
قال الهضيبي:
“جرت على بعض الألسن لفظة «الحاكمية»، تعبيراً عن معانٍ وأحكامٍ، تضمنتها آياتُ القرآن الكريم والأحاديث الشريفة؛ ثم أسندت اللفظةَ إلى اسم المولى عزَّ وجلَّ؛ فقيل: «حاكمية الله». ثم تفرعت عن اللفظةِ ـ مضافةً إلى اسم المولى عزّ وجلّ ـ أحكامٌ، فقيل: إن مفهوم «حاكمية الله كذا وكذا، ومقتضى ذلك أن يعتقد الشخص كذا وكذا، وأن يكون فرضاً عليه أن يقوم بكذا وكذا من الأعمال؛ فإن لم يعملها وعمل غيرها، فهو خارج عن حاكمية الله تعالى، فوصفُهُ كذا».
ونحن على يقين أن لفظة «الحاكمية» لم ترد بأيّة آيةٍ من الذكر الحكيم. ونحن ـ في بحثنا في الصحيح من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ـ لم نجد منها حديثاً قد تضمن تلك اللفظة، فضلاً عن إضافتها إلى اسم المولى عز وجل.
والتجارب ـ واقع حال الناس ـ يقول لنا: إن أصحاب الفكر والنظر والباحثين، قد يلحظون ارتباطًا بين معاني مجموعة من الآيات بالقرآن الكريم والأحاديث الشريفة، وفكرةٍ بارزة فيها، فيضعون مصطلحاً لتلكم المعاني.
غير أنّه لا يمرُّ إلا الوجيزُ من الزمن، حتى يَسْتَسْهِلَ الناسُ المصطلحَ الموضوع، فيتداولونه بينهم، ثم يتشدّق به أناسٌ قليلٌ منهم من قرأ الكثير، الذي كتبه الباحثون والمفكرون أصحاب النظر، شرحاً للآيات والأحاديث التي كانت هي الأصل عندهم، وتعبيراً عن المعاني التي لاحظوها. والأقلُّ من هؤلاء القليل، مَنْ يكون قد استوعب ما كتبه الباحثون والمفكرون، واستطاع أن يفهم ما أرادوه، وأدرك حقيقة مقصدهم. والغالبية العظمى تنطق بالمصطلح، وهي لا تكاد تعرف من حقيقةِ مُرادِ واضعيه، إلا عباراتٍ مبهمةً سمعتها عفواً هنا وهناك، أو ألقاها إليها من قد لا يُحسن الفهم، أو يُجيد النقل والتعبير.
وقد لا يمضي كثيرُ وقتٍ، حتى يستقلَّ المصطلحُ بنفسه في أذهان الناس، ويَقَرُّ في آذانهم أنّهُ الأصلُ الذي يُرجَع إليه؛ وأنه الحكمُ الكلّي الجامعُ الذي تتفرع عنه مختلف الأحكام التفصيلية. وينسى الناس أن الآيات والأحاديث ـ التي لوحظ فيها المعنى الذي وُضع المصطلح عنواناً له ـ هو الأصل الذي يتعين الرجوع إليه. بل قد يغيب عنهم أن مُرادَ واضعي المصطلحِ، لم يكن غير التعبير عن معانٍ عامةٍ، أرادوا إبرازها وجذب انتباه الناس إلى أهميتها، دون أن يقصدوا وضع أحكامٍ فقهية، خاصةً التفصيليةَ منها.
وهكذا يجعل بعضُ الناس: أساساً لمعتَقَدِهم؛ مصطلحاً لم يَرِد له نصٌّ من كتاب الله أو سنة الرسول؛
أساسا من كلام بشر، غير معصوم، وارد عليه الخطأ والوهم؛
أساسًا من كلام بشر، غير معصوم، عِلْمُهم بما قاله ـ في الأغلب الأعَمّ ـ علمٌ مبتسر مغلوط.
لذلك كان لزاماً علينا ألّا نتعلق بالمصطلحات، التي يقول بها البشر غير المعصومين؛ وأنْ نَتَشَبَّثَ ونلوذَ بكلام رب العالمين، وكلام المعصوم سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام”.
المثال الثاني من نفس الفصل بعد صفحات قليلة:
قال الهضيبي:
“والحق أن عقيدةَ قداسة أولي الأمر، أو عصمتهم، أو الظنُّ أنّ أوامرهم كأوامر الله تعالى، أو أنّ لهم أن يُحِلّوا ما حرمه الله، أو يُحرّموا ما أحلّهُ الله؛ ذلك كله معدوم الوجود بين غالب عامة المسلمين. وينطق الواقعُ أنّه حيث يكون أمر الله تعالى معلوماً، غير خافٍ، ولا محل لاختلاف الآراء، فإن أحداً من عامة الناس، لا يتشكك في أن أمر الله تعالى، هو الحق الواجب الاتباع، لا يُبطلُهُ قولُ قائل، ولا تشريع ذي سلطان؛ وأن عامة المسلمين هم على العقيدة الأكيدة أن الخمر حرام: شاربها آثمٌ، رغم توالي السنوات الطوال، وأصحابُ السلطة ـ في بلاد الإسلام ـ لا يعاقبون شارب الخمر بعقوبة ما.
وعامة المسلمين لا يتشككون في أن الزنا حرام، رغم شيوعه والتعالن به، وقعود الحكام عن إقامة الحدود على مقارفة.
وعامة المسلمين على عقيدتهم أنّ الربا ـ وإن جهلوا تفصيلات أحكامه ـ آثمٌ آخِذُهُ ومُعطيه، رغم أن القوانين السائدة تُبيحه ولا تعاقب عليه.
ومثال ذلك كثير.
بل إنّا لنقول: إنّهُ حتى الكثيرون من الذين يقارفون مثل تلك الكبائر، ويجهرون بها ـ لِشعورهم من أنهم في مأمن من العقاب ـ فإنهم يقارفون ما يقارفونه، وليس عندهم شكٌّ في أنّ ما يأتونه مُحَرَّمٌ عند الله، لم يجعله حلالاً قعودُ ذوي السلطان عن إنفاذ أمر الله فيهم”.
انتهى ما نقلناه من كلامهم في الرد على خطايا سيد قطب.
قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَاناً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴿77﴾ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴿78﴾ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذاً لَظَالِمُونَ﴿79﴾
﴿إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ﴾
الذين قالوا هذا هم إخوة يوسف، يلمزون من قناة أخيهم، الذي لا يعلمون أنه الآن يسمعهم ويراهم، فيتهمونه بما لم يفعله.
أما نحن فلم نصدقهم بما قالوا، وصدَّقهم مفسرون بحثوا عن مصداق ما قالوا، كأنهم رأوهم قالوا الحق! فيا عجباً ممن يقبلون من هؤلاء قولاً يقولونه في نبيٍّ، هو أخوهم الذي ألقوه في غيابةِ الجُبِّ! وإنما صَدَّقهم من صدّق أنهم أنبياء، فتأول لهم كل ما فعلوا. وقد بَيَّنّا خطأ هذا القول عند تفسيرنا لقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾.
﴿فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَاناً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾
فلما قالوا: ﴿إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ﴾، اشتد غضب يوسف من شهادتهم الكاذبة على أخيهم الذي يرون أنه مات، وأوشك أن يجيبهم بكلمة قاسية، فيقول لهم: ﴿أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَاناً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾؛ لكنه لم يشأ أن يعرفوه في هذه المرحلة، فكظم غيظه، وجعل كلمته مكنونة في نفسه. وذلك تأويل قوله تعالى: ﴿فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ﴾. فقوله: ﴿قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَاناً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾ هو تفسير لقوله: ﴿فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ﴾.
وفي هذا قال المرحوم سيد قطب:
“وتنطلق الروايات والتفاسير، تبحث عن مصداق قولهم هذا، في تَعِلّاتٍ وحكاياتٍ وأساطيرَ، كأنهم لم يكذبوا قبل ذلك على أبيهم في يوسف! وكأنهم لا يمكن أن يكذبوا على عزيز مصر، دفعاُ للتهمة التي تحرجهم، وتبرؤاً من يوسف وأخيه السارق، وإرواءً لحقدهم القديم على يوسف وأخيه. لقد قذفوا بها يوسف وأخاه: ﴿فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ﴾: أَسَرّ هذه الفعلةَ، وحَفِظَها في نفسه، ولم يُبْدِ تأثُّرَه منها، وهو يعلم براءته وبراءة أخيه”.
﴿قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ﴾
لقد أصبحوا الآن في أشد أحوالهم زِرَايةُ ومَسْكَنة: فقراءَ في سنوات المجاعة يطلبون صدقة ـ كما سنرى بعد قليل ـ اشتد لوم أبيهم لهم لما فعلوا أولاً؛ وسيشتد أكثر حين يرجعون إليه دون أخيهم، الذي راودوه عنه، فأرسله معهم بشق الأنفس. فلما رأوا ما هم فيه، لم يجدوا إلا أن يعرضوا التضحية بأحدهم، فيصير عبداً بدل السارق، إذ لم يعد لديهم قدرة على تحمل لوم والد نبيّ شيخٍ، أضرّوا به كثيراً وصَبَر أكثر. وهذا أول موقف إيجابيٍّ يصدر عن هذه العصبة، بل ربما صدر هذا القول عن الأخ الذي كان قد قال لهم من قبل: ﴿لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ (يوسف/10).
﴿إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾
ختامُ الرجاء تعليلٌ لاستجداء الإحسان، من كريم يقدر قيمة رجاء المنكوبين، وتهييجٌ لعواطفه لتستجيب للمطلوب. ولا شيء أدعى لتلبية الرجاء، من تذكير المحسن بطبيعته المجبول عليها. فكأن قد قالوا: «قد رأينا من أفعالك ما يدلنا على أنّ مثلك لا يصدر منه ما يسوءُ أباً شيخاً كبيراً فقد ابنه الأصغر في أيامه الأخيرة».
ولولا أن يوسف ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يُعِدُّ كلَّ شيء لنهاية حسنة، لاستجاب. لكنّ ما كاده له ربُّه ـ عزّ وجلّ ـ قضى بأن يصبر نفسه على ما سمع، فيؤجل الاستجابة. وذلك لما قضى الله من سكنى بني يعقوب مصر، وتناسلهم فيها إلى زمن موسى ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيحدث ما كتب الله في كتابه الأزليِّ، من خلق قومٍ هم الأفضل، إلى ظهور أمّة محمد صلى الله عليه وسلم. نعلم ذلك من كونهم الأكثر من أهل الجنة، باستثناء أمة النبيّ الأُمِّيِّ، كما نطق بذلك قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّونَ مَعَهُمْ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ؛ حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ أُمَّتِي هَذِهِ؟ قِيلَ: بَلْ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ. قِيلَ: انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ. فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلَأُ الْأُفُقَ. ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فِي آفَاقِ السَّمَاءِ؛ فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلَأَ الْأُفُقَ، قِيلَ: هَذِهِ أُمَّتُكَ”.
﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ﴾
﴿مَعَاذَ اللَّهِ﴾: مضاف ومضاف إليه. الأول: ﴿مَعَاذَ﴾ مفعول مطلق. فهو مصدر منصوب بفعل محذوف، لا يجوز إظهاره. والعرب تفعل ذلك في كل مصدر وضعته موضع «يفعل» و«تفعل»، كقولهم: «حمدًا لله»، و«شكرًا له»، بمعنى: «أحمد الله وأشكره». فكأن قد قال: «أعوذ بالله مَعَاذاً»، أي: «ألتجئُ إليه التجاءً».
فهو يحتمي بالله من نفسه، أن يفعل ما لا يُرضي مولاه. لهذا كانت هذه الاستعاذة من تمام الكيد الذي كاده له الله. لكنه لجأ إلى المعاريض، فلم يقل: «معاذ اللّه أن نأخذ بريئاً بجريرة سارق»، لأنه يعلم أن أخاه ليس بسارق؛ بل قال: ﴿مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ﴾. ثم أكد كيده بقوله:
﴿إِنَّا إِذاً لَظَالِمُونَ﴾
أي لو أخذنا أحداً لا يستحق.
وقد قلت إن ذلك من تمام الكيد، لأنه وصف من يأخذ بريئاً بجريرة لم يجترحها بالظلم. ويوسف قد أخذ أخاه بسرقة مُلَفَّقة. فكان تبرؤه من الظلم خلاف الظاهر في شريعتنا. ولولا أنّ الله قال إن ذلك من كيده ـ سبحانه ـ الذي بدأ بدس السقاية في رحل الفتى، فكان هذا إتماماً له؛ لولا ذلك لكان هذا ظلماً. ولكنْ أيُّ ظلم في فعلٍ أمر به اللهُ نبياً لحكمة عنده؟
وبهذا التأويل لما فعل يوسف ـ صلى الله عليه وسلم ـ في قضية السرقة المفتعلة، وما نتج عنها من حوار اللحظة؛ نكون ـ بحول الله ـ قد وُفِّقنا إلى الخروج من معضلة تفسير ما لا يُفَسَّرُ، باختراع حيل شرعية، نرفع مقام الأنبياء عنها.
اللهم اجعل هذا مقبولاً. ولا حول ولا قوة إلا بك.
فَلَمَّا اسْتَيْئَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيّاً قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴿80﴾
﴿فَلَمَّا اسْتَيْئَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيّاً﴾
﴿اسْتَيأَسُوا﴾: جمع «استيأس» على وزن «استفعل»، وهي صيغة في بعض تحولاتها تفيد الصيرورة، كما يُقال: استأسد فلان في الدفاع عن دينه، أي: صار أسداً في الدفاع عن دينة. وكذا قوله تعالى: ﴿اسْتَيأَسُوا مِنْهُ﴾، أي: صاروا يائسين من استجابته.
﴿خَلَصُوا﴾: الخالص هو ما تَخَلَّص مما اختلط به من غيره. فقوله: ﴿خَلَصُوا﴾: انفردوا خالصين من غيرهم، فابتعدوا عن الناس، ومنه قوله تعالى في يوسف: ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ (يوسف/24) أي: من عبادنا الذين خلّصناهم من شوائب التعلّق بغيرنا.
﴿نَجِيّاً﴾: «النَّجِيُّ» مصدر جُعل نعتاً. ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيّاً﴾ (مريم/52). وهو لفظٌ يُوصَف به من يُحادث غيره سراً، سواء كان واحداً أو جماعة أو مذكراً أو مؤنثاً، فهو مثل «عدو» يوصَف به الفرد، وتوصَف به الجماعة كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ﴾ (النساء/92).
فكأن قد قال: فلما يئس إخوة يوسف من استجابته رجاءهم، بأن يأخذ أحداً منهم مكان الذي قيل إنه سرق، انفردوا بعيداً عن القوم يتشاورون سراً.
﴿قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾
وفي إعراب: ﴿مَا﴾ في جملة ﴿وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ﴾ قال الناس كلاماً كثيراً، أظهَرُهُ ـ عندي ـ قولان: الأول أنها زائدة، والثاني هو المختار عندي وهو: أنها اسم موصول بمعنى «الذي» مبتدأ مؤخر، خبره الظرف المتقدم ﴿َمِنْ قَبْلُ﴾. وعلى هذا يكون المعنى بكلامنا البشري: «ومن قبل هذا تفريطكم في يوسف».
وفي تأويل الآية أقول إن شاء الله:
هذا محتوى ما قاله الأخ الأكبر، يُذكّر إخوته المتناجين بما أخذ عليهم أبوهم من الميثاق: أن يرجعوا بأخيهم الأصغر، إلا أن يُحاط بهم. كما يذكّرهم بما فعلوا من قبلُ، حين فرَّطوا في يوسف. فهو الآن يُعلنهم بأنّه لن يعود معهم، حتى يأتيه من أبيه سماحٌ، أو يُصدر الله حكمه ببراءته.
فليت شعري، أكان هذا هو الذي نهاهم أن يقتلوا يوسف من قبل؟ فخطابه يوحي بأنه يرى نفسه غير مشارك لهم، في الجريمة الأولى!
وليس في ذلك دليلٌ، على أنَّ من حقِّ كلِّ من رأى نفسه على حقٍّ، أن يتوقع البراءة. فحتى لو كان القائل هو الذي نهاهم، لما كان غير مشارك في الجريمة، لكونه لم يُبَلّغ أباه بِنَّيِتهم قتل ابنه الأحبّ؛ ثم لم يبلغه بما فعلوا بعد أن فعلوه. وإن كثيراً ممن يطلبون حكم الله، إنما يطلبونه على هواهم. وقد رأينا كيف رفع الخوارج شعار: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (الأنعام/57، يوسف/40، 67) ثم كانوا خاطئين. دع عنك المتدينين الجدد، فهم ليسوا أهل دين بل تجار سياسة.
وثمة ملاحظة أخرى في قول الأخ الأكبر لإخوته: ﴿وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ﴾ حيث جعل الجريمة مجرد «تفريطهم»، فيما كان واجبهم أن يحفظوه فضاع! كأنه ضاع لإهمال غير متعمد، مع أنه يعلم أنهم إنما محقوه محقاً، عن سوء نِيَّةٍ وسبقِ إصرار.
فانظر إلى دقّة التعبير القرآني في فضح خوالج الأنفس. وصدق من قال بأن الكلمات مُشبَعَةٌ بالنوايا، لِما لها من تاريخ استعمال يضيء عتمة الحروف.
﴿وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾
تذييل يُعلن به صاحبه ختام المشاورات ونتيجتها، بعد إذ بلغت حدودها القصوى، فيقبل بحكم الله، بعد أن يئس من حكم البشر. وهو قولُ حقٍّ لولا ما يشوبه من طمع في أن يحكم الله له، رغم كل ما شارك فيه من الإثم. وهذا قولٌ من قولِ من لا يتوقفون عن المعصية، إلا بعد أن يفقدوا القدرة عليها، فهم ـ من ثَمَّ ـ يرجون أن تقف معاصيهم بأبواب الأشد إثماً من المشاركين. وقد رأيتُ من بعض من ارتكبوا الكبائر العجب: قوماً خاضوا في الدماء حتى إذا ما امتنعتْ عليهم باستغناء السادة عن خدمات العبيد، أعلنوا توبتهم، وطلبوا من الله أن يعاقب سادتهم من دونهم؛ وقالوا بملء أفواههم:
﴿رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا* رَبَّنَا آَتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً﴾ (الأحزاب/67 ــ 68).
ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ﴿81﴾ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴿82﴾
هذا أمرُ الأخ الأكبر لإخوته وقد قرر ألّا يرجع معهم.
لا ريب أنَّهم عصبة متوافقة متواثقة متكافلة مُوَحَّدَة، بدليل هذا الأمر من الأخ الكبير، الذي تشهد الوقائع بأنهم أطاعوه. إنهم عصبة حقاً، وقد اعتزوا من قبل بأنّهم كذلك، فتشاوروا في الوسيلة التي يعالجون بها «ضلال أبيهم» إذ رأوه يحب ابنه الأصغر أكثر منهم، فقالوا: ﴿لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (يوسف/8).
وها هي ذي العصبة تتشاور مرة أخرى، ثم تأتمر بأمر الكبير. فإن كان هو الذي قال لهم في المرة الأولى: ﴿لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ﴾ (يوسف/10)، فقد أطاعوه يومها كما يطيعونه الآن. لكنّ النص لا يوضح، ثم لا نقبل بما ينقل لنا قتادة ومجاهد ـ دع عنك السُّديَّ ـ وغيرهم، من الإسرائيليات في تَعيِيِنِهِ. فلو كان في تعيينه خيرٌ، لذكر لنا ذلك المعصومُ صلى الله عليه وسلم. ولكن المصائب في التفسير جاءتنا منذ أحبَّ بعض الناس رواية القصص الإسرائيلي في التفسير. وكان منهم ـ للأسف ـ بعض الصحابة، كابن عباس.
وإنه لَحَقٌّ أنّ الذين كتبوا التوراة ـ التي استقى منها بعض هؤلاء القدماء تفاسيرهم ـ كانوا سلالةَ هذه العصبة من المتآمرين. فلئن شعر الكاتبون في لحظة من الزمن، بضرورة أن يحفظوا أسماء أجدادهم، في كتاب يكتبونه ﴿بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (البقرة/79)، فما حاجتنا نحن بما في كتاب لا نعرف صحيحه من سقيمه؟
ولقد أتَفَهَّم أن يقرأ العهدَ القديمَ شاعرٌ، ليتسلى بقصصه ويقتبس من رموزه؛ لكن أن ينقل منه مفسرٌ، فيفسر بما فيه كلام رب العالمين ـ الذي ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ (فصلت/42)…
وهَبْ سلالةَ هؤلاء حفظوا أسماء أجدادهم، دون تغيير تفرضه الصراعات؛ فهل في نقلها منهم ما يساوى قلامةَ ظُفرٍ، من تركيز مفسّرٍ على الرابط الأقوى، بين تلاعب أبناء يعقوب الأوائل بأبيهم، ثم تَأَثُّمِ أحفادهم من حمل حليِّ المصريين، تأَثُّماً كاذباً حملهم على تحويلها إلى عجل فعبدوه؟ فلو أنّي رأيتُ من المفسرين ـ القدامى والمحدَثين ـ من أشار إلى هذا؟
أكلُّ هذا التَّوَرُّع خشية أن يكون هؤلاء أنبياءَ؟ فلولا تورّعوا أن يقولوا: إن يوسف قعد بين فخذي امرأة العزيز، وحلّ تكة سرواله؟
وحقِّ الله قد كان جديراً بالمفسرين أن يَتَوَرّعوا فلا يقدموا لنا أنبياء يقولون عن أبيهم في غيبته: ﴿إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (يوسف/8)، ثم يواجهونه بكل وقاحة وقد ضيّعوا أخوين: ﴿تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ95﴾ (يوسف/95).
فالآن بعد هذا الاعتراض الطويل على المفسرين، نعود إلى مواصلة الكلام عن هذه العصبة، فنقول إنّ لكلَّ عصبة رئيساً ولا شك. ولقد يبلغ من تماسكهم ألا يخرج الرئيس على ما اتفقوا عليه، ولو اقتضى الأمر أن يتستر على فعلتهم لدى الأب. لكنه الآن وقد أُحيط بهم يقول:
﴿ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ﴾
ولقد قالوا. ولو كانوا يشعرون أن «السارق» أخوهم ـ كما هم إخوةٌ ـ لقالوا: «إن أخانا سرق». لكنهم قالوا ما أمرهم كبيرهم أن يقولوا، بما يشير إلى أنّهم ما يزالون عاتبين على أبيهم، لما يرونه من إيثاره يوسف وأخاه بالحب عليهم!
وبمجرد أن سرد علينا التنزيل العزيز قول الأخ الكبير: ﴿ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا﴾ طوى الزمن والمكان، فنقل الكلام من مصر إلى فلسطين، بحمله الإخوة إلى أبيهم، ليقولوا ما أوصاهم الأخ الأكبر، بما أصاب أباهم ـ النبيَّ الموصول الشيخ الصابر ـ بذهاب البصر.
فيا لله! أفما من ضوء في هذا النفق!
ولكني أرى بصيصاً يبدو من وراء الكلمات: إذ بدا لي أن الأب قام فور سماع الكلمات يتحسس طريقه، وقد بدأت أستار الليل تنزل على عينيه، فشعر الأبناء بقسوتهم لأول مرة، فاستدركوا:
﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ﴾
ووالله لا أدري أحقاً كان هذا التَّلَطُّفُ، أم خوفاً من عدم التصديق؟ فقد رأيناهم يُشفقون على أبيهم، من قسوة الخبر الذي أبلغوه إيّاه فظاً، كأنهم يتبرأون من أخيهم. لكنهم يخشون ألا يصدقهم، وقد تعوّد منهم الكذب، فيستشهدوا بالغرباء:
﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾
فمنح الآيُ كُلّاً من ﴿الْقَرْيَة﴾ التي هي محل، و﴿الْعِير﴾ التي هي آلة؛ وعياً بشرياً، إذ أوقع السؤال عليهما، مع أن المقصودين بالسؤال أهل القرية وراكبو العير. ولكنه مجاز مرسل، علاقة الأول مَحَلِّيَّة، والثاني آلِيَّة.
ولقد أساء قومٌ نفوا المجاز عن كتاب الله، فقالوا في كل موطن ما يضحك الثكلى. فمن ذلك ما نقله عنهم السمين الحلبي، من أنهم قالوا هنا: «إنّ الأبناء قد نطقوا بالحقيقة حين قالوا لأبيهم: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾، لما يعلمون من نبوّة أبيهم، التي تُمكنه من سؤال بيوت القريةَ، وآذان الإبل، فيتعيّن على الجماد والبهائم أن ينطقا فيجيباه».
﴿وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾
هذا ختام كلامهم وحاصله: تعبير مكثّفٌ في جملة حملت أربعة توكيدات: واو القسم، وإسمية الجملة، و«إنّ» الثقيلة في﴿إِنَّا﴾، واللام المزحلقة في ﴿لَصَادِقُونَ﴾.
فكأن علموا أن أباهم لا يصدقهم، فأقسموا. وذلك طبع الكذوب: يُقسم دون أن يُستَقسم.
لكنه لم يصدقهم كما سنرى في القابل من الآيات.
قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴿83﴾ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴿84﴾
﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً﴾
الحرف ﴿بَلْ﴾ للإضراب. ولا بد له من قولٍ قبله محذوف. إذ انتهى كلامُهم الذي لقنهم إيّاه كبيرهم، فردَّ عليهم أبوهم فقال: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً﴾ فكأن قد قال: «كلا، ليس الأمر على ما زعمتم، فلم يسرق ابني. ولو كان كما تقولون، فمن أعلم العزيزَ بأنّ السارق يُؤخذ بسرقته، إلا وشايتكم ، لتتخلصوا من أخيكم»؟
﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾
كان هذا هو نفس ما قاله يعقوب ـ صلى الله عليه وسلم ـ لنفس الأبناء، في الآية الثامنة عشرة، فأعربناه هناك. فليرجع إليه من شاء. لكن نكتفي هنا ببيان المعنى: فكأن قد قال سيدنا يعقوب في استقبال هذه المصيبة الجديدة: «فصبري الجميل الذي علمني مولاي أجدرُ بي».
فيا لَصَبرِ شيخ في خريف العمر يُفجَع في أبنائه ثلاث مرات، فلا يشكو إلا لمولاه، ولا يستعين على صبره إلا به، ولا يفقد ثقته به في عِزِّ حلكة هذا الليل. لقد قلت من قبل إنها سورة يعقوب لولا أن الناس سموها سورة يوسف.
ولئن بدا لي ـ من تتبع أحداث القصة كما ترويها السورة ـ أن يعقوب ـ صلى الله عليه وسلم ـ علم من الله أنه سيُبتَلى في ولديه بإخوتهم؛ لقد وَطّن نفسه على تحمل البلاء. لهذا رأيناه يشك في دوافعهم حين طلبوا منه أن يرسل معهم أخاهم أول مرة. لكنه ظنّ أنّ ذلك بداية تحقق المقدور. وما كان لنبيٍّ أن يحاول دفع ما قال له ربه إنه كائن؛ فأرسله معهم. وهذا ما يلقي عندي بعض الضوء على سِرّ قوله لهم يومئذ حين زعموا له أن الذئب أكله: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ (يوسف/18).
ثلاث فجائع متوالية لم تفتَّ في عضد سيدي يعقوب صلى الله عليه وسلم، ثلاث متوالية: ضياع يوسف، وخيانة الأبناء، ثم ضياع الثالث.
فلما أن بلغ السكين المحزّ، وأوشكت العنق أن تنقطع، علم النبيُّ الموصول أن الفرج يقترب، فزفر زفرة ذبيح صابر:
﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾
واللافت في هذا التعقيب من يعقوب على قوله: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ اختلافه عن تعقيبه السابق على نفس الجملة: فلئن قال هناك: ﴿وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ استقبالاً للمصيبة بالاستعانة عليها بالله، لقد قال هنا: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً﴾. ولا أرى في هذا إلا إشارة بشعور الشيخ أن الفرج قريب. ألا ترى أنه يختتمه بقوله: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ ثقة بأن الله يرى ويحكم وفق ما يرى؟
لكن اقتراب الفرج بعد طول المعاناة يهيّج الشوق، فتبدو على المُحِبِّ بوادرُ اللهفة: ألم تَرَ إلى موسى وقد ﴿كَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾ ففاض به شوق الوصال فصاح: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ (الأعراف/143)؟
فلا جرم رأينا سيدنا يعقوب ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعد هذا الدعاء المعلن، يلجأ إلى خلوته، ليناجي مولاه، بما يليق أن يناجي نبيٌّ مولاه، ليس بينه وبين الله إلا الله، فيقول عنه مولاه:
﴿وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ﴾
فأيُّ اتصال! وسبحان الذي يبتلي أحبابه ليرفع درجاتهم في الآخرة وذكرهم في الدنيا. وإن شئت فقارن بين مكانة سيدك يعقوب في قلبك بعد هذ الصبر، وبين مكانته فيه لو لم يصبه الصبر. ثم انظر كم من دروس المحبّةِ يُعلّمك الله بهذا!
وفي قوله: ﴿يَا أَسَفى﴾ ـ بالألف المقصورة ـ قال الزّجاج: “معناه: «يَا حُزْناه». والأصل: «يَا أَسَفي»، إلا أن «يا» الإضافة يجوز أن تُبدَل ألِفاً، لِخِفة الألف والفتحة”.
قلت: وهذا معناه أن حذف الهاء إنما كان لاعتبارات الجمال: فأنت ترى أن لو قال «يا أسفاه على يوسف» لكان أدنى من حيث الموسيقى. وفي القرآن اعتبار للجمال كبير، بل هو أحد أوجه الإعجاز فيه: فلقد يبدل اللفظة باللفظة لتكون أجمل كما هي أبلغ.
والأسف: هو الحزن تارةَ والغضب أخرى، بحسب ما يدلّ عليه السياق. وقد نقلوا عن بعض السابقين أنه فسره بالجزع، فإن صح النقل عنه فقد أخطأ: فقد يحزن المرءُ ويغضب فلا يجزع. وما كان لنبيٍّ أن يجزع.
فأمّا أنّه الحزن، فقد دلّنا عليه قول أُمّنا عائشة عليها سلام الله، لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حين أمر أن يصلي أبو بكر بالناس: “إنَّ أبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أسِيفٌ” وفي رواية مفسرة: “إذَا قَرَأَ غَلَبَهُ البُكَاءُ”.
وأمّا أنّه الغضب، فقد قال لنا ذلك الله في قوله: ﴿فَلَمَّا آَسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ (الزخرف/55).
وقوله: ﴿يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ﴾ يدل على أنّه الحزن، فهو ليس غاضباً على يوسف كما نعلم.
ولقد ظل حُزْنُ الشيخ يتردد في جوفه، فيبتلعه. وكلما ابتلعه صعد إلى حلقه فرأسه، حتى أعمى عينيه. لكنه لم يتكلم بسوء أبداً ـ على عادة الأنبياء لا يقولون سوءاً ـ صلى الله عليهم وسلم وألحقنا بهم ـ ولم يسمعه إلا الله. وكم يليق بالمؤمن أن يضعف أمام ربه فيتخشّع ويتذلّل. ويقول ما لم يكن قائله أمام الآخرين!
لقد فارق الشيخ أبناءه إلى خلوته، وهو يقول: ﴿يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ﴾. فنظر إليه الله وقال مادحاً:
﴿وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾
قال شيخ المفسرين رحمه الله ونور ضريحه: “فهو مكظوم على الحزن، يعني أنه مملوء منه، مُمْسِك عليه لا يُبينه. صُرِف «المفعول» منه إلى « فعيل»”. قلت: كما نصرف «المحقور» إلى «حقير»، و«المخبوء» إلى «خبيء».
فيا له من نبل في حزن نبي لا يبثه إلا لمولاه! فوحقك يا مولاي، ما كظم عبدك يعقوب حزنه أمام الناس إلا فيك، وما بثّه إلا إليك، وما صبر إلا بك، وما شكا إلا إليك. وما أجمل ما قال القشيري رحمه الله: “لجأ إلى قرب خلاصِهِ من الضُّرِّ بالصبر”.
قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ﴿85﴾ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴿86﴾ يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴿87﴾
﴿قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ﴾
﴿تَفْتَأُ﴾: تزال، أو: تفتر. و﴿تَاللَّهِ تَفْتَأُ﴾: قسم وجوابه. تقديره: «تَاللَّهِ لا تَفْتَأُ» أي: «والله لا تزال» أو: «والله لا تفتر». فحذف «لا» لدلالة الكلام عليها. وحذفها في مثل هذا الموضع من جواب القسم كثيرٌ في كلامهم، من ذلك قول الملك الضِّلِّيل:
فقلتَ: يمينَ اللهِ أبْرَحُ قاعداً ولو قطعوا رأسي لديكِ وأوصالي
يقصد: يمين الله لا أبرح قاعداً.
وقد تمثل هذا شعراء إسلاميون، منهم «صريع الغواني» إذ قال:
وأقسمتُ أنسى الداعياتِ إلى الصبا وقد فاجأَتْها العينُ والسِّتْرُ واقعُ
يقول: وأقسمت لا أنسى دواعي الصبا.
وقيّدوا جواز الحذف بالقسم، فمنعوه في غيره. وقد رأيتُ ما يخالف هذا في قول خداش بن زهير:
وأبرَحُ ما أَدامَ اللهُ قومي بحمدِ اللهِ مُنْتَطِقاً مُجيدا
يقول: لا أَبْرَحُ مُنْتَطِقاً مُجِيداً؛ أي: صاحبَ نِطاقٍ وجَوَادٍ ما أدامَ اللهُ قَوْمِي.
فأنت لا ترى ها هنا قسماً ولا ما يشبه القسم، ومع ذلك فالشاعر يحذف «لا». وبعد لأُيٍ وجدتُ في شرح ابن عقيل ما يؤيد ما ذهبت إليه، إذ قال بعد أن أورد هذا البيت: “الشاهد فيه: قوله «أبرح» حيث استعمله بدون نفي أو شبه نفي، مع كونه غير مسبوق بالقسم”.
﴿حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً﴾
﴿حَرَضاً﴾ مصدر بمعنى اسم المفعول «مُحْرَض» خبر كان. والحَرَض هو الفاسد في جسمه فهو مريض، أو في عقله فهو أحمق. واحدُه وجمعُه سواءٌ. وُقد قيل لمن أذابه الحزنُ أو العشقُ: «مُحْرَض»، لذهاب عقله وجسمه.
ففي المُحْرَض العاشق قال العرجي:
إِنِّي امْرُؤٌ لَجَّ بِي حُبٌّ فَأَحْرَضَنِي حَتَّى بَلِيتُ وَحَتَّى شَفَّنِي السَّقَمُ
يقول: الحب أذهب قواي.
وفي المُحْرَض المريض قال الملك الضِّلِّيل:
أَرَى المَرْءَ ذَا الأذْوَادِ يُصْبِحُ مُحْرَضَاً كَإِحْرَاضِ بَكْرٍ في الدِّيَارِ مَريضِ
يقول: أرى الغنيَّ يدركه الهرمُ، فيغدو مثل بعير لا خير فيه.
﴿أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ﴾
استدراك معطوف على ﴿حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً﴾. والهلاك هو الموت. كما في قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً﴾ (غافر/34).
فكأن قد سمع أبناءُ يعقوب أباهم ـ في ذهابه إلى خلوته ـ يناجي مولاه في يوسف، فأشعلتهم الغيرة حتى استحمقوا، فوصفوه بالحمق. ثم استدركوا زَلَّة ألسنتهم، فأضافوا: ﴿أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ﴾ أي: «والله تظل حزيناً على يوسف حتى يقتلك الغم. فهذا ما قصدناه حين وصفناك بالمُحْرَض».
قلتُ: ومثل هذا مشهود في حياتنا، حين يستحمق أحدهم عليك، ثم يحاول استدراك ذلك، فلا ينفعه.
فقال يعقوب صلى الله عليه وسلم:
﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾
فَنَبَّههم إلى قصور علمهم، مقارنةً بما يعلم من الله، وَرَّد على اعتزازهم بشبابهم باعتزازه بمولاه. وأولئك هم الأنبياء ـ صلوات ربي وسلامه عليهم ـ يُعلّمهم ربُّهم فيتعلمون، وَيَذَرُ المستهزئين فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.
و«البَثّ»: أشدُّ الحزن. وأكثر ما يُستَعمَل في المخفيّ منه، كما في حديث أم زرع المشهور، حين قالت: في وصف زوجها الذي ينام فلا يلتفت إليها: “ولَا يُولِجُ الكَفَّ لِيَعْلَمَ البَثَّ”.
وسيدي يعقوب ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا يشكو حزنه إلا لمولاه. فهو حزنٌ دفينٌ أذهب بصره. وإن شئت فانظر في حرف القصر: ﴿إِنَّمَا﴾، ترَ مصداق ما قلنا. فكأن قد قال: «لا أشكو بثي وحزني إلا لمولاي، فما شأنكم بما بيني وبينه»؟
ثم صرّح لهم بشيء ممّا يعلمه، وكاشفهم بمعرفته كذب دعواهم، في أكل الذئب يوسفَ، من أول يوم. ولم يكشف ما بينه وبين الله من خصوصية العلم، إلا بعد أن رأى اللهُ وقاحة الأبناء، فأَذِنَ لعبده أن يخزيهم فيقول:
﴿يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ﴾
فكأن نظر بعضهم إلى بعض، شاعرين بأن أباهم قد كشف مكرهم، إذ لا يزال يُعيد ويكرر نفس ما قاله منذ سنوات بعيدة، من أن يوسف لم يأكله الذئب، وأنه يعلم ذلك من الله، ويدعوهم إلى البحث، لا عن الأخ المعلوم مكانه فحسب، بل عن الأخ القديم كذلك.
فهل علم سيدنا يعقوب ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن قد اجتمع الأَخَوان في الواقع، فقرَنَ بينهما في الخطاب؟ الله يعلم، ونحن لا نعلم. لكنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ خاطب أبناءه أباً عطوفاً، وقد خاطبوه عجوزاً خرفاً: فأوقفهم على حمقهم، وسوء أدبهم، وضعف علمهم، وجرأتهم على الله، وهو يُعَرِّض بهم فيقول:
﴿وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ﴾.
وفي تأويل هذا، قال شيخ المفسرين رحم الله روحه ونوّر ضريحه: “ولا تقنطوا من أن يُرَوِّحَ اللهُ عنا ما نحن فيه من الحزن”.
قلت: ذلك لما قيل من أنّ «الرَّوْح» و«الرُّوْح» ـ بفتح الراء المشددة وضمها ـ في الأصل واحد. فـ«الرُّوْح» هو اسم النَّفّس الذي ينفخه الإنسان، وكذلك «الرَّوْح»: لأن النَّفّس بعض «الرُّوْح». فاستعاره للرحمة بعد القنوط، وللفَرَج بعد الشدّة. وقد سُمّي جبريل بالرُّوح لما ينزل به من رحمة الله من الوحي، وكذلك سُمّيت الملائكة، لِما يدعون الله للعباد أن يرحمهم، ولِما ينزلون به من الغيث. وقد «أراح الإنسان»: إذا تَنَفَّس. فإذا وقع الإنسان في كربة، فكأنما انقطع نَفَسُهُ، فإذا فُرِّجت عنه، تنفس الصُعَداءُ. وعلى كل الأحوال فالرَّوُح في الآية هو الرحمة.
فكأن قد قال يعقوب لِبَنِيه: «قد فعلتم كل شيء حتى قاربتم الكفر؛ فلا تقعوا فيه، ونفذوا ما آمركم به من أمر مولاي: ﴿فَتَحَسَّسُوا﴾ أي: ابحثوا بكل حواسّكم، حتى لو أدّى الأمر إلى أن تجثوا على ركبكم، فتستنطقوا الأرض بأكفّكم، عسى أن تخبركم بمكانه».
وقد قيل: بل أمرهم بطلب يوسف بجميع حواسِّهم: بالبَصَرِ لعلَّهم تقع عليه أعينهم، وبالسَّمْع لعلَّهم يسمعون ذِكْرَه، وبالشمِّ لعلهم يجدون رِيحَه.
وقال ابن عطية بأن في ذلك حذفاً. والتقدير “فتحسسوا نبأً أو حقيقةً من أمر يوسف”.
قلت: بل يمكن حمل التَّحَسُّس على الحقيقة دون مجاز، وعلى التمام دون حذف، فيُقال بأنّ ﴿مِنْ﴾ في قوله: ﴿مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ﴾ على عادتها في التبعيض. فكأن قد قال لهم أبوهم: «حتى لو تفرقت أعضاء أخويكم في الأرض، فتحسسوا الأرض شبراً شبراً، حتى تجدوا شيئاً منهما».
وهو مبالغة من سيدنا يعقوب في أمر أولاده بألا يتكاسلوا. ونحن نعلم أن الإخوة يعلمون مكان أخيهم الأصغر، لكن هذا الخطاب يُقرِنُ من لا يعلمون مكانه بمن يعلمون، لِعلم الأب ـ أو لنفث روح القدس في رُوْعه ـ أنهما مجتمعان في مكان واحد.
﴿إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾
فما دام المرء مسلماً يعرف الله، فإنه يعرف بأن رحمته وسعت كل شيء، فلا ييأس من رحمته. وإنما ييأس من رحمته من لم يعرفه فلم يعرف رحمته. فأنت لا ترى المؤمن يائساً من رحمة الله، فإن رأيته يائساً من رحمة الله، فكأن قد أصاب ذنباً يرى أنه أكبر من رحمة الله. وهذا الشعور من الكبائر.
وفي الآية نهي عن التَّشبُّهِ بالكافرين. فكأن قال يعقوب لبنيه: «لا يجدر بكم أن تتكاسلوا، فتشبهُ أفعالُكم أفعالَ الكافرين».
قلت: وهكذا ترى أن ليس في الآية دليلٌ على أن مطلق اليأس كفر.
فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴿88﴾
﴿مُزْجَاة﴾ اسم المفعول من «أزجىٰ»، بمعنى: «دفع». قال تعالى: ﴿رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ﴾ (الإسراء/66)، أي: يدفع الفلك فتتقدم. وقال: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَاباً﴾ (النور/43)، أي يدفع السحاب. وقول إخوة يوسف ليوسف: ﴿وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ﴾ أي: جئنا بثمن بخس يزهد فيه المتبايعان.
وفي هذا الموضع حذف واختصار، حيث يطوي السياقُ الزمان والمكان بالمسافرين من فلسطين إلى مصر، فيضعهم أمام عزيز مصر يوسف، يخاطبونه بتَحَنُّنِ ومسكنة واستعطاف، فيعرضون عليه مأساتهم مختصرة فيقولون: ﴿مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ﴾.
فلا ريب أنهم الآن يشكون المجاعة، لكنَّ في توسلهم رنّةً غريبة، وإشارةَ إلى شيء آخر، أورثهم هذا الذُّلَّ، من دون أهل الإقليم، هو ما يعلمه العزيز من تضييع أخيهم، وما يُكِنّونه في أنفسهم من حزن أبٍ أفقده بصره؛ ثم ما جاؤوا به من ثمن بخس لا يقضي ثمن القمح، الذي جاؤوا يشترون.
فلما قالوا: ﴿فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾ علم العزيز أنّهم يتسولون تسولاً مضاعفاً: فمن جهة هم يطلبون كيلاً أوفى مما تستحق بضاعةٌ بخسة. ثم هم يتسولون فوق ذلك صدقةً زائدة دون ثمن: فتلكما صدقتان، صدقة بعد صدقة.
ثم يختتمون تَسَوُّلَهم بما يختتم به كل مُتَسَوّلٍ مدفوع بالأبواب تَسَوُّله، فيقولون قولاً بحسب عادة المتسولين، الذين لا يقصدون سوى ترقيق القلوب: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾.
فهم إنما يتذللون، لما نعلم من كونهم يرون العزيز وثنيّاً على دين الملك والمصريين، فأي وثن هذا الذي يجزي المتصدقين، في عُرف ملك لا يؤمن بدين يعقوب؟
إنهم يتسولون، ولا يعلمون أن هذا الاستعطاف الذليل منهم، يطرق الآن أبواب قلب أخيهم الكريم، بقوة تُصَدِّع جلمود الصخر. فقد أخبروه من قبل أن لهم ﴿أَباً شَيْخاً كَبِيراً﴾ (يوسف/78)؛ لكنهم أخبروه الآن بأنه قد كُفَّ بصره من الحزن. نعلم هذا مما سيفعله بعد قليل، حين يطلب منهم أن يلقوا قميصه على وجهه ﴿يَأْتِ بَصِيراً﴾ (يوسف/93).
والآن يمكن تصور هيئة هؤلاء، الذين كانوا يرون أنفسهم عصبة، فيستقوون على أبيهم بالمكر، وعلى أخيهم بانفراده وصغر سنه: يمكن تصور وجوههم الخاشعة، ورؤوسهم المنكسة، وأنفسهم المنكسرة، وهيئتهم الرَّثّة؛ وقد وصلوا من السفر شعثاً غبراً يتسولون، من عزيز يجلس على العرش، وقد كان من قبل في قعر البئر بفعلهم!
لقد صدق رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حين وصف يوسف بالْكَرِيم ابْن الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ. ولو لم يكن كذلك، لَهَيَّج ذلُّهم ذكريات الأسى في قلبه، فلَثارَ ولَبطشَ حتى اشتفى من إخوته. لكن هيهات للكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم أن يشتفي من أهله، أو حتى من خصوم غرباء. هيهات هيهات والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: “الإِيمَانُ قَيَّدَ الْفَتْكَ”.
فانظر إلى جزاء الله للناس في الدنيا بما يكسبون. فهؤلاء أبناء نبيٍّ ـ حتى قيل بأنهم أنبياء ـ واقفون الآن جياعاً يطلبون الصدقة. ولو كانوا أنبياء لما فعلوا ما فعلوا من قبل، ولما أوقفهم الله هذا الموقف أصلاً. كيف وقد أبى الله لخاتم الأنبياء محمد ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أن يأكل الصدقة، لما فيها من معنى الذُّلّ؟
ويبدو أن تحريم الصدقة على الأنبياء حكم عام في جميعهم، لتعليل الرسول ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ تحريمها عليهم، بكونها أوساخ الناس، كما قال لبعض آل البيت: “إنَّ الصَّدَقَةَ لا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ؛ إنَّما هي أَوْسَاخُ النَّاسِ”. وقال لِلْعَبَّاسِ: مَا كُنْتُ لِأَسْتَعْمِلُكَ عَلَى غُسَالَةِ ذُنُوبِ النَّاسِ”. بل إنّه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لمّا أَخَذَ حفيده الطفلُ الْحَسَنُ بْنُ فاطمة ـ عليهما السلام ـ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، قال له: “كِخْ، كِخٍ. ارمِ بها. أَمَا علمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ”؟
وهؤلاء لو كانوا أنبياء ـ كما يزعم البعض ـ لما أوقفهم الله هذا الموقف، ولما ألزمهم بأكل أوساخ الناس.
قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴿89﴾ قَالُوا أَئِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴿90﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آَثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ﴿91﴾ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴿92﴾ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴿93﴾
﴿قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾؟
التنزيل يحكي باللغة العربية، محتوى الحدث وما قال يوسف لأخوته، فيقول إنه سألهم: ﴿هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾؟ فجاءت ﴿مَا﴾ ها هنا اسماً موصولاً بمعنى «الذي»، أي: هل علمتم الذي فعلتم؟ وجاءت ﴿إِذْ﴾ ظرفاً للزمن الماضي بمعنى: «حين» أو: «عندما».
وإذ لم يعد في استطاعة يوسف الصبر على ما أصاب أهله من الذّلِّ أكثر من ذلك؛ نظر الله في قلبه، فرأى رِقّة الأخ ورِقَّة المؤمن، فأذِنَ له أن يكشف لهم عن شخصيته، فـ﴿قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ﴾ ففرقتم بينهما، وحرمتماهما البيت وحنان الأبوين؟
فهو استفهام استنكاري لغرض العتاب، ووفاءً لوعده تعالى له حين ألقوه في الجُبّ؛ بأنه سيأذن له ـ ذات يوم ـ بأن يذكّرهم بما فعلوا، وذلك حين قال تعالى في أول السورة: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (يوسف/15).
فإن قال بعضهم: بل هو استفهام التوبيخ؛ قلنا: يردّ قولكم ختامُ الآية: ﴿إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾ أي: في زمن جاهليتكم. فاخترع يوسف ـ صلى الله عليه وسلم ـ لإخوته العذر حين راجعهم بما فعلوا، فكان عتاباً.
﴿قَالُوا أَئِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ﴾؟
استفهام غرضه التعجب. وفي ﴿أَئِنَّكَ﴾ همزتان: الأولى للاستفهام، والثانية همزة إنّ الناصبة. والكاف ضمير متصل في محل نصب اسم إن. واللام في ﴿لَأَنْتَ﴾ هي المزحلقة التوكيدية. وجملة ﴿لَأَنْتَ يُوسُفُ﴾ في محل رفع خبر إنّ.
﴿قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي﴾
صرح باسمه وقرن أخاه به تعظيماً لما رزقه الله من النصر، فكأن قد قال: نعم، أنا يوسف الذي ظلمتموه صغيراً فألقيتموه في الجب، واتهمتموه بالسرقة كبيراً حين قلتم: 76﴿إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ (يوسف/77). وهذا أخي الذي نزعتموه مني ونزعتموني منه.
﴿قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾
نفي لما يُتَوَهَّمُ من الفخر في قوله السابق: ﴿أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي﴾ وبيان بأن هذا حمد لله واعتراف بفضله وتحديث بنعمته. ثم علل ذلك فقال:
﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾
وهذا شرط وجوابه يفيد التعميم، ويعلن قاعدة كلية تفيد بأن كل من اتقى وصبر، نال من الله جزاء المحسنين. قال جار الله: “فوضع المحسنين موضع الضمير، لاشتماله على المتقين والصابرين”. يقصد أن المحسن هو من جمع بين التقوى والصبر.
﴿قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آَثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾
اعترفوا أخيراً بأنه يستحق التفضيل من الله، وكانوا من قبل يحسدونه على ما يرونه تفضيلاً من أبيه له. فردوا قليل حب الأب لابنه، فنالوا من الله أن أحبه أكثر. فسبحان من رد كيد الحاسد إلى نحره.
﴿وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ﴾
ثم اعترفوا بذنبهم. وأنت ترى أن الاعتراف بالذنب لا يَتَأَتَّىٰ إلا آخر الأمر. فكل ما فعلوه لم يجعلهم يرون أنفسهم خاطئين، فلما رأوا تفضيل الله من كادوه، وإحسان المكيد إليهم رغم كشفه كيدهم، اعترفوا، فقال:
﴿قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ﴾
التثريب من الثَرْبُ قال في الصحاح: “شًحْمٌ قد غَشيَ الكَرِشَ والأمعاءَ رقيقٌ”.
وأوضح جار الله المقصود فقال: “لأنه إذا ذهب [الشحم] كان ذلك غاية الهزال والعجف، الذي ليس بعده، فضًرب مثلا للتقريع، الذي يمزق الأعراض ويذهب بماء الوجوه”.
وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا”.
فكأن قد قال يوسف لإخوته المعترفين بخطيئتهم: لا تأنيب عليكم اليوم ولا عتب. ثم دعا لهم فقال: ﴿يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾
﴿اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً﴾
أمر يحمل في طياته الشرط ما يستتبعه من جواب. وفائدة الشرطية هنا الدلالة على سرعة الاستجابة، فكأن قد قال: بمجرد أن تلقوا قميصي على وجه أبي، يبصر فيسرع بالمجيء.
والقميص إما يُطلق على الثوب كاملاً، وإما على «الشِّعار» الذي تحته مما يغطي جلد الجزء العلوي من الجسم، ويُقال له اليوم: «الشَّبّاح». ويقابله «الدِّثار» وهو الثوب الذي فوق الشعار. والغالب أن المراد بالقميص هنا الشعار، لما فيه من ريح الجلد. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار شعاراً لقربهم من قلبه في قوله: “الأنصارُ شِعارٌ والنَّاسُ دِثارٌ”.
فأعطاهم يوسف قميصه ليلقوه على وجه أبيه فيشم فيه ريح يوسف فيرتد إليه بصره. وتلك لا شك معجزة، لكنها تدل على شدة العلاقة بين الأب والابن.
﴿وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾
وهكذا سكن أبناء يعقوب مصر، وأنسلوا شعباً صار فيما بعد مفضلاً على العالمين، بما اتبعوا الأنبياء. ثم انحرفت أنسالهم فلعنها الله. وكذا حدث لأمة محمد صلى الله عليه وسلم: أعطاها الله كتابا ورسالة، فاتبعت النبيَّ وصدقت بالكتاب، فكانت خير أمة أخرجت للناس. ثم انحرفت أنسالها وزعمت ما يزعم بنو إسرائيل اليوم، مع أن كل عاقل يعلم أن البركات لا تورث للأحفاد إن فسقوا.
فلله الأمر من قبل ومن بعد.
وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ﴿94﴾ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ﴿95﴾
﴿رِيحُ يُوسُفَ﴾: رائحته. فريح الشيءِ ورائحته واحد. وفي صحيح البخاري: “مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً، لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً”
﴿فَصَلَتِ الْعِيرُ﴾: قال الجوهري: “فَصَلَ من الناحية، أي” خرجَ”. وقال الراغب: “فصل القوم من مكان كذا وانفصلوا: فارقوه”. وقال جار الله: “فَصَلَ من البلد فصولاً، إذا انفصل منه وجاوز حيطانه”.
وقد صح عن ابن عباس أن الريح جاءت ليعقوب برائحة يوسف من مسيرة ثمان ليال. ولما كانت المسافة بين عاصمة مصر القديمة وفلسطين، أكثر من هذا بكثير، لقد رأينا المفسرين يقولون إن هذا حدث حين خرجت القافلة من العريش، آخر حدود مصر مع الشام. والمقصود أن الريح حملت ليعقوب رائحة يوسف بمجرد دخولها الأرض المقدسة.
قلت: ولا أقبل بما يقول ابن عباس في هذا الضرب من التفسير، إلا ما يرويه عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وسوى ذلك عندي هو مما تلقاه من الإسرائيليات. وإلا فمن أين يأتي بهذه الأخبار. وجلالةُ الحَبْرِ البحر لا تمنعنا من مناقشته الحساب؟
﴿لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ﴾: لولا أن تفندوني. حذفت ياء المتكلم تخفيفاً، بعد نون الوقاية، وبقيت الكسرة. وأصل التفنيد هو الإفساد. والشيخ المُفَنَّد هو العجوز الخرف الذي فسد رأيه. والتفنيد في الاستعمال هو: ردّ الكلام على قائله، وتخطئته، وادعاء فساده. قال هَانئُ بن شكيم العَدَوِيُّ:
يا صاحبيَّ دَعا لَوْمي وتفنيدي فليس ما فات مِن أَمْرٍ بمردودِ
فيعقوب ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: «إني أشمّ ريح يوسف، ولكني أخشى أن تُسَفِّهوا ما أقول، وتنسبوني إلى العجز». قلت: وذلك لما يعلم من أنهم يرون حبَّ يوسف قد ذهب بعقله.
قال صاحب الظلال رحمه الله:
“كيف وجد يعقوبُ ريحَ يوسف، منذ أن فصلت العير؟ ومن أين فصلت؟ يقول بعض المفسرين: إنها منذ فصلت من مصر، وأنه شَمَّ رائحةَ القميص من هذا المدى البعيد. ولكن هذا لا دلالة عليه؛ فربما كان المقصود: لما فصلت العير عند مفارق الطرق في أرض كنعان، واتجهت إلى محلة يعقوب على مدى محدود. ونحن بهذا لا ننكر أن خارقة من الخوارق يمكن أن تقع لنبيٍّ كيعقوب، من ناحية نبيٍّ كيوسف. كل ما هنالك أننا نحب أن نقف عند حدود مدلول النص القرآني، أو رواية ذات سند صحيح. وفي هذا لم تَرِد روايةٌ ذات سند صحيح. ودلالة النص لا تعطي هذا المدى الذي يريده المفسرون. ولكن المحيطين بيعقوب، لم يكن لهم ما له عند ربّه، فلم يجدوا ما وجد من رائحة يوسف”.
وحاصل ما أقول في هذا المعنى: إن يعقوب ـ صلى الله عليه وسلم ـ احترز قبل أن ينطق لسانه بما تلقته روحه من ريح المحبوب. ولقد كان بإمكانه أن يكتم ما يجد من ريح يوسف، التي أتاه بها من على البعد مولاه ـ سبحانه ـ لولا أن غلبته عاطفةُ أبٍ فقد ولده الأحب، فقال: ﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ﴾ لكنه استدرك فقال: ﴿لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ﴾.
ولقد فَنَّدوه بالفعل، فقالوا وأقسموا:
﴿تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ﴾
والضلال القديم هنا ليس معناه: «العتيق» في الزمن؛ بل الراسخ الذي لا يزول. ذلك أنه لا يستمر قديم على قدمه إلا إذا كان راسخاً.
والآن أقول: أفليس في هذا إشارة إلى بعض ما عاناه يعقوب ـ صلى الله عليه وسلم ـ ممن حوله، الذين هم الآن يتهمونه بالضلال علناً وفي وقاحة؟
أفليس هذا إشارة إلى أن استهانة أبناء يعقوب بأبيهم، أغوت الأقارب الحضور من أزواج وأحفاد ـ وربما الجيران كذلك ـ بأن يستهينوا بالنبي الشيخ؟
إن أبناء يعقوب لم يصلوا بعد، بل مجرد فصلت بهم العير من مكان بعيد، فشم أبٌ رائحة ولده، فاتهمه سامعوه بالضلال! فأي عقوق لدى أبناء لا يرى الناس بأساً من تضليل أبيهم، وهم يعلمون؟
فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴿96﴾
﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ﴾:
﴿الْبَشِيرُ﴾ حامل البشري. وهو ـ في العادة ـ شخصٌ يركض لِيُبَلِّغَ خبراً لٍمُتَلَقٍّ يسعد به.
وقد وزعم مفسرون قدماء بأن البشير هو البريد. ولا أرى ذلك صحيحاً، فما من حاجة إلى مؤسسة دولةٍ، تركض نحو مواطن، لتبلغه الخبر. كما أنه ليس من الضروري أن يكون البشير من أبناء يعقوب، كما زعمت تفاسير ذكرت له اسماً، ونَسَجَتْ له قصة، لا يمكن أن يكون مصدرها من غير تآليف أهل الكتاب. وقد درج كثير من المفسرين على نقل هذه القصص المُزجاة، ووصفوها بأنها من إنتاج إجماع المفسرين. فمن أين جاء بها المفسرون؟ لا جواب سوى النقل عن قدماء تكلموا في التفسير، بما سمعوه من أهل الكتاب. ورحم الله الإمام أحمد إذ التفت إلى هذه الظاهرة فقال: “ثلاثة ليس لها أصل: التفسير والملاحم والمغازي”.
قلت: والبشير في الآية: شخص تلقى القادمين على أبواب القرية، أو كان معهم، فحمل من أبناء يعقوب الخبر والقميص وركض مسرعاً، يحمل الخبر ليعقوب ـ صلى الله عليه وسلم ـ لينال البشرى. وكانوا يمنحون البشير جائزةً، لقاء مجيئه بالفرح بعد الحزن، ويسمونها البشرى.
وفي حديث توبة كعب بن مالك، رأينا الصحابة ـ رضي الله عنه وعنهم ـ يقاطعون كعباً، عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتخلفه عن غزوة تبوك، فيعتزل كعبٌ في بيته، حتى إذا نزلت توبته من الله قال: “ورَكَضَ إلَيَّ رَجُلٌ فَرَساً، وسَعَى سَاعٍ مِن أسْلَمَ، فأوْفَى علَى الجَبَلِ، وكانَ الصَّوْتُ أسْرَعَ مِنَ الفَرَسِ، فَلَمَّا جَاءَنِي الذي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي، نَزَعْتُ له ثَوْبَيَّ، فَكَسَوْتُهُ إيَّاهُمَا ببُشْرَاهُ”.
وزعم النحويون والبلاغيون بأنَّ الحرف ﴿أَنْ﴾ في جملة قوله: ﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ﴾ زائد. وهرب بعضهم من التصريح بالزيادة في كتاب الله فقالوا: «صلة». وهي عندهم بنفس معنى الزائد. ثم تناقض الفريقان مع ما أطلقت ألسنتهم فقالوا: «للتأكيد».
ولا أعلم ـ والله ـ كيف يكون شيءٌ في كلام الله زائداً، وهو يؤكد شيئاً قاله! فهل لا لزوم في الكلام للتأكيد؟
وقد حاول الإمام الزركشي ـ رحمه الله أن يعتذر عن هذا القول القبيح من أهل اللغة ـ فقال: “ومعنى كونه زائداً: أن أصلَ المعنى حاصلٌ بدونه، دون التأكيد. فبوجوده حصل فائدة التأكيد. والواضعُ الحكيمُ لا يضع الشيء إلا لفائدة”.
قلت: فبذلك نفى الزركشي الزيادة.
ورحم الله شيخنا العلامة محمد عبد الله دراز، حين قال في هذا:
“فليس فيه كلمةٌ، إلا وهي مفتاحٌ لفائدة جليلة. وليس فيه حرفٌ، إلا جاء لمعنى. دع عنك قولَ الذي يقول في بعض الكلمات القرآنية: إنها «مُقْحَمَة»، وفي بعض حروفه: إنها «زائدة زيادة معنوية». ودع عنك قولَ الذي يستخفّ كلمة «التأكيد»، فيرمي بها في كلِّ موطنٍ يظنُّ فيه الزيادة… أجلْ، دع عنك هذا وذاك، فإن الحكم في القرآن، بهذا الضرب من الزيادة أو شُبَهها؛ إنما هو ضربٌ من الجهل ـ مستوراً أو مكشوفاً ـ بدقّة الميزان الذي وُضع عليه أسلوب القرآن”.
قلت: والحق أنك لو تأملت جيداً في مجيء الحرف ﴿أَنْ﴾ بين الفعل والفاعل في جملة قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ﴾ لرأيت فاصلاً صوتياً أخّرَ الفعل أن يفعل، فكأنْ جعلَ البيان القرآنيُّ البشرى تتأخر صوتياً، لتتناسب مع طول مدة الفراق بين يعقوب ويوسف ـ صلى الله عليهما وسلم ـ فكأن قد قال: «وبعد أن طالت مدة الفراق جاء البشير».
﴿أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً﴾:
لا شك أنك تعلم أن حرف الفاء في قوله: ﴿فَارْتَدَّ﴾ تفيد التعقيب في الحال، دون مسافة زمنية. فإن طلبتَ البيان، قلنا لك: اقرأ قوله تعالى في دخول الملائكة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَاماً﴾ (الحجر/52) فبمجرد أن دخلوا قالوا: سلاماً.
وإني لأَتصورُ البشير وقد وصل الآن إلى باب يعقوب يلهث ـ وكان ينادي من بعيد ـ فخرج النبي الشيخ الصابر الموصول ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى الباب، يَتَحَسَّس طريقه. ولو نظرتَ في تلك اللحظة إلى هذا الوجه المنير، وقد استنار فأضاء المكان، لانغلقَ عليك كل بيان، ولأُرتِج عليك كل لسان، ولَوَقَفْتَ مندهشاً من بصيرٍ فقد بصره، يضيء كلَّ ما حوله من الأشياء، وقد حفّت الملائكة بالمكان، تسبح بصوت تسمعه كل الأشياء دون المحجوبين من أمثالي.
فبمجرد أن فُتح الباب، ومنذ الباب، وقبل الوصول، ومن مسافة معقولة؛ ألقى البشيرُ القميصَ على وجه سيدنا يعقوب، فارتدَّ بصره إليه، بنعمةِ الله ومعجزةِ الفعل الإلهي، الذي لا يبحث عن الأسباب، فيجريها حين يشاء، ويُعطّلُها حين يشاء، ولا يلتفت إلى تساؤلات الكافرين بالغيب.
﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾
ثمة ها هنا احتمالان:
1: الأول: أن يكون المخاطَبون أهل البيت والجوار، الذين قالوا ليعقوب في الآية التي سبقت هذه: ﴿تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ﴾ فهم الآن واقفون ينظرون، والبشير ينتظر الجائزة.
2: والثاني أن يكون المخاطَبون أبناءه، وقد أنزلوا الأحمال ووصلوا بعد قليل من وصول البشير. وهذا هو اختيار المفسرين، وربما اختاروه لقربه مما بعده من قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾
والأول أحبُّ إليّ، لأن كلام يعقوب جوابٌ لما قيل قبل قليل، ولا يتأخر ليقوله لمن لم يقل له ﴿تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ﴾.
قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴿97﴾ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴿98﴾ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آَوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ﴿99﴾ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴿100﴾
لقد شجع الأبناءَ غفرانُ أخيهم لهم وقيلُهُ: ﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ﴾، على طلب مغفرة الأب، خصوصاً وقد دعا لهم فقال: ﴿يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾.
فالآن وقد انقضت فصول المحنة على خير، يجدون أنفسهم قادرين على طلب غفران الأب والربّ.
هذا شأنُ الولد، أما شأن الوالد فمختلف.
لقد غرس اللهُ في قلوب الآباء إيثارَ الأولاد بالمحبة، ولو على أنفسهم: فما يؤلم الأولادَ في أنفسهم، يؤلم الآباء أكثر. وقد تألم يعقوب على شقاء ابنه من فعل أبنائه. فالآن يطلبون منه أن ينسى كل ذلك في لحظة؛ ويوسف لم يصل بل قميصه! الآن يطلبون من يعقوب أن ينسى غياب يوسف، ولم يَحظَ بِضَمِّهِ وشَمِّه وتقبيله بل قميصه! إن هؤلاء ذهبوا بيوسف ثم جاؤوا إليَّ بقميصه يطلبون المغفرة. فليمنحهم القميص المغفرة!
﴿قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾
ومهما بلغ الفرح بالوالد لنجاة الولد، فليس من السهل أن يُنسيه ذلك معاناةَ السنين. بل إن كثيراً من الفرح ليأتي بنقيضه، إذْ يُذَكِّرُ بأسباب ضياعه، فيبعث الأسى متجدداً. أفلم نَرَ كيف ينفجر العتاب المُرُّ عند المصالحة بين المحبين؟
﴿قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾
وإذ صعد الألم المكبوت من أعماق الشيخ، لم يجد نفسه قادراً على المغفرة لأبناء عاقين حاولوا قتل أخيهم؛ فَهَشَّهُمُ الأبُ الشيخ النبيُّ الصابر عن وجهه، كما يهشُّ المرءُ أمّةً من الذباب، إلى حين يرى يوسف ويسكن الغضب، فقال لهم: ﴿سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي﴾ الذي كان دوماً ربي، وتحتاجونه الآن، وتعرفون بأنه كان لي ـ من دونكم ـ كهفاً آوي إليه من ألم فقدان يوسف. سيأتي وقت أستغفر لكم فيه ربي، ولكني الآن عنكم مشغول بغضبي القديم وفرحي الجديد. ولا بأس بأن تنتظروا قليلاً، فقد أتعبتموني طويلاً. لكن مع ذلك أنتم أبنائي، وهو ربي ﴿الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾
﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آَوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ﴾
هكذا طوى الخطاب الزمن والمكان، لنجد أنفسنا ـ نحن مستمعي هذه التلاوة الشائقة ـ أمام مشهد ترجمته اللغةُ إلى صورة، حيث وصل الجميع من فلسطين، ودخلوا على يوسف، فـ﴿آَوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ﴾: فكأن قد صار حضن يوسف مأوى الشيخين من الحزن، وقد أحتضنهما يقبلهما ويبكي، ويبكى الشيخان. ومن وراء ذلك يغمغم يوسف: ﴿ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ﴾
﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً﴾
ولا شك أنه تخلص من حضن أبويه بصعوبة، ليتمكن من رفعهما على العرش. فلئن رأى في الرؤيا أن أبويه يسجدان له، لقد أبى أن ينحنيا له الآن، فرفعهما على العرش إلى جانبه. لكنهما سجدا له مع الساجدين تحية وفرحاً، سجدت روحاهما إذ أبى عليهما الابن النزول إلى تحت. قال الفخر الرازي رحمه الله: “وعندي أن هذا التأويل مُتَعَيِّنٌ، لأنه لا يُسْتَبْعَدُ من عقل يوسف ودينه، أن يرضى بأن يسجد له أبوه، مع سابقته في حقوق الولادة والشيخوخة والعلم والدين وكمال النُّبُوَّةِ”.
وإذن فقد خَرَّ الإخوةُ ساجدين خاضعين راجين مغفرة الأب. وأظن تلك اللحظة هي ما أقنع الأب بأن يغفر لهم، ويستغفر لهم ربَّه المحيط بالمشهد.
بقي أن نقول: إنَّ كلَّ ما قاله المفسرون، عن كون هذا سجود تحية ـ لا سجود عبادة ـ صحيح، ولكن لا قيمة له عندي، إذ يبدو تبريراً للسجود، وقولاً على الله بغير علم. وإلا فهل يجوز لنا أن نسجد اليوم مثل ذلك؟ اللهم لا. فلم يتبق لنا إلا أن نقول: إن ذلك كان مباحاً في شرائع السابقين، ثم نسخته شريعة سيدي النبيّ الأُمّيِّ صلى الله عليه وسلم. فالآن كل سجود لغير الله ـ عندنا ـ إنما هو سجود يقارب العبادة، بل هو عبادة، بل هو كفر أكبر يُخرج الساجدَ من دين الإسلام؛ إن لم يكن مُكرَهاً إكراهاً يوشك أن يودي بحياته. وإلا فليس كل ما يُقال إنه إكراهٌ إكراهاً.
وفي الحديث الصحيح قال عبد الله بن أوفى رضي الله عنه: “لمَّا قدِمَ معاذٌ منَ الشَّامِ، سجدَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ. قالَ: ما هذا يا مُعاذُ؟ قالَ أتيتُ الشَّامَ فوافقتُهُم يسجُدونَ لأساقفتِهِم وبطارقتِهِم، فوَدِدْتُ في نَفسي أن نفعلَ ذلِكَ بِكَ. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: فلا تفعَلوا، فإنِّي لو كُنتُ آمراً أحداً أن يسجُدَ لغيرِ اللَّهِ، لأمَرتُ المرأةَ أن تسجُدَ لزوجِها”.
وثمة شيء آخر لا بد من توضيحه، وقاله مفسرون قدماء وصدقوه، ونقلوه عن السُّديّ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأضرابهما. فلا والله ما أصابوا فيه قلامة ظفر، إذ قالوا: إنَّ أُمَّ يوسف ماتت منذ زمن بعيد، وإنَّ هذه الجالسة إلى جانب يوسف على العرش مع يعقوب، زوج أبيه التي هي خالته أخت أمه. فقال الناس بقولهم هذا، في تفسير كلام الله، ما قاله كاتبو التوراة الكاذبون، مما يخالف نصوص القرآن والتوراة من قبل.
فأما السُّدي فشيعي محترق. ودين الشيعة ينقل من أهل الكتاب أكثر بكثير مما ينقل دين أهل السُنة، مع ضعفهم في علم الرجال. وأما عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فمنكر الحديث قال فيه الشافعي رضي الله عنه: “قيل لعبد الرحمن بن زيد: حدثك أبوك عن جدك: أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: إنّ سفينة نوح طافت بالبيت، وصلت خلف المقام ركعتين؟ قال: نعم”.
ووالله لا أقبل هذا، ثم والله لا أقبله، ثم والله لا أقبله. بل رفع يوسفُ أباه وأُمَّهُ على العرش. فلم تكن أُمُّه قد فارقت الحياة، وليذهب الذين يأبون صريح التنزيل إلى كتابات الأحبار. ولكن يجب ألا يقولوا: إنَّ أبويه هما أبوه وخالته، ولو على سبيل التغليب: فلا يُرَدُّ صريحُ النص القرآني، إلى قاعدةٍ لغوية من إنتاج البشر.
وقد أحسن ابن إسحق إذ أبى كل هذا الهراء، وقال: بل هي أمه. وقال بقوله شيخ المفسرين. والحمد لله رب العالمين.
ولكن دعونا الآن من كل كلام، لنتأمل الشمس والقمر على العرش. فأي جمال وأي مهابة وأي قداسة! وتلكم هي الكواكب ساجدة تحت. أليس هذا هو تأويل الرؤيا؟
﴿وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقّاً﴾
لا ينسى المؤمن ـ في عِزِّ فرحه ـ مصدرَ الفرح الأول، ولا يشغله عن مولاه شغل، فكما قدم يوسف المشيئة حين قال: ﴿ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ﴾ ها هو الآن يقول: ﴿هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقّاً﴾، مما يذكرنا بقول الحفيد سليمان من بعد حين رأى عرش ملكة سبأ بين يديه: ﴿هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾ (النمل/40).
فلله ذُرِّيَّةٌ طاهرة مقدسة بعضها من بعض. صلى الله عليهم وسلم، وجمعنا مع نَبِيِّنا وهم ـ وسائر الأنبياء ومن نحبُّ ـ عنده في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. إنه القادر على تجاوز ما فعلنا إلى جواره.
ثم يواصل يوسف استذكار آلاء الله في لحظة الشكر فيقول:
﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي﴾
فلا تثريب على إخوته. ألم يقل ذلك من قبل؟ وإذن فسبب كل هذا الحسد والأذى هو نزغ الشيطان. والذي أدخله السجن أسباب الشيطان، أفليس هو من أغوى امرأة العزيز من قبل؟ والذي أخرجه من السجن مولاه الواحد الأحد، فكما كفله وآواه حين أوشك على الانزلاق في المعصية، أخرجه من سجن الناس إلى كنف الله وملك مصر. والذي حمل هؤلاء من صحراء فلسطين إلى بلاد النيل هو الله.
ألا نرى هنا كيف يقشع الإيمان الأسباب ويزيحها جانباً، ليرى السعيد من ورائها الفاعل الحقيقي، لا إله إلا هو؟
﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ﴾
فلطفه بي وبإخوتي عصمهم أن يقتلوني فيدخلوا النار، وعصمني أن أموت فلا آتي بكم إلى مصر، ليقضي الله من أمره ما شاء، من ظهور أمَّةٍ عظيمة من نسلكم، ينجبون سلالة عظيمة من الأنبياء. فهو سبحانه يُمضي مشيئته بلطفٍ خفيٍّ لا يراه الناس، وكثيراً ما لا يرون أسبابه. وهذا من تمام إطلاق المشيئة، التي لا يُقيّدها قولٌ ولا وعدٌ ولا وعيدٌ. وفي ذلك قال الإمام الصادق عليه السلام: “أوقف حكم عباده تحت مشيئته: إن شاء عذّبهم، وإن شاء عفا عنهم، وإن شاء قرَّبهم، وإن شاء أبعدهم، لتكون المشيئة والقدرة له لا لغيره”.
﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾
فلا جرم يعلم الله ما يكون، فيفعل بالأسباب ما يقتضي أن يكون. وإن شاء عطّل الأسباب، ليمتحن إيمان الناس بالغيب. ويا لله كم من الناس يرسبون في هذا الامتحان، إذ يرون أنّ على الله أن يقدم لهم الإجابات المقنعة، ليستشيروا عقولهم إن كانت ستوافق على ما قال الله أم سترفضه. ثم يقولون إنهم مؤمنون بأنه ﴿هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾! وما هذا بقول المؤمنين:
﴿أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمَ الظَّالِمُونَ* إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (النور/50 ــ 51).
رَبِّ قَدْ آَتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴿101﴾
قد اختتم يوسف ـ صلى الله عليه وسلم ـ الآية السابقة بقوله: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾. فقال هنا: ﴿رَبِّ قَدْ آَتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾، فكان هذا التفاتاً من ضمير الغائب إلى ضمير المُخَاطَبِ. فكان يتكلم عن الله، فصار الآن في حضرته يكلمه، فاستفتح بالثناء تمهيداً للطلب. فحمد مولاه على ما آتاه من المُلْك، وما علّمهُ من تأويل الأحاديث، ثم توجه إليه باسمه الذي فطر به الأشياء كلها، فحمده على ما آتاهُ منها. بما يُذَكّرنا بقول رب العزة في القرآن: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ (النحل/53). ثم قال:
﴿أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ﴾
﴿أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا﴾: تتولاني فيها، فتُمَكِّنُني من بعد ضعف، وتُحرِّرُني من بعد رِقٍّ، وتنجيني من فاحشة أحاطت بي لولاك، وتخرجني من السجن، وتملكني مصر، وتجمعني بأهلي.
وأنت وليي في ﴿الْآَخِرَةِ﴾ تتولاني بحملي إلى أعلى الدرجات في الجنة.
فحمد نبيٌّ ربّه على نعمة النصر في الدنيا، ثم استشفع بالحمد لطلب نعيم الآخرة.
﴿تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾
قال بعض أهل الحقيقة: عَلِمَ أنه ليس بعد الكمال إلا الزوال، فَسأَلَ الوفاة. ذلك أن من علامات الاشتياق تمنِّي الموت على بساط العافية. فيوسف ـ صلى الله عليه وسلم ـ أُلقِيَ في الجُبِّ، فلم يقل: ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِماً﴾. ثم أقام في بيت العزيز فتعرض للفتنة، فلم يقل: ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِماً﴾. ثم حُبِسَ في السجن سنين، فلم يقل: ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِماً﴾. فلما اكتمل له نعيم الدنيا، وانعقد له المُلْكُ، وسجد له الإخوةَ الحاسدون، واعترفوا بفضله، والتقى أبويه ورفعهما معه على العرش، قال في نفسه: الآن اكتمل نعيم العاجلة، وذقت من طعمه، فاحملني إليك يا ربّ فقد اشتقت إليك، ولمن في جوارك من آبائي.
فأحبَّ يوسفُ لقاء الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ”. وأحب ذلك رغم ما يتمتع به من بحبوحة الدنيا. فلا ريب يعلم الأنبياء أن “لَوْ كَانَت الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّه جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْها شَرْبَةَ مَاءٍ”.
فأولياء الله لا تنزل بهم رحمة، إلا هَيَّجت شوقهم إلى الرحمة الكبرى، رحمة الرحمات، حيث النظر إلى وجه الرحمن الرحيم. ويوسف ـ صلى الله عليه وسلم ـ يشعر الآن بأن قد بلغ به مولاه تمام النعيم الدنيوي، فهو يرى يده في كل ما حوله، فيُنسيه ذلك كل هذا العالم، ويستعجل الانتقال منه إلى هناك.
لقد التقى أهله ونال من الدنيا كفايته. وهذا هو الذي فهمه الحبر البحر من الآية إذ قال: “اشتاق إلى لقاء ربه، وأحبَّ أن يلحق به وبآبائه، فدعا الله أن يتوفَّاه ويُلْحِقه بهم. ولم يسأل نبيٌّ قطّ الموتَ غير يوسف”.
وهذا هو الراجح عندي في تأويل هذه الآية، اخترته لما اختاره عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وقد صح الإسناد إليه إن شاء الله.
وقيل: ليس في قوله: ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِماً﴾ طلبٌ للموت، وإنما هو دعاءٌ بالثبات على الإسلام، إلى حين الموت. فكأن قد قال: «اللهم أَدِمْ نعمتك على عبدك، حتى إذا حان أجله، قبضتَهُ على الاسلام، وألحقتَهُ بالصالحين». وقد صاغ السيد الألوسي ـ عليه سلام الله ـ حجّة القائلين بهذا بقوله: “والحاصل أنه ـ عليه السلام ـ إنما طلب الموافاة على الاسلام. لا الوفاة”.
وقد زعم بعض من قال هذا، بأن يوسف ـ صلى الله عليه وسلم ـ عاش بعد هذا الدعاء طويلاً، ولو تمنى الموت لاستجاب له الله، فَلَتَوَفّاهُ إليه في الحال. وليس هذا الاحتجاج قوياً، لسببين: الأول: لعدم ثبوت تاريخ وفاة يوسف. والثاني: أنه لو افترضنا القبول برواية التوراة، من أنه عاش بعد ذلك طويلاً؛ فلا حجّةَ فيه على أنه لم يطلب من ربّه الوفاة: فقد يطلب النبيُّ من ربه طلباً، فيؤخر الله الاستجابة له، لما هو خيرٌ منه. أليس هو الذي يعلم ولا نعلم؟ وفي صحيح البخاري أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ طلب من ربّه أن يلعن أقواماً، فقال له الله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ (أل عمران/128).
وقال بعض أهل الله: “﴿تَوَفَّنِي مُسْلِماً﴾: مفوضاً إليك شأني كلَّه، بحيث لا يكون لي رجوعٌ الى نفسي، ولا إلى سببٍ من الأسباب، بحالٍ من الأحوال. ﴿وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾: بمن أصلحتَهم لحضرتك، وأسقطتَ عنهم سِماتِ الخلقِ، وأزلتَ عنهم رعونات الطبع”.
ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴿102﴾ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴿103﴾ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴿104﴾
ضمير المُخاطَب المقدّر بـ«أنت» في هذا الآي كلِّهِ، يحيل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما المُشار إليهم بضمير الغائبين «هم» في الآية ﴿102﴾ فإخوة يوسف. ثم يتحول ضمير الغائبين في الآيتين ﴿103﴾ و﴿104﴾ فيحيل على كفار قريش، الذين يستمعون لهذا القصص يُتلى عليهم، بلسان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقد نزل طازجاً للتوّ.
وكلُّ خطاب خوطب به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أول مرة ـ ولم يقم دليل على اختصاصه به ـ هو خطابٌ لأُمَّتِه في كل زمان ومكان.
وكلُّ حُجَّةٍ أقامها الإسلامُ على المُكَذِّبين بالتنزيل العزيز أول مرة ـ دون أن يقوم دليل على اختصاصهم به ـ هي حُجَّةٌ على كل من بلغه الخطاب من المُكَذِّبين في كل زمان ومكان.
وكلُّ مسلم هو داعيةٌ إلى دين الله، بهذا القدر أو ذاك. حتى إنه ليمكن أن يُقال بأنّ محتوى الخطاب، الآن في هذا العصر، يحيل إلى الصيغة الآتية:
«هذا القصص هو مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، الذي أوحيناه إلى النبي، ويتوجب على اتباعه أن يتلوه على الأمم، تأكيداً على عموم الرسالة. فرغم أنهم لم يكونوا معاصرين لأحداث القصة، ولا مشاركين فيها، إلا أنّ المقصود هو أن يُقال لكل مكذب بهذا القرآن: هوذا دليلنا على أنه من عند الله، إذ ترى أنّنا إنما نقصُّ عليك عِلْمَ ما لم يعلم أحدٌ، مما حدث قطعاً، فإن كذَّبتَ ومتُّ دون تصديقٍ، فلك النار قطعاً خالداً فيها أبداً، كما كانت لمشركي مكة الذين ماتوا قبل أن يتوبوا».
قلت: وكلُّ هذا يقتضي أنَّ على كل داعيةٍ للإسلام ـ وكلُّ مسلم هو داعيةٌ للإسلام على قدر علمه وطاقته ـ أن يُبَلِّغ هذا للناس، كما بَلَّغه النبيُّ الأُمّيُّ أول مرة، دون أن يتلوث بمصالح الدنيا وشهوات النفس، كما لم يتلوث بها الرسول صلى الله عليه وسلم.
فوالذي بعث محمداً بالحق، إنّ من حق المُبَلَّغين أن يصلهم البلاغُ المبين؛ وإنّ كل بلاغ مَشُوبٍ بالمصالح والأطماع، هو بلاغٌ غير مبين ولا حجة فيه. ولقد خشيتُ أن لو قال اليوم شخصٌ عُرض عليه الإسلام، من قبل دعاة اليوم الملوثين بالدنيا والرغبات: «لم تبلغني دعوة السماء كما نزلت على محمد». لقال حقاً.
ألم تَرَ كيف اعتبر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الإمام الذي يطيل في صلاته فَتَّاناً، يفتن الناس عن دين مُيَسَّرٍ فيُصَعِّبُهُ.
هذا ولا مصالح لدى هذا الإمام الصحابيّ ولا شهوات، ولكن سوء فهم. فليت شعري، أيُّ فتنة ينشرها اليوم أشباهُ الدعاة هؤلاء بين الناس! وماذا سيُقال غداً لدعاةٍ أثرياء في بلاد الغرب، يَتَنَعَّمون من أموال جمعوها باسم الله ـ لله ـ ثم يأكلونها، فيستخزيَ بهم كلُّ متدين حقيقي؟
وأما قصة يوسف في هذا العرض القرآني فقد تَمَّتْ، والتفت الخطاب الآن إلى رسول الله محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال:
﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾
فأشار إلى ما تقدم من قصة يوسف. وامْتنَّ على محمد بنعمة الوحي، وعَرَّضَ بتكذيب قريشٍ، ونْبَّهم إلى صدق الرسول.
والضمير في ﴿لَدَيْهِمْ﴾ عائدٌ إلى إخوة يوسف، وكذلك الضمائر إلى آخر الآية.
فكأن قد قال: «هذا الذي نَقُصُّه عليك ـ من أنباء يوسف وإخوته ـ بعضٌ من أخبار الغيب الذي نوحيه إليك، ولولا وحيُنا لما علمتَه: فما كنتَ عند إخوة يوسف، ولم تَرَهُم حين تشاوروا واتفقوا على اختلاس أخيهم الصغير من أبيه الشيخ. وما كنت عندهم وهم يكذبون عليه بأن الذئب قد أكله. وما كنت لديهم حين عدلوا عن قتل يوسف إلى إلقائه في الجُبّ، ثم ﴿جَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ﴾».
وأما قوله تعالى:
﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾
فتسليةٌ لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بتهوين كُفْرِ الكافرين على قلبه، ولفت نظره إلى الحقيقة القائلة بأن طبيعةَ الخلق كفرانُ الحق، لا يشذُ منهم إلا القلة المؤمنة.
والاعتراض في قوله: ﴿وَلَوْ حَرَصْتَ﴾ جاء لغير حشو الكلام ـ كما هو غالب اعتراضات الخطاب البشري ـ بل أفصح عن شدة حرص الرسول على إيمان قومه، وأكّدَ على ذلك: فكأن حَدَّثت نفسُ رسولِ اللهِ رسولَ الله، أن من الممكن لقومه أن يؤمنوا، إن جاءهم بالدليل على صدقه. فلما قصَّ عليهم القصص، الذي لم يكن لهم أن يعرفوه دون الوحي، فلم يؤمنوا؛ هوّن عليه ربُّه الأمر فقال له:
«إن الإيمان ليس وليد الاقتناع والرغبة ـ وإن بدا ذلك ـ بل هو مشيئتي وما كتبتُ للناس منذ الأزل. فلستُ أَتَحَنَّنُ إيمانهم مثلك، فأنا الله العليُّ الأعلى، لا أنتظر من المخلوقين مِنَّةَ أن يؤمنوا، ﴿بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (الحجرات/17). وإنّ حرصَكَ ـ يا محمد ، على إيمانهم، لن ينفعهم: إذ هم لن يؤمنوا لمجرد أنهم أهلك وترغب في سعادتهم».
قلت: فكأنّ الآية تشير إلى ما جُبل عليه الإنسان، من الجمع بين النقيضين: فهو معجب بعقله فكان ﴿أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً﴾ (الكهف/54). وهو ـ من ناحية أخرى ـ معجب بما ورث عن آبائه. فكأنه كلما لم يجد لعقله مَساغاً، استسلم لما تَلَقَّاه عن الآباء.
﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾
هذا توبيخ لقريش وإقامة للحجة عليها. فكأن قد قال: «ما أسفههم إذ تدعوهم إلى الهدى دون أجر فيُعرِضون».
وفيه إشارة وتصريح:
فالإشارة في قوله: ﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ توحي بأنّ كل أجر على الدعوة يمكنه أن يكون مادة للصدِّ عنها.
والتصريح في قوله: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ نصٌّ على عمومية الرسالة لكل العالم، من الإنس والجن، في كل زمان.
وَكَأَيِّنْ مِنْ آَيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴿105﴾ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴿106﴾ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴿107﴾ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴿108﴾
﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ آَيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾
﴿كَأَيِّنْ﴾: كافِ التشبيه اتصلت بـ«أيٍّ» المُنَوَّنة. وتفيد التكثير، بمعنى: «كم من».
وفي الآية تعجيبٌ من حمق الكافرين، الذين أعماهم العنادُ، واتّباعُ أديان الآباء دون تفكّرٍ، من رؤية ما حولهم من آيات الله المبثوثة في الكون. وفي ذلك قال شيخ المفسرين رحم الله روحه ونوّر ضريحه:
“يقول جَلَّ وعَزَّ: وكم من آية في السموات والأرض لله، وعبرةٍ وحجةٍ ـ وذلك كالشمس والقمر والنجوم ونحو ذلك من آيات السموات، وكالجبال والبحار والنبات والأشجار وغير ذلك من آيات الأرض ـ ﴿يَمُرُّونَ عَلَيْهَا﴾، يقول: يُعاينونها فيمرُّون بها مُعرضين عنها، لا يعتبرون بها، ولا يفكرون فيها وفيما دلَّتْ عليه من توحيد ربِّها؛ وأن الألوهةَ لا تنبغي إلا للواحد القهَّار، الذي خلقها وخلق كلَّ شيء، فدبَّرها”.
﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾
هذه الآية عامة وصعبة، ولا أُراها إلا تسليةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن ربّه ـ سبحانه ـ يقول له: هوّن الأمر عليك يا حبيبي، فمهما دعوتَهم فلن ينجو منهم إلا من كتبنا له النجاة.
وهي آية تصف أحوال من يقولون إنهم يؤمنون بالخالق، في كل زمن ومكان:
1: فبعضهم مؤمنٌ لا ينفعه إيمانه، لما يشوبه من الشرك الجليّ؛ كاليهود والنصارى والعرب الجاهليين، ومتديني هذه الأديان الآسيوية العجيبة:
فاليهود يقولون: ﴿عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾ (التوبة/30)، ويصورون الله في صور البشر.
والنصارى يقولون: ﴿إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ (المائدة/73).
والعرب يعبدون الأصنام ويجعلونها شفعاء لهم من دون الله، ويقولون: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ (الزمر/3).
والأديان الآسيوية وثنية تجعل البشر آلهةً، وبعضها يجعلهم رسلاً بقوة الآلهة، وبعضهم يعبد المخلوقات جهاراً، إلخ.
2: وبعضهم مؤمن يَضُرُّ إيمانَه ما يُلَوِّثه من رياءٍ، يحاول به أن يُعجب الخلق، فيسخطهم الله عليه. أو ما يُطيع به الطغاةَ رغبةً أو رهبةً، فيطمع بما في أيديهم كأنه في أيديهم من دون الله، ويخشاهم على رزقه كما لو كان غير مؤمن بحفظ الله لها، أو يخافهم على حياته كأنهم يملكون أن ينتقصوا من عمره. كلُّ ذلك وغيره مع قوله إنه مؤمنٌ بما أُنزل على محمد.
وهؤلاء هم في الحقيقة مؤمنون بالأسباب، يخافونها ويتقونها ـ ويرون ذلك من الحزم ـ بما يشي بأن علاقتهم بخالق الأسباب مُشَوَّشَةٌ غائمة. وشركُ هؤلاء درجات:
فبعضه من الكبائر، فلا يُخرج من المِلّة، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الشِّركُ في أمَّتي أخفى من دَبيبِ النَّملِ علَى الصَّفا”.
وبعضه يُخشى أن ينزلق بصاحبه إلى الكفر.
وكان السابقون يسمون هذا الصنف من الإيمان «الشرك الخفيّ»، ويميزون بينه وبين الأول فيقولون: «كفر دون كفر». وجُلُّ الأفكار التكفيرية يرجع إلى عدم التفريق بين هذا الصنف من الشرك والذي سبقه.
وكل هذا الذي قلناه من تفسير الآية، منقول بأسانيد مقبولة عن ابن عباس وتلاميذه من التابعين، ومن تلاهم من مفسري الصدر الأول.
ومن الكلام الجامع في الفرق بين هذين الصنفين من الشرك، قول الإمام القشيري رحمه الله: “الشّرْكُ الجَليُّ: أن يتَّخِذَ من دونه ـ سبحانه ـ معبوداً. والشِّرْكُ الخفِيُّ: أن يتخذ بقلبه عند حوائجه من دونه ـ سبحانه ـ مقصوداً”.
﴿أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾
الغاشية هي ما يغشى الناس فيغطيهم من العذاب الحسّي أو المعنوي: فكأنما هجم عليهم العذاب من كل الجهات فغطاهم.
وأغشى الغواشي: أن تنزل بالقلب قسوةٌ تحجبه: فلا يصعد منه دعاء، ولا ينفعه التضرع.
والآية تعقيب مناسب على ما أشرك به المشركون من الصنفين، فكأن قد قال: «أنتم أيها الكافرون، وأنتم أيها المؤمنون إيماناً منقوصاً؛ ما الذي يجعلكم هكذا؟ أخوفاً من غيرنا على الرزق والحياة؟ فهل أمنتم أن نصيبكم بقارعة مفاجئة؟ أم أمنتم أن تقوم الساعة فجأة فلا يتبقى لكم وقت للتوبة»؟
﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾
التفات من ضمير الغائب إلى ضمير المخاطَب، زيادة في التَّسرية عن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبعد أن كان الكلام يشير إلى الكافرين، انتقل إلى الرسول كأنه يقول له:
«انفض يديك منهم، فلا يحزنك كفرهم. والتفت إلى واجبك في التبليغ، بعد أن تقول لهم: هذه طريقي أنا ومن اتبعني، وهذا اختياري واختيارهم، وهذا ما أمرني به ربي وأمرهم: أن نفقه ما ندعو، ونُبَلّغ ما فقهناه مما ندعو، فلا نكون مثلكم مشركين ونحن ننهاكم عن الشرك».
وفي الآية إشارة ودليل: إشارةٌ إلى أنّ من اتبع الرسول هو على بصيرة. ودليلٌ على منع الحمقى من الكلام في الدين، إذ المعلوم أن الأحمق لا بصيرة له، فإن تكلم في الدين أساء إليه.
وأحمقُ الحمقِ أن يتكلم في الدين جاهلٌ فيقول: «اجتهدت».
كأن الاجتهاد برسيم يَطعَمُهُ كلُّ حمار.
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴿109﴾
﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾
ما هو إلا أن نستمع إلى هذه الآية، حتى نستعيد ذكرى أولئك المكذبين ﴿مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ الذين كانوا يطلبون رسلاً من الملائكة، وردَّ عليهم الله في كل موطن بما يُلجمهم. ثم قصمهم فجعلهم ذكرى، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (الأعراف/96).
والخطاب لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على مسمع من المكذبين، تثبيتاً له، وتوبيخاً لهم، فكأن قد قال: «يا محمد، إن رسالتك ماضيةٌ، على سُنَّةِ اللّه في إرسال الرُّسُلِ ﴿رِجَالاً﴾: فلو كانوا نساءً، لتحكّمت فيهم العاطفة، ولو كانوا ملائكةً، لأفزعوا أهل الأرض، ولو ظهروا في صورة البشر، لكذّبهم الناس فقالوا: إنهم بشر، وقد طلبنا ملائكة».
ومفهوم كلمة «الرجال» هو: «الأشخاص»، ومنطوقها هو: «الذكور من البشر من دون الإناث».
وأما قول البعض بأن ليس في ذلك احترازاً من جنس النساء، فليس صحيحاً: إذ المعلوم أن المنطوق مُقَدَّمٌ على المفهوم. ولم يرسل اللهُ رسولاً من النساء، لعلتين: الأولى: فضيلة الرجال المنصوص عليه والمعترف بها، والثانية: عاطفتهن الجياشة التي تسببت في نقص التثبّت لديهنّ قبل الإقدام. ومهما قال أنصار النسوان من خزعبلات، فإنهم لا يستطيعون نفي منطوق قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ (النساء/34).
فقوامة الرجال ـ حسب الآية ـ مصدرها أمران: التفضيل في النوع، والإنفاق من المال. فإذا غاب الإنفاق بقيت فضيلة النوع.
فقوله: ﴿رِجَالاً﴾ يحيل إلى ثلاثة أمور متلازمة: أنهم من البشر، ومن الذكور، وليسوا ملائكة.
وأما قوله: ﴿مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ فقد نظرنا في بداوة نبيِّ الله يعقوب وأبيه إسحق ـ صلى الله عليهما وسلم ـ فعلمنا من ذلك أن ليس المقصود منها الاحتراز عن أهل البوادي، بل لوصف الأمر في غالب ما آل إليه الواقع. فلا ريب أن الرسل أغلبهم من أهل القرى، وإن وُجد منهم القليل من أهل البوادي، كما علمنا ذلك من قول يوسف لأبيه صلى الله عليهما وسلم: ﴿وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ﴾ (يوسف/100).
و﴿الْقُرَى﴾ جمع: قرية، على غير القياس. وهي: الحاضرة المسكونة ذات الأبنية الكثيرة. ولئن قيل اليوم للتجمعات الريفية قرى، فهذا مما انتشر أخيراً على غير الأصل. فالقرى في الآية هي ما يُقال عنه اليوم: المدن الكبرى. وقد نعى كعب بن سعد الغنوي على من نصحوه بالهرب بأخيه من الوباء إلى البادية، فرأى الموت هناك كما هو بالبادية، فقال:
ونبأتماني إنما الموت بالقرى فكيف وهاتي هضبة وكثيب
والمقصود أن الله يرسل الرسل إلى مراكز التجمع الكبرى، ليكون البلاغُ أعمَّ وأشملَ. ومن هنا فلا محلَّ لأن يُقال بأن الله استبعد البادية لجفاء أهلها. بل كان جُلُّ الرسالات في الحواضر ـ لا كلها ـ كما أسلفنا.
وقد رأينا أمير المؤمنين الفاروق ـ رضي الله عنه ـ على فراش الموت، يُوْدِع الصحابة وَصِيَّتَه للخليفة من بعده، وفيها: “وأُوصِيهِ بالأعْرَابِ خَيْراً؛ فإنَّهُمْ أصْلُ العَرَبِ ومَادَّةُ الإسْلَامِ”.
وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: “مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا”؛ فخاصٌّ بالمهاجرين، يوصيهم بألّا يبتعدوا عن دار هجرتهم إلى البادية، كما نهاهم من قبل عن العودة إلى مكة بعد فتحها. دلّنا على ذلك ما رأيناه منه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حجة الوداع، إذ عاد سعد بن أبي وقاص من مرضه، فقال: “اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ. لَكِنْ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ. يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ”.
قلت: وكان سعد بن خولة ـ رضي الله عنه ـ مهاجراً شهد بدراً ومات في حجة الوداع بمكة، فرثى له رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أَنْ مَاتَ خارج المدينة المنورة، وخشي أن يُنتَقَص أجر هجرته.
قال العلّامة ابن عاشور رحمه الله:
“فإن الله لم يرسل رُسُلاً من النساء، لحكمة قبول قيادتهم في نفوس الأقوام؛ إذ المرأةُ مُستضعَفَةٌ عند الرجال، دون العكس. ألا ترى إلى قول قيس بن عاصم حين تنبأت سَجَاحِ:
أضحتْ نَبِيئتُنا أنثى نُطِيف بها وأصبحتْ أنبياءُ الناسِ ذكرانا
وأما قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾
فاستفهامٌ غرضه استنكار فعلهم، وتعجيبٌ للعقلاء من أحوالهم. والخطاب ظاهره للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وحقيقته للكافرين، ينعى عليهم عدم الاتّعاظ بمصارع أهل القرى الذين كذبوا الأنبياء.
وفي الخطاب تلويح من الله لقريش، بإيقاع العقوبة بها، كما أوقعها بأهل القرى.
وقوله تعالى: ﴿وَلَدَارُ الْآَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾
استئناف لمعنى جديد، بالانتقال من الخصوص ـ الذي هو الخطاب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ـ إلى العموم، بذكر قاعدة كلية تقول: إنّ دار الآخرة خيرٌ من كل شيء.
فالواو في ﴿وَلَدَارُ﴾ واو الابتداء. واللام كذلك هي لام الابتداء. والغرض التوكيد. وقد أضيفت «الدار» إلى ﴿الآخرة﴾. مع أن الدار هي الآخرة. كما أضيف «الدِّين» إلى ﴿الْقَيِّمَةِ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ (الَبِّينة/5) مع أن الدين هو القَيِّم. وإنما أُنِّثت ﴿الْقَيِّمَةِ﴾ لأنها جُعلت صفةُ للمِلّة ، كأنه قيل: «وذلك المِلَّةُ القيِّمة».
قال الفراء: وقد تضيف العرب الشيء إلى نفسه إذا اختلف لفظه، كقوله: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ﴾ (الواقعة/95). و«الحق» هو «اليقين». قال الشاعر:
ولو أقْوَتْ عليكَ ديارُ عبسٍ عرفتَ الذُّلَّ عرفانَ اليقينِ
والعرفان هو اليقين.
وقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾: متعلق بقوله: ﴿وَلَدَارُ الْآَخِرَةِ خَيْرٌ﴾، فكأن قد قال: دار الآخرة خيرٌ، لكن ليس ذلك لكل أحد، بل ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾. وهو قصرٌ يستبعد من لم يكن من الذين اتقوا أن تكون لهم الآخرة خيراً.
وقوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾:
استفهام غرضه التعجيب مُوَجَّهٌ إلى غير المتقين. فهو تعجيب من الكافر أنْ كَفَرَ بالآخرة، وتعجيبٌ من مسلم لا يعمل للآخرة بما يكفي.
حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴿110﴾
هُوَذا: لا يتنزّل النصرُ حتى تبلغَ القلوبُ الحناجر، لطول الثبات والصبر، وشدة التكذيب والأذى.
و﴿اسْتَيْأَسَ﴾ على وزن «استفعل»، وقد قلنا من قبل: إن من معاني «استفعل» الصيرورة. فكأن قد قال: «حتى إذا تأخر النصر، وصار الرُّسُل يائسين من ثبات الذين اتبعوهم، وبقائهم على الدين، وتوقعوا أن يكذبوهم بما كانوا صدّقوا به من قبل؛ حتى إذا بلغ الأمر هذه الدرجة من الصعوبة، وأوشك الرُّسُلُ أن يصيروا منفردين دون اتباع، تَنَزَّل النصرُ من عند الله عزيزاً. ذلك أنه لا بد لاستنزال النصر المباشر من الله، أن تُحشَدَ الوسائلُ وتُسْتَنْفَد. فهنا فقط يرى المؤمنون يد الله تمتد إليهم من وراء الأسباب. ولا ريب أنّ هذا البيان الإلهي يشير إلى قصص الرُّسُلَ مع مكذبيهم من أهل القرى، الذين ظلوا يكذبونهم، حتى نزل بهم غضبُ الله، فنصر الرُّسُلَ والقِلَّة من الأتباع، ﴿فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾.
قال صاحب الظلال رحمه الله:
“تلك سُنَّةُ اللّه في الدعوات: لا بُدَّ من الشدائد، ولا بُدَّ من الكروب، حتى لا تبقى بقيّةٌ من جَهْدٍ، ولا بقيَّةٌ من طاقة. ثم يجيء النصرُ، بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة، التي يتعلق بها الناس؛ يجيء النصرُ من عند اللّه، فينجو الذين يستحقون النجاة: ينجون من الهلاك الذي يأخذ المكذبين، وينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم المتجبرون؛ ويَحِلُّ بأسُ اللّه بالمجرمين، مُدَمِّراً ماحقاً لا يقفون له، ولا يصدُّهُ عنهم وليٌّ ولا نصير. ذلك كي لا يكون النصر رخيصاً، فتكون الدعوات هزلاً. فلو كان النصر رخيصاً، لقام في كلِّ يومٍ دَعِيٌّ بدعوةٍ لا تُكَلّفه شيئاً، أو تُكَلّفه القليل. ودعواتُ الحق لا يجوز أن تكون عبثاً ولا لعباً؛ فإنما هي قواعدُ للحياة البشرية، ومناهجُ ينبغي صيانتها وحراستها من الأدعياء. والأدعياء لا يحتملون تكاليف الدعوة، لذلك يُشفقون أن يَدَّعوها. فإذا ادَّعَوها عجزوا عن حملها وطَرَحوها، وتَبَيَّنَ الحقُّ من الباطلِ، على مَحَكِّ الشدائد التي لا يصمد لها إلا الواثقون الصادقون، الذين لا يتخلّون عن دعوة اللّه، ولو ظنّوا أن النصر لا يجيئهم في هذه الحياة. إنَّ الدعوةَ إلى اللّه ليست تجارةً قصيرةَ الأجل: إمّا أن تربح ربحاً مُعَيَّناً مُحَدَّداً في هذه الأرض؛ وإمّا أن يتخلى عنها أصحابُها إلى تجارةٍ أخرى، أقربَ ربحاً وأيسرَ حصيلةً”.
قلت:
وفي هذه الآية قراءتان صحيحتان متواترتان ﴿كُذِبُوا﴾ بالتخفيف و﴿كُذِّبُوا﴾ بالتشديد. وكلاهما بنفس المعنى، وإن أوهمتِ الأولى بما لا يليق بالرُّسُلِ صلى الله عليهم وسلم. وقد كانت أُمُّنا عائشة ـ عليها سلام الله ـ تفضل قراءة التشديد. وبسبب هاتين القراءتين سألها عروة بن الزبير ـ وقد كان ابن أختها أسماء رضي الله عنها ـ إن كان الرُّسُل قد شعروا بأن الوحي قد كَذَبَهُم، فقالت أُمّنا: “مَعَاذَ اللَّهِ: لَمْ تَكُنِ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذَلِكَ بِرَبِّهَا. وَأَمَّا هَذِهِ الْآيَةُ، قَالَتْ: هُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُوهُمْ، وَطَالَ عَلَيْهِمْ الْبَلَاءُ، وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمْ النَّصْرُ، حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَتْ مِمَّنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ، وَظَنُّوا أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ كَذَّبُوهُمْ؛ جَاءَهُمْ نَصْرُ اللَّهِ”.
وقال شيخ المفسرين رحم الله روحه ورفع درجته في عليين:
“حَدَّثني المُثَنَّى، قال: حَدَّثَنا عارم أبو النعمان، قال: حَدَّثَنا حماد بن زيد، قال: حَدَّثَنا شعيب، قال: حَدَّثَني إبراهيم بن أبي حرّة الجزري، قال: سأل فتى من قريش سعيدَ بن جبير، فقال له: يا أبا عبد الله، كيف تقرأ هذا الحرف، فإني إذا أتيتُ عليه تمنَّيت أن لا أقرأ هذه السورة: ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا﴾؟ قال: نعم: حتى إذا استيأس الرُّسُلُ من قومهم أن يصدِّقوهم، وظن المُرْسَلُ إليهم أن الرُّسُلَ كَذَبوا. قال: فقال الضحاك بن مزاحم: ما رأيتُ كاليوم قط رجلاً يُدعى إلى علم فيتلكَّأ! لو رحلت في هذه إلى اليمن كان قليلاً”.
قلت: وهذا إسناد صحيح.
ثم قال رضي الله عنه ورفع قدره:
” حَدَّثني المُثَنَّى، قال: حَدَّثَنا الحجاج، قال: حَدَّثَنا ربيعة بن كلثوم، قال: حَدَّثَني أبي، أن مسلم بن يسار سأل سعيد بن جبير، فقال: يا أبا عبد الله، آيةٌ بلغت مني كل مبلغ: حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا﴾. فهذا الموتُ: أن تظنّ الرُّسُلُ أنهم قد كُذِبوا، أو نظنّ أنهم قد كَذَبوا (مخففة). قال: فقال سعيد بن جبير: يا أبا عبد الرحمن، حتى إذا استيأس الرُّسُلُ من قومهم أن يستجيبوا لهم، وظنَّ قومُهم أن الرُّسُلَ كَذَبَتهم ﴿جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾. قال: فقام مسلم إلى سعيد، فاعتنقه وقال: فرّج الله عنك كما فرّجت عني”.
قلت: وهذا إسناد صحيح مثل السابق. وهذا الذي قاله سعيد بن جبير، إنما تعلمه من شيخه عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ كما أسند عنه ذلك شيخُ المفسرين من طرق عدّة. قال ابن عباس: “لما أَيِسَتِ الرُّسُلُ أن يستجيب لهم قومُهم، وظنَّ قومُهم أن الرُّسُلَ قد كذَبَوهم، جاءهم النصر على ذلك، فننجّي من نشاء”.
لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴿111﴾
﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾
﴿عِبْرَةٌ﴾: آية وعظة. و﴿فِي قَصَصِهِمْ﴾: شبه جملة في محل نصب خبر ﴿كَانَ﴾ المقدم. و﴿عِبْرَةٌ﴾: اسمها المؤخر. وقُلِبَ تكوين الجملة لغرض القصر، فكأن قد قال: «لم يكن في قصصهم عبرة إلا لأولي الألباب لا لغيرهم».
وهذه الآية تَتَنَزّل من السورة منزلة ما استنبطه أهل البديع من البلاغة القرآنية وسمّوه فيما بعد: «التصدير»، أو: «رَدّ العجز على الصدر»: لما تحمل من إشارات إلى ما قال في أَوَّلِ السورة: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾. فكأن قد قال في نهاية السورة: «ها أنت الآن ترى أنها أحسن القَصَصَ، بصدق ما فيها، وحُسْن أسلوبه، وجمال عاقبته»
وظاهر الآية يشهد لما ذهبنا إليه من قبل، من أن التفضيل في قوله تعالى: ﴿أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ هو تفضيلٌ على كل جنسِ قَصَصٍ في غير القرآن، وليس تفضيلَ قَصَصِ سورة يوسف على باقي القَصَصَ في السور الأخرى؛ وذلك لعموم ما دلّ عليه قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ إذ نراه تعليلاً لقوله الأول: ﴿أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ المُعَلَّل حُسْنُه في نفس الآية بعده مباشرة بقوله: ﴿بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآَنَ﴾ (يوسف/3).
وأولو ﴿الْأَلْبَابِ﴾: هم أصحاب العقول المهتدية، وإلا فالعقول التي لم يُكتَب لها الهدى، ليست ألباباً، بل عَمىً لا يرى، وصَمَماً لا يسمع، وحُمْقاً لا يفقه.
فإن أعياك أن ترى هذا، فتذكّر أنّ الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كَنَّوا أبا الحَكَم عمرو بن هشام المخزومي بـ«أبي جهل»؛ فكانت كُنيةً مطابقةً لوصفه ومعناه. ولو لم يسمعوها من رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ لما نطقوها: ففي صحيح مسلم “عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قالَ أَبُو جَهْلٍ: هلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بيْنَ أَظْهُرِكُمْ”؟
﴿مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ﴾
﴿مَا كَانَ﴾ صيغة منع تنفي حدوث ما بعدها. والمُشار إليه هو القرآن. واسم ﴿كَانَ﴾ ضمير مستتر تقديره «هو» يُحيل إلى القرآن؛ فتنفي عنه الآية أن يكون كلامَ كذبٍ مُختَلَقاً.
وقال بعضهم بأن المُشار إليه هو حديث قصة يوسف. وهو كلام يَرُدّه ما بعده من قوله: ﴿وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ﴾.
فإن قيل بأنّ قصة يوسف، في القرآن، تصديقٌ لما جاء منها في التوراة التي نزلت ـ لا التوراة التي بين أيدينا اليوم ـ فصحيح؛ لكنها ليست تفصيل كل شيء، فهذا يُقال للكتاب العزيز كله، لا لسورة واحدة منه.
وقوله: ﴿وَلَكِنْ﴾ نفيٌ لما مضى وإثباتٌ لما يأتي؛ بمعنى: «بل». تتلوها «كان» الناسخة المضمرة التي اسمها ضمير مستتر تقديره «هو» يعود على القرآن، وخبرها ﴿تَصْدِيقَ﴾.
فكأن قد قال: «كلا، لم يكن هذا القرآن حديثاً يُفْتَرَى، فيأتي به مخلوق ـ أو كل المخلوقين ـ بل هو من عند الله، تَصْدِيقاً لكل ما سبقه من كتبه المنزلة ـ قبل أن يُحَرِّفها الأحبار والقسس ـ وَتَفْصِيلاً لما على البشر أن يعتقدوه ويفعلوه، لينالوا السعادتين».
﴿وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾
﴿هُدًى وَرَحْمَةً﴾: مجازٌ مُرسَلٌ علاقته سببية؛ إذ القرآن سببٌ للهدى ونزول الرحمة. ولكنّ ذلك ليس إلا للمؤمنين، لأنهم هم الذين يفرغون قلوبهم من كل هوى وهم يقرأونه.
وأما قوله تعالى: ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ فاحتراز من تعميم الهدى والرحمة لغير المؤمنين: فالمؤمنون فقط هم الذين تنفتح قلوبهم لأنواره، فتنزل عليهم رحمة الله، مصداقاً لقوله تعالى في موطن آخر من التنزيل العزيز: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَاراً﴾ (الإسراء/82). وإلى ذلك أشار بعض الصالحين فقالوا: رُبّ قارئٍ للقرآنِ والقرآن يلعنه.
وكم من مرة ـ والله ـ رأيت تلاوةَ القرآن تعذّب شياطين الإنس والجن؛ فمن الإنس من يطوون قلوبهم على بغضه، وفضحهم الله إذ قال: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ (الزمر/45) ومن الجنِّ من تحرقه قراءةُ القرآن، فلا يجد أولياؤه من الإنس تفسيراً لذلك غير التكذيب.
تمت تأملات العبد الفقير إلى الله في سورة يوسف. فاللهم اجعل هذا مقبولاً وضعه في ميزان أبويّ، وانفع به، وأجرني من النار.
لا إله إلا أنت.