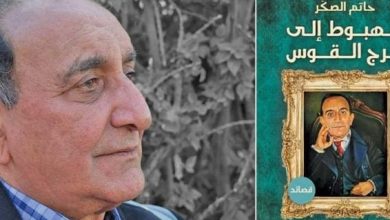بقلم: السماح عبدالله الأنور
كيف يرى “فتحي عبد الله” الشعر؟

سؤال يبدو شديد الحيرة، بالنسبة لي على الأقل، وقد حاولت كثيرا أن أضع اقتراحات للإجابة، هذه الاقتراحات التي كانت تصدق أحيانا، ولا تصدق غالبا، هو نفسه ظل متأرجحا ما بين رؤاه النظرية وبين تطبيقاتها في كثير من قصائده المتباينة، حتى أننا نستطيع أن نقول إن ثمة أكثر من “فتحي عبد الله”.
هو شاعر مولع بالتجريب، ومغرم بالمغامرة، ما إن تطأ قدماه أرضا شعرية حتى يغادرها باحثا عن سواها، منذ بداياته الأولى والارتباكة اليقينية هي أبرز ملمح فني له، وقد اتسعت رقعة ارتباكته الفنية تلك في قصائده التفعيلية التي كان يقرأها علينا وهو طالب في كلية دار العلوم، لم يكن اليقين النثري قد أعلن عن وجوده بهذا الشكل المكثف، ويبدو أنه كان بالفعل في انتظار هذه النثرية التي كانت بالنسبة له الملاذ الآمن، وقد أنقذته هذه النثرية من ارتباكته الكبيرة، فاعتنقها عقيدة راسخة، حتى أنه كان يراها الافتراض الأكثر إقناعا للخروج من أزمة القصيدة، أما لماذا أنقذته النثرية، فلأنه برغم دراسته للقواعد اللغوية والنحوية والعروضية في دار العلوم، وبرغم قراءاته الشعرية العديدة، لم يستطع أن يقبض على اليقين المكتمل للشكلانية التي تتطلبها القصيدة الملتزمة، دائما ثمة اهتزازات شكلانية في تفعيليته، وكأنه كان على موعد مؤجل مع البراح المطلق والفضاء الكبير.
هو من بين جيل الثمانينيات الشعري، الوحيد الذي انطلق من مفهوم سياسي، حتى أنه انخرط تنظيميا في التكتلات السياسية البحتة، الأمر الذي جعله يُعتقلُ لمدة تقترب من الثلاثة أشهر في الثمانينيات المتقدمة من القرن العشرين، ما جعل رؤاه الشعرية رهينة بمعتقده السياسي، حيث للإبداع دور عضوي، وحيث لا بد من ارتكازة تنظيرية للسطر الشعري، ويمكننا أن نلحظ الرؤى الفكرية التي تستند عليها تجربته الشعرية في دواوينه غير الكثيرة التي تركها لنا، فهو يحتفي بالزراعي في ديوانه الأول (راعي المياه)، عندما كان مؤمنا إيمانا راسخا بأن المصري فلاح، والمصرية هي الزراعة، وكان يغبط “محمد عفيفي مطر” كثيرا، وهو يراه في القيلولة حاملا فأسه ومتجها للحقل، والقيلولة هي تلك المساحة الزمنية التي يرتاح فيها الفلاحون تحت ظلال الشجرات، هو ابن قريته رملة الأنجب، وكان يشترك مع أبناء القرية في إطلاق لقب الشيطان على “عفيفي مطر”، الذي لا يهتم بضربة الشمس على قفاه، غير أن “عفيفي” ملتزم، وقصيدته ملتزمة، بينما “فتحي” يشبه رفاقه الذين يستريحون في القيلولة تحت الشجرات، وشعره في هذه الفترة كان رصدا غائما لفكرة الفلاح الأسطوري المحمل بتجاربه الخرافية، وكأنه بهلوان يعبر الأزمنة بلا منطق شعري تنهض عليه الفكرة المرتجاة، وأنت تجتهد كثيرا لكي تعرف المغزى الفني الذي يرومه الشاعر حين يقول:
لا مانع من سقف دون الجدران
الحرب حالة نوم
في السوق حائط يمشي
رجل في سلة خبز
بقرات بالقرب من السماء
دخل حديقة الأوبرا وسرواله فوق ظهره.
أما فكرة الموت، فقد رجته رجا، خاصة بعد موت أبيه، فمثل الموت تيمة شديدة الحضور، ليس فقط في ديوانه (الرسائل عادة لا تتذكر الموتى)، بل في امتداد تجربته كلها، ومع الموت استطعنا أن نلمح هذه الرنة الصافية في شعره، واستطعنا أن نعرف أن الموت حياة، وأن الموتى يشاركوننا في فعل حيواتنا، بل استطعنا أن نعرف أننا موتى:
الرسائل عادة لا تذكر الموتى
لكنهم يظهرون في أوقات متأخرة من الليل
كأن يغلق أبي خزانة الطعام
ويطمئن على نوم أمي.
في ديوانه الأخير، (يملأ فمي بالكرز)، كان الشاعر قد وصل ليقين آخر، أو لفكرة جديدة، فالفلاح خلع جلبابه، وارتدى البنطلون الجينز والتي شيرت، واستبدل بالفأس عصا ذات مقبض أبنوسي، وترك الحقول صاعدا للجبال، وكأنه يعود لخلاصه النهائي، الصحراء والجبال ومراقبة النجوم:
في الصحراءِ لم يجدوا لها قماطا ولا ثلوجا
وضحكوا من لُهاثها المقطوع
وقالوا: تنام على خشخشةٍ من الصوف
وترى قمرًا له وجوه كثيرة
أحيانًا يأخذها إلى أشجار تحتها وعول
ويتركُها وحيدة
وأحيانًا يحملها إلى عاصفةٍ دون صندوق
فلا تستطيع الإشارة
ولا تعرف من يقبض على رأسها في الليل
فقط عواءات بعيدة
وإنذاراتٌ من هنا أو هناك
ويأتي الملاكُ على رأس من ذهبوا إلى حقول الموز.
لماذا يبدو”فتحي عبد الله” عنيفا، بل عنيفا جدا؟.
لأنه يخاف من العنف.
وجدانه ممتليء بالرعب من سيطرة الحروب الحداثية على العالم الفقير، ولديه تصور خرافي بأن الاستعمار الغربي سيرتدي عما قليل أزياءنا الفقيرة، ويدخل علينا بيوتنا، ليقطعنا أشلاء في حجرات الجلوس، وكان يحتمي بعزلته من هذا الغزو المنتظر، وقد شاعت في قصائده بدون مبرر فني، هذه اللغة العنيفة، فالعاشق يستدرج حبيبته للسرير، لا ليفعل فعل العشاق، ولكن ليستخرج مدية حادة يقطع بها أثداءها، ويعلقها في حيطان الغرفة، والراقص بعد أن يؤدي رقصته على المسرح، يخرج من الجمهور من يجتز رقبته، ويحملها تحت إبطه، ويخرج وسط تصفيق المتفرجين.
قصيدته فوضوية مثله، ليست مرتبة، ولا يفضي سطرها العلوي لسطرها السفلي، وكأن كل جملة شعرية قصيدة وحدها، أو كأن كل شعره قصيدة واحدة ذات حالات متعددة، هو نفسه كان فوضويا بدرجة ما، ووجوديا بدرجة ما، وعدميا بدرجة ما، حتى أن سؤال كينونته الفلسفية، يبدو واحدا من الأسئلة المستحيلة، كما أن سؤال كينونته الدينية يبدو هو الآخر سؤالا مستحيلا، فهو الترتسكي الذي يصوم رمضان، ويقرأ القرآن، وينجذب للحضرة الصوفية، ويكلمنا عن مظلومية الإخوان.
ترى ما الذي منحه الشعر لـ “فتحي عبد الله”؟.
المحبة كاملة، محبته للناس كلهم، حتى وهو يهجوهم في قعدات المقاهي، وعلى صفحات الفيس بوك، ومحبة الناس كلهم له، حتى وهم يمارسون معه لعبة الإقصاء، لكن، تظل له على الدوام، حجرة خاصة في القلب.