عصفور.. تحديات الناقد والمجتمع المعاصر (١)

د. أيمن حماد | القاهرة
على الرغم من اختصاصه في دراسة الأدب ونقده، فإن المفكر الكبير د. جابر عصفور- يرحمه الله – يتعدى كونه ناقدًا أدبيًا إلى مفكر راسخ القدم في ميدان العلوم الإنسانية عامة، في تقديرنا.
وأتصور أن هذا الأمر كان مقصودًا من جانبه، من بداية أيام الطلب إلى الآن، بعدما أنتج أعمالًا نقدية وفكرية تبرهن على ذلك.
وإذا قرأت كتابه القيم “نظريات معاصرة” ستجد أن “عصفور” بثقافته الموسوعية المعهودة، لم يقصر كتابه هذا على النقد الأدبي فحسب، بل يمتد ذلك ليشمل فنونًا غير أدبية، كالرسم والموسيقى والفن التشكيلي، وقد تجلى ذلك بداية من عنوان الكتاب فلم ينعته بـ “نظريات أدبية معاصرة”، أو “نظريات نقدية معاصرة”، بل جعله “نظريات معاصرة”، ليكون الحديث عن الإبداع أدبًا كان، أو رسمًا، أو موسيقيًا، أو فنًا تشكيليًا، بحيث يشمل الفنون الإبداعية الزمانية والمكانية، على السواء، وذلك لإدراكه ووعيه بأهمية تداخل هذه الفنون مع بعضها بعضاً، وهو ما يطلق عليه في الدراسات الإنسانية والنقدية الحديثة مصطلح “الدراسات البينية”.

وآية ذلك ما نجده في حديثه عن نظرية التعبير وفلسفتها وأبرز أعلامها، مستندًا في ذلك إلى مقولاتهم في هذا الشأن، كمقولات الشاعر والناقد ت. س.إليوت، والناقد إيفور أمسترونج ريتشاردز، وفيلسوف الجمال بنديتو كروتشه، وكذلك الفيلسوف جون ديوي مؤلف كتاب “الفن خبرة”.
يعرض عصفور عرضًا شيقًا آراء ووجهات نظر هؤلاء النقاد والفلاسفة والمبدعين، ويناقشها مبينًا من خلالها سمات وخصائص وآليات عمل نظرية التعبير، التي جاءت رد فعل على “نظرية الانعكاس” التي ترى الفن انعكاسًا استاتيكيًا للواقع الخارجي، كما يعرض أيضًا رد الفعل على نظرية التعبير، تحت عنوان “نقض نظرية التعبير” من جانب نقاد النظريات الاجتماعية، الذين ركزوا على الدلالة الاجتماعية التي ينطوي عليها العمل الأدبي، من حيث هو محاولة لفهم الواقع وتغييره.
وهنا نجد عرضًا فلسفيًا ونقديًا متنوعًا تشتبك فيه آراء ووجهات النظر المختلفة لأنصار ومعارضي هذه النظرية، والتي يتولد عنها نظرية، بل نظريات أخرى كالبنيوية والبنيوية التوليدية وغيرها، ما يعد دلالة على أهمية الالتفات إلى دراسة فلسفة العلم (فلسفة نظريات العلم) حتى نستطيع الدخول الى تحليل النص عبر مداخل متعددة تكشف عن دلالات أعمق، تلك النوعية من الدراسات الغائبة الآن عن تخصصات الآداب والفنون في أغلب جامعاتنا ومعاهدنا، وهو أمر أساسي وفي مقدمة اهتمامات جامعات أوروبا، حيث تأتي دراسة فلسفة العلم الذي سيتخصص فيه الطالب/ الباحث، قبل الممارسة العملية التطبيقية.
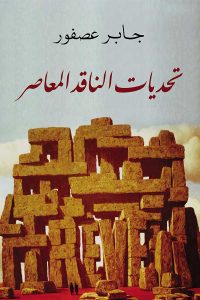
وليس ثمة شك في أن دراسة الآليات والأدوات والأسس التي ينبني عليها العلم ونظرياته وتطورها وأعلامها ومدى الإضافة التي تمت إليها على مدار العصور، لهو أمر في غاية الأهمية لبناء ناقد وباحث علمي أصيل، بل مثقف موسوعي يشكل لبنة في بناء صرح العلم، لأنه من المعلوم أن العلوم – وخاصة العلوم الإنسانية، والنقد الأدبي تحديدًا – لم تنم بين يوم وليله، بل شهدت إضافات وتطورات وابتكار آليات وأدوات وتقنيات جديدة، منذ البداية وحتى مراحل نضجها، ولا يخفى على باحث مدقق أن كل نظرية، أو أي إضافة جديدة لميدان علم، لا تلغي ما سبقها، بل تبني عليها وتستقي تطورها من منجز ما قبلها.
إن الحقيقة الموكدة – كما يقول عصفور- هي أن النظرية الأدبية أو النقدية، في سعيها لأن تكون علمًا من العلوم الإنسانية، تظل في حالة “تماس” على الأقل مع كل علم من العلوم الإنسانية، التي تشمل التاريخ وعلم الاجتماع والسياسة وعلم النفس واللغة، ومن ثم السيميوطيقا (علم الإشارات)، وأخيرًا علوم الاتصال. وكل علم من هذه العلوم يتطور على نحو متصاعد، وكل تطور يؤدي إلى تصاعد إيقاع ما يؤدي إليه، أو يترتب عليه من تقدم متواصل، وذلك في متتالية متزايدة التسارع والتولد الذي يضيف أنواعًا جديدة من العلم، خصوصًا في مناطق التماس البينية التي أصبحت هي نفسها مجالًا علميًا جديدًا، لا نهاية لإنجازاته المتجددة في مدى ما أصبح يسمى العلوم البينية” (جابر عصفور: تحديات الناقد المعاصر، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط١، ٢٠١٤، ص ٣٣، ٣٤)
ومن أسف أن ذلك لم يتوقف عند غياب الإلمام بفلسفة العلم في أغلب جامعاتنا، ولدى باحثينا، بل إن الأدهى والأمرّ هو عدم تمكن هؤلاء الباحثين من كتابة الاملاء صحيحة، وحتى يتبين لك مدى التخلف العلمي (وأعمم فأطلق عليه التخلف الحضاري ) أنه بدلًا عن أن نبحث عن دراسة فلسفة العلم ونعيدها بمنهجية فائقة لمعاهدنا وكلياتنا، نهدر وقتنا في تعليم باحث يريد التدريس لأبنائنا في الجامعة، أقول: نهدر وقتنا في تعليمه مبادئ وقواعد الإملاء والنحو، فهل هذا الباحث بهذا التدني العلمي يستحق أن يلتقي طلابًا ويدرس لهم، هل تريدون لمتخلف، علميًا وحضاريًا، أن يلقي بحمم جهله في أدمغة أبنائنا الذين ننفق عليهم الغالي والنفيس؟
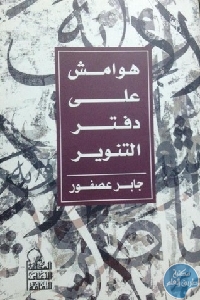
ولا ريب أن غياب مثل هذه الفلسفة قد أدى إلى غياب إعمال العقل، وشيوع نمط الحفظ والتلقين، ما أدى بالتبعية إلى الجمود العقلي الذي يعد بمثابة التربة الخصبة لنمو الفكر الظلامي الإرهابي، الذي ساد في مجتمعاتنا العربية وسيطر على الشرائح محدودة الثقافة والوعي، نتيجة التخلف الحضاري والعلمي وإهمال مقومات بناء الإنسان السوي، ولذلك كان الخطوة الثانية، التي اشتغل عليها عصفور، بذكاء وتؤدة ولماحية، وهي توسيع اهتمامه بالجوانب التنويري، مدركًا أن هذا هو الدور الأهم والرائد للمثقف العضوي في المجتمع، فكان مشروعه الذي تبلور في دراساته وأبحاثه ومقالاته المتعددة عن التنوير.
ويكفي المرء أن يقرأ كتاب “هوامش على دفتر التنوير”لـ«عصفور»، الذي شخص فيه علل وأمراض هذه الأمة، ووقوعها في حبائل التيارات الراديكالية، المتدثرة بعباءة الإسلام السياسي، ذي النزعة الماضوية المشدودة بحبال الفكر المتجمد المناهض للاجتهاد والتأمل وإعمال الفكر، عبر مناهج وأدوات عصرية تلائم المستقبل وما مرت به المجتمعات الحديثة من تحولات على الصعد كافة. أقول: تكفي المرء هذه القراءة، حتى يقف على مدى التخلف الحضاري الذي أصاب هذه الأمة، ولا يزل يصيبها، جراء تعطيل العقل لحساب النقل، وعبادة التراث واعتباره إلها “لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه”.
على أن أهم ما يثيره عصفور، هو تلك الردة الفكرية التي أصابت عقول الأمة، بعدما شهدت حقبة ميراث تنويري عظيم امتد أفقيًا ورأسيًا، في مصر والعالم العربي. إن هذا “الميراث التنويري العظيم الذي افتتحت به مطالع النهضة حلم التقدم العربي، وتضافر في صنعه أفندية الاستنارة ومشايخها، في تتابع بدأ بشيخ الاستنارة الذي راد الطريق لتلامذة الافندية الذين سرعان ما حملوا العبء وأسهموا معه في تحقيق الحلم، وذلك بالمعنى الذي راد به الشيخ رفاعة الطهطاوي الطريق أمام علي مبارك الذي تبعه بإحسان في طريق التقدم، وامتد بالاستنارة إلى كل أنحاء الوطن، بواسطة تنظيم التعليم الحديث وانتشاره هذا الميراث الذي أصله المشايخ والأفندية، المسلمون والمسيحيون، المصريون والشوام والمغاربة، يبدو كما لو حكم عليه بالإعدام، يطارد في المكتبات، يلقى عمدًا في زوايا النسيان، تغتاله يد النقل التي تحاول أن تمحوه من ذاكرة الأمة، وتستبعده ومن دور النشر، وتستبدل به الميراث المناقض الذي يؤكد، ويصوغ، عقلية النقل والتقليد، ونزعة التصديق والاتباع، وتُفرض على الجميع آلية اتباعية لا تفارق تصور المستقبل بصورة الماضي”.(جابر عصفور: هوامش على دفتر التنوير، دار سعاد الصباح، ط١، ١٩٩٤، ص١١(
ولقد ترتب على هذا سيطرة البنية العقلية التسلطية على المجتمعات العربية، سواء من جانب هذه التيارات، أو من جانب السلطات الحاكمة، نتيجة هذا القمع النقلي الذي يعوق التفاعل مع تيارات الحاضر الواعدة في تغيير صورة المستقبل، كما يشير عصفور، والتي أدت إلى هامشية التيار العقلاني، إضافة إلى القمع النقلي. وأدى هذا أيضاً إلى الارتباط بالتراث والانشداد إليه كأصل ثابت متجمد، في صورة إله معبود من لدن تلك الجماعات.
وهذا ما دفع عصفور للتساؤل عن هذا الأصل الثابت، موضحًا “إنه الوضع الاجتماعي الاقتصادي الذي يبرر نفسه، إيديولوجيا، بإشاعة منطق الاتباع، ويؤكد حضوره دينيا، بتقديس مبادئ التقليد، وينفي كل مخالف له، سياسيًا واجتماعيًا، إلى دائرة الضلال التي تفضي إلى النار دينيا. ولعل هذا الوضع يتكشف من زاوية دالة بواسطة تأمل علاقة العداء التي تضع الحداثة وإسلام النفط، على سبيل المثال، موضع النقيضين، والتي تجعل من الحداثة ضلالة سياسية وفكرية ودينية في آن”(السابق: ص١٢)
من ثم كان تأكيده على أهم التحديات التي تواجه الناقد الأدبي في عالمنا العربي عامة ومصر خاصة، من حيث هو فاعل اجتماعي يواجه تحدي الإرهاب الديني في حياته؛ “ولذلك يكتسب وضع هذا الناقد دلالة مائزة، خصوصًا إذا كان ناقدًا مصريًا لم يشهد محاولات تديين الدولة في زمن الإخوان الذي مضى إلى غير رجعة فحسب، بل شهد ما حدث من قبل في مسار متصاعد من تصاعد تيارات دينية منغلقة تعمل، ولا تزال، على هدم حلم الدولة المدنية الحديثة بكل تجلياتها، كي تستبدل بها نموذجًا يماثل النموذج الأفغاني في زمن القاعدة التي لا يزال خطرها قائمًا.. وهو ما يفرض على الناقد الأدبي، في مصر على الأقل، أن يضع الإرهاب الديني في الطليعة من التحديات التي يواجهها بوصفه فاعلًا اجتماعيًا، ينطوي على قيم الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية” (تحديات الناقد المعاصر، ص ١١)
وفي تقديرنا، أن ما طرحه عصفور، في هذا الصدد، والذي يلتقي فيه مع كثير من المفكرين وعلماء الاجتماع السياسي، كان جرس إنذار لبلد كمصر، وغيرها من البلاد العربية، في فترة مبكرة نسبيًا، قبل حدوث موجات الربيع العربي الأخيرة، لكن من أسف، لم تؤخذ هذه الأفكار والطروحات مأخذ الجد والتطبيق العملي على أرض الواقع، فوقع ما وقع، لأن “آفة حارتنا النسيان”، الذي أراه متعمدًا، في أحيان كثيرة.





