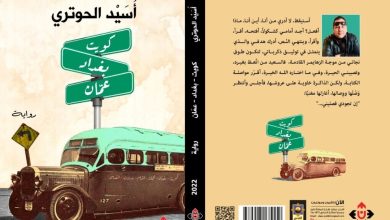قراءة في ديوان “لك.. كل هذا البوح” للشاعر مصطفى أنيس الحسون
بقلم: فرحان الخطيب|شاعر وناقد سوريّ
ما يرشح من عنوان هذه المجموعة غير ما تشي به القراءة الأولى، وذلك يقع في دائرة المرواغة اللفظية والمخاتلة الشّعرية، إذ عنون الشاعر مصطفى الحسون ديوانه ب ” لكِ كل هذا البوح ” الصادر حديثاً في دمشق، ولا أعلم كم هي نسبة القصدية في هذا الاختيار، والاختباء وراء هذا العنوان الذي يوحي بأنّ كلّه غزل وبوح شفيف ورقيق لها، ولها فقط، أتت به شاعرية متقدة شوقاً وهياماً، وحبّاً وغراما، والذي يوحي بأنّ الشاعر في حدائق هناء وصفاء لا يمسسها شحوب أو غبش أو ذبول من أية جهة كانت، وما عليه إلّا أن يستحمّ بضوء القمر، ويسلك طريق النجوم ليعبر إلى مفازات الغزل الرقيق، إلى هودج من يهوى المحمول على مفردات شاهقة ومخضلّة بعطر وعنبر المعاني المحتشدة باللذاذات الغاوية لذات الشاعر التي تطلق من نافورة الوجد والهوى، هذا البوح الجوّانيالمضمّخ والمخضّب بطيوب الكلام الذي يتعمشق على جدران القلب، كالورد الصاعد على شبابيك بيوتاتنا في ضيعة تتربع على تلّة من السحر والجمال .
والشاعر الحسون وبدُرْبة ومكْنة عالية عرف كيف يلوي عنق لغته بعنوانه عبر كلمتين “لكِ و بوح”، وكيف يعطف السراب على الماء، والوجع على الفرح، فشبك لحمته بسداه، وزركش سجادة الكلام بلوحات شاعرية داهشة، وهمّهُ بذلك يكمن في أن يفقد المتلقي البوصلة الدالة على مقاصده ومبتغاه.

والقارىء المتمكّن من سبر أغوار جملة مصطفى بمعانيها المتوخاة، ما أن يسير متفحّصاً بعض القصائد، حتى يجد وقد أمسك الشاعرُ المتلقي من يد قراءته إلى كنه المعنى الذي يريد، وتنزاح غلالة الديوان، ويعلنها الشاعر جهراً بأنّ مخاتلة قصدها في بوحه لها، يقول :
” أمشي على ظلّي المخاتل ..
أستريح من التفاصيل التي في الضّوء..
توضحها تلاوين الحقيقة في طريق الخصب..
والخصبُ يبابْ ..
في الظلّ تختبىء الحكاياتُ فواعجبي ..
لماءٍ يقتفي أثر السّرابْ..” ص ٦٩.
شاعرٌ خبر شعاب اللغة، وجاس أعطافها، واستنطق جلّ معانيها من على أغصان أكنافها، فجرّب التّخفي خلف ظلال وأفياء الكلمات، فخانته عاطفته الصّادقة التي عبّرت بوضوحِ عن أناه، ولا أعرف أن أنا الشاعر تتفرد بشعور محايد، بل حمّالة للأنا الجمعية التي ينتمي إليها الشاعر، وليس من الممكن أنْ يخلعَمفردهُاللبوس الجمعيوما شاء الشعر ذلك، فإذا ذاته يحيط بها الوجع والهم والسواد، يقول :
” وأنا الذي ما زلتُ أزرعُ بيدرَ الحبّ رحيقاً ..
لا أبالي بالغرابيب وأبني عالماً من دفء أشواقي ..
ليحيا في ربيع اللون ..
يغزل من جدائل شمسه قصص المحبّة والسلام..” ص٤٤.
فالشاعر مهما أحاطت به الغرابيب البشعة، الكالحة السواد، وهي كل شيء جهم وعدو للحياة، سيبقى ولو بالكلمة يغزل قصص المحبة والسلام من جدائل الشمس، من الضوء الطارد لكل عتمة، من التنوير الطارد بل الفاتحلكل مستغلقٍ في هذا الوجود .
الشاعر الحسون وببراعة مخاتلة، يبوح لها، ولها وحدها يوجه مطلع قصائده، الموشّاةبفرادة الأزهار المائجة بألوانها الجميلة، وبألحان الطيور السابحة في الفضاء الطلق، ويخاطب محبوبته بأعالي درجات الهمس والإيحاء، راجياً أن تعيده إلى مطارح البهجة والإغواء، ويسترسل في هذا الرّجاء إلى أن يجفّله هادم اللذات كما في الأساطير القديمة، كل هذا الفرح كان متاحاً لولا وجود اللا أمان، يقول :
” لكِ أنْ تعيديني إلى درجِ البنفسجِ ..
كي أعنون باسمكِ الورديّ دربَ البيلسانْ ..
لك أن تعيديني إلى عهدِ الغوايةِ ..
أرتجي ظلّاً يُهدهدُ لليمامْ ..
لكي يحطَّ على شراييني يسائلُ عن بلادٍ من أمانْ ..”
إنّه يسائل عن بلادٍ من أمان، وهل يستوي الحب والخراب والدمار، وهل يخفق قلب للحبيبة في ظل الوجع والحراب المستلة على صدورنا، يأخذنا الشاعر الحسون إلى قصائد نزار قباني التي يتقاطع معها في هذا المعنى، يقول نزار :
” من قبل أن أكتب عن عينيك يا حبيبتي..
لا بدّ أن أستأذن الوطن ..”
فالوطن هو الدفء والعاطفة والحب والحنان والأمان، وإذا تخلخلت أركانه، وتصدعت أركانه، فليس للحب موضع أو مكان، والوطن البلادُ عند كلا الشاعرين هو المظلة التي يجلس تحت أفيائها عاشقان، وهما يريان أن الجلوس غير ممكن الآن.
وأما شاعرنا الحسون فإنه يوغل بعيداً في بيداء تراثنا الشعري، ويستحضر أقوى صرخة عرفها ” الجاهليون” أطلقها الصعاليك، وتمثّل الشاعر هنا بلامية الشنفرىالنّضاحة لمشاعر الجوعى، والفضّاحة لجهة الظلم والحيف الذي يخيم على المجتمع آنذاك في مجاهيل الصحراء، بين خيام العرب، يقول :
” يا بنتَ سواقي الدّمع هلمّي ..
صبّي فوق الرأس مياه صقيعك ..
كي يوقظ صمتك أو صوتك أو سوطك حلمي ..
كي أتصعلك ، فأهيمُ على وجهي ..
وتغنّي الصّحراء لحزني ” لامية الفقراء ” .. “
فالحسون يريد أن يتصعلك، ويطوّف في البلاد، يبحث عن صبح جديد، ولون جديد، عن عدالة بين الناس، وهذا دأب صاحب لا مية العرب قبله الشنفرى حين قال:
” أقيموا بني أمّي صدور مطيّكم..
فإنّي إلى قومٍ سواكم لأميلُ..
وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى..
وفيهالمنْ خاف القلى مُتعزّل.. “
فكلا الشاعرين يبحثان عن أمن وأمان، ويهربان من واقع مرير، لايريان ذاتهما الإنسانية مصانة ومكرمة كما يشتهيان ..
ويرجع شاعراً خالي الوفاض من رحلته في مفازات الصحراء، يعود بخفي شطرين من الشعر للشنفرى، ليحطّ رحاله بعد ألف عام ونصفها في رحاب شاعر أخر، علّ الوضع قد تغيّر، وحال العرب قد تبدّل، وعاد الشاعر العربي من غربة ذاته إلى ذاته، ومن غربة روحه إلى روحه، ولا أدري إذ كانت قد أخذته الصدمة، أو هزّ كيانه هول المفاجأة، فمازال السّيّاب يجترّ شعر الصعاليك، يقول الحسّون:
” فعلامَ تتركني بلادي تائهاً خلف الحدودْ ..
وعلامَ يا قلبي المهاجر لا تفكّر أن تعود ..
مادام بحر العمر، بحر الجمر لا يحتاج كي نمضي نقود .. “ ص ٣٢ .
فهل هي أضغاث أحلامّ كما سمّى الشاعر قصيدته، أم الحلم والواقع بآن حين نستيقظ من أحلامنا .
الشاعر الحسون لا يتحدث عن قصة حدثتْ ليطرّز بها بعض قصائده هنا وهناك، بل هو الشاعر الذي يشفّ حدسهُ وشاعريتهُ وذوقهُ الاستشرافي عن ماهية الأشياء وجوهرها، ولا يعبأ بحوادث التاريخ الموروثة شعرياً بقدر ما يستجلي الواقع الرّاهن بصورته المماثلة لذات الصور المنقولة لتوجيهنا إلى نفس الحالة الماضية الحاضرة المتتابعة بآن، وهذه مهمّة الشاعر الذي ترقّ ستارة إبهام الشعر لتغدو الصورة قريبة من النظر، ملامسة للقلب، لا تربكنا بإبهامها وغموضها كي يحرفنا تزويق وتزيين الجملة الشعرية عما يريده لنا الشاعر، وهو أن نذهب إلى مسرح الفكرة الشاعرة لنلج في مضمونها، ونعيش حالتها ونتماهى مع كل إشراقاتها الفجائعية.
ولكي لا تضيع بوصلة الشاعر منا، ونفقد نشيده الصاخب الصفاء تجاه أنثاه، لا بدّ لنا وأن نعترف بأن الشاعر يمتلك دفقات شعرية عشقية كتلك الإنسانية التي مرّت ووسمت مقبوساتنا السابقة، فالمرأة لديه شريكة العمر في رفع مداميك الحياة مع الرجل عالياً، ولا يتأتى ذلك إلّا بذلك النشيد الخالد الذي أطلقاه معا منذ أن أهدته تفاحتها المشتهاة، وإلّا لكان الكون يمشي على قدم واحدة وعندها يتعثر، يقول:
” لكِ في خاطر الورد ربيعٌ من قصيدْ ..
وعلى ليلكةالسّحر تلافيف النّشيدْ ..
لك حبّي ..
ثم فوق الحب حب من جديدْ ..
لك دنيا من عبيرٍ كي يصيرَ العيدُ عيدْ ..” ص ٤١ .
ويزيد الشاعر من سرعة جريان جداوله نحو بحور الجمال والبهاء عند النساء، فهو لا يرى كوناً ملوناً إلّا بهنّ، ولا يرى وجوداً بهيّاً من دونهنّ، وليس مغالياً في كلّ هذا، بل يضع القصيدة في مكانها العالي والعاجي عندما يسلّمها مفاتيح الشعر والحياة بآن، يقول :
” فكلُّ الممالكِ تسقطُ والحامياتُ ..
ولكن ستبقى برغم الخطوبِ ..
برغم الزّمان ..
عيونُ النّساءْ ..
ستبقين أنثى تمرُّ يداكِ بجوفِ الخرابِ ..
فيغدو ربيعاً ..
وتغدو الصّحارى إذا مرّ طيفكِ واحةَ ماءْ ..” ص ٢٢ .
الشاعر مصطفى الحسّون يعيد الروح لذاته وللحياة عبر وجود الأنثى، وبهذا يرمم ما تصدّع وانهار في روحه والمجتمع بوجود هذا الكائن الجميل الذي يتجاوز الممالك والحضارات بالبقاء، ويحيي الصحارى ويحيلها بمجرد مرور طيفها إلى واحة ماء، وهل نحن بعد كلّ ذلك بحاجة لأن نبرهن على أن الشاعر رغم كل المأساة الدامية، والجراحات البليغة، والندبات الموجعة، فهو يرفو الحياة بامرأة وقصيدة.
جاءت لغة الشاعر في كل الديوان مرج مخضوضر من المفردات والجمل السلسة والرشيقة والهادئة، تطرزه زهور انزياحات جاذبة ومزركشة ما منح الجملة الشعرية لديه توازنها الشاعري والشعري دون أدنى نتوءات من غموض، أو تقعرات في اللغة، أو استغلاق في الصورة، كل ذلك عبر شلالات بطيئة وهادئة من الموسيقا الخليلية التي رافقت المجموعة، إلى الإيقاعات الداخلية التي تناغمت مع بعضها لتمنحنا جوّاً هادئاً رخيماً منساباً تضافرت فيه الكلمة والصورة واللحن ليصلَ إلينا نشيداً صافياً يعلي لدى ذائقتنا منسوب المتعة، وارتقاء المزاج، وخصوصاً أنّه ما مرّ على وجع او غربة أو رماد، إلّا وأعقبها بآمال فسيحة عبر عنها بمفردات صائبة، كالورد والعطر والشروق والأمل والصباحات الجديدة.
تهنئتي لك الشاعر مصطفى الحسون وإلى مزيد من الإبداع والعطاء والألق.