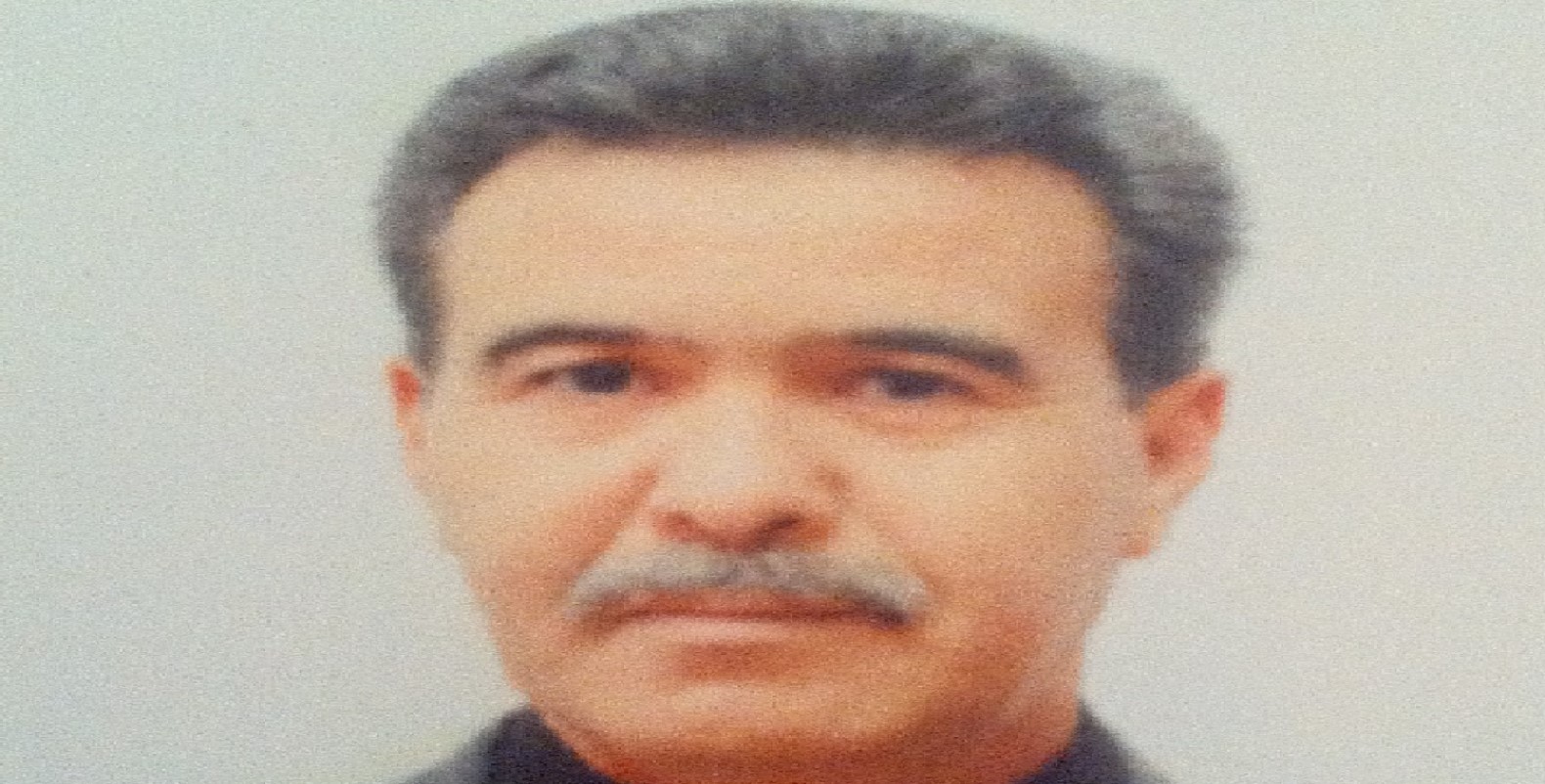الأبارتهايد كحل للمعضلة الديمغرافية

نهاد أبو غوش | فلسطين

في معظم دول العالم الطبيعية، تكتسب الدراسات الديمغرافية طابعا شيقا ومثيرا لما تكشفه عن خصائص التركيبة السكانية للبلد، سماتها وشرائحها وقطاعاتها المكونة، واتجاهات تطورها التي غالبا ما تنطوي على عناصر تنوع وإثراء للمجتمع المعني، وتطرح فرصا وتحديات وواجبات على صناع القرار من السياسيين والمخططين نظرا لما يمكن أن تكشفه الدراسات والتحليلات من تباينات وفروق في درجات التطور، أو معدلات الدخل والاستفادة من الخدمات العامة أو التحصيل التعليمي وغير ذلك من مؤشرات التنمية. أما في الدول التي تنتهج سياسات التمييز العنصري فسوف يكون الأمر معاكسا تماما، وهذا ما ينطبق على دولة “إسرائيل” التي ربما تكون الدولة الوحيدة في العالم التي تستخدم مصطلح “الخطر الديمغرافي” و”القنبلة الديمغرافية” في إشارة للخطر الذي يمثله السكان، وتحديدا الفلسطينيون الباقون في وطنهم، سواء في ذلك الجزء المحتل منذ العام 1948 والذي فرضت فيه الجنسية الإسرائيلية على الفلسطينيين، أو في الأراضي المحتلة بعدوان حزيران 1967.
حين نبحث في المعضلة الديمغرافية في إسرائيل، فإننا نتحدث عن حقلين متمايزين، ولكنهما متقاطعان ومتداخلان، ومحكومان بالمنطق العنصري التمييزي نفسه.
يرتبط الحقل الأول، وهو الرئيسي على كل حال، بنظرة المؤسسة الصهيونية الحاكمة للفلسطينيين باعتبارهم تهديدا لنجاح المشروع الصهيوني، أما الحقل الثاني فيتصل بالتركيبة السكانية الداخلية للمشروع الصهيوني الذي فشل بعد 73 عاما في تحقيق رؤية أبرز مؤسسيه دافيد بن غوريون حول “بوتقة الصهر” وهي آلية اجتماعية ثقافية تربوية اعتمدتها المؤسسة الصهيونية لخلق إنسان إسرائيلي صهيوني جديد، وشعب جديد مختلف عن جذوره التي جاءت من مناطق مختلفة ومتنافرة، لكن هذه الآلية العنصرية المنحازة للأشكناز الغربيين ضد الشرقيين ما لبثت أن انتكست، وها هي المجاميع الاثنية والعرقية المشكلة لدولة إسرائيل تعبر عن نفسها كل يوم وخاصة في الدورات الانتخابية المتعاقبة، كما في لغة الشارع اليومية، وفي الثقافة والفنون وفي أماكن السكن وقطاعات العمل المختلفة.
وبالنسبة للحقل الأول الذي سنركز عليه في هذا المقال، تتبدى مشكلة الفلسطينيين الديمغرافية بالنسبة للمشروع الصهيوني ، في علاقة “دولة إسرائيل” مع مجموع الفلسطينيين الذين يعيشون على أرض فلسطين التاريخية، والذين بات عددهم مساويا لعدد اليهود الإسرائيليين، فحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغ عدد من يعيش في فلسطين التاريخية من الفلسطينيين 6.8 مليون فلسطيني، مقابل 6.88 مليون يهودي. وتوقعت علا عوض رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء أن يتساوى عدد الفلسطينيين مع اليهود في نهاية العام 2022 ليبلغ نحو 7.1 مليون لكل منهم (1)، وهذا بخلاف وجود اكثر من 6.5 مليون فلسطييني في بلدان الشتات والمهاجر، بالإضافة إلى وجود ما بين 800 ألف – 900 ألف إسرائيلي يهودي يقيمون بشكل دائم (اكثر من سنة) في الخارج.
شعب يحكم شعبا آخر
تساوي أعداد اليهود والفلسطينيين على أرض فلسطين يطرح جملة من المشكلات السياسية والقانونية والأخلاقية على دولة إسرائيل في ضوء رفضها القاطع لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وهي مشكلات يلخصها سؤال: كيف لشعب أن يحكم شعبا آخر يساويه في العدد أو يفوقه، ويحرمه من حقوقه المدنية والسياسية كافة؟ يثور هذا السؤال وتشتد حدته مع مضي إسرائيل قدما في بناء نظام الأبارتهايد الذي اتخذ طابعا رسميا وقانونيا بعد إقرار قانون القومية في تموز 2018 وهو القانون الذي حصر حق تقرير المصير في “أرض إسرائيل” بالشعب اليهودي.
السؤال السابق لا يؤرق الأوساط اليمينية والعنصرية المتطرفة، التي يزداد نفوذها وتاثيرها في إسرائيل يوما بعد يوما، لا سيما وأنها تحظى بدعم وغطاء دائمين من قبل الإدارة الأميركية سواء كانت جمهورية او ديمقراطية، إلى تواطؤ، او تغاضي العواصم المركزية في أوروبا، مع اندلاق عدد من الأنظمة العربية للتطبيع مع إسرائيل حتى وهي في ذروة تطرفها وعنصريتها.
لكن السؤال يبقى مؤرقا لبعض أوساط المثقفين وصناع السياسة والمخططين الاستراتيجيين، وأحد الخيارات الرئيسية لتقليص حجم المشكلة هي محاولات إخراج قطاع غزة بسكانه المليونين من معادلة الصراع، من خلال العمل لإدامة الانقسام الفلسطيني، ومواصلة السياسات التي تجعل من الأراضي الفلسطينية المحتلة مكانا طاردا لسكانه، مع بقاء خيارات الترانسفير ضمن الحلول المعتمدة، وتأجيل الحل النهائي إلى أمد غير منظور.
القنبلة الديمغرافية
وبالنسبة لفلسطينيي الداخل عبر النائب الصهيوني المتطرف بتسليئيل سموتريتش رئيس قائمة الصهيونية الدينية مؤخرا عما يجول داخل وعي كثير من قادة الحركة الصهيونية، حين تحدث من على منصة الكنيست وقال ان بن غوريون لم يكمل المهمة التي بدأ بها ولم يطرد جميع العرب(2)، وكان هذا النائب الفاشي يتحدث خلال نقاش قانون الهجرة، وضرورة الحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، وخلال حديثه صاح مخاطبا النواب العرب ” نعم يهودية ..بأغلبية يهودية.. . أنتم هنا عن طريق الخطا، والخطأ هو ان بن غوريون لم يكمل المهمة ولم يطردكم في العام 1948″.
تصريحات النائب سموتريتش ليست سوى وجه واحد من الوجوه الصارخة والفجة عن موقف المؤسسة الصهيونية الحاكمة من فلسطينيي المناطق المحتلة عام 1948، فثمة مواقف سياسية أكثر نعومة في الظاهر، وإن حافظت على نفس الجوهر التمييزي العنصري، والتي تتفاوت بين طرح خيار الترحيل الجماعي (الترانسفير) والذي تبناه كل من الوزير المقتول رحبعام زئيفي كخط رئيسي لسياسة حزبه (موليدت)، أو كما يطرح الوزير أفيغدور ليبرمان بضم سكان (وليس أراضي) بلدات وقرى المثلث لمناطق الحكم الذاتي المقترح للسلطة الفلسطينية، والغريب أن هذه الصيغة وجدت طريقها لكي يتبناها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مشروعه المسمى “صفقة القرن” التي هي في حقيقة الأمر تبنيا من قبل ترامب لبرنامج اليمين الإسرائيلي المتطرف. التيارات الرئيسية في الحركة الصهيونية تزيّن خطاباتها عن اندماج المواطنين العرب في الدولة (يحجمون عن وصفهم بالفلسطينيين) ويتحدثون عن حقوق متساوية للمواطنين، ولكن في المحطات الفارقة، وفي الممارسات الفعلية في مختلف ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية تنحاز القوى السياسية الصهيونية جميعها ل”يهودية” الدولة في مواجهة “ديمقراطيتها” إذا كان ثمن هذه الديمقراطية المفترض حقوقا سياسية ومدنية متساوية.
اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، وتشتيتهم في المنافي، ثم العمل على تبديد هويتهم الوطنية، بدا شرطا ضروريا من شروط نجاح المشروع الصهيوني على الأرض واستقراره، ولهذه الغايات الواضحة المعلنة، أي لهذه المهمة التي لم يكملها بن غوريون، استخدمت العصابات الصهيونية ولاحقا دولة إسرائيل، كل ادوات التهجير والترحيل وابرزها المجازر لترويع الفلسطينيين ودفعهم للهجرة الطوعية كما جرى في سلسلة المجازر المعروفة على امتداد فلسطين من الطنطورة قرب حيفا شمالا، إلى دير ياسين في ضواحي القدس والدوايمة في منطقة الخليل، إلى جانب عشرات المجازر الصغيرة والمتوسطة والعمليات العسكرية ضد المدنيين في قلب المدن والتجمعات الفلسطينية، وعمليات الترويع والتهديد والتخويف، والتي نجحت في مجموعها في تشريد وتهجير نحو نصف مليون فلسطيني، وتدمير أكثر من اربعمئة قرية ومدينة، وعلى الرغم من كل هذه الأعمال، فقد بقي في المناطق المحتلة عام 1948 نحو 170 ألف فلسطيني شكلوا في ذلك الوقت نحو 16% من مجموع سكان الدولة الناشئة، ويمثلون 13% من تعداد الشعب الفلسطيني.
كان يمكن للدولة الصهيونية أن تتسامح مع بقاء هذه النسبة الضئيلة من الفلسطينيين الذين بقوا في أرضهم، لولا أنهم لم يرضخوا للتصنيف الذي اريد لهم فيه أن يكونوا في مرتبة ادنى، منقوصي الحقوق المدنية والسياسية، وظلوا على الدوام متشبثين بأرضهم وبهويتهم الوطنية وبانتمائهم للشعب العربي الفلسطيني كما ثبت في الهبات والانتفاضات المتكررة وأبرزها يوم الرض عام 1976، هبة تشرين عام 2000، والهبة التضامنية في ايار الماضي تزامنا مع أحداث القدس ومعركة سيف القدس.
حطابون وسقاة ماء
لا تعود فكرة التسامح هذه إلى منطق قبول الآخر المختلف، بل لأن منظري الحركة الصهيونية في بداياتها الأولى تطرقوا إلى وجود شعب آخر غير يهودي، فالذي كان يهم جابوتنسكي على سبيل المثال هو الاحتفاظ بأغلبية يهودية في الدولة المنوي إنشاؤها(3) وكان هذا الأخير مستعدا لقبول مليون او مليوني عربي بين النهر والبحر طالما تواجد في المنطقة يهود أكثر منهم. لكن هذه النظرة “التسامحية” في ظاهرها لم تكن سوى غطاء لنظرة عنصرية كانت وما زالت حتى الآن تنظر لغير اليهود على أنهم أقل شأنا من اليهود أي “حطابين وسقاة ماء” كما ورد في التوراة، وهو المصطلح الذي ظل حاضرا في أدبيات قادة الحركة الصهيونية وحتى لدى مسؤولي دولة إسرائيل على شاكلة أوري لوبراني الذي شغل منصب مستشار بن غوريون للشؤون العربية وشغل مواقع دبلوماسية وسياسية متصلة بالعرب في عدة حكومات لاحقة.
إزاء رفض الفلسطينيين العرب الاستكانة لمصيرهم الدوني المرسوم، مدنهم وقراهم على امتداد سنوات الاحتلال الطويلة، عملت المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة بشكل منهجي على فصم انتماء فلسطينيي الداخل عن أمتهم العربية وشعبهم الفلسطيني، من خلال جملة من السياسات والإجراءات، ابرزها تقسيم هؤلاء الفلسطينيين إلى مجموعات طائفية وسكانية متمايزة (عرب مسلمون ومسيحيون، وبدو ودروز وشركس)، هذه السياسات التمييزية لم تحقق سوى نتائج محدودة وبشكل خاص من خلال فرض التجنيد الإجباري على الفلسطينيين الدروز ومحاولة اصطناع هوية درزية متمايزة، لكن هذه المساعي تواجبه مقاومة وطنية مستمرة من قبل عموم القوى الوطنية في الداخل ومن قبل منظمات أهلية ومبادرات ناشطة في أوساط الدروز بشكل خاص.
ولا تقتصر الخشية الصهيونية من وجود الفلسطينيين في الداخل من حجمهم ونسبتهم العددية، التي لا تمثل اي تهديد للأغلبية اليهودية في المدى المنظور، ولكنهم يهددون المشروع الصهيوني من زاويتين، زاوية نقائه العنصري باعتباره فكرا عنصريا في الفكر والممارسة، وزاوية الخشية الحقيقية السياسية، من أن يحول فلسطينيو الداخل وزنهم وحجمهم إلى قوىة سياسية مؤثرة في معادلة الصراع العام الفلسطيني الإسرائيلي، ويالتالي ينحازون إلى “شعبهم” الفلسطيني في مواجهة “دولتهم” الإسرائيلية، لذلك سعت المؤسسة الصهيوينية الحاكمة إلى تقليص حقوقهم يوما بعد يوم من خلال سلسلة من التشريعات العنصرية التي لا تكتفي بالانتقاص من حقوقهم المدنية والسياسية، بل تطعن حتى في شرعية تمثيلهم السياسي ومشروعية انتمائهم لشعبهم الفلسطيني.
هوامش
(1) المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتائج العام 2020 ، 31/12/2020
(2) تايمز أوف يسرائيل 13/10/2021
(3) سيرة حياة واعمال فلاديمير جابوتنسكي، موقع مدار، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية