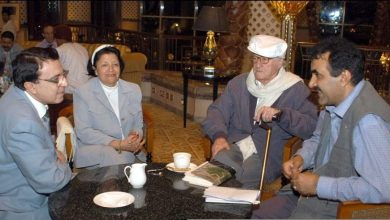التاريخ الإسلامي بين التدوين والتأويل

بقلم: حسن محمد العمراني
هناك رأي سائد أن التاريخ يكتبه المنتصر. وهو رأي راجح إلى حدٍ كبير. فمن يملك إرادته، هو القادر غالباً على إملاء التاريخ واستكتابه.والتاريخ -مثله مثل السير والمغازي والفتوحات- قابل للتأويل والحذف والإضافة، والذي بدوره قد يخل بواقع الحدث قلباً وقالَباً، وخصوصاً عندما يخضع للشطط والذاتية الممجوجة. لكنه أيضاً فيه ما فيه من العبر، وذلك للتأسي بقصص الغابرين والوقوف على آثارهم واستنباط العبرة والمثل، لمسايرة الواقع واستشراف المستقبل.

غير أن الغريب في الأمر أن هناك بعضاً من المؤرخين المتحفظين أنفسهم من يرسل العبارات جزافاً أو تعميماً بأن التاريخ مجموعة من الأكاذيب متفق عليها! لكن الواقع والدراسات الأكاديمية تكاد تجزم أنه لا يوجد هناك إجماع بين المفكرين والمثقفين والمنظرين حتى الآن على أن التاريخ كله أكاذيب أو كله حقائق. لماذا؟! لأن هناك ما يُسمى بالقرائن والشواهد التي يعضد بعضها بعضاً، فترقى لكونها أدلة كبياض الصبح على صحة حادثة ما أو موقف تاريخي بعينه. وإلا لماذا نقرأ التاريخ الإسلامي، القديم والمعاصر؟! وماذا عن سيرة ابن هشام مثلاً؟! وكتاب “تاريخ مكة” ” وكتاب “أعلام الملوك والنبلاء” للذهبي؟ وكتاب ” المستطرف في كل فن مستظرف” للأبشيهي؟! وكتاب “المُلْك” لابن الجوزي؟! وكتاب “تاريخ الحملات الصليبية” للدكتور ممدوح حسين؟! وكتاب “تاريخ المغول” و”حياة محمد” لهيكل و”عبقرية المسيح” للعقاد؟! و”حياة المسيح” لخالد محمد خالد؟! و” حياة الصحابة” للكندهاوي، وغيرها من أمهات الكتب وعيون التراث؟! أليس هذا تاريخاً يؤصل لأحداثٍ جسام؟!

وقد يتبادر للذهن هذا السؤال: لماذا التركيز على التاريخ الإسلامي دون التعرض للصنوف التاريخية الأخرى؟! ذلك لأن التاريخ الإسلامي يلمس جانباً عقدياً فريداً، له كينونته الراسخة التي تشكل كيان ونسيج الأمة. كما أنه يضع المثقف المستنير على المحك. فالقضية ليس مفادها ماذا نقرأ أو نطالع من كتب التاريخ بقدر ما تتوقف على محاور وعناصر أخرى في غاية الأهمية: كمن هو الذي يقرأ، وماذا يقرأ، وكيف يقرأ ولمن يقرأ. وتلك هي القراءة الواعية الراشدة الفاحصة لكتب التاريخ والروافد الثقافية الأخرى. وأرى أن ذلك لا يتحقق، بل قد لا يتسنى، إلا من خلال دراية وخلفية كاملة وواعية، تمكن المطالع للتاريخ الإسلامي من خوض معركة التنوير بخطى واثقة، يميز فيها الخبيث من الطيب والغث من الثمين، والسم في العسل. وذلك ينطوى على جرأة لا تفقد المثقف جذوره ولا تأتي على ثوابته من جانب، ولا ترده العصور الجهل والجمود والتخلف من جانب آخر. ولكلٍ معالم يقف عليها، تمكنه من التوفيق بين الراكد والوافد دون شطط مُضل أو جنوح مُخِلّ. وهناك أيضاً فارق كبير بين رواية التاريخ – التي تخضع للتمحيص والتفنيد والتثبت والتأصيل، وتلك الرواية التاريخية التي قد تجنح أحياناً للتأويل الشخصي والرؤية الوحدوية والمغالاة وتغليب الهوى، بل للتحامل على واقعية الحدث وتفريغه من مضمونه الأصيل دون الوقوف على ملابساته الأصلية.